خطبة الجمعة من المسجد الحرام: أثرُ الإيمانِ بالغيبِ واليومِ الآخر
خطب الحرمين الشريفين

أثرُ
الإيمانِ بالغيبِ واليومِ الآخر
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن
محمد آل طالب - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "أثرُ الإيمانِ بالغيبِ واليومِ
الآخر"، والتي تحدَّث فيها عن الإيمانِ بالغيبِ واليوم الآخر والبَعثِ
والنُّشُور، وأثرِ ذلك في حياةِ العبدِ، وانعِكاسِهِ على أقوالِه وأفعالِه
وسُلُوكِه.
الخطبة الأولى
إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفُسنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ الطيبين الطاهِرين، وصحابتِه الغُرِّ الميَامِين، والتابِعِين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
ثم أُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى الله في السرِّ والعلانِية، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: 3]. فتزوَّدُوا ليوم معادِكم، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281].
ما التكالِيفُ إلا لتحقيقِ العبوديَّة وتقوَى الله - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
ألا وإن شهرَكم قد أخذَ في النقصِ، فزِيدُوا أنتُم في العملِ، ولئِن قارَبَ أن يتصرَّمَ ثُلُثاه، فقَد بقِيَ خيرُه وأزكاه: عشرُ ليالٍ مِن آخرِ رمضان هي مِضمارُ السابِقِين، ومَغنَمُ الرابِحِين.
"كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهِدُ في العشرِ الأواخِرِ ما لا يجتهِدُ في غيرِه"؛ رواه مسلم.
وفي "الصحيحين": "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخَلَت العشرُ شدَّ مِزرَه، وأحيَا ليلَه، وأيقَظَ أهلَه".
فيها ليلةٌ هي خيرٌ مِن ألفِ شهر، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قامَ ليلةَ القَدر إيمانًا واحتِسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ»؛ متفق عليه.
وعن عائشة - رضي الله عنها -، "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتَكِفُ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضان حتى توفَّاه الله، ثم اعتَكَفَ أزواجُهُ مِن بعدِه"؛ أخرجه الشيخان.
بِسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 1- 5].
إن إدراكَ شهر رمضان نعمةٌ مِن الله سابِغة، ومِنَّةٌ مِنه بالِغة؛ فهو شهرُ الصيام والقِيام، وغُفران الذنوبِ ومَحوِ الآثام، ومَن صَامَ رمضانَ وقامَه إيمانًا واحتِسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ.
شهرُ الصلاة والدُّعاء والقُرآن، وموسِمُ الصدقة والتوبةِ والإحسان، وتاريخُ الذِّكريات والفتُوحات. فتقرَّبُوا إلى الله ما استَطعتُم، وأبشِرُوا وأمِّلُوا.
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185] نزلَ القرآنُ في شهر رمضان، فكان مطلَعَ الصُّبح الصادِقِ في ليلِ الإنسانيَّةِ الغاسِقِ، ومِن سَنَا القرآن وجَذوَتِه تتبدَّدُ الظُّلَم، وبالتِماسِ الأمةِ هَديَها مِن هُداه، ورِيَّها مِن رُواه، يجمعُ الله لها شَعَثَ أمرِها، ويُبدِّدُ حالِكَ ليلِها.
وحقيقٌ بالأمة أن تعودَ إلى هذا القرآن في كل حِين، فتنهَلَ مِنه نَهلَ الظامِئِين، لا عودةً إلى قراءتِه فحسب، ولكن إلى تأمُّل معانِيه، وتدبُّر آياتِه، وبثِّ حقائِقِه في حياةِ الناسِ؛ لتكون قضايا القُرآن الكُبرى هي قضايا الناس؛ كقضايا التوحيدِ والبعثِ والرِّسالة، ولنُعظِّمَ ما عظَّمَه القُرآنُ مِن العقائِدِ والشرائِعِ والأخلاقِ، ونُعطِيَ كلَّ قضيةٍ بقَدرِ ما أعطاها القُرآن لا وَكسَ ولا شَطَط، إن فعَلنا ذلك فقد صدَقْنا في العَودة إلى القرآن، وما أحوَجَ الأمةَ أن تعودَ إلى كتابِ ربِّها، وتهتَدِيَ بهُداه.
عباد الله:
ومَن قرأَ القرآنَ العظيمَ رأى قضيةَ الإيمان باليوم الآخر والبعثِ والنُّشُور حاضِرةً فيه أتمَّ الحُضُور، كرَّرَها الله تعالى في مواضِعَ مِن كتابِه، وأعادَ القُرآنُ فيها وأبدَى، وضرَبَ الأمثالَ والآياتِ، وجادَلَ فيها المُشرِكِين، وأمَرَ الله نبيَّه مُحمدً - صلى الله عليه وسلم - أن يُقسِمَ عليها في ثلاثةِ مواضِع مِن كتابِهِ:
قال الله - عزَّ وجل -: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]، وقال - سبحانه -: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ [سبأ: 3]، وقال - عزَّ اسمُه -: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: 53].
فكان الإيمانُ باليوم الآخر رُكنًا مِن أركان الإيمان.
وفي التِّبيان: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177].
وفي حديثِ جبريل المشهُور - عليه السلام -، لما أتَى يُعلِّمُ الأمةَ أمرَ دينِها، والذي ورَدَت فيه معاقِدُ الدين وحُجَزُه، قال: "فأخبِرنِي عن الإيمانِ، قال: «الإيمانُ: أن تُؤمِنَ بالله وملائكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه واليوم الآخر، وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خيرِه وشرِّه»، قال: صدَقتَ"؛ رواه مسلم.
جاء أُبَيُّ بن خلَفٍ أو العاصُ بن وائِلٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفي يدِه عظمٌ رَمِيمٌ، وهو يُفتِّتُه ويُذرِيه في الهواء، ويقولُ: يا مُحمد! أتزْعُمُ أنَّ اللهَ يبعَثُ هذا؟ فقال: «نعم، يُميتُكَ اللهُ ثم يبعَثُكَ، ثم يحشُرُكَ إلى النار»، وأنزَلَ اللهُ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 77- 83].
أيها الناس:
خيرُ الأدواءِ لأمراضِ القلوبِ: المواعِظ، ومِن أعظمِ العِظاتِ: تذكُّرُ اليوم الآخر، وهَولُ المطلَعِ وبعثَرَة القبُور، ومشهَدُ البعثِ والنُّشُور.
يومٌ تذُوبُ فيه بين العالَمين الفوارِق، وتَبِينُ فيه وُجوهُ الحقائِق. يومٌ تنطَفِئُ فِيه مِن النُّفوسِ حُظُوظُها، وانتِصارُها لآرائِها وأفكارِها. يومَ يُعرَضُ العبدُ على ربِّه ليس معَهُ أحدٌ، ولا تَخفَى على اللهِ مِنه خافِيةٌ، ويكونُ فيه اللِّقاءُ الأعظَم، والمُواجَهةُ الكُبرَة؛ إنها مُواجهةُ الإنسانِ بكلِّ ضَعفِه مع الله - جلَّ جلالُه -؛ حيث لا تَخفَى عنه يومئذٍ خافِية، والأسرارُ في علمِه - سبحانه - ظاهِرةٌ علانِية.
أيها المُسلمون:
لحَظاتُ البعثِ بعد المَوتِ، وبِداياتُ استِهلالِ الحياةِ بعد الفناءِ، وأهوالُ يوم المطلَعِ مشهَدٌ طالَما أمَضَّ قُلوبَ العارِفِين، وأطالَ السُّهادَ في أعيُنِ المُتعبِّدِين، وانخَلَعَت له أفئِدَةُ المُوقِنِين.
ففي يومٍ ليس كسائِرِ الأيام، وعلى عرَصَاتٍ لا حياةَ فيها ولا أحياء، وفيه سُكُون هذا الكَونِ العظيمِ، وبعد فَناءِ الخلائِقِ أجمعين، وحين يأذَنُ ربُّ العالَمين تُمطِرُ السماءُ أربَعين صباحًا مطرًا غليظًا كأنَّهُ الطَّلِّ، فتنبُتُ مِنه أجسادُ الناسِ كما ينبُتُ البَقْلُ، وقد بَلِيَ مِن الناسِ كلُّ شيءٍ إلا عَجْبَ الذَّنَب - وهو العَظمُ المُستَدِيرُ الذي في أصلِ الظَّهر -، ومِنه يُركَّبُ الخَلقُ.
ثم ينفُخُ إسرافِيلُ - عليه السلام - في الصُّور نفخةَ البَعثِ والنُّشُور، فتُعادُ الأرواحُ إلى الأجسادِ، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: 51].
وتتشقَّقُ القُبُورُ عن أهلِها، ويخرُجُ الناسُ أجمَعُون مِن لدُنْ آدم - عليه السلام - إلى أن تقُومَ الساعةُ، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: 99]، ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: 53].
فتصوَّر في نفسِكَ الفَزَعَ لصَوتِ تشقُّق الأرضِ وتصدُّعِها، وخُروجِ الناسِ كلِّهِم مِن قبُورِهم، وقِيامِهم لله قَومةً واحِدة، ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الصافات: 19].
تتشقَّقُ عنهم القُبُور، وقد لبِثُوا فيها الأعوامَ والدُّهُور، في نعيمٍ أو عذابٍ، في فُسحةٍ أو ضِيقٍ، وأولُ مَن ينشَقُّ عنه القَبرُ مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، يقولُ - عليه الصلاة والسلام -: «أنا سيِّدُ ولَد آدم يوم القِيامَة، وأولُ مَن ينشَقُّ عنه القَبر، وأولُ شافِعٍ وأولُ مُشفَّعٍ».
يُحشَرُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104].
قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: يا رسولَ الله! الرِّجالُ والنِّساءُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟ فقال: «الأمرُ أشَدُّ مِن أن يُهِمَّهم ذلك».
وأولُ مَن يُكسَى مِن الخلائِقِ إبراهيمُ - عليه السلام -.
يخرُجُ الناسُ مِن قُبُورِهم يمُوجُ بعضُم في بعضٍ، يذهَبُون ويَجِيئُون، لا يَدرُون إلى أين يمضُون، في حَيرةٍ وتفرُّقٍ واضطِرابٍ، هل رأَيتَ الفَراشَ المبثُوث؟! ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: 4]، ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ [القمر: 7، 8]، ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 52].
يُقالُ لهم: يا أيها الناس! هلُمُّوا إلى ربِّكم، ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: 108]، ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101]، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 34- 37]، ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: 16].
يُنادِي الجبَّارُ - جلَّ جلالُه -: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟! ثم يُجيبُ نفسَه: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 16، 17].
﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [الأنعام: 73].
يُبعَثُ رجُلٌ مِن قبرِهِ مُلبِّيًا: "لبَّيكَ اللهُمَّ لبَّيكَ"؛ لأنه ماتَ مُحرِمًا، ويُبعَثُ رجُلٌ يثعُبُ جُرحُه دمًا، اللَّونُ لَونُ الدمِ والرِّيحُ رِيحُ المِسكِ، ذاك هو الشَّهِيدُ في سبيلِ الله.
ويُساقُ الناسِ إلى أرضِ المحشَر، وأرضُ المحشَرِ أرضٌ بيضاءُ نقِيَّة، ليس فيها مَعلَمٌ لأحدٍ، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: 105- 107].
يُحشَرُ المُؤمنون إلى العَرَصات: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: 85]، ويُحشَرُ المُجرِمُون يومئذٍ زُرْقًا، واجِفةً قُلُوبُهم، خاشِعةً أبصارُهم، شاخِصةً لا ترتَدُّ إليهم، ويُحشَرُ الكافِرُ على وجهِهِ.
قال رجُلٌ: يا نبيَّ الله! كيف يُحشَرُ الكافِرُ على وجهِهِ؟ قال: «ألَيسَ الذي أمشَاهُ على رِجلَين في الدُّنيا قادِرًا على أن يُمشِيَه على وجهِهِ يوم القِيامَة؟!»، ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: 97].
ويُحشَرُ المُتكبِّرُون كأمثالِ الذَّرِّ في صُورةِ الرِّجال.
وتُحشَرُ الخلائِقُ كلُّها حتى الوُحوش والبهائِم، ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: 5]، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38]، ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: 49، 50]، ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود: 103]، ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 47].
وإذا جمعَ الله الأولين والآخرين يُرفَعُ لكل غادِرٍ لِواء، يُقالُ: «هذِهِ غَدرَةُ فُلانِ بن فُلانٍ».
ويأتِي كلُّ امرِئٍ بما غَلَّ يحمِلُهُ على ظَهرِه؛ مِن ذهبٍ، أو فضَّةٍ، أو غيرِ ذلك؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجِيءُ يوم القِيامة على رقَبَتِه بَعِيرٌ له رُغاء، يقُولُ: يا رسولَ الله! أغِثْنِي، فأقُولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد أبلَغتُكَ».
والغَلُولُ هو ما أُخِذَ مِن مالِ المُسلمين العام بغيرِ حقٍّ، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 161].
﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ فأضاءَت حين يتجلَّى الحقُّ - تبارك وتعالى - للخلائِقِ لفصلِ القضاء، ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ كِتابُ الأعمال، ﴿وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ يشهَدُون على الأُمم بأنَّهم بلَّغُوهم رسالاتِ الله إليهم، ﴿وَالشُّهَدَاءِ﴾ مِن الملائِكةِ الحَفَظَة على أعمالِ العِباد مِن خيرٍ وشرٍّ، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: 69].
قال الله - عزَّ وجل -: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47].
ترَى الوجوهَ يومئذٍ إما مُبيَضَّةً أو مُسوَدَّةً، وترَى الموازِين طائِشةً إما ثِقالًا وإما خِفافًا، وترَى الكُتبَ إما في ميامِنِ الأيدِي أو في شمائِلِها.
فلله! ما أعظمَ ذلك الموقِف! ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4]، يطُولُ على الناس الوقُوف، وتدنُو مِنهم الشمسُ على قَدرِ مِيل، ويعرَقُون على قَدرِ أعمالِهم، وأُناسٌ في ظِلِّ عرشِ الرحمن يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه، حتى يأذَنَ اللهُ بالشفاعَةِ لمُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في الفصلِ بين الخلائِقِ، ويُنِيلُه المقامَ المحمُود.
فصلَّى الله على مُحمدٍ في الأولين، وفي الآخرين.
﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75].
يحكُمُ الله في الأولين والآخرين، وينطِقُ الكَونُ أجمعُه، ناطِقُه وبهيمُه لله ربِّ العالمين بالحمدِ في حُكمِه وعدلِه، فكلُّ المخلُوقات شهِدَت له بالحمدِ.
قال قتادةُ: "افتَتَحَ الخَلقَ بالحمدِ في قولِه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1]، واختَتَمَ الحمدَ في قولِه: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾".
بِسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 101- 103].
اللهم اجعَلنا يومَ الفزَعِ مِن الآمِنِين، ولحَوضِ نبيِّك مِن الوارِدِين، ومِمَّن يأخُذُ كتابَه باليَمين، وارزُقنا الفِردوسَ الأعلَى مِن الجنَّة يا أرحم الراحمين.
بارَك الله لي ولكم في القرآن والسنَّة، ونفَعَنا بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ الله تعالى لي ولكم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرحمنِ الرحيم، مالِك يوم الدين، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له الملِكُ الحقُّ المُبِين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الصادِقُ الأمين، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وصحبِه أجمعين.
أما بعدُ .. أيها المُسلمون:
فإن الإيمانَ باليوم الآخر وبالبعثِ والنُّشُور كفِيلٌ بتصحيحِ مسارِ الحياة، وأن تنبَعِثَ الجوارِحُ إلى الطاعات، وتكُفَّ عن المعاصِي والسيِّئات، وآياتُ القُرآن تُبِينُ هذا المعنَى، وتُظهِرُ علاقةَ الإيمانِ باليوم الآخر بفِعلِ الطاعاتِ والكفِّ عن المعاصِي.
يقولُ الله - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 18]، ويقولُ - سبحانه -: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 45، 46]، ويقولُ لنبيِّه: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: 85]، وفي آياتِ الطلاقِ: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: 232].
مَن آمنَ باليو الآخر حقَّ الإيمان، وكانت الآخرةُ حاضِرةً في قلبِه؛ كفَّ عن الحرام، وابتَعَدَ عن الآثام، ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: 36].
يقولُ الحقُّ - سبحانه - مُحذِّرًا: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 1- 6].
عباد الله:
الإيمانُ باليوم الآخر يصنَعُ إنسانًا جديدًا له أخلاقُه وقِيَمُه ومباِدئُه، ونظرتُه إلى الحياة، لا يلتَقِي إنسانٌ يُؤمنُ بالآخرة ويحسِبُ حسابَها مع آخر يعيشُ لهذه الدنيا وحدَها، ولا ينتَظِرُ ما وراءَها، ولا يلتَقِي هذا وذاك في تقديرٍ أمرٍ واحدٍ مِن أمورِ هذه الحياةِ، ولا قِيمةٍ واحدةٍ مِن قِيَمِها الكثيرة، ولا يتَّفِقان في حُكمٍ على حادِثٍ أو حُكمٍ أو شأنٍ مِن الشُّؤون، فلكلٍّ مِنهما مِيزان، ولكلٍّ مِنهما نظرٌ يرَى عليه الأشياءَ والأحداثَ، والقِيَمَ والأحوالَ.
الإيمانُ باليوم الآخر يُزيلُ الشُّبَهَ الوارِدةَ على القلوبِ والعقُول، وضعفُ الإيمانِ بذلك اليوم يُنبِتُ في القلبِ الشُّكُوكَ والشُّبُهات، قال الله - عزَّ وجل -: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: 112، 113].
ومتى آمَنَ العبدُ باليوم الآخر، وأيقَنَ بما بعد المَوتِ، تقشَّعَت عنه كثيرٌ مِن الشُّبُهات، ومَن قرأَ القرآنَ بقلبٍ حاضرٍ أسفَرَ صُبحُ فُؤادِه؛ فإنه كلامُ الله، وفيه الشِّفاءُ لأمراضِ القلوبِ والأبدان: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].
أيها المُسلمون:
المُؤمنُ بالله واليوم الآخر مُرتاحُ الضَّمير، مُطمئنٌّ إلى مُستقبَلِهِ النَّضِير، يُؤمِّلُ رحمةَ الله وعفوَه وإحسانَه، ويخشَى ربَّه، ويخافُ عذابَه، يُدرِكُ أنَّ بعد هذا اليومِ يومًا، وأن وراءَ الدنيا آخرة، إن فاتَه شيءٌ مِن الدنيا فهو يرجُو العِوَضَ في الآخرة، وما وقَعَت عليه مِن مُصيبةٍ فإنه يحتَسِبُها، وإن رأى نعيمًا في الدنيا تذكَّرَ نعيمَ الآخرة، يقرأُ قولَ الله - عزَّ وجل -: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64].
يعملُ في دُنياه كما أمَرَه الله، ويُحسِنُ إلى الناس، ويعمُرُ الأرضَ، يُؤمِنُ أن الآخرةَ تُعدِّلُ ما مالَ في هذه الدنيا مِن مَوازِين، وتخفِضُ ما ارتفَعَ مِن باطِلٍ، ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ [الواقعة: 1- 3].
اللهم اجعَلنا مِمَّن يُؤمِنُ بالآخرة أعظمَ الإيمان، ويُوقِنُ بها حقَّ اليقِين، واجعَلنا عند الفَزَعِ مِن الآمِنِين، وإلى جنَّاتِك سابِقِين.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على مَن أرسلَه الله رحمةً للعالمين، وهَديًا للناسِ أجمعين.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابَتِه الغُرِّ الميامِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الطُّغاةَ والملاحِدةَ والمُفسِدين، اللهم انصُر دينَك وكِتابَك، وسُنَّة نبيِّك، وعِبادَك المُؤمنين.
اللهم مَن أرادَ الإسلامَ والمُسلمين ودِينَهم ودِيارَهم بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، ورُدَّ كيدَه في نَحرِه، واجعَل دائِرةَ السَّوء عليه يا رب العالمين.
اللهم انصُر المُجاهِدين في سبيلِك في فلسطين، وفي كل مكانٍ يا رب العالمين، اللهم فُكَّ حِصارَهم، وأصلِح أحوالَهم، واكبِت عدوَّهم.
اللهم إنا نسألُك باسمِك الأعظَم أن تلطُفَ بإخوانِنا المُسلمين في كل مكان، اللهم كُن لهم في فلسطين، وسُوريا، وفي العِراق، واليمَن، وبُورما، وفي كل مكانٍ، اللهم الْطُف بهم، وارفَع عنهم البلاءَ، وعجِّل لهم بالفرَج، اللهم أصلِح أحوالَهم، واجمَعهم على الهُدَى، واكفِهم شِرارَهم.
اللهم عليك بالطُّغاةَ الظالمين ومَن عاونَهم.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادمَ الحرمين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ به للبِرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه ونائِبَه وأعوانَهم لِما فيه صلاحُ العباد والبلاد.
اللهم احفَظ وسدِّد جُنودَنا المُرابِطين على ثُغورنا وحُدودِ بلادِنا، والمُجاهِدين لحِفظِ أمنِنا وأهلِنا ودِيارِنا المُقدَّسة، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا وحافِظًا.
اللهم انشُر الأمنَ والرخاءَ في بلادِنا وبلادِ المُسلمين، واكفِنا شرَّ الأشرار، وكيدَ الفُجَّار، وشرَّ طوارِقِ الليلِ والنهار.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ويسِّر أمورَنا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، اللهم اغفِر لنا ولوالدِينا ووالدِيهم وذُريَّاتهم، وأزواجِنا وذريَّاتِنا، إنك سميعُ الدعاء.
اللهم تقبَّل صِيامَنا، اللهم تقبَّل صِيامَنا، وقِيامَنا، ودُعاءَنا، وصالِحَ أعمالِنا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم.
سُبحان ربِّنا ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

اغتنامُ
العشر مِن رمضان
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "اغتنامُ العشر مِن رمضان"، والتي تحدَّث فيها عن محاسبةِ النفسِ في شهر رمضان وقد مرَّ أكثرُه، وعما قليلٍ سيرتَحِل، في وقفةٍ مع النفسِ؛ لينظُر كلُّ واحدٍ منَّا ماذا قدَّم فيه مِن أعمالٍ صالِحةٍ، وماذا اقترَفَ فيه مِن السيئات، فيجتهِد في الطاعات، ويجتنِبَ المُحرَّمات؛ ليسعَدَ بما أعدَّه الله تعالى للصائِمين والصائِمات، والقائِمين والقائِمات.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله ربِّ الأرض والسماوات، ذي النِّعَم والبركات، لا تنفعُه الطاعات، ولا تضُرُّه السيئات، وإنما تنفَعُ وتضُرُّ مَن عمِلَها والله الغنيُّ عن المخلُوقات، أحمدُ ربي وأشكُرُه على آلائِهِ التي نعلَمُ والتي لا نعلَمُ فله الحمدُ والشُّكرُ في جميعِ الحالات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، له الأسماءُ الحُسنى وأعظمُ الصِّفات، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالبراهين والمُعجِزات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه المُسارِعِين إلى الخَيرات.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عزَّ وجل - بالأعمال التي تُرضِيه، والبُعد عن غضَبِه ومعاصِيه؛ فما فازَ إلا المُتَّقُون، وما خسِرَ إلا المُجرِمُون.
أيها المُسلمون:
مُحاسَبةُ النَّفسِ، والاجتِهادُ في الطاعات، والازدِيادُ مِن الحسنات، والمُحافظةُ على ما أعانَ الله عليه ووفَّقَ مِن العمل الصالِح، والحَذَرُ مِن مُبطِلات الطاعات هو عَينُ السعادة والفَلاحِ في الحياةِ وبعد المَمات.
قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41]، وقال - عزَّ وجل - عن أهلِ الجنَّة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: 25- 27].
وقال - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].
قال ابنُ كثيرٍ - رحمه الله - في تفسيرِ قَولِ الله - سبحانه -: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: 18]: "حاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبُوا، وانظُروا ماذا ادَّخَرتُم لأنفسِكم مِن الأعمال الصالِحة ليوم معادِكم وعرضِكم على ربِّكم". اهـ.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الكَيِّسُ مَن دانَ نفسَه وعمِلَ لِما بعد الموتِ، والعاجِزُ مَن أتبَعَ نفسَه هواها وتمنَّى على الله» حديثٌ حسنٌ.
كما أنَّ الشقاوَةَ والخِذلانَ والخُسرانَ في اتِّباع الهَوَى، وركوبِ المُحرَّمات، وتركِ الطاعات، أو اقتِراف ما يُبطِل الحسنات. وبحَسبِ امرئٍ مِن الشرِّ أن يأتِيَ ما ينقُصُ به ثوابُ الطاعات.
أيها المُسلمون:
أنتُم ترَون سُرعةَ انقِضاء الأيام والليالِي، وإدبارَ السِّنين الخوالِي، وإنَّ يومًا مضَى لن يعُودَ بما فِيه، والعُمرُ ما هو ليالٍ وأيامٍ، ثم ينزِلُ الأجَل، ويقنطِعُ العمل، ويُعلَم غُرورُ الأمَل.
وقد ولَّى أكثرُ شهر الخَيرات، وبقِيَ أيامٌ وليالٍ شرِيفة، وساعاتٌ لطِيفَة، فمَن أحسَنَ فليَحمَدِ اللهَ الذي أعانَه ووفَّقَه، وليحفَظ أعمالَه مِن المُبطِلات، ومِن نقصِ الثوابِ والوقوعِ في العِقاب، وليُتبِعِ الإحسانَ بأحسنِ الإحسان، قال الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].
ومَن اعتراهُ بعضُ التقصير فليُجِدَّ في التَّشمِير، وليجتَهِد في العباداتِ والطاعات؛ ليجبُرَ التقصِير، فالأعمالُ بالخواتِيم، وليلةُ القَدر لا تزالُ مرجُوَّة، والذنوبُ برحمةِ الله - عزَّ وجل - ومغفرتِه وحِلمِه وكرمِه وتجاوُزه ممحُوَّة.
وفي الحديثِ: «مَن قامَ ليلةَ القَدر إيمانًا واحتِسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ»؛ رواه البخاري ومسلم مِن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 3].
قال المُفسِّرُون: "عبادتُها أفضلُ مِن عبادةِ ألفِ شهرٍ ليس فيها ليلةُ القَدر".
قال أبو مُصعَب أحمد بن أبي الزُّهريُّ: "حدَّثَنا مالِكٌ أنه بلغَه أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُرِيَ أعمارَ الناسِ قبلَه، فكأنَّه تقاصَرَ أعمارَ أمَّته ألا يبلُغُوا مِن العمل الذي بلَغَ غيرُهم في طُول العُمر، فأعطاه الله ليلةَ القَدر خَيرًا مِن ألف شهر".
ومِن حِكَم الله البالِغة العظيمة، ورحمتِه الواسِعة، وفضلِه الواسِع العظيم أن فرَضَ صِيامَ رمضان على الأمة الإسلاميَّة، الذي أُنزِل فيه القرآنُ المجيدُ، وسَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِيامَه ورغَّبَ فيه، فقال: «مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ»؛ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وحثَّ القرآنُ والسنَّةُ على أنواع البِرِّ كلِّها في هذا الشهر المُبارَك؛ ففرضُ صيامه، والترغيب في قِيامه، والحثُّ على فعلِ الخيرات فيه مِن شُكر الله على نعمةِ القرآن العظيم الذي أنزلَه الله رحمةً للعالَمين.
فالقُرآنُ أعظمُ وأجَلُّ النِّعَم، وأعلَى المِنَن التي تحيَا بها الرُّوح، فهو أولُ نِعَم الرُّوح على أمةِ الإسلام، وتأتِي بعده نِعمةُ الإيمان، فمَن وفَّقَه الله تعالى للإيمانِ مِن هذه الأمة، فقد اجتمعَ في حقِّه أولُ نعمةٍ عامَّة، وهي القُرآن المجيد، وأولُ نعمةٍ خاصَّة به، وهي الإيمان، ومِن حقِّ نعمة القرآن ومِن حقِّ نعمة الإيمان شُكرُ الله - عزَّ وجل - على ذلك، والصيامُ والقيامُ وأنواعُ الطاعات شُكرٌ لله تعالى على نعمِه، وتقرُّبٌ إليه، والنِّعمُ حقُّها، والواجِبُ لله عليها الشكرُ بالقول والعمل، ومحبَّة المُنعِمِ - جلَّ وعلا -.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1، 2].
والكَوثرُ: الخَيرُ الواسِعُ المُبارَك المُتَّصِل، ومِنه: نهرُ الكَوثَر.
فأرشَدَ الله نبيَّه مُحمدًا - صلى الله عليه وسلم - على هذه النِّعَم إلى القِيام بحقِّ الله تعالى بالصلاةِ وغيرِها مِن العبادات؛ ليُحسِن إلى نفسِه ويشكُر.
وقد وفَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مقاماتِ العباداتِ حقَّها، وقامَ بذلك أتمَّ قِيام، ثم أرشَدَ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - إلى الإحسانِ إلى الخلق بالإطعام وعُموم النَّفع. فهذا شُكرُ نبيِّنا وسيِّدنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على النِّعَم.
وقال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: 66].
وقال - عليه الصلاة والسلام - لعائشة - رضي الله عنها - لما قالت: يا رسولَ الله! أتُصلِّي حتى تتفطَّر قدَماك، وقد غفَرَ الله لك ما تقدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّر؟! قال: «أفلا أكُونُ عبدًا شَكُورًا؟!»؛ رواه البخاري ومسلم.
وقال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، وقال تعالى لمُوسَى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144].
ولما ذكَرَ الله نِعمَه على مريَم - عليها السلام -، قال: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: 43].
وقال عن الصحابةِ - رضي الله عنهم -: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29].
فشُكرُ الله بهذا.
فالعباداتُ في رمضان مِن شُكر الله على نعمةِ القُرآن العظيم، والقُرآنُ الكريمُ له سُلطانٌ قويٌّ على الرُّوح في رمضان، يهدِي الرُّوحَ إلى كل خيرٍ، ويزجُرثها عن كلِّ شرٍّ؛ لأنه لما ضعُفَت النفسُ الأمَّارةُ بالسُّوءِ مِن أجلِ الصَّوم تغذَّت الرُّوحُ بالقرآن فصَلُحَت.
واختَبِر نفسَك - أيها المُسلم -: هل تُبتَ إلى الله في رمضان؟ هل عمِلتَ لِما بعد المَوتِ في رمضان؟ هل ردَدتَ المظالِمَ إلى أهلِها قبل الحِسابِ واتَّقَيتَها؟ هل كَفَفتَ شرَّك عن الخلقِ؟ هل أحسَنتَ إلى الخلق؟ هل وصَلتَ الرَّحِم؟ هل برَرتَ والِدَيك؟ هل أمَرتَ بالمعروف ونهَيتَ عن المُنكَر؟ هل أقلَعتَ عن الرِّبا والمكاسِبِ المُحرَّمة؟
هل اجتَهَدتَ في الاقتِداءِ بالرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وصحابتِه والتابِعين لهم بإحسانٍ في صفاءِ الرُّوح، واستِقامةِ الخُلُق، وزِيادة الإيمان، وقوَّة اليقين والمعانِي السَّامِية التي نالُوها في رمضان؟
اقرأ كتابَك - أيها المُسلم - في الدُّنيا قبل أن يُقال لك في الآخرة: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14].
القُرآنُ العظيمُ النِّعمةُ العُظمَى التي أنزلَها الله في رمضان، ولن يُصلِح حالَ المُسلمين إلا القرآن والسنَّة.
ولو اجتمَعَ حُكماءُ العالَم مِن أولِهم إلى آخرهم أحياؤُهم وأمواتُهم لحَلِّ مُعضِلةٍ مِن مُعضِلات، لما اهتَدَوا إلى ذلك سبيلًا إلا بالقرآن العظيم.
انظُر مسألةَ العقيدة في الله تعالى وأسمائِه وصِفاتِه وأفعالهِ، وحقِّه في عبادتِه، كم عددُ العقائِدِ في هذا البابِ؟ لا تُعدُّ ولا تُحصَى، والحقُّ فيها ما قالَ القرآن الكريم.
ومُعضِلة الاقتِصاد في العالَم أعجَزَت الحُكماء، والحقُّ فيها ما قال القرآن والسنَّة.
وهكذا كلُّ مُعضِلات المُسلمين بيَّن القرآنُ الحقَّ فيها، وبعضٌ مِن غير المُسلمين استفادَ في بعضِ الأبوابِ مِن الشريعةِ الإسلاميَّة، ولا يُمكن أن يكون الناسُ كلُّهم مُسلمين، ولكن على المُسلمين أن يتمسَّكُوا بالقرآن والسنَّة، فإذا رأَى الناسُ القُدوةَ الحسنةَ مِن كل مُسلمٍ انتفَعُوا بها، ولو في أمورِ دُنياهم.
وكلُّ ابن آدم خطَّاء، وخَيرُ الخطَّائين التوابُون.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 9].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآياتِ والذكرِ الحكيم، ونفَعَنا بهَديِ سيِّد المُرسَلين وقولِه القَويم، أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائر المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِروه.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله رب العالمين، أحمدُ ربِّيَ وأشكُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له القويُّ المتين، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه الأمين، اللهم صَلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله تعالى، وتقرَّبُوا إليه - عزَّ وجل - بما أمَر، والبُعد عما نهَى عنه وزجَر، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14، 15]. رُوِيَ عن عُمر بن عبد العزيز أنه كان يأمُرُ الناسَ بإخراجِ صدقَةِ الفِطر ويتلُو هذه الآية.
وزكاةُ الفِطر واجِبةٌ على كل مُسلمٍ؛ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: "فرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صدقَةَ الفِطر صاعًا مِن بُرٍّ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن زَبِيب".
ومِقدارُ هذا الصَّاع ثلاثة كِيلو إلا شيئًا، والثلاثةُ أحوَط.
ويُجزِئُ قُوتُ البلَد، ولا تُجزِئُ القِيمة، وهي على الصَّغير والكبير، والذَّكَر والأُنثَى، ويجوزُ إخراجُها قبل العِيد بيومٍ أو يومَين، وهي طُهرةٌ للصائِمِ مِن اللَّغو، وتجبُرُ ما نقصَ مِن بعضِ التقصِير، ومَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهو مِن وقتِها، ومَن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدقَةٌ مِن الصدقات.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
اللهم وارضَ عن الصحابةِ أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديِّين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين برحمتِك يا أرحمَ الراحِمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذلَّ الشِّركَ والمُشركين، والكفرَ والكافرين يا رب العالمين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافِية، والمُعافاة الدائِمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم أعِذنا من شُرور أنفسِنا، اللهم أعِذنا من شُرور أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالِنا.
اللهم أحسن عاقِبتَنا في الأمورِ كلِّها، وأجرنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم تقبَّل ما وفَّقتَنا له وأعَنتَنا عليه مِن الحسنات، واحفَظها لنا يا ربَّ العالمين وللمُسلمين، اللهم وكفِّر عنَّا السيئات برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين، اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ يا رب العالمين، اللهم اجعَلنا وإياهم مِن الراشِدين، اللهم اغفِر لنا يا رب العالمين وللمُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل، ونعوذُ بك من النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا مِن إبليس وذريَّتِه وشياطينه وأوليائِه يا رب العالمين وجنوده يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن شُرورِ أنفُسِنا وسيِّئات أعمالِنا، اللهم أعِذِ المُسلمين مِن شُرور أنفسِهم وسيئات أعمالِهم يا رب العالمين، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارفَع الفتنَ، وأطفِئ الفتنَ عن المُسلمين، وأعِذنا وأعِذ المُسلمين مِن مُضِلَّات الفتَن.
اللهم ثبِّت قُلوبَنا على طاعتِك، اللهم يا مُصرِّف القلوبِ والأبصار صرِّف قُلوبَنا على طاعتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك أن تنصُر جنودَنا على القوم الظالِمين يا رب العالمين، اللهم احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكرُوهٍ، واحفَظ بلادَ المُسلمين يا ذا الجلال والإكرام مِن مُضِلَّات الفتَن، إنك على كل شيء قدير.
اللهم تولَّ أمرَ كل مُسلمٍ ومُسلمة، وأمرَ كل مُؤمنٍ ومؤمنة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدين، اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدين يا رب العالمين.
اللهم لا تكِلنا إلى أنفُسِنا طرفةَ عينٍ، ولا أقلَّ مِن ذلك.
اللهم وفِّق خادمَ الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عمَلَه في رِضاك يا رب العالمين، وأعِنه على كل خيرٍ إنك على كل شيء قدير، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عمَلَه في رِضاك، وأعِنه على كل خيرٍ يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أحسِن العاقِبة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعَل هذا الشهر شهرَ خيرٍ علينا وعلى المُسلمين، وأن تجعَل شهورَ رمضان خيرًا لنا وللمُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
عبادَ الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا الله العظيمَ الجليلَ يذكُركُم، واشكُروه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "من نفحَات العشر الأواخِر"، والتي تحدَّث فيها عن شهر رمضان المُبارَك وأن أيامَه وليالِيه في انصِرامٍ وانقِضاء، وضرورة اغتِنامِ المُسلمين أفضل أوقاتِه هذه الأيام العشرِ؛ لِما فِيها مِن ليلةِ القَدر التي هي خيرٌ مِن ألف شهر، وما يتنزَّلُ في تلك الأيام مِن الرحمات والبركات.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُك ربِّي ونستعينُك ونستغفِرُك ونتوبُ إليك، نحمدُه تعالى ونشكُرُه حبانا ليالِيَ مُباركاتٍ عشرًا، وأجرَى فيها مِن البركات والرَّحمات ما أجرَى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظَمَ للصائِمِين القائِمِين ثوابًا وأجرًا، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه أزكَى البريَّة محتِدًا وقَدرًا، صلَّى الله وبارَك عليه وعلى آله وصحبِه المُوفَّقين وِردًا وصَدَرًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ يرجُو بِرًّا وذُخرًا، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واعلَمُوا أنكم في موسِمٍ مِن أجلِّ مواسِم التقوَى، وقد ختَمَ الله آيةَ الصيامِ بقولِه - سبحانه -: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
معاشِر المُسلمين:
تتفيَّأ الأمةُ الإسلاميةُ هذه الأيام موسِمًا عظيمًا مِن أجلِّ المواسِم في تأريخِها، ذلكُم هو العشرُ الأواخِرُ مِن رمضان، وإن لله في أيامِ الدَّهر لنَفَحات، تتنزَّلُ فيها الرحمات والبركات.
ومُنذ أيامٍ قليلةٍ كنا نستَطلِعُ هِلالَ شهر رمضان، ونستَشرِفُ مُحيَّاه بقلبٍ وَلْهان، وبعد أيامٍ قليلةٍ نُودِّعُه، وعند الله نحتَسِبُه ونستَودِعُه.
|
رمضانُ ما لكَ تلفِظُ
الأنفاسَا |
|
أوَلَم تكُنْ في
أُفْقِنا نِبْراسَا؟! |
|
لُطْفًا .. رُوَيْدَك
بالقُلوبِ فقَد سَمَتْ |
|
واستَأنَسَت بجَلالِك
استِئناسَا |
أيها الصائِمُون القائِمُون:
هلُمُّوا نتضمَّخُ مِن نهاياتِ الشهر بأزكَى الطُّيُوب، تكون لقُلوبِنا تِرياقًا وشِفاءً.
|
دَمعٌ تناثَرَ بل قُلْ:
مُسْبِلٌ هَطِلُ |
|
وَالقَلبُ مِن حسرةٍ
مُستَوحِشٌ خَجِلُ |
|
وَدِّعْ حَبِيبَكَ
شَهرَ الصَّومِ شَهرَ تُقًى |
|
وهَلْ تُطِيقُ وَدَاعًا
أيُّهَا الوَجِلُ؟! |
فيا بُشراكُم ويا نُعماكُم .. يا رعاكم الله! بِهذه الأيام المُباركة القلائِل ازدلِفُوا فيها إلى ربِّكم بالفرائِضِ والنَّوافِلِ، واستَدرِكُوا ما فاتَكم مِن الأعمال الجَلائِل.
|
فشُدُّوا المآزِرَ
وأحْيُوا لَيَالِيَهُ |
|
ولْتَذْرِفِ العَينُ
دَمْعَ النَّدَمْ |
|
فَرَبِّي غَفُورٌ
رَحِيمٌ وَدُودٌ |
|
حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ
كَثِيْرُ النِّعَمْ |
أيها المُسلمون:
ولقد كان مِن هَديِ نبيِّكم مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: أنه يجتَهِدُ في هذه العَشر المُبارَكة ما لا يجتَهِدُ في غَيْرِها.
في "الصحيحين" مِن حديثِ أم المُؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخَلَت العشرُ أحيَا لَيلَه، وأيقَظَ أهلَه، وشَدَّ مِئزَرَه".
فشُدُّوا - يا عباد الله - رِحالَ الأعمال ما دُمتُم في فُسحَةِ الآجال؛ فالفُرصةُ سانِحة، والتجارةُ رابِحة، مُغتَنِمين بقيَّة دُرَر العشر لأعظم المَثُوبة والأجر.
أمةَ القُرآن والصِّيام في مشارِقِ الأرضِ ومغارِبِها! وفي هذه العشر الأواخِر المُبارَكة اختَصَّنا البارِي - تبارك وتعالى - بليلةٍ عظيمةِ الشَّرفِ والقَدر، مُبارَكة الشَّأن والذِّكر، بالخَير والرَّحمة والسلام اكتَمَلَت، وعلى تنزُّل القُرآن والملائِكِ الكرام اشتَمَلَت، هي مِنَّا على طَرَفِ الثَّمام - بإذنِ المَلِك العلَّام -، إنها ليلةُ القَدر ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2، 3].
وقد روى البخاريُّ مِن حديثِ ابن عُمر - رضي الله عنهما -، أن رِجالًا مِن أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا ليلَةَ القَدر في المنامِ في السَّبعِ الأواخِر، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرَى رُؤيَاكم قد تواطَأَت في السَّبعِ الأواخِر، فمَن كان مُتحرِّيها فَلْيتَحَرَّها في السَّبعِ الأواخِرِ».
وها هي دُونَكم هذه السَّبعُ - أيها المُشمِّرُون -.
إنها ليلةٌ خَيرٌ مِن ألفِ شهر، خَفِيَ تعيُّنُها اختِبارًا وابتِلاءً؛ ليتبيَّن العامِلُون والمُقصِّرُون، فمَن حرَصَ على شيءٍ جَدَّ في طلبِه، وهانَ عليه ما يَلقَى مِن عظيمِ تعبِه. إنها ليلةٌ تجرِي فيها أقلامُ القضاء بإسعادِ السُّعداء، وشقاءِ الأشقِياء، ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4].
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قامَ ليلةَ القَدرِ إيمانًا واحتِسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِهِ»؛ متفق عليه.
اللهُ أكبر! اللهُ أكبر! أيُّ فضلٍ لها، وأيُّ أجرٍ عظيمٍ لقِيامِها؟!
|
شهرٌ تنزَّلُ أملَاكُ
السَّماءِ بِهِ |
|
إلَى صَبِيحَتِهِ لَم
تُثْنِها العِلَلُ |
|
فلَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ
لَو ظَفِرْتَ بِهَا |
|
مِنْ أَلفِ شَهرٍ
وأجْرٌ ما لَهُ مَثَلُ |
عن أم المُؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! أرأَيتَ إن علِمتُ أيَّ لَيلَةٍ هي لَيلةُ القَدرِ، ما أقُولُ فِيها؟ قال: «قُولِي: اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العَفوَ فاعْفُ عنِّي».
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العَفوَ فاعْفُ عنَّا.
ألا فجِدُّوا في طلبِها وتحَرِّيها، وشَمِّرُوا للظَّفَر بفضائِلِها ومَرامِيها، واستَبِقُوا دقائِقَها وثوانِيها في تهذيبِ النُّفوس؛ تخلِيةً وترقِيةً، تحلِيةً وتزكِيةً.
|
فيا رِجالَ اللَّيلِ
جِدُّوا |
|
رُبَّ دَاعٍ لا يُرَدُّ |
|
لا يَقُومُ اللَّيلَ
إلا |
|
مَنْ لَهُ عَزْمٌ
وجِدُّ |
أيها المُؤمنون:
إن الغَيُورَ ليتساءَلُ في لَهَفٍ لَهِيفٍ ونحن في خِتامِ شَهرِنا: هل استَطاعَت أمَّتُنا الإسلاميَّةُ أن تعِيَ حقيقةَ الصَّوم بكل ملامِحِها ودلائِلِها مِن نَهَلٍ للنَّقل، وجلاءٍ للعَقل، وصفاءٍ في القَلبِ، وأُنسٍ للرُّوح، ووَعيٍ مُقتَرِنٍ بالتقوَى، وعلمٍ مُتَّصلٍ بمخَافَةِ المَولَى؟!
هل أدرَكنا أن لشهر رمضان نُورًا يجدُرُ أن تستضِيءَ به النُّفوسُ والقُلوبُ، فتُثبِّتُ الأمةُ أقدامَها على طريقِ التغيير والإصلاح، بوَعيٍ لا تَشُوبُه رغَبات، وبثباتٍ لا يُعكِّرُه ارتِجالٌ وثبات، أم أنَّ حظَّنا مِن رمضان هو الاسمُ المعروفُ، والزمنُ المألُوف، وصِلةُ المُناسِبة المُنبَتَّةُ عن الواقِعِ والحال، حين تُشرِقُ الشَّمسُ أو يُطِلُّ الهِلال؟!
ويا لله! كَم نسعَدُ ونغتَبِطُ بشهر رمضان حين نجعَلُ مِنه دورةً زمنيَّةً خَيِّرةً قويَّةً تقُودُنا إلى تحقيقِ الذَّات، والنُّصرةِ على المُعتَدين بيَقينٍ وثبات، وما أعظمَه حين ذات خَيرًا يُصنَع، ودرجةً أثِيلةً تُنال.
فهل جعَلَت الأمةُ مِن رمضان شهرًا للتراحُم والتصافِي، وفُرصةً لمُراجعة النُّفوسِ وإصلاحِ الأعمال بما يحمِلُه هذا الشهرُ الكريمُ مِن دروسٍ عظيمةٍ في التسابُقِ في الخيرات والأعمال الصالِحة؟
هل عمِلَت الأمةُ على الإبقاءِ على الصُّورة المُشرِقة التي اتَّسَم بها هذا الدينُ الإسلاميُّ في وسطيَّته واعتِدالِه، ومُكافَحَة الغُلُوِّ والتطرُّفِ والإرهابِ، ودَعمِه وتموِيلِه، وأن هذه الأعمال الإجراميَّة لا ترتَبِطُ بدينٍ أو ثقافةٍ أو مِلَّة؟
هل عمِلَت على تعزيزِ التسامُحِ والتعايُشِ بين الشُّعوب، ونَبذِ العُنصريَّة والطائفيَّة؟!
وهل تصدَّت لكل ما يُفسِدُ على العالَم أمنَه واستِقرارَه؟ هل وقفَت بحَزمٍ أمام مَن يُريدُ هَزَّ ثوابِتِها، والنَّيلَ مِن مُحكمَاتِها، والتطاوُل على مُسلَّماتها وقطعيَّاتها؟!
معاشِر المُسلمين:
إنَّكم إذ تعيشُون شرَفَ الزمانِ والمكانِ، وتَنعَمُون بطِيبِ المقامِ ووَارِفِ الأمان على هذه الأجواءِ العَبِقَة الأرِيجة، والجِواء المُنشَّرَة البَهِيجة، لا مَعدَى لنا عن تذكُّر إخوانِنا المكلُومِين في أُولَى القِبلتَين ومَسرَى سيِّد الثَّقَلَين، وفي أكنافِ المسجدِ الأقصَى وبيتِ المقدِسِ، وفي الأرضِ المُبارَكة فِلسطين، وفي بلادِ الشَّام، وبُورما، وأراكان، وإخوانِنا في العراق واليمَن وغيرِها.
فهل تُحرِّكُ الأحوالُ الإنسانيَّة، وبُكاءُ اليتامَى، وصَرَخاتُ الأيَامَى تحت أنقاضِ البُيُوت، ولَوعَةُ الأرامِلِ في الظُّلُمات، وحُزنُ المُلتاعِين في المُخيَّمَات. هل تُحرِّكُ دُعاةَ السلام، ومُحارِبِي الإرهاب، والمُدافِعِين عن حُقوقِ الإنسان؟!
|
لكنَّها خُلَّةٌ قد سِيطَ
مِن دَمِها |
|
فَجْعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ
وتَبْدِيلُ |
إنها مُناشَدةٌ جَهِيرةٌ في أُخرَيات هذا الشهر العظيم لأَنْ يَتَنادَى المُسلمون جميعًا إلى التواصِي بالحقِّ والخَير، والتعاوُن على البِرِّ والتقوَى، وأن يعتَصِمُوا بالكتابِ والسُّنَّة.
ويا حَمَلةَ الأقلام .. ويا رِجالَ الإعلام! هلُمُّوا إلى عَقدِ مِيثاقِ شرَفٍ أخلاقيٍّ مِهنيٍّ يَصُونُ المبادِئَ والقِيَم، ويحرُسُ المُثُلَ والشِّيَم، ويُعلِي صَرحَ الفضيلَة التي انتَحَبَت مِن الوَأدِ غِيْلَة.
هلُمُّوا إلى التصدِّي للحَمَلات المُغرِضَة ضدَّ الإسلام وبَنِيه وبِلادِه، لاسيَّما بِلادُ الحرمَين الشريفَين، والوقوف بحَزمٍ أمام قنَوات التضلِيلِ والفِتنة، ومواقِعِ الشَّائِعات المُغرِضة، والافتِراءات الكاذِبة، وأن يُفعَّلَ الإعلامُ الإسلاميُّ مِن حَيِّزِ التَّنظيرِ والنَّجوَى، إلى واقعِ الحِراكِ والجَدْوَى.
هذا الرَّجاءُ والأمل، ومِن الله نستَلهِمُ التوفِيقَ لصالِحِ العمل.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].
بارَكَ الله المَولَى الوهَّاب لي ولكم في آيِ الكتاب، ونفعَني وإياكُم بهَدْيِ النبيِّ المُصطفَى الأوَّاب، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّةِ المُسلمين والمُسلِمات مِن كل الذنُوبِ والخَطِيئات؛ فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إن هو الغفورُ التوَّاب.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله نَحفِدُ إليه بالصِّيام ونَسعَى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له نرجُو دَفعَ السُّوء والضُّرِّ دَفعًا، وأشهدُ أنَّ نبيِّنَا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه أعظمُ البريَّة للعالَمين نَفعًا، صلَّى الله وبارَك عليه، وعلى آلِه وصحبِه خَيرِ مَن أرهَفَ لهَمِّ الصِّيام خُلُقًا وطَبعًا، والتابِعِين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ما أجرَى رمضانُ مِن التوَّابِين دَمعًا، وسلَّم تسليمًا مزيدًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واغتَنِمُوا أواخِرَ شهرِكم لمَحوِ الذُّنُوب بالتوبة، وبادِرُوا زيادةَ الحسناتِ بالاستِغفار والأوْبَة، وكثرةِ الحَمد والشُّكرِ لله - جلَّ وعلا -؛ فإنَّ الأعمالَ بالخَواتِيم، ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.
أمة الإسلام:
لقد شرَعَ الله لكم في خِتامِ شَهرِكم عِباداتٍ عظيمةٍ، مِنها: إخراجُ زكاةِ الفِطر، فأخرِجُوها طيِّبةً بها نفوسُكم قبل صَلاةِ العِيدِ، ولا بأسَ بإخراجِها قبل العِيدِ بيومٍ أو يَومَين، وهي صَاعٌ مِن غالِبِ قُوتِ البلَدِ.
في "الصحيحين" مِن حديثِ ابن عُمر - رضي الله عنهما - قال: "فرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكَر والأُنثَى مِن المُسلمين".
معاشِر الصائِمِين المَيامِين:
إنَّ الأمةَ بحاجةٍ إلى الثباتِ على الطاعةِ والتقوَى، فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، ولا تركَنُوا إلى المعاصِي وقد ذُقْتُم حلاوةَ الطاعة؛ فمَن ركَنَ إليها عكَلَتْه وأهلَكَتْه، وإن الثباتَ على الطاعةِ والتقوَى لمِنْ علاماتِ قَبُول العمل.
قال الإمامُ عليُّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: "كُونُوا لقَبُول العَملِ أشدَّ اهتِمامًا مِنكُم بالعمل، ألم تسمَعُوا قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]؟".
ولم يجعَل الله لعبادتِه أجلًا دُون المَوتِ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99].
عباد الله:
إنَّ مِن التحدُّثِ بنِعَم الله ما نَعِمَ ويَنعَمُ به المُعتَمِرُون والزَّائِرُون في رِحابِ الحرمَين الشريفَين مِن منظُومةِ الخدَمَات المُتكامِلَة المُتوَّجةِ بالأمنِ والأمانِ، والرَّاحةِ والاطمِئنانِ، كلُّ ذلك بفضلِ الله، ثم ما سخَّرَتْه هذه الدولةُ المُبارَكة مِن جُهودٍ عظيمةٍ لخِدمةِ ضُيوفِ الرحمن.
ولا غَرْوَ؛ فقد اختصَّها الله بهذا الشَّرَفِ العظيم، ونسألُ اللهَ أن يُثِيبَها ويُعِينَها على مُواصَلَة هذا الشَّرَف المُؤثَّل، والمَجدِ المُؤصَّل في خِدمةِ الحرمَين الشريفَين مكانًا، وقاصِدِيهما إنسانًا.
وتحيةُ تقديرٍ وإجلالٍ وإعزازٍ لرِجالِ أمنِنا البواسِلِ، ولجنُودِنا الأشاوِس المُرابِطِين على ثُغُورِنا وحُدودِنا، وللعامِلين في خِدمةِ الحرمَين الشريفَين وقاصِدِيهما. لا حرَمَهم الله أجرَه وثابَه، إنه جوادٌ كريم.
هذا، وصلُّوا - رحِمَكم الله - على النبيِّ الخاتَم، خَيرِ عابِدٍ وصائِم، ومُتهجِّدٍ وقائِم، كما أمرَكم المَولَى العظيمُ في التَّنزِيل الكريم، فقال - عزَّ مِن قائلٍ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
|
نِعْمَ
الصَّلاةُ على خَيرِ البريَّةِ ما |
|
هَبَّ
النَّسِيمُ قَضِيبَ البانِ فانْعَطَفَا |
|
وآلِهِ
الغُرِّ والصَّحبِ الكِرامِ ومَنْ |
|
تَلَا
سَبِيلَهُمُ مِن بَعدِهِم وَقَفَا |
وارضَ اللهم عن الخُلفاءِ الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معَهم برحمتِك وكرمِك يا أكرمَ الأكرَمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، ودمِّر أعداءَ الدِّين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح ووفِّق واحفَظ أئمَّتنا ووُلاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا خادمَ الحرمَين الشريفَين، اللهم وفِّقه لِما تُحبُّ وتَرضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، وكُن له على الحقِّ مُؤيِّدًا ونصيرًا، ومُعينًا وظَهيرًا، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه وأعوانَهم وإخوانَهم إلى ما فِيه عِزُّ الإسلام وصَلاحُ المُسلمين، وإلى ما فيه الخيرُ للبِلاد والعِباد.
اللهم وفِّق قادةَ المُسلمين لتحكيمِ شرعِك، واتِّباع سُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -، اللهم اجعَلهم رحمةً على عبادِك المُؤمنين.
اللهم اسلُك بِنَا سَبيلَ الأبرار، واجعَلنا مِن عبادِك المُصطفَين الأخيار، ومُنَّ علينا جميعًا بالعِتقِ مِن النَّار، اللهم أعتِق رِقابَنا ورِقابَ آبائِنا وأمَّهاتِنا ووُلاتِنا وعُلمائِنا وإخوانِنا وأزواجِنا وذُريَّاتِنا والمُسلمين مِن النَّار يا عزيزُ يا غفَّار.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العَفوَ فاعْفُ عنَّا.
اللهم أنقِذِ المسجِدَ الأقصَى، اللهم أنقِذِ المسجِدَ الأقصَى، اللهم أنقِذِ المسجِدَ الأقصَى مِن الصَّهايِنةِ المُعتَدين الغاصِبين المُحتلِّين، اللهم اجعَله شامِخًا عزيزًا إلى يومِ الدين.
اللهم كُن لإخوانِنا في فِلسطين، وفي بِلادِ الشَّام، اللهم أصلِح حالَ إخوانِنا في العِراق، وفي اليمَن، وفي لِيبيا، وفي بُورما، وكل مكانٍ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول والإنعام.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين، ونفِّس كَربَ المكرُوبين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، وارحَم موتانا برحمتِك يا أرحم الراحمِين.
اللهم اجعَلنا مِمن يُوفَّقُ لقِيامِ ليلةِ القَدر، اللهم اجعَلنا مِمن يُوفَّقُ لقِيامِ ليلةِ القَدر، فيُمحَى عنه كلُّ ذنبٍ ووِزر، ويُرفعُ له كلُّ الدرجات وعظيمُ المَثُوبة والأجر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول والإنعام.
اللهم وفِّق رِجالَ أمنِنا، اللهم وفِّق رِجالَ أمنِنا، وكُن لجُنودِنا المُرابِطين على ثُغورِنا وحُدودِنا، اللهم تقبَّل شُهداءَهم، واشفِ جَرحَاهم، وعافِ مرضاهم، ورُدَّهم سالِمين غانِمِين منصُورِين مُظفَّرِين يا قويُّ يا عزيز.
اللهم رُدَّ عنَّا وعن بلادِنا كَيدَ الكائِدِين، وحِقدَ الحاقِدِين، وحسَدَ الحاسِدِين، وعُدوانَ المُعتَدين، اللهم مَن أرادَنا وأرادَ بِلادَنا وأرادَ دينَنا وأرادَ أمنَنا، ووحدتَنا، واجتِماعَنا، واستِقرارَنا، ورخاءَنا بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، ورُدَّ كَيدَه في نَحرِه، واجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا سميعَ الدُّعاء.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفِر لنا ولوالِدِينا ووالِدِيهم وجميعِ المُسلمين والمُسلِمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، الأحياءِ مِنهم والأموات.
اللهم اختِم لنا بخَير، واجعَل عواقِبَ أمورِنا إلى خَير، وأعِد رمضان علينا أعوامًا عديدة، وأزمِنةً مدِيدَة، ونحن ووُلاةُ أمرِنا وبلادُنا في خيرٍ وصحَّةٍ وحياةٍ سعيدةٍ يا ذا الجلال والإكرام.
سُبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عمَّا يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "منهَجُ المُسلم بعد رمضان"، والتي تحدَّث فيها عن المنهَج الذي يجِبُ أن ينتَهِجَه المُسلمُ في حياتِه، وخصوصًا بعد الخُروجِ مِن موسِمٍ مِن أعظم مواسِمِ الطاعات، ألا وهو شهرُ رمضان؛ حيث جاءَت سُورةُ الشَّرح تُمثِّلُ هذا المنهَج الذي وضَعَه الله تعالى لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - وأمَّتِه مِن بعدِه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله على ما قدَّر مِن خيرٍ في رمضان ووَهَب، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له بشَّرَ المُؤمنين بالمغفِرةِ وفرَّجَ الكُرَب، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه كانَ سبَّاقًا إلى فعلِ القُرَب، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه الذين بلَغُوا أعلَى الرُّتَب.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
يُودِّعُ المُسلمُ رمضان الذي كانت لليالِيه حلاوة، ولنهارِه طرَاوَة، ولنسَماتِه نَداوَة. رحَلَت ليالِيه، وولَّتْ أيامُه، وبقِيَ رونَقُها في النُّفوس، وأثَرُها في القلوبِ، وجَلالُها على الأرضِ التي مشَتْ عليها أقدامُ الصائِمِين.
وإذا تأمَّلنا معانِيَ سًورة الشَّرح التي تُخاطِبُ آياتُها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجَدناها تُصوِّرُ أعظمَ ثمرةٍ يخرُجُ بها المُسلمُ مِن رمضان، والمنهَج الذي يجِبُ أن يسيرَ عليه بعد رمضان: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح].
﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ امتَنَّ الله على نبيِّه بنعمةٍ مِن أعظمِ النِّعَم، وهي: نعمةُ انشِراحِ الصَّدر، التي هي مِن ثِمارِ قَبُول رمضان، وأيُّ توفيقٍ أعظمُ مِن أن يهَبَ اللهُ عبدَه صَدرًا مُنشَرِحًا بعد أن ذاقَ حلاوةَ الإيمانِ في رمضان، ونوَّرَت معانِي القُرآن قلبَه.
ومَن باشَرَ طِيبَ شيءٍ ولذَّتَه وتذوَّقَه، لم يكَدْ يصبِرُ عنه؛ وهذا لأنَّ النَّفسَ ذوَّاقةٌ توَّاقةٌ، فإذا ذاقَت تاقَت، وإذا تاقَت تسلَّت.
ولذلك تجِدُ المُؤمنَ في حالةِ انشِراحٍ دائمًا، سواءٌ كان في نعمةٍ أم في ابتِلاء؛ لأنَّ حالَه لن يخرُج عن أحدِ أمرَين: إما شاكِرٌ، وإما صابِرٌ.
يقولُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عجَبًا لأمرِ المُؤمن، إنَّ أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمُؤمن؛ إن أصابَتْه سرَّاءُ شكَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضرَّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له».
وشتَّان ما بين صَدرٍ مُنشَرِحٍ يعيشُ الحياةَ في سُرورٍ وأملٍ، وصَدرٍ مُنغلِقٍ حَرِجٍ تتقلَّبُ أيامُه بين نكَدٍ وقلقٍ.
﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ مِن ثِمار قَبُول رمضان التي يُكافِئُ الله بها الصالِحين: وضعُ الأوزار، ومَحوُ السيئات والخطايا.
والإنسانُ إذا تخفَّفَ مِن الذنوبِ كان أقربَ إلى السَّعادةِ، فالذنوبُ والمعاصِي ثِقَلُها على الإنسانِ عظيمٌ، وقَيدُها على جوارِحِه مَتِين، تُورِثُه الأسقامَ والأمراضَ؛ ذلك أنَّ سَقَمَ الجسَد بالأوجاع، وسَقَمَ القلوبِ بالذنوبِ، فكما لا يجِدُ الجسَدُ لذَّةَ الطعامِ عند سَقَمِه، فكذلك القلبُ لا يجِدُ حلاوةَ العبادةِ مع الذنوبِ.
ومِن أثقَلِ الأوزارِ على عاتِقِ الإنسان: تلك الذنوبُ التي يُؤذِي بها الآخرين؛ مِن غِيبةٍ، ونميمةٍ، وكذِبٍ، وظُلمٍ.
وقد شبَّهَ القُرآنُ الأوزارَ بالأثقالِ أو بالثِّقَل الذي يكادُ يقصِمُ الظَّهر، ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾.
﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ رفَعَ الله قَدرَ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - ورفَعَ ذِكرَه، فلا يُذكَرُ الله إلا ذُكِرَ معه رسولُه - صلى الله عليه وسلم -، والذين خشَعَت جوارِحُهم، واطمأنَّت قلوبُهم بالقرآن، ولهَجَت ألسِنتُهم بالذِّكرِ والدُعاءِ في نهارِ رمضان وليالِيه يرفَعُ الله ذِكرَهم، ويُعلِي قَدرَهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو مقياسُ التمايُزِ والتفاضُلِ بين الناسِ.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يرفَعُ بهذا الكِتابِ أقوامًا ويضَعُ به آخَرين».
وقال: «يُقالُ لصاحِبِ القُرآن: اقرَأ وارْقَ ورتِّل كما كُنتَ تُرتِّلُ في الدنيا؛ فإنَّ منزِلَك عند آخرِ آيةٍ تقرَؤُها».
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدَ الشَّاكِرين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وليُّ الصَّابِرين، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه إمامُ المُتَّقين، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه أجمَعين.
﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ هكذا يجِبُ أن يكون العبدُ مُستمرًّا على طاعةِ الله، ثابتًا على شَرعِه؛ فحياةُ المُسلم كلُّها موسِمُ عملٍ وتقرُّبٍ لله، فإذا فرَغتَ مِن صَلاتِك فارغَب إلى ربِّك في الدُّعاء، وانْصَبْ إليه، وإذا فرَغتَ مِن أمرِ دُنياك فانْصَبْ في عِبادةِ ربِّك، فلا عُطلةَ للمُؤمنِ عن طاعةِ الله، بل يتنقَّلُ مِن طاعةٍ إلى طاعةٍ.
وليس أجمَلُ مِن وقتٍ تدَعُ فيه أشغالَ الدُّنيا وهُمومَها خلفَ ظهرِك، لتخلُوَ بين يدَي ربِّك، ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾.
هذه الآياتُ أبلَغُ نداءٍ، وأعظمُ توجِيهٍ يُحفِّزُ على العملِ والجِدِّ في استِثمارِ الزَّمَن قبل النَّدَم، وأُسوةُ المُسلم في المُبادَرة إلى الطاعات والمُداوَمة عليها: نبيُّ الرحمةِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد كان يقُومُ حتى تتفطَّرَ قَدَماه.
وإنَّ مِن الحِرمان: أن يعُودَ المَرءُ بعد الغَنيمةِ في شَهر رمضان خاسِرًا، وأن يُضيِّعَ المكاسِبَ التي وفَّقَه الله لها في شَهر الخَيرات، قال الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 98، 99].
ألا وصلُّوا - عباد الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك يا أرحَم الراحِمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ بلادَنا وأرادَ الإسلامَ والمُسلمين بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم وفِّق جُنودَنا، وانصُرهم على الحُدود يا رب العالمين، اللهم احفَظهم بحفظِك، واكلأهم برعايتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم وفِّق إمامَنا لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لكل خيرٍ يا رب العالمين، وخُذ بناصيتِهما للبِرِّ والتقوَى يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الجنةَ، ونعوذُ بك مِن النار.
اللهم إنا نسألك مِن الخيرِ كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا منه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا منه وما لم نعلَم.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

فضلُ
الشُّكر والشَّاكِرين
ألقى فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضلُ الشُّكر والشَّاكِرين"، والتي تحدَّث فيها عن شُكرِ نِعَم الله تعالى، وأنه مُؤْذِنٌ بدوامِ النِّعَم وزيادتِها، كما نبَّهَ إلى وجوبِ شُكرِ نعمةِ الله - جلَّ وعلا - بتمامِ صِيامِ شهر رمضان وقِيامِه، وأنَّ أعظمَ بُرهانٍ على شُكرِ الله على هذه النِّعمة هو دوامُ العمل الصالِح بعدَه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، رفيع الدَرَجات، مُسبِغِ النِّعم والبَرَكات، مَنَّ علينا بمواسِمِ الخَيرات والرَّحمات، وهدانا إلى الطاعات والقُرُبات، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم ربَّنا لك الحمدُ، لك الحمدُ بما خلَقتَنا ورَزقتَنا، وهدَيتَنا وعلَّمتَنا، لك الحمدُ بالإسلام، ولك الحمدُ بالقُرآن، ولك الحمدُ بالأهلِ والمالِ والمُعافاة، كبَتَ عدوَّنا، وبسَطتَ رِزقَنا، وأظهَرتَ أمنَنا، وجمَعتَ فُرقتَنا، وأحسَنتَ مُعافاتَنا، ومِن كل ما سألنَاك ربَّنا أعطَيتَنا، فلك الحمدُ على ذلك حمدًا كثيرًا.
لك الحمدُ حتى ترضَى، ولك الحمدُ إذا رضِيتَ، ولك الحمدُ بعد الرِّضا.
أما بعدُ .. معاشِرَ المؤمنين:
اتَّقُوا اللهَ تعالى في السرِّ والعلَن، واجتنِبُوا الفواحِشَ ما ظهرَ منها وما بطَن، واعلَمُوا أن اليوم عملٌ ولا حِساب، وغدًا حسابٌ ولا عمل، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7، 8].
أيها المُسلمون في كل مكان:
هنِيئًا لكُم هذا العِيد، وجعلَنا الله وإياكُم مِن أهل يوم المَزيد، وجعلَ عِيدَكم سُرورًا، وملَأَ صُدورَكم فرَحًا وحُبُورًا.
العِيدُ - أيها المُسلمون - شَعِيرةٌ مِن شعائِرِ الله، يتجلَّى فيها الفَرَحُ بفضلِه وبرحمتِه، وجُودِه وإحسانِه.
العِيدُ يومُ جمالٍ وزِينة، وفرَحٍ وسعادة. العِيدُ موسِمٌ لإصلاحِ ذاتِ البَين، وصِلةِ الأرحام والإحسان، وتجديدِ المحبَّة والمودَّة.
وفي الحديثِ المُتَّفقِ على صحَّتِه: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أحَبَّ أن يُبسَطَ له في رِزقِه، ويُنسأَ له في أثَرِه، فليَصِل رَحِمَه».
أمةَ الإسلام:
لما كانت الشرائِعُ بأحكامِها، والعباداتُ بأنواعِها نِعمًا مِن الله - تبارك وتعالى - وجَبَ حمدُه وشُكرُه عليها.
فيا مَن وُفِّقتُم للصِّيام والقِيام، وعظَّمتُم شعائِرَ الله، واجتَنَبتُم محارِمَه! اشكُرُوه - سبحانه - على ما هداكم، ويسَّرَ لكم الطاعةَ واجتباكُم بإظهارِ أثَرِ النِّعمة على ألسِنَتكم ثناءً واعتِرافًا، وعلى قلوبِكم محبَّةً وشُهودًا، وعلى جوارِحِكم طاعةً وانقِيادًا.
فاللهم لك الحمدُ والشُّكرُ أن هدَيتَنا للإسلام، ولك الحمدُ والشُّكرُ على ما أنعَمتَ به علينا مِن إتمامِ الصِّيام والقِيام، ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].
الشُّكرُ - يا عباد الله - مِن صفاتِ الرَّحمن - جلَّ جلالُه، وتقدَّسَت أسماؤُه -، فالله تعالى شاكِرٌ وشَكورٌ، والشُّكرُ مِنه - تبارك وتعالى -: مُجازاةُ العبدِ والثَّناءُ؛ فهو - سبحانه - بَرٌّ رحيمٌ كريمٌ يشكُرُ قليلَ العمل، ويعفُو عن كثيرِ الزَّلَل.
ومِن كرمِه وجُودِه وفضلِه: أنَّه لا يُعذِّبُ عبادَه الشَّاكِرين، ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 147].
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "وسمَّى نفسَه شاكِرًا وشَكُورًا، وسمَّى الشَّاكِرين بهذَين الاسمَين، فأعطاهُم مِن وَصفِه، وسمَّاهم باسمِه، وحسبُك بهذا محبَّةً للشَّاكِرين وفضلًا".
وكما أن الشُّكر مِن صِفاتِ الله - جلَّ جلالُه -، فهو مِن صِفاتِ المُؤمنين، بل أهلُ شُكرِه هم أهلُ عبادتِه، ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: 172].
وهو مِن أجَلِّ العبادات وأعلاها، ومِن المقاصِدِ العُظمَى التي خُلِقَ الخلقُ مِن أجلِها، ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78].
فلِذا أثنَى الله تعالى على أهل شُكرِه، ووصَفَ به خواصَّ خَلقِه، فقال عن نُوحٍ - عليه السلام -: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3]، وهو الذي دعَا قومَه ليلًا ونهارًا، سِرًّا وجِهارًا ألفَ سنةٍ إلا خمسِين عامًا، فما آمَنَ معه إلا قليلٌ.
وقال - سبحانه - في ثَنائِه على خلِيلِه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 120، 121].
وأما نبيُّنا - صلواتُ ربِّي وسلامُه عليه -، فقد لقِيَ مِن قومِه ما لقِيَ، فكان أشكَرَ الخلقِ لربِّه، وكان يقُومُ مِن الليل حتى تتفطَّر قَدَماه، فقالت له عائشةُ - رضي الله عنها وأرضاها -: أتصنَعُ هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّر؟! فقال: «يا عائِشة! أفَلا أكُونُ عبدًا شَكُورًا؟»؛ رواه البخاري ومسلم.
ولما نقَضَت غزوةُ أُحُد، وأُصِيبَ - صلى الله عليه وسلم - في جسَدِه، وقُتِلَ أحبُّ الناسِ إليه عمُّه حمزةُ - رضي الله عنه وأرضاه -، وكان مُصابُ الصحابةِ عظيمًا، وجُرحُهم عمِيقًا، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أشدِّ الساعاتِ تعَبًا وألَمًا، ومع ذلك قال لأصحابِه: «استَوُوا حتى أُثنِيَ على ربِّي». فصارُوا خلفَه صُفوفًا، ووقَفَ - صلى الله عليه وسلم - وقوفًا طوِيلًا يشكُرُ ربَّه ويُثنِي عليه. كما في "مسند الإمام أحمد".
معاشِرَ المُؤمنين:
إنَّ رِضا الله - تبارك وتعالى - مُعلَّقٌ بالشُّكر؛ فالنِّعمُ مهما صَغُرَت، فشُكرُها سببٌ لحُلول رِضوانِ الله - تبارك وتعالى -.
ففي "صحيح مسلم": قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله ليَرضَى عن العبدِ أن يأكُلَ الأكلَةَ فيحمَدَه عليها، أو يشرَبَ الشَّربةَ فيحمَدَه عليها».
ورِضا العزيزِ الغفَّار أعظمُ نعيمٍ في الجنَّة للشَّاكِرين الأبرار.
ففي "الصحيحين": أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ اللهَ يقُولُ لأهلِ الجنَّة: يا أهلَ الجنَّة! فيقُولُون: لبَّيكَ ربَّنا وسَعدَيك، والخَيرُ في يَدَيك، فيقُولُ: هل رضِيتُم؟ فيقُولُون: وما لَنَا لا نرضَى يا ربِّ! وقد أعطَيتَنا ما لم تُعطِ أحدًا مِن خلقِك؟! فيقُولُ: ألا أُعطِيكُم أفضلَ مِن ذلك؟ فيقُولُون: يا ربِّ! وأيُّ شيءٍ أفضَلُ مِن ذلك؟ فيقُولُ: أثحِلُّ عليكُم رِضوانِي فلا أسخَطُ عليكم بعدَه أبَدًا».
وإنَّ مِن شُكرِ النِّعَم في أيامِ العِيدِ: أن يظهَرَ على المرءِ أثَرُ نعمةِ الله عليه مِن غير إسرافٍ ولا كِبرياء.
ففي "مسند الإمام أحمد": أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كُلُوا واشرَبُوا، وتصدَّقُوا، والبَسُوا مِن غيرِ مَخِيلةٍ ولا سَرَفٍ، إنَّ الله يُحبُّ أن تُرَى نعمتُه على عبدِه».
وتقوَى الله تعالى مِن شُكر النِّعَم، وإذا أنعمَ الله على عبدِه بنعمةٍ وهو غافِلٌ عن شُكرِها، مُتمادٍ في معصِيةِ واهِبِها، فاعلَم أنَّما هو استِدراجٌ.
ففي "مسند الإمام أحمد": عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأَيتَ اللهَ يُعطِي العبدَ مِن الدُّنيا على معاصِيه ما يُحبُّ، فإنَّما هو استِدراجٌ»، ثم تَلَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44]».
أمةَ الإسلام:
إنَّ نِعمَ الله تعالى لا تُعدُّ ولا تُحصَى، وقد امتَنَّ الله بها على عبادِه، ودعاهُم إلى ذِكرِها وشُكرِها، فلا زوالَ للنِّعمةِ إذا شُكِرَت، ولا بقاءَ لها إذا كُفِرَت، ومَن رُزِقَ الشُّكرَ رُزِقَ الزيادة، ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7].
وكلُّ نِعمةٍ وإن كانت يسيرةً سيُسألُ عنها العبدُ يوم القِيامة.
ففي "سنن الترمذي": قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أولَ ما يُسألُ عنه يوم القِيامة - يعني: العبدَ مِن النَّعِيم - أن يُقال له: ألم نُصِحَّ لك جِسمَك، ونُروِيَك مِن الماءِ البارِدِ؟!».
ثم اعلَمُوا - أيها المُؤمنون - أنَّ كلَّ نعمةٍ تستوجِبُ الشُّكر، والشُّكرُ نعمةٌ تحتاجُ إلى شُكرٍ، وهكذا يبقَى العبدُ مُتقلِّبًا بين نِعمِ ربِّه وشُكرِها، حتى يدخُلَ دارَ الشَّاكِرين.
أعوذُ بالله مِن الشيطانِ الرجيم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 42، 43].
بارَك الله لي ولكم في القرآنِ والسنَّة، ونفعَنا وإيَّاكُم بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه؛ إنه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله حمدَ الشَّاكِرين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له إلهُ الأولين والآخرين، وأشهدُ أن نبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه أجمعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
أما بعدُ .. معاشر المُؤمنين:
إنَّ مِن أعظم النِّعَم إدراكَ مواسِم الطاعات، والمُسارَعة فيها بأنواع القُرُبات في وقتٍ حُرِمَ البعضُ مِن اغتِنامِها، أو حالَ الأجَلُ دُون بلوغِها.
وإنَّ مِن شُكرِ النِّعمة بعد مواسِمِ الطاعة: المُداومةَ على العِبادة.
وقد سُئِلَت عائشةُ - رضي الله عنها -: كيف كان عملُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ هل كان يخُصُّ شيئًا مِن الأيام؟ قالت: "لا، كان عملُهُ دِيمةً" أي: إذا عمِلَ عملًا داوَمَ عليه.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يُوصِي أصحابَه بالثَّباتِ على الطاعاتِ، والمُداومَة على القُرُبات، ولو كان شيئًا يسيرًا.
ومِن العبادةِ الدائِمة التي هي أحَبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى: المُحافظةُ على الفرائِضِ.
ففي "صحيح البخاري" عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ قال: مَن عادَى لِي ولِيًّا فقد آذَنتُه بالحَربِ، وما تقرَّبَ إلَيَّ عبدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ما افتَرضتُ عليه، وما يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإذا أحبَبتُه كُنتُ سَمعَه الذي يسمَعُ بِه، وبصَرَه الذي يُبصِرُ به، ويدَهُ التي يبطِشُ بها، ورِجلَه التي يمشِي بها، وإن سألَنِي لأُعطِيَنَّه، ولئِن استَعاذَني لأُعِيذنَّه».
فالمُؤمنُ - يا عباد الله - ينتَقِلُ مِن عبادةٍ إلى عبادةٍ، ومِن طاعةٍ إلى طاعةٍ، ومِن شُكرٍ إلى شُكرٍ إلى أن يُلاقِي ربَّه، ففي القرآن الكريم: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99].
وإنَّ مِن النِّعَم العظيمةِ: ما مَنَّ الله به علينا في هذه البلادِ المُبارَكةِ مِن أمنٍ وأمانٍ، واجتِماعٍ للكلِمةِ، وأُلفةٍ ومودَّةٍ مع وُلاةِ أمرٍ تدعُون لهم ويدعُون لكم، وتَدِينُون لهم بالطاعة، ويَدِينُون بالحِرصِ على مصالِحكم.
فاشكُرُوا اللهَ - عباد الله -، ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103].
اللهم اجعَلنا لك شاكِرين، اللهم اجعَلنا لك شاكِرين، اللهم اجعَلنا لك شاكِرين، لك ذاكِرين، لك راهِبِين، لك مِطواعِين، إليك مُخبِتين مُنِيبين.
ربَّنا تقبَّل توبتَنا، واغسِل حَوبَتَنا، وأجِب دعوتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، واهدِ قُلوبَنا، وسدِّد ألسِنتَنا، واسلُل سخِيمةَ قُلوبِنا.
اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتِك، اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتِك، اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتِك.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجُودِك ومِنَّتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، واحمِ حَوزةَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ، اللهم إنا نسألُك بفضلِك ومِنَّتِك أن تحفظَ بلادَ المُسلمين مِن كل سُوءٍ برحمتِك يا أرحَم الراحِمين.
اللهم احفَظ بلادَ الحرمَين، اللهم احفَظها بحفظِك، واكلَأها برعايتِك وعنايتِك، اللهم أدِم أمنَها ورخاءَها واستِقرارَها برحمتِك يا أرحَم الراحِمين.
اللهم وفِّق خادِمَ الحرمَين لما تُحبُّ وترضَى، واجزِه عن الإسلام والمُسلمين خيرَ الجزاء، اللهم اجمَع به كلمةَ المُسلمين يا رب العالمين، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لما فيه خيرٌ للبلاد والعباد.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على حُدودِ بلادِنا، اللهم أيِّدهم بتأيِيدك، واحفَظهم بحِفظِك برحمتِك وجُودِك يا رب العالمين.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوبين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين، واشفِ مرضانا ومرَى المُسلمين.
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].
سُبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

حلاوةُ
الإيمانِ بدوامِ العبادةِ بعد رمضان
ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة عيد الفطر بعنوان: "حلاوةُ الإيمانِ بدوامِ العبادةِ بعد رمضان"، والتي تحدَّث فيها عن شُكرِ الله تعالى بدُوامِ العبادةِ بعد رمضان؛ فرمضانُ موسِمٌ للخَير تعقُبُه مواسِم، والله يُحبُّ مِن عبدِه دوامَ العملِ وإن قَلَّ، كما ارتكَزَ حديثُه عن تذوُّقِ حلاوةِ الإيمانِ بالثباتِ على الطاعاتِ والأعمالِ الصالِحة.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقوا الله - عباد الله - حقَّ التقوَى، وراقِبُوه في السرِّ والنَّجوَى.
أيُّها المسلمون:
مِن صِفاتِ الله تعالى: الشُّكرُ والكرمُ، وبفضلِه - سبحانه - يُذِيقُ الطائِعين أثرًا مِن آثار عبادتِهم في الدُّنيا؛ ليتحقَّقَ لهم صِدقُ وعدِه في ثوابِه لهم بجنَّاتِ النَّعيم.
وفي شهر رمضان ذاقَ المُسلِمون نفَحَاتٍ مِن ربِّ العالمين، مِن تعلُّقِهم بالله، وانشِراحِ صُدورِهم، وصفاءِ قُلوبِهم؛ ليُلازِمُ العبادُ طاعةَ ربِّهم في أيامِ دهرِهم، لتحقيقِ النَّعيم الذي هو غايةُ النُّفوسِ ومطلُوبُها، وبه ابِتهاجُها وسُرورُها، والخلقُ كلُّهم ينشُدُونَه رغبةً وفِعلًا.
والنَّعيمُ التامُّ إنما هو بالتمسُّك بالإسلام علمًا وعملًا؛ فأهلُه في نعيمٍ دائمٍ في الدنيا والبرزَخ والآخرة، قال - سبحانه -: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: 13]، [المطففين: 22].
ففي الدنيا شرَحَ الله صُدورَهم للإسلام، وأحياهم به، وجعلَهم له نُورًا، قال - جلَّ وعلا -: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 122].
وكتبَ لهم الرحمةَ في الدارَين، فقال: ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: 71].
وأسعَدَهم - سبحانه -، فأثابَهم في الدنيا، وما أعدَّه لهم في الآخرة خيرٌ وأعظَم، قال - جلَّ وعلا -: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: 30].
وأكبَرُ مِنَن الله على عبادِه في الدنيا: أن حبَّبَ إليهم الدينَ، وزيَّنَه في قلوبِهم، وأذاقَهم حلاوةَ طاعتِه، فتجمَّلَت بواطِنُهم بأصولِ الدين وحقائِقِه، وتزيَّنَت ظواهِرُهم بامتِثالِ أوامِرِه، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 7].
فالإقبالُ على الله والرِّضا به وعنه ثوابٌ عاجِلٌ، وجنَّةٌ حاضِرة، والإيمانُ بالله ورسولِه جِماعُ السَّعادة وأصلُها.
وحلاوةُ الإيمانِ في القلبِ أمارةٌ على أن الإسلام هو الدينُ الحقُّ.
سألَ هِرقلُ أبا سُفيان عن نبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وصِدقِ نبُوَّتِه، فقال: "وسَألتُك: هل يرتَدُّ أحدٌ سَخطةً لدينِه بعد أن يدخُلَ فيه، فزَعَمتَ أن لا، وكذلك الإيمانُ حين تُخالِطُ بَشَاشتُه - أي: حلاوتُه - القُلوبَ لا يسخَطُه أحدٌ"؛ متفق عليه.
والمُؤمنُون مِن أطيَبِ الناسِ عيشًا، وأنعَمِهم بالًا، وأشرَحهم صدرًا، وأسَرِّهم قلبًا، قال - جلَّ وعلا -: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: 62، 63].
ومِن سعادتِهم: أنَّ الأمنَ في القلبِ وخارِجِه قَرينُ حياتِهم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82].
وليس في الدنيا مِن اللذَّات والنَّعيم أعظمُ مِن العلمِ بالله ومعرفتِه، فإذا عرَفَ العبدُ ربَّه أحبَّه وعبَدَه، ولا شيء يعدِلُ توحيدَ الله في شَرحِ الصدرِ وإسعادِه، ومُنتهَى الفرَح إنما يكونُ به تعالى، قال - سبحانه -: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].
فالفرَحُ بفضلِه ورحمتِه تَبَعٌ للفَرَحِ به - سبحانه -؛ فالمُؤمنُ يفرَحُ بربِّه أعظم مِن فرَحِ كلِّ أحدٍ بما يفرَحُ به، ولا ينالُ القلبُ حقيقةَ الإيمانِ حتى يجِدَ طعمَ هذه الفَرحةِ ويظهَرَ سُرورُها في قلبِه، ونظرَتُها في وجهِه.
وكلَّما قَوِيَت معرفةُ العبدِ بالله قَوِيَت محبَّتُه له، وليس للعبدِ سُرورٌ إلا في محبَّةِ الله والتقرُّبِ إليه بما يُحبُّه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].
وعبادةُ الله وحدَه هي غايةُ الخلقِ والأمرِ، وبها نعيمُ العبادِ وكرامتُهم؛ فالصلاةُ قُرَّةُ عيُون المُسلمين.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «وجُعِلَت قُرَّةُ عينِي في الصلاة»؛ رواه أحمد.
وكيف لا ينعَمُ المُؤمنُ بصَلاتِه، والله قِبَل وجهِه إذا صلَّى، وأقربُ ما يكونُ مِن ربِّه وهو ساجِدٌ فيها؟!
وقد قال المُشرِكُون في معركةٍ مع المُسلمين: "ستأتِيهم صَلاةٌ هي أحبُّ إليهم مِن الأولاد"؛ رواه مسلم.
وكلَّما ذاقَ العبدُ حلاوةَ الصلاة، كان انجِذابُه إليها أشدَّ، وامتِثالُه إليها أسرَع.
والزَّكاةُ قَرينةُ الصَّلاة، مَن أخرَجَها طيِّبةً بها نفسُه أذاقَه الله حلاوةَ الإيمانِ وطعمَه.
قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "والمُتصدِّقُ كلَّما تصدَّقَ بصدقةٍ انشرَحَ لها قلبُه، وانفَسَحَ لها صدرُه، وقَوِيَ فرَحُه، وعظُمَ سُرُورُه. ولو لم يكُن في الصَّدقَة إلا هذه الفائِدة وحدَها، لكان العبدُ حقيقًا بالاستِكثارِ مِنها والمُبادرَةِ إليها".
وللصَّومِ لذَّةٌ ولأهلِه به فرحةٌ. قال - عليه الصلاة والسلام -: «للصائِمِ فَرحَتان: فَرحةٌ عند فِطرِه، وفَرحةٌ عند لِقاءِ ربِّه»؛ متفق عليه.
والحَجُّ تهفُو إليه النُّفوسُ فتسعَدُ، وتتسابَقُ إلى مشاعِرِه.
والفلاحُ كلُّه في تزكِيةِ النَّفسِ بالعبادةِ ومكارِمِ الأخلاقِ، قال - عزَّ وجل -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9].
والدَّاعِي إلى الله مُفلِحٌ يهنَأُ في نعيمٍ وسُرورٍ، قال - جلَّ وعلا -: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].
والعلمُ النافعُ يشرَحُ الصدرَ ويُوسِّعُه، ويُقرِّبُ مِن الربِّ، قال - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28].
قال شيخُ الإسلام - رحمه الله -: "ليس في الدنيا نعيمٌ يُشبِهُ نعيمَ الآخرة إلا نعيمَ الإيمان والمعرِفة".
وذِكرُ الله يشرَحُ الصدرَ، وبه ينعَمُ القلبُ، وهو أخَفُّ الأعمال مؤُونةً، وأكثَرُها فرَحًا وابتِهاجًا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
وأعظمُ الذِّكرِ: القُرآن العظيمُ، هو هُدًى وشِفاءٌ ورحمةٌ للمُؤمنين، وهو فضلُ الله ورحمتُه الذي يفرَحُ به العباد، قال - عزَّ وجل -: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الرعد: 36].
وإذا سمِعَ المُؤمنُ آياتِ الله تُتلَى استبشَرَ فرَحًا وسُرورًا؛ لما يجِدُه في قلبِه مِن السَّكينةِ والطُّمأنينةِ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: 124].
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "وإذا أردتَ أن تعلَمَ ما عندك وعند غيرِك مِن محبَّة الله، فانظُر محبَّةَ القُرآن والتِذاذِك بسَماعِه".
للقُرآن حلاوةٌ ألَذُّ مِن العسل.
أتَى رجُلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي رأيتُ الليلةَ في المنامِ ظُلَّةً - أي: سَحابةً - لها ظِلٌّ تنطُفُ السَّمنَ والعسلَ - أي: يقطُرُ مِنها -، فقال أبو بكرٍ - رضي الله عنه - لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعنِي أَعبُرْها - أي: أُفسِّرُ الرُّؤيا"، فقال: «اعبُرْها»، قال: "أما الظُّلَّةُ فالإسلامُ، وأما الذي ينطُفُ مِن العسل والسَّمن، فالقُرآنُ حلاوتُه تنطُفُ، أي: يقطُرُ حلاوةً"؛ متفق عليه.
ولا يزالُ أهلُ الطاعة في نعيمٍ حتى يظفُرُوا بمُنتهاه في جنَّاتِ النَّعيم، وأعظمُ لذَّاتِهم فيها: النَّظرُ إليه - سبحانه - وسماعُ كلامِه مِنه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «فيكشِفُ الحِجابَ، فما أُعطُوا شيئًا أحَبَّ إليهم مِن النَّظَر إلى ربِّهم - عزَّ وجل -»؛ رواه مسلم.
وكان مِن دُعائِه - صلى الله عليه وسلم -: «وأسألُك لَذَّةَ النَّظَر إلى وجهِك، والشَّوقَ إلى لِقائِك»؛ رواه النسائي.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
مَن ذاقَ حلاوةَ الإيمان لم يكَدْ يشبَعُ مِنه، فيُقبِلُ على الطاعةِ، ويظهَرُ أثَرُها على لِسانِه وجوارِحِه، وينجُو مِن كل ما يُفسِدُ عليه دِينَه، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7].
قال ابنُ رجبٍ - رحمه الله -: "إذا وجَدَ القلبُ حلاوةَ الإيمانِ أحسَّ بمَرارةِ الكُفر والفُسُوقِ والعِصيَان؛ ولهذا قال يُوسفُ - عليه السلام -: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: 33]".
ومتَى ذاقَ العبدُ طعمَ الإيمانِ لم يتطلَّع لمَدحِ الناسِ، وأورَثَه الله الثباتَ على الدينِ، ودوامَ العبادةِ ومحبَّتَها، والزيادة مِنها.
للدِّين حلاوةٌ وطعمٌ مَن ذاقَه تسلَّى به عن الدُّنيا وما عليها، وهانَتْ عليه المصائِب، قال السَّحرةُ لفرعَون لما ذاقُوا حلاوةَ السُّجُود والإيمان: ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 73]، وقالُوا له بعدما توعَّدَهم بالقتلِ والصَّلبِ: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72].
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
نعيمُ الإيمان مشرُوطٌ بالإخلاصِ لله، وبالإخلاصِ والنَّصِيحة ولُزوم الجماعةِ سَلامةُ الصدرِ وانشِراحُه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «ثَلاثٌ لا يغِلُّ عليهنَّ قَلبُ مُسلمٍ: إخلاصُ العملِ لله، ومُناصحَةُ أئمةِ المُسلمين ولُزوم جماعَتِهم»؛ رواه الترمذي.
وحَلاوةُ الإيمانِ تَتبَعُ كمالَ محبَّةِ العبدِ لربِّه؛ وذلك بتكمِيلِها وتفريغِها ودفعِ ما يُضادُّها.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحَبَّ إليه مما سِواهما، وأن يُحبَّ المرءَ لا يُحبُّه إلا لله، وأن يكرَه أن يعُودَ في الكُفر كما يكرَهُ أن يُقذَفَ في النار»؛ متفق عليه.
ولا يجِدُ العبدُ أُنسَ الطاعةِ حتى يكون فرَحُه بدينِه وعبادتِه أشدَّ فرَحًا مِن كل شيءٍ، وحتى يكون أشدَّ تسليمًا لربِّه ونبيِّه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «ذاقَ طعمَ الإيمانِ مَن رضِيَ بالله ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمُحمدٍ رسُولًا»؛ رواه مسلم.
ودُعاءُ الله وحُسنُ الظنِّ به مِفتاحُ كلِّ خَيرٍ. قال الله في الحديثِ القُدسيِّ: «أنا عند ظنِّ عبدِي بِي».
والإيمانُ بالقضاءِ والقَدَرِ يَؤُولُ بصَاحِبِه إلى السعادة.
قال عُبادةُ بن الصَّامِتِ - رضي الله عنه - لابنِه: "يا بُنيَّ! إنَّك لن تجِدَ طعمَ حقيقةِ الإيمانِ حتى تعلَمَ أنَّ ما أصابَك لم يكُن ليُخطِئَك، وما أخطَأَك لم يكُن ليُصيبَك"؛ رواه أبو داود.
قال إبراهيمُ الحربيُّ - رحمه الله -: "أجمَعَ عُقلاءُ كلِّ أمةٍ أنَّه مَن لم يَجرِ مع القَدَرِ لم يَتَهنَّ بعَيشِهِ".
وعُنوانُ سعادةِ العبدِ أنَّه إذا أنعمَ الله عليه شكَرَ، وإذا ابتُلِيَ صَبَرَ، وإذا أذنَبَ استغفَرَ.
والإكثارُ مِن النَّوافِلِ، والاستِعانةُ بالصَّبر والصَّلاةِ يفتَحُ على العبدِ أبوابًا مِن النَّعيم. قال الله في الحديثِ القُدسيِّ: «ولا يَزالُ عبدِي يتقرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّه»؛ رواه البخاري.
ومَن رأَى أنه لا يَنشرِحُ صَدرُه، ولا يحصُلُ له حلاوةُ الإيمان ونُورُ الهِداية فليُكثِر التوبةَ والاستِغفار، وليُلازِم الاجتِهادَ بحسبِ الإمكان؛ فإنَّ الله يقُولُ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].
وكفُّ النفسِ عن الحرامِ تعقُبُه لذَّةٌ وسلامةٌ، والنَّظرُ للمُحرَّمات سَهمٌ مِن سِهامِ إبليس، مَن ترَكَه خوفًا مِن الله أثابَه الله إيمانًا يجِدُ حلاوتَه في قلبِه.
قال مُجاهِدٌ - رحمه الله -: "غَضُّ البصَرِ عن محارِمِ الله يُورِثُ حُبَّ الله".
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
فلا نعيمَ للعبادِ ولا سُرورَ لهم إلا بمعرفةِ الله ومحبَّتِه والفرَحِ بطاعتِه، ولا نعيمَ لهم في الآخِرة إلا بجِوارِه في دارِ النَّعيم والنَّظَر إليها، فهاتان جنَّتان لا يدخُلُ الثانِيةَ مِنهما إلا مَن دخَلَ الأُولَى.
ومَن لم يجِد للعملِ حلاوةً في قلبِه وانشِراحًا، فليتَّهِم نفسَه وعملَه؛ فإنَّ الربَّ شَكُورٌ، وليس العجَبُ مِمَّن لم يجِد لذَّةَ الطاعة، إنَّما العجَبُ مِمَّن وجَدَ لذَّتَها ثم فارَقَها.
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولجميعِ المُسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له تعظِيمًا لشأنِه، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا.
أيُّها المسلمون:
في العيد تتجدَّدُ للمُسلمين أفراحُهم، وتتجلَّى نِعمُ الله ومواهِبُه عليهم، فأظهِرُوا فيه الفرَحَ والسُّرورَ، وأدخِلُوا السعادةَ على غيرِكم، ووسِّعُوا على أنفُسِكم وأهلِيكُم بما أُبِيحَ لكم، واجعَلُوا فرحتَكم بالعيد مصحُوبةً بتقوَى الله ومُراقبتِه، واشكُرُوه على ما مَنَّ به عليكم.
وعلى الزوجةِ أن تُدخِلَ السُّرورَ على زوجِها، وتُحسِنَ عِشرتَها معه، وأن ترعَى أولادَه، وتُحسِنَ تربيتهم لها.
وعلى المرأة أن تُرضِيَ ربَّها بالحِشمةِ والحياءِ والسِّتر والعفافِ، وطاعتِه - سبحانه -.
واحذَرُوا جميعًا العِصيَان بعد شهر الطاعة، واسألُوا اللهَ القبُول والتوفيقَ لما يأتِيكم؛ فرمضانُ موسِمٌ للخَير تعقُبُه مواسِم، والله يُحبُّ مِن عبدِه دوامَ العملِ وإن قَلَّ.
ومَن أتمَّ صَومَ الشهرِو، وأتبَعَه بستٍّ مِن شوالٍ فكأنَّما صامَ الدَّهرَ كلَّه.
عباد الله:
إذا وافَقَ العيدُ يوم الجُمعة - كهذا اليوم - جازَ لمَن حضَرَ العيدَ أن يُصلِّي الجُمعة، أو أن يُصلِّي ظُهرًا.
ثم اعلَموا أنَّ الله أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَمِ التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدين، الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بجُودِك وكرمِك يا أكرَم الأكرَمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا رخاءً، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم تقبًّل منَّا صِيامَنا وقِيامَنا.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]، ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
اللهم وفِّق إمامَنا لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، ووفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المسلمين للعمل بكتابِك يا ذا الجلال والإكرام.
سُبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

خُلق الوفاء
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن
عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة عيد الفطر بعنوان: "مِن جوامِع الأخلاق:
خُلق الوفاء"، والتي تحدَّث فيها عن خُلُقٍ هو مِن جوامِع الأخلاق، ومجمَع
المُروءات، في أعلَى منازِل الشَّهامة، وأسمَى مقامات المُروءة، هو خُلُق الوفاء،
مُبيِّنًا فضائِلَه وأفضلَ نماذِجِه مُتمثِّلةً في آياتِ الله تعالى، وفي نبيِّنا
مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - القُدوة والأُسوة الحسنة، أعظَم البشَر وفاءً، ثم بيَّنَ آثارَ الوفاءِ في
المُجتمع.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله أنشَأَ وبرَأ، والله أكبر أبدعَ كلَّ شيءٍ وذرَى، ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: 6- 8]، والحمدُ لله على ما منَحَ ووهَب، واللهُ أكبر التقوَى عنده أشرَفُ نسَب، لا إله إلا الله سهَّل لأوليائِه في طاعاتِه كلَّ نَصَب، والحمدُ لله تعاظَمَ ملَكُوتُه فاقتَدر، والله أكبر تعالَى جبَرُوتُه فقَهَر، رفعَ بحكمتِه أقوامًا وخفَضَ أقوامًا أُخَر، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه على نعمٍ تتوالَى في الآصالِ والبِكَر، كريمٌ جَواد يذكُرُ مَن ذكَر، ويشكُرُ مَن شكَر.
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالِصةً مُخلِصةً تُنجِي صاحبَها يوم الفزَع الأكبَر، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه مُصطفاهُ مِن الرُّسُل، ومُجتبَاه مِن البَشَر، أيَّدَه ربُّه بمُعجِز الآياتِ والسُّور، كلَّمَه الحجَر، وانشَقَّ له القمَر، الشافِعُ المُشفَّعُ في المحشَر، صلَّى الله وسلَّم وباركَ عليه، وعلى آله الأطهار السَّادَة الغُرَر، وأصحابِهِ الميامِين أعزَّ الله بهم دِينَه ونصَر، والتابِعِين ومن تبِعَهم بإحسانٍ وسارَ على نَهجِهم والأثَر.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا.
أما بعد:
فأُوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوَى الله، فاتَّقوا الله - رحمكم الله -، وانظُرُوا لأنفسِكم، واعتبِرُوا بالحوادِثِ والغِيَر، وتأمَّلُوا في الآياتِ والعِبَر؛ فليس العِيَان كالخَبَر، تأهَّبُوا واستعِدُّوا، فإنَّكم على الأثَر، وتزوَّدُوا زادَ التُّقَى، فأنتُم على سفَر، وبادِرُوا بالأعمال الصالِحة، فالأعمارُ في قِصَر، وما أمرُ السَّاعَة إلا أقرب مِن لَمحِ البصَر، وكفَى بهذه الدُّنيا مُعتبَر.
جعلَنِي الله وإيَّاكُم مِمَّن أخلَصَ لربِّه فيما أعلَنَ وأسَرَّ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18].
الله أكبر ما صامَ صائِمٌ وأفطَر، والله أكبر ما عادَ عيدٌ وتكرَّر.
أيها المسلمون:
عيدُكم مُبارَك، وصِيامُكم مُتقبَّل، بارَك الله لكم بما مَنَّ عليكم بهذا اليوم الأغَرِّ يوم عِيدِ الفِطر يومِ الحُبُور والسُّرُور، تمتَلِئُ فيه القلوبُ بَهجَة، وتزدانُ به الأرضُ زِينَة، تخرُجُون لصلاتِكم حامِدِين، ولنِعمِ مولاكُم شاكِرِين، وبتمامِ شَهرِكم مُغتَبِطين، ولثوابِ ربِّكم مُؤمِّلِين، ولفضلِه وإحسانِه راجِين.
عيدُنا - أهلَ الإسلام - عِيدُ غِبطةٍ في الدِّين والطاعَة، وعِيدُ بَهجةٍ في الدُّنيا والحياة، عِيدُ تزاوُرٍ وصِلةٍ وقُربَى، وصفحٍ وعفوٍ، ومُسامحَةٍ ومحبَّةٍ، وإخاءٍ وأُلفةٍ، ليس عِيدَ أشَرٍ ولا بطَرٍ، ولا فِسقٍ ولا فُجُور.
الله أكبر ما تلَا قارِئٌ كتابَ ربِّه وتدبَّر، والحمدُ لله ما بذَلَ مُحسِنٌ مِن مالِه وشكَر.
أيها المسلمون:
الإسلامُ في بنائِه الأخلاقِيِّ جاءَ بكلِّ ما هو راقٍ ومُتحضِّرٍ، وسمَا بأتباعِهِ فوقَ كلِّ الصغائِر، ورسَمَ للإنسانيَّة حياةً كريمةً تُحيطُ بها كلُّ المعانِي السَّامِية. بِناءٌ أخلاقيٌّ متِين تستَقِيمُ به الحياة، وتُؤدَّى به الرسالة، ويقُومُ عليه البِناء، ويُواجِهُ كلَّ التجاوُزات.
وإنَّ ما تُعانِيه الأمةُ في كثيرٍ مِن مواقِعِها ومُجتمعاتِها بسببِ الضعفِ الأخلاقيِّ، وتلاشِي كثيرٍ مِن القِيَم. ودينُ الإسلام في قِيَمِه وأخلاقِهِ يأبَى أن تُمارَسَ الفضائِل في سُوقِ المنفَعَة العاجِلَة، أو أن تنطَوِي دخائِلُ النفوس على نِيَّاتٍ مغشُوشة.
معاشر المسلمين:
وثَمَّةَ خُلُقٌ هو مِن جوامِعِ الأخلاقِ، ومجمَع المُروءات. خُلُقٌ في أعلَى منازِل الشَّهامة، وأسمَى مقامات المُروءة. قِيمةٌ إسلاميَّةٌ عظيمةٌ، ورصيدٌ إنسانيٌّ نبِيلٌ، يحسُنُ التذكيرُ به والتذاكُر في هذا اليوم المُبارَك يوم عيدِ المُسلمين واجتماعِهم وبَهجَتهم وسُرُورهم.
خُلُقٌ كريمٌ يدفِنُ الأخطاء، ويمحُو الزلَّات، ويُعلِي المحاسِن، ويغُضُّ عن المعايِب، تتفاوَتُ فيه أقدارُ الرِّجال تفاوتًا واسِعًا، بهذا الخُلُق تُصانُ المودَّات، وتتوثَّقُ العلاقات، ويدُومُ الإحسان، وتسُودُ السَّكِينة، وتستقِرُّ النُّفوس.
إنه خُلُقُ الوفاء. نعم - حفِظَكم الله - الوفاءُ خُلُقٌ عزيزٌ، لا يقدُرُه حقَّ قَدرِه إلا القلِيلُون أو الأقلُّون، وقد قال ربُّ العِزَّة: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: 102].
وقالت العربُ في أمثالِها: "أعَزُّ مِن الوفاء".
بل إن الله - عزَّ وجل في عُلاه - تمدَّحَ به، فقال - عزَّ شأنُه -: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 111]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: 6].
الوفاءُ مِن أخَصِّ صِفاتِ المُؤمنين، ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23].
ومِن أبرزِ نُعوتِ أُولِي الألبابِ: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 19، 20].
الله أكبر عَنَت الوُجوهُ لكبرياءِ ربِّنا وعظَمَتِه، والله أكبر أجرَى - سبحانه - المقادِيرَ بحكمتِه.
أيها الأحِبَّة:
الوفاءُ - حفِظَكم الله، وبارَكَ لكم في عيدِكم، وزادَكم هناءً ووفاءً - مِن أسمَى الأخلاقِ الإنسانيَّة وأرقاها، يحمِلُ معانِي الصدق، والإخلاص، والمحبَّة، والعدل، والكرَم، والنُّبْل، والثِّقة، والجُود، والنَّجْدة.
وما كان الوفاءُ بهذه المنزِلَة إلا لأن الوفاءَ مِن كل شيءٍ تمامُه وكمالُه، ومِن دقائِقِ المعاني في لُغةِ العرب: أن الوفاءَ يعني: الخُلُقَ الشريفَ العالِي الرَّفيعَ.
والوفاءُ في حقيقتِه - حفِظَكم الله - هيئةٌ في النَّفس راسِخة، تُنبِئُ عن طهارتِها وسُمُوِّها، يصدُرُ عنها أداءُ ما التَزَمَه المرءُ مِن حقوقٍ ومسؤوليَّاتٍ، وهذه الحُقوقُ - كما يُفسِّرُها ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - هي: العُهُود مما أحلَّ الله وما حرَّم، وما فرَضَ وما حدَّدَ في الدينِ كلِّه.
الله أكبر ما راقَبَ عبدٌ في السرِّ والعلانية ربَّه، والله أكبر ما تغافَلَ مُسلمٌ عن عيُوبِ الناسِ ولعُيُوبِ نفسِه تنبَّه.
الوفاءُ - بارَكَ الله لكم في أعيادِكم وأيامِكم - ينتَظِمُ جميعَ المسؤوليَّات الدينية والدنيوية، فمَن تولَّى عملًا أو التَزَمَ أمرًا، فقد تعهَّدَ أن يفِيَ بِه على أفضل الوُجوهِ، وعلى قَدر التقصيرِ يكونُ الإخلالُ بهذا الخُلُق العظيمِ.
الوفاءُ ينتَظِمُ جميعَ العلاقات بين الأفرادِ والجماعاتِ والشُعُوب والدُّول، ومساراتِ الإنسانيَّة كلِّها، والوفاءُ والإنسانيَّةُ صِنوان؛ فمَن فقَدَ الوفاءَ فقَدَ إنسانيَّتَه.
وأولُ ما يجِبُ الوفاءُ بِهِ: مسؤوليَّةُ العبد نحوَ ربِّه بامتِثالِ أوامِرِه، واجتِنابِ نواهِيه، والمُسارَعة إلى الخَيرات، وتطلُّبِ مراضِي الله - سبحانه -، وذِكرِه وشُكرِه وحُسن عبادِه. «فاقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ».
يقولُ أبو العالِية - رحمه الله -: "عهدُ الله إلى عبادِه دينُ الإسلام أن يتَّبِعُوه".
ومِن أعظم الوفاءِ: الوفاءُ مع جنابِ المُصطفَى سيِّدنا ونبيِّنا مُحمدٍ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي بلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصَحَ الأمةَ، وما مِن خيرٍ إلا دلَّ عليه، وما مِن شرٍّ إلا حذَّرَ مِنه، بيَّن المحجَّةَ بيضاء لا يَزِيغُ عنها إلا هالِك.
الوفاءُ معه - عليه الصلاة والسلام - بمحبَّتِه وتعظيمِه، وكثرةِ الصلاةِ عليه، والاعتِرافِ بعظيمِ مِنَّة الله ببِعثتِه، فيتعلَّقُ القلبُ بسُنَّته، ويتَّبِعُ مِلَّتَه وهَديَه، يزَمُ ذلك حتى يلقَى ربَّه.
ومِن الوفاءِ: الوفاءُ مع النَّفسِ بالحِفاظِ عليها وصِيانتِها؛ فإنَّ لنفسِك عليك حقًّا، فلا يحرِمها الطيِّبات، ولا يُورِدُها المهالِك، يسعَى في صلاحِها وإصلاحِها، وفَكاكِها مِن النَّار، وإدخالِها الجنَّة.
ثم الوفاءُ للوالِدَين ببِرِّهما، والإحسانِ لهما، وحُسن صُحبتِهما، والاعتِرافِ بفضلِهما، وخَفضِ الجَناحِ لهما، والدُّعاءِ لهما في الحياةِ وبعد الممات، ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23، 24].
ومِن الوفاءِ: الوفاءُ بين الزَّوجَين، مما يجعَلُ الأُسرةَ مُطمئنَّةً، والحياةَ مُستقِرَّةً. وفاءٌ جميلٌ في حالِ الشدَّة والرَّخاء، والعُسر واليُسر، وفاءُ مودَّةٍ ورحمةٍ، وحُسن عِشرةٍ، ولُطفِ معيشةٍ، وتحمُّلٍ وتجمُّلٍ.
والوفاءُ للأقرَبِين، والأصحابِ، والمعارِفِ بالسُّؤال والمُزاوَرَة والتفقُّد والبَذل والتعاوُن والتسامُح والمعرُوف.
والإنسانُ في وطنِه ومع وُلاةِ أمرِه على عهدٍ والتِزامٍ بأن يقُومَ بمسؤوليَّته في السَّمع والطاعة، والمنشَط والمكرَه، والعُسر واليُسر، والأمانة والنَّصِيحة، والأمر بالمعروق، والنهي عن المُنكَر، والحِفاظ على المُكتسَبات.
مُواطِنٌ وفِيٌّ يعملُ ولا يُهمِل، ويبنِي ولا يهدِم، ويُخلِصُ ولا يغشُّ.
والوفِيُّ الكريمُ لا ينسَى جَميلَ المُعلِّم، وجَميلَ الصَّدِيق، وجَميلَ كلِّ صاحِبِ جَميلٍ. ومَن أُوتِيَ علمًا فكتَمَه، فقد خانَ ولم يَفِ.
أما الوفاءُ بالعُقودِ والعُهودِ والمواثِيقِ، والأيمانِ والنُّذُور، والدُّيُون والمُعاملات فهذا مِن أعظم الأماناتِ وأوسَعها وألزَمها.
معاشر المسلمين:
ومِن الوفاءِ: الوفاءُ لماضِي الأمةِ وتُراثِها وتارِيخِها، فلا يجوزُ للمرءِ أن يتنكَّرَ لماضِيه؛ فمَن لا ماضِيَ له لا مُستقبَلَ له، والوفاءُ للماضِي ليس بتقدِيسِه وادِّعاء عِصمتِه وتبرِئتِه مِن الأخطاء والنقائِص، وإنما الوفاءُ بالارتِباطِ به، وعدم الانفِصال عنه؛ لأنه يُمثِّلُ الجُذُور، وفصل الشَّجَرة عن جُذُورها يُميتُها.
الله أكبر، الله أكبر ما تعاقَبَت الأهِلَّة هِلالًا بعد هِلال، والله أكبر ربُّ رمضان وربُّ شوال.
أيها الإخوة:
مَن رُزِقَ الوفاء فقَد رُزِقَ الخير كلَّه؛ فهو الدليلُ على طِيبِ الأصل، وهو البُرهانُ على شرَفِ العُنصر.
أما آثارُه الوفاءُ - عباد الله - وثِمارُه فأكثَرُ مَن أن تُحصَى أو تُحصَر؛ فبالوفاءِ يكونُ تحصيلُ التقوَى، ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى﴾ [آل عمران: 76]، ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 7].
وبالوفاءِ يتحقَّقُ الأمنُ، وتُصانُ الدماء، وتُحفَظُ الحُقوق، ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: 72].
بالوفاءِ تكفِيرُ السيِّئات، ودخُول الجنَّات ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: 12]، ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: 10].
بالوفاءِ تكونُ النَّجدَة والشَّهامة والمُروءَة، ودوامُ الصِّلة، وانتِشارُ الخير والمعروف، وحِفظُ النِّعَم، وغرسُ معانِي الإنسانيَّة ومكارِمِ الأخلاقِ. وبسِيادةِ الوفاءِ تجرِي العلاقاتُ الإنسانيَّة برُوح الأخُوَّة والمحبَّة والثِّقَة.
الله أكبر مَنَّ ربُّنا على مَن شاءَ مِن عبادِه بالفضلِ فكانُوا مِن المرحُومِين، والله أكبر قضَى بحكمتِه على مَن أعرَضَ وتولَّى فكانُوا مِن المحرُومين.
وبعدُ .. حفِظَكم الله:
صاحِبُ الوفاء تعظُمُ منزلتُه وتبقَى سيرتُه لِسانَ صِدقٍ في الآخَرين والآخِرين، وأقدارُ الرِّجال تتفاوَتُ تفاوُتًا واسِعًا، وثَمْلُ الوفاء قد يكونُ فادِحًا يُكلِّفُ المرءَ حياتَه قبل مالِه، وهذه - وربِّكم - تكالِيفُ المجدِ المنشُود في الدنيا والآخرة، والفضائِلُ لا تتجزَّأ، فلا يكونُ المرءُ كريمًا مع قومٍ لئيمًا مع آخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: 91].
نفعَني الله وإياكم بهَديِ كتابِه، وبسُنَّة نبيِّه مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائر المُسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه؛ إنه هو الغفورُ الرحيم.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسُبحان الله بُكرةً وأصيلًا، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على عبدِه ورسولِه سيِّدنا محمدٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله أعادَ وأبدَى، والله أكبر أنعمَ وأسدَى، والحمدُ لله كثيرًا، والله أكبر كبيرًا حمدًا وتكبيرًا مِلءَ السماوات ومِلءَ الأرضِ إرغامًا لمَن استَكبَر عِنادًا وجَحدًا، أحمدُه - سبحانه - لا أُحصِي لنعمِه عدًّا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا أحدًا، فردًا صمَدًا شهادةً أتَّخِذُها عند الرحمنِ عهدًا، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه كرُمَ رسُولًا، وشرُفَ عبدًا، شريعتُه شريعةُ الحقِّ، ونَهجُه نَهجُ الهُدَى، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وأصحابِه عزَّ بهم هذا الدينُ وعلا شرَفًا ومجدًا، والتابِعِين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ومَن بهَديِهم اقتَدَى، وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أبدًا سرمَدًا.
الله أكبر خزائِنُ جُودِ ربِّنا لا تنفَدُ ولا تُحصَر، والحمدُ لله ما حفِظَ عبدٌ أوقاتَ الطاعةِ وعمَّر.
أما بعد .. معاشِر الإخوة:
ومِن الوفاءِ: الوفاءُ بالعُهود والمواثِيق، والعلاقات الدوليَّة. وتاريخُ الإسلام ناصِعٌ مُنذ فجرِه الأول؛ فصفحتُه بيضاء نقيَّة، لم يُدنَّس بخيانةٍ، ولا غدرٍ، ولا نقضِ عهدٍ.
يقولُ الإمامُ الثوريُّ - رحمه الله -: "اتَّفقُوا على جوازِ الخِداعِ في الحربِ إلا أن يكون فيه نقضُ عهدٍ أو أمانٍ، فلا يحِلُّ".
وتاريخُ الإسلام يُحدِّثُ أحسنَ الحديثِ عن الوفاءِ في صفحاتِ مجدٍ وفَخارٍ، يأتِي في مُقدِّمة ذلك: حبيبُنا وسيِّدُنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - مع أهلِه، ومُعاهداتِه ومواثِيقِه:
أما وفاؤُه مع أهلِ بيتِه: فتأمَّله مع زوجِهِ خديجة - رضي الله عنها -، واستَمِع إلى عائشة - رضي الله عنها - وهي تقُولُ: "ما غِرتُ على امرأةٍ ما غِرتُ على خديجَة، ولقد هلَكَت قبل أن يتزوَّجَني بثلاثِ سِنين؛ لِما كُنتُ أسمَعهُ يذكُرُها، وإن كان ليَذبَحُ الشاةَ ثم يُهدِي في خُلَّتِها مِنها".
وفي بعضِ المروِيَّات: "اذهَبُوا به إلى فُلانةٍ؛ فإنها كانت صَدِيقةً لخَدِيجة".
تقُولُ عائشةُ: فرُبَّما قُلتُ: كأنَّما لم يكُن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجَة، فيقولُ: «لقد آمَنَت بِي إذ كفَرَنِي الناسُ، وصدَّقَتني إذ كذَّبَني الناسُ، وواسَتْني بمالِها إذ أخرَجَني الناسُ، ورَزَقَني الله مِنها الوَلَد».
أما في مُعاهداتِه واتِّفاقيَّاتِه فالأمرُ أكبرُ وأعظمُ، وكلُّ صُلح الحُديبية بأحداثِه ومُفاوضاتِه صِدقٌ ووفاءٌ والتِزامٌ.
وتأمَّلُوا في قصة حُذيفَة بن اليَمَان ووالِدِه - رضي الله عنهما -، وسبب تخلُّفِهما عن غَزوَة بدرٍ. يقُولُ حُذيفةُ - رضي الله عنه -: "ما مَنَعَنا أن نشهَدَ بدرًا إلا أخِي وأبِي، أقبَلْنا نُريدُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخَذَنا كُفَّارُ قُريش، فقالُوا: إنَّكُم تُريدُون مُحمدًا، فقُلنا: ما نُريدُه، إنما نُريدُ المدينةَ، فأخذُوا علينا عهدَ الله ومِيثاقَه لتصِيرُون إلى المدينة ولا تُقاتِلُوا مع مُحمدٍ.
فلما جاوَزناهُم أتَينَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرنا له ما قالُوا وما قُلنا لهم، فما ترَى. قال: «نستَعِينُ اللهَ عليهم، ونفِي بعهدِهم». فانطَلقنَا إلى المدينة، فذاك الذي منَعَنا أن نشهَدَ بدرًا".
وقصةُ إسلام أهل سمَرقَند بعد انسِحابِ جيش قُتيبَة بن مُسلم بعد أن أمَرَه أميرُ المُؤمنين عُمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بالوفاءِ لهم بعَهدِهم، قصةٌ مِن أشهَر وقائِع التاريخ وأصدَقِها وأنبَلِها.
الله أكبر جعَلَ في تصرُّمِ الأعوامِ والشُّهُور عِبرةً لمَن تفكَّر، والله أكبر كتَبَ الفلاحَ لمَن جدَّ في عمل الصالِحات وشمَّر.
معاشر المُسلمين:
ومِن الوفاءِ والشُّكرِ والعِرفان: استِشعارُ ما عليه بلادُ الحرمَين الشريفَين المملكة العربية السعودية مِن الخير، والأمن، والإيمان؛ فهي - بفضلِ الله ومِنَّتِه - مأرِزُ الإسلام، ومنبَعُ الدعوةِ إلى الله، وأمانُ الخائِفِين، وعَونُ المُحتاجِين للدُّول والأفرادِ. يدٌ حانِية تُواسِي المكلُومِين، وتُداوِي جِراحَ المُسلمين، وتنطلِقُ فيها أعمالُ الإحسان؛ فهي - بفضلِ الله وكرمِه - مصدرُ الخَير بأنواعِه، ومنبَعُ البِرِّ بألوانِه.
لا يُقال هذا عاطِفةً أو مُجاملةً، ولكنَّه يقينًا وتحقيقًا، ونظرًا في الآثارِ والسُّنَن، فمَن يصِلُ الرَّحِم، ويحمِلُ الكَلَّ، ويُعينُ على نوائِبِ الحقِّ لا يُخزِيه الله أبدًا، ومَن كثُرَت حسناتُه وإحسانُه حسُنَت - بإذنِ الله - عاقِبتُه، وحفِظَه ربُّه في دينِه وأهلِه وديارِه.
إنَّ بلادَ الحرمَين الشريفَين المملكة العربية السعودية بقِيادتِها وحِكمتِها تُدرِكُ كما يُدرِكُ كلُّ عاقلٍ مُنصِفٍ صادقٍ أنه لا أمنَ ولا استِقرارَ ولا تنمِيةٍ في مُحيطٍ يعُجُّ بالقلاقِلِ والأزمات، ولا طريقَ للخلاصِ والسلامةِ والرَّخاء إلا الاتِّحادُ والتضامُن والصدقُ في التصدِّي للمُشكِلات والأزمات.
إنها الدولةُ المُبارَكة قلبُ العالَم الإسلاميِّ والعربيِّ في ثوابتِها المُرتكِزَة على الدين الحَنِيف، وتوحيدِ الكلِمة، وصِيانةِ اللُّحمَة، واجتِماعِ الأمة، وتبنِّي المُبادَرات في الإعانة والإغاثة والدَّعم وتأكيدِ اللُّحمة والأُخُوَّة، والتصدِّي للفساد والإرهاب، والمُساعَدة في الأزمات، والنَّأْي عن التدخُّل في الشُّؤون للداخِليَّة للدُّول.
هذه الدولةُ السَّنِيَّة لها سِجِلُّها الحافِلُ بمُبادرات الخَير والإصلاحِ لدَعمِ الأشِقَّاءِ العربِ والمُسلمين، في حقائِقَ ثابِتة لا تقبَلُ المُزايَدة، وفي إيمانٍ راسِخٍ بوحدةِ الهدفِ والمَصِير.
ومِن هذه النماذِج والمواقِفِ والمُبادَرات: اجتِماعُ قمَّة مكة المُكرَّمة في هذه العشر الأخِير المُبارَكة مِن شهر رمضان المُعظَّم، لدَعمِ دولةٍ شقيقةٍ، ومُساعدتها في خُروجِها مِن أزمتِها.
وقد كان قبلَه قريبًا تحويلُ قِمَّة الظَّهران إلى قِمَّة القُدس؛ تأكيدًا وتذكيرًا لقضيَّتنا الأولى والكُبرى فلسطين والقُدس وأهلِها.
إنه الدورُ الرِّياديُّ المُبارَك لهذا البلَد المُبارَك، وتجسيدُ معنى الأُخُوَّة العربيَّة والإسلاميَّة الحقَّة، بعيدًا عن الدَّعاوَى والشِّعارات.
إنها محضِنُ العرب والمُسلمين وحِصنُهم المَنِيعُ - بإذن الله - في اجتِماعاتٍ مُباركةٍ، ومُحادثاتٍ ومُباحثاتٍ لبَحثِ السُّبُل الكفيلةِ - بإذن الله - لحلِّ كلِّ مُشكِلةٍ، والتغلُّبِ على كلِّ ظُروفٍ صعبةٍ. رُؤيةٌ عميقةٌ تقُومُ على التضامُن، والتنسيقِ، والهمِّ المُشترَك، والعمل المُشترَك.
إنها - بإذن الله وعونِه - طَوقُ النَّجاة لأشِقَّائِها؛ فصَفَحاتُ عطاءاتِها ملِيئةٌ بالمواقِفِ المُشرِّفة في دَعمِ الأشِقَّاء ونُصرتِهم مهما كانت التحديات، ومهما كلَّفَ التصدِّي لها مِن ثمنٍ، وذلك كلُّه مِن غير مَنٍّ ولا انتِظارِ مُقابِل.
الله أكبر عمَّ الوُجودَ بإحسانِه ورحمتِه، والله أكبر أجزَلَ العطايا بمِنَّتِه.
والحديثُ عن الوفاءِ يُحتِّمُ الإشارةَ والتَّنوِيهَ بما عليه رِجالُ أمنِنا، وقوَّاتِنا المُسلَّحة في بُطولاتِهم واستِبسالِهم ويقَظَتهم ومواقِفهم الشُّجاعة المشهُودة، في إخلاصٍ وتفانٍ وإتقانٍ وكفاءةٍ، وبأعمالِهم ويقَظَتِهم - بإذن الله وعونِه - تبقَى هذه البلادُ عزيزةً محفُوظةً، آمِنةً مُطمئنَّةً.
إنهم مصدرُ عِزٍّ وفَخار؛ فهُم - بتوفيقِ الله - صمَّامُ الأمان في حِماية دِيارِ الإسلام بِلادِ الحرمَين الشريفَين، ومهدِ مُقدَّسات المُسلمين، وسيظلُّون تاجَ الرُّؤوس، ومصدرَ طُمأنينةِ النُّفُوس.
واليوم يومُ عيدٍ وتبادُل التهانِي، فليهنَأ المُسلِمون في هذه البلاد مُواطِنُون ومُقيمُون، فليهنَؤُوا بدينِهم وأمنِهم، ولتَهنَأ وتُهنَّأ الدولةُ - حفِظَها الله - برِجالِها وجنُودِها وشعبِها، ولتطمئنَّ الأمةُ إلى حِرصِ وُلاةِ الأمور ويقَظَتِهم في مواقِف لا يُقبَلُ فيها إلا الحَزمُ والعَزمُ.
فالحمدُ لله ثم الحمدُ لله على نِعمِه التي لا تُحصَى، جمَعَ كلمتَنَا، وأسبَغَ علينا نِعمَه ظاهرةً وباطنةً. سدَّد الله الخُطَى، وبارَكَ في الجُهود والأعمال، وجنَّبَنا الفتنَ ما ظهَرَ منها وما بطَن.
ألا فاتَّقُوا اللهَ - رحِمَكم الله -، واعلَمُوا أن الوفاءَ مِن أقوَى الدلائِل على طِيبِ الأصل، وأوضَحِ البراهِين على شرَفِ العُنصر، ومِن أجلِ هذا عظَّمَ الله أمرَه بقولِه: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة: 40].
وقال أهلُ الحكمة: "وعدُ الكريم ألزَمُ مِن دَين الغَرِيم، ووَعدٌ بلا وفاءٍ عداوةٌ بلا سبَب، وبالوفاءِ يدُومُ الإخاء".
الله أكبر ما هلَّ هِلالٌ وأبدَر، والحمدُ لله والله أكبر على ما سهَّل ويسَّر.
معاشِر المُسلمين:
ابتَهِجُوا بعيدِكم؛ فعِيدُكم مُبارَك، وتقبَّل الله طاعتَكم.
ابتَسِمُوا وابتَهِجُوا، وانشُروا السُّرورَ والبهجةَ في أنفسِكم وأهلِيكم وإخوانِكم. العيدُ والتهنِئةُ لمَن يزرَعُ البسمةَ على شِفاه المُحتاجِين، ويُدخِلُ السُّرورَ على المرضَى والمكلُومِين.
أيها المُسلمون:
العيدُ مُناسبةٌ كريمةٌ لتصافِي القلوب، ومُصالحَة النفوس. مناسبةٌ لغَسلِ أدران الحقد والحسَد، وإزالةِ أسبابِ العداوة والبغضاء.
وإنَّ في مواقِع التواصُل الاجتماعيِّ، والمجموعات التي يُنشئُها الأقاربُ والأصدقاءُ وذوُو الاهتمام والمُتابعات، في هذه المواقِع طرائِقُ حسنة، وأبوابٌ مُتَّسِعة للكلام الطيبِ، وإدخالِ السُّرور، وحُسن الحديث، ولطيفِ المُتابَعة، ورقيقِ السؤال، وتبادُل عبارات المرَح المُباح.
العيدُ فرحٌ وسُرورٌ لمَن طابَت سريرتُه، وخلُصَت نيَّتُه، وحسُنَ للناسِ خُلُقه، ولَانَ في الخطابِ كلامُه. إدخالُ السُّرور شيءٌ هيِّن، تسُرُّ أخاك بكلمةٍ أو ابتِسامة أو ما تيسَّر مِن عطاءٍ أو هديَّة، تسُرُّه بإجابةِ دعوةٍ أو زيارةٍ.
العيدُ لمَن اتَّقَى مظالِمَ العباد، وخافَ يوم التَّناد، العيدُ لمَن لم يحسُد الناسَ على ما آتاهم الله مِن فضلِه.
فافرَحوا وأدخِلوا الفرَحَ على كلِّ مَن حَولَكم؛ فالفرحُ أعلَى أنواع نعيمِ القلبِ ولذَّته وبهجَته.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
ومن مظاهرِ الإحسانِ في العِيدِ بعد رمضان: استِدامةُ العبد على نَهج الطاعة والاستِقامة، وإتباعُ الحسنة الحسنة، وقد ندَبَكم نبيُّكم محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - لأَنْ تُتبِعُوا رمضانَ بستٍّ مِن شوال، فمَن فعَلَ فكأنما صامَ الدهرَ كلَّه.
تقبَّل الله منا ومنكم الصيامَ والقيامَ، وسائِرَ الطاعات والأعمال الصالحات.
الله أكبر ما أنعمَ ربُّنا من الفضلِ والخيرات، والله أكبر ما أفاضَ من الآلاء والبركات.
هذا صلُّوا وسلِّموا على الرحمة المُهداة، والنعمة المُسداة: نبيِّكم محمدٍ رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربُّكم، فقال - عزَّ قائلاً عليمًا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك نبيِّنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذُرِّيَّته، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الصحابةِ أجمعين، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وجُودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، واحمِ حَوزةَ الدين، وانصر عبادَك المؤمنين، واخذُل الطغاةَ والملاحِدةَ وسائرَ أعداء الدين.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيِّك وعبادك الصالحين.
اللهم آمِنَّا في أوطاننا، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتَنا فيمن خافَك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم أيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامَنا ووليَّ أمرنا، ووفِّقه لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى، وارزُقه البطانةَ الصالحةَ، وأعِزَّ به دينك، وأعلِ به كلمتك، واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين، واجمَع به كلمةَ المسلمين على الحقِّ والهُدى، اللهم ووفِّقه وولِيَّ عهدِه وإخوانَه وأعوانَه للحق والهدى، وكل ما فيه صلاحُ العباد والبلاد.
اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وبسنَّة نبيِّك محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً لعبادك المؤمنين، واجمَع كلِمَتهم على الحقِّ والهُدى يا رب العالمين.
اللهم وأبرِم لأمةِ الإسلام أمرَ رُشدٍ يُعزُّ فيه أهلُ الطاعة، ويُهدَى فيه أهلُ المعصِية، ويُؤمَرُ فيه بالمعروفِ، ويُنهَى فيه عن المُنكَر، إنك على كل شيءٍ قدير.
اللهم عليك بالصَّهايِنة اليهود المُحتلِّين؛ فإنهم لا يُعجِزونَك، اللهم وأنزِل بهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين، اللهم إنا ندرَأُ بك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورِهم.
اللهم احفَظنا مِن شرِّ الأشرار، وكيدِ الفُجَّار، وشرِّ طوارِقِ الليلِ والنهار.
اللهم يا ذا الجُود والمَنِّ احفَظ علينا هذا الأمنَ، وسدِّد قِيادتَه، وقوِّ رِجالَهم، وخُذ بأيدِيهم، وشُدَّ مِن أزرِهم، وقوِّ عزائِمَهم، وزِدهم إحسانًا وتوفيقًا وتأييدًا وتسديدًا، اللهم واشفِ مرضاهم، وارحَم شُهداءَهم، واحفَظ أُسَرَهم وذريَّاتهم يا رب العالمين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان، واحقِن دماءَهم، واجمَع على الحقِّ والهُدى والسنَّة كلِمتَهم، وولِّ عليهم خِيارَهم، واكفِهم أشرارَهم، وابسُط الأمنَ والعدلَ والرَّخاءَ في دِيارِهم، وأعِذهم مِن الشُّرور والفتَن ما ظهرَ منها وما بطَن.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
سُبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسُبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على سيِّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
خطب الحرمين الشريفين

ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الأخوة الإسلامية"، والتي تحدَّث فيها عن الأُخُوَّة الإسلاميَّة، والوحدة الدينيَّة؛ إذ بيَّن أن الشَّريعة الإسلاميَّة جاءَت بالأُخُوَّة والاعتِصام، والتحذيرِ مِن الفُرقةِ والانقِسام، مُعرِّجًا على بيانِ فضلِ الصُّلحِ بين المُسلمين وأنَّ ذلك يعُودُ إيجابًا على الأمةِ الإسلاميَّة كلِّها بالنَّفع والعِزَّة والاستِقرار.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله على ما خوَّلَنا مِن آلاء الأُلفة وأَولَانا، أحمدُه - سبحانه - ترادَفَ فضلُه على عبادِه هتَّانًا، فأَولَى الشَّاكِرين زيادةً وإحسانًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُزكِّي مِنَّا قلوبًا وتعمُرُ أوطانًا، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه أتقَى البريَّة إنسانًا، وأطهَرُها جوارِح وجَنانًا، صلَّى الله عليه وعلى آله الباذِلِين في الله مُهَجًا وأزمانًا، وصحبِه الذين تقارَضُوا الوُدَّ ألوانًا، وكانوا في الذَّودِ عن الديار فُرسانًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ يبتَغُون فضلًا مِن الله ورِضوانًا، وسلَّم تسليمًا كثيرًا مُبارَكًا إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله - حقَّ التقوَى، واسعَوا في تحصِيلِها والتِماسِها، واستَضِيئُوا دَومًا بنِبراسِها؛ تلِنْ لكم القلوبُ العصِيَّة بعد شِماسِها، وتُحقَّقُ لكم السعادةُ العُظمَى في أطراسِها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 102، 103].
|
مَن يَتَّقِ اللهَ فِي
الأعماقِ مُتَّجِهَا |
|
إلى الإلَهِ سيَرقَى
عَالِيَ الرُّتَبِ |
|
ويَنهَلُ الحقَّ
شَلَّالًا بخَافِقِهِ |
|
ويُلجِمُ النَّفسَ
إذعانًا لمُجتَنَبِ |
معاشِر المُسلمين:
عاشَت الأمةُ الإسلاميةُ خلالَ أيامٍ موسِمًا عظيمًا، وعيدًا سعيدًا كريمًا، وإنَّ في اختلافِ الليلِ والنهارِ لآياتٍ وعِبرًا لأُولِي الألباب وعِظات. فما أسرَعَ مُرورَ الليالِي والأيام، وكرَّ الشُّهُور والأعوام!
فها هو شهرُ الصيام وموسِمُ العيد السعيد قد مرَّ كلَمحةِ برقٍ أو غَمضَةِ عينٍ.
|
فطُوبَى لمَنْ كانَت
التَّقوَى بِضاعَتَهُ |
|
فِي شَهرِهِ وبِحَبلِ
اللهِ مُعتَصِمَا |
قال الحسنُ البصريُّ - رحمه الله -: "إنَّ الله لم يجعَل لعملِ المُسلمِ أجَلًا دُون المَوتِ"، وقرأَ قولَه تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99].
وإنَّ مِن علاماتِ القَبُول وأماراتِه: الثَّباتَ على الطاعةِ بعد انقِضاءِ رمضان والعيدِ وفَوَاتِه.
قال الإمامُ عليُّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: "كُونُوا لقَبُول العمل أشدَّ اهتِمامًا مِنكُم بالعمل، ألم تسمَعُوا إلى قولِ الله - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]؟!".
فيا مَن أقبَلتَ على ربِّك في شهر الصِّيام! لا تَكسَل ولا تَتوانَى، وكُن مِن عبادِ الله الشَّاكِرين؛ فإنَّ مِن شُكرِ نِعمةِ الله - عزَّ وجل - على توفيقِه للصِّيام والقِيام أن يستمرَّ المُسلمُ على طاعةِ الله - سبحانه - في حياتِه كلِّها، ومِن علامةِ قَبُول الحسنةِ الحسنةُ بعدَها.
ولقد كان سلَفُنا الصالِحُ - رحمهم الله - يَدعُون اللهَ تعالى بعد رمضان أن يتقبَّلَ مِنهم الطاعات، وقد نَدَبَكم نبيُّكم - صلى الله عليه وسلم - إلى صِيامِ سِتَّةِ أيامٍ مِن شوال، وجعَلَ صِيامَها بعد رمضان كصِيامِ الدَّهر، كما في حديثِ أبي أيوب - رضي الله عنه -، الذي خرَّجَه مُسلمٌ في "صحيحه".
تقبَّل الله مِنَّا ومِنكم صالِحَ الأعمال.
أيها المُسلمُون:
لقد جاءَت الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالأُخُوَّة والاعتِصام، والتحذيرِ مِن الفُرقةِ والانقِسام، وفي مُزدَحِمِ شُؤُون الحياةِ ومشاغِلِها، وفي دوَّامة قضايا الأمة ومُتغيِّراتها، ينسَى كثيرُون - بل يتناسَون - مقصِدًا مِن أجَلِّ مقاصِدِ إسلامِنا الحقِّ، وشريعتِنا الغرَّاء، ذلكم هو مقصِدُ الأُخُوَّةِ الإسلاميَّة، والوحدة الدينيَّة، فيُحِلُّون محلَّ الاجتِماع والائتِلاف التفرُقَّ والاختِلافَ، غافِلِين عن قولِ الحقِّ - تبارك وتعالى -: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71]، وقولِه - سبحانه -: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].
فالأُخُوَّةُ الإسلاميَّةُ مقصِدٌ عظيمٌ مِن مقاصِدِ شريعتِنا البَلْجاء، وليس لأحدٍ مِن أبناءِ الأمة أن يشُقَّ عصاهُ مِن أجلِ أهواء شخصيَّة، أو أطماعٍ دنيويَّة، أو تعصُّباتٍ حِزبيَّة، بل الأوجَبُ الاعتِصامُ بالجماعة، وحُسن السمع للإمام والطاعة. فالاتِّحادُ والإخاءُ هو لُبُّ الإسلام المَصُون، وجَوهَرُه المَكنُون، وقِوامُ السيادة والسياسة، وطُنُبُ الحكمة والكِياسة.
يقولُ الإمامُ الطحاويُّ - رحمه الله -: "ونرَى الجماعةَ حقًّا وصوابًا، والفُرقةَ زَيغًا وعذابًا".
ويقولُ شيخُ الإسلام - رحمه الله -: "ثم إنَّ الاعتِصامَ بالجماعة والائتِلاف مِن أصولِ الدين".
ويبرُزُ ذلك - يا رعاكم الله - في فُشُوِّ ظواهِر خطيرة لها آثارُها البالِغة في توسِيع هُوَّة الخلافِ في الأمة وتقطيعِ جسَدِها الواحِد إلى أوصال مُتناثِرة، وأشلاء مُتنافِرة.
ومَن أمْعَنَ النَّظَر في آفاقِ التاريخ العافِي والأَمَم، واستقرَأَ أحوالَ الأُمَم، وما نابَها مِن غِيَر الدُّثُور بعد الاستِقرار والظُّهور عبر الدُّهور، الفادُون عناء، وبمَدِيدِ الجلاء أنَّ ما أصابَها مِن التشرذُم والفناء، والهلَكَة والامِّحاء إنما سببُه التنازُع والشِّقاقُ، والتخالُفُ والافتِراق، فهو الخَطْبُ الرَّاصِد، والبلاءُ الوافِد، والجَهلُ الحاصِد.
وماذا تَجنِي مُجتمعاتٌ تُضرِمُ السَّخائِم والعصبيَّات، وتُورِثُ الأوجالَ والمعَرَّات، وهي تعلَمُ أنَّ الخلافات والنَّعَرات سَهمٌ غَرَبٌ يجعَلُ النَّظيمَ أشتاتًا مُتناثِرة، والأمةَ المُتراصَّة طرائِق مُتنافِرة، والقُوَى المَرِيرة مُزَعًا مبثُوثة، والصُّفوفَ المُعتصِمَة أبادِيدَ منكُوثة، قد غشَّاها البَأْوُ والوَهم، وجَفاهَا الحِجَى والفَهم. وتلك رَجوَى العدوِّ مِنَّا، ومطمَحُه الأخيرُ فينا، يقولُ - سبحانه -: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].
ولن يصُدَّ تيَّارَ هاتِيك التشدُّد وأتِيَّه، ولن يُقَوِّمَ مُعوَجَّه وعصِيَّه إلا اتِّحادُ المُسلمين وتلاحُمُهم، وترابُطُ أواخِيهم وتراحُمُهم، وتلك هي الشَّعيرةُ التي احتَفَى بها الإسلامُ أيَّما احتِفاء، فوطَّدَها وعزَّزَها ووتَّدَها.
أليست هي عِمادَ القُوَّة والمُنَّة؟! ونِعمَت النِّعمةُ والمِنَّة؟! وذلك لما يترتَّبُ عن الاتِّحاد والأُخُوَّة مِن المحبَّة والوِداد، واستِئصال السَّخائِم والأحقادِ، والتفرُّغ للإعمارِ والبِناء، والتطويرِ والنَّماء.
إخوة الإيمان:
ورغمَ ما تُعانِيه أمَّتُنا الإسلاميَّةُ مِن تشتُّتٍ وتفرُّقٍ، إلا أن تباشِيرَ الأمل والضِّياء تُبدِّدُ دائمًا دياجِيرَ الظُّلَم واليأس.
وفي هذه الآوِنة العصِيبَة، والحُقبة التأريخيَّة اللَّهِيبة أُثلِجَت صُدورُ المُؤمنين، وقرَّت أعيُنُ الغَيُورِين مع أفراحِها بالعيدِ السَّعيد، تجدَّدَت أفراحُها بحدَثٍ كبيرٍ، وعملٍ جليلٍ، وإنجازٍ تأريخيٍّ، وعملٍ استِثنائيٍّ، ألا وهو المُصالحةُ بين أبناءِ الشَّعب الأفغانيِّ الأبِيِّ؛ عملًا بقولِه تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].
واستِبصارًا بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «عليكُم بالجماعة، وإيَّاكُم والفُرقَة»؛ أخرجه الترمذي، وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
وقد قال عبد الله بن مسعُودٍ - رضي الله عنه -: "عليكُم بالجماعة؛ فإنَّ الله لن يجمعَ أُمَّةً مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على ضلالةٍ".
لقد جاءَت هذه المُصالحةُ المُبارَكةُ لتُبدِّدَ غياهِبَ الغُمَّة التي أظَلَّت الأمة، فتُفيقَ مِن تَهوِيمِها الذي طالَ أمَدُه، وتَغوِيرِها الذي اسبَطَرَّ عمَدُه، وتعُودَ هذه البلادُ الإسلاميَّةُ العَريقةُ إلى سابِقِ مَجدِها ورِفعتِها، وتسترِدَّ سامِقَ عِزِّها ومكانتِها، ولتحقيقِ العفوِ والصُّلح بين المُسلمين، قال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128].
وبمشاعِرِ الحُبِّ التي تجِلُّ عن الوَصفِ، وبعواطِفِ التقديرِ التي يقصُرُ عنها الرَّصفُ، أرسلَتْها بلادُ الحرمين الشريفين هتِيفةً مُشفِقةً حانِية؛ إشادةً بهذه المُصالَحة المُبارَكة، وتجديدِ الهُدنة المُوفَّقة التي تمَّ التوصُّلُ إليها بين الأفراد الأفغانيَّة لفترةٍ أطوَل؛ ليتسنَّى للجميعِ العملُ على تحقيقِ الأمنِ والسلامِ لأبناءِ الشعبِ الكِرامِ.
فالشعبُ الأفغانيُّ الشَّقيقُ له مكانتُه المرمُوقة في العالَم الإسلاميِّ، وله صفحةٌ ناصِعة، وسجِلٌّ حافِلٌ في الجِهاد في سبيلِ الله، وقد عانَى كثيرًا مِن وَيلاتِ الحُروب، يتطلَّعُ ويتطلَّعُ معه العالَمُ الإسلاميُّ إلى طَيِّ صفحة الماضِي، وفتحِ صفحةٍ جديدةٍ قائِمةٍ على التسامُح والتصالُح، ونَبذِ العُنف وإراقة الدماء، والمُحافظَة على حياةِ الأبرِياء؛ استِنادًا إلى التعاليمِ الإسلاميَّةِ العظيمةِ التي تدعُو إلى نَبذ الفُرقة والخِلاف، والتعاوُن على البِرِّ والتقوَى، والعفوِ والإصلاحِ بين الإخوة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10].
|
إنَّ الجماعةَ حَبلُ
الله فاعتَصِمُوا |
|
مِنْهُ بعُروتِهِ
الوُثقَى لمَنْ دَانَا |
|
لولا الأئِمَّةُ لم
تُؤْمَنْ لنا سُبُلٌ |
|
وكانَ أضعَفُنا نَهبًا
لأقوَانَا |
وقد دعَمَت بلادُ الحرمين الشريفين - حرسَها الله - حكومةً وشعبًا، ومِن خلالِ مُؤسَّساتِها الرسميَّة قرارَ المُصالَحة؛ لأنه قرارٌ حكيمٌ، قائِمٌ على هَديٍ مِن الشريعة، وقِيَمِها الرفيعة، ويهدِفُ إلى صالِح شعبٍ مُسلمٍ عزيزٍ، وتجاوُز الخلافات التي عانَى مِنها طويلًا، ولم تُجْدِ مُواجهاتُها إلا مزيدًا مِن إراقة الدماء والدمار، والعداوة والتناحُر والتَّبار.
والأمةُ الإسلاميَّةُ والإنسانيَّةُ أحوَجُ ما تكونُ لتغليبِ منطِقِ العقل والحِكمة والحِوار، لتحقيقِ مصالِحها العُليا على كافَّة المطامِع، والنِّزاعاتِ الضيِّقة التي تعُودُ خسائِرُها بأكثر مِن مكاسِبِها الموهُومة، وللتأريخِ في هذا شواهِدُ ماثِلة لا يعتبِرُ بها إلا مَن وفَّقَه الله تعالى.
ومِن مِنبَر الحرم الشريف: هذه دعوةٌ حرَّاء، مُضمَّخةٌ بالوُدِّ والوفاء إلى مُواصَلة الجُهود نحو المزيدِ مِن التوافُقِ والتصالُحِ والتسامِي دومًا فوقَ الخِلافات.
هيَّا إلى التنافُسِ الشريفِ، والتسابُقِ المحمُود، والإنجازِ الرائِع، والإبداعِ المُتألِّق دُون تعصُّبٍ أعمَى، أو تجريحٍ للآخرين وازدراءٍ لهم؛ فمَيدانُ العمل مفتُوحٌ تحت مِظلَّةٍ رسميَّةٍ مأمُونة تُحقِّقُ المودَّةَ والتجرُّد، ورُوحَ الترابُط، في حِكمةٍ رَصِينةٍ مُتوَّجةٍ بأَوفَى الضوابِط المُحكَمة، تُحيِي التُّراثَ الإسلاميَّ الحضاريَّ المُعتبَر، والمورُوثَ الاجتماعيَّ المُزدَهِر.
ولتكُن هذه البدايةُ انطِلاقةً لعمليَّةِ سلامٍ ومُصالَحةٍ حقيقيَّةٍ شامِلةٍ ينعَمُ بظِلِّها شعوبُ المنطِقة بالأمنِ والأمانِ، والسلامِ والاطمِئنان، ولتزأَر فيكُم - أيها المُتصالِحُون - دُون إبطاءٍ آمالُ التحدِّي للشِّقاقات، ولتُزَمجِر في دواخِلِكم اعتِبارُ أعلَى المقاصِد في الأمة والمآلات، ولتتدفَّق في مرابِعِكم شلَّالاتُ الحُبِّ والوُدِّ والوِفاق والمكرُمات؛ حِفاظًا على سُمعة هذا البلَد الإسلاميِّ، وإرثِه الحضاريِّ، ونَبذ العُنف والسِّلاح، ومُواصَلة الحِوار لتجاوُز كافَّة سُبُل النِّزاع، ومتى تجرَّدَت النُّفوسُ لهذا الغرضِ النَّبِيل، كان العَون والتأييد، وحصَلَ الخَيرُ والأمنُ والسلامُ، والمحبَّةُ والمودَّةُ والوِئام.
وإنَّكم - بإذن الله - لفاعِلُون، وإنَّ الغَيُورين لينتظِرُون، وربُّنا الرحمن المُستعان على ما تصِفُون.
حقَّقَ الله الرَّجاء، وحقَنَ الدماء، ووقَى الجميعَ شرَّ الثَّارات والخلافات، ووفَّقَنا لخالِصِ النيَّات، وأسمَى الأُمنِيات.
|
تلكُم لعَمْرِي أنماطٌ
لوحدتِنا |
|
فهَل تُرانَا لصَوتِ
العَقلِ نمتَثِلُ؟! |
|
فنَكتُبُ اليومَ
للتأريخِ ملحَمَةً |
|
تُفِيضُ حُبًّا وتِيهًا
إنَّهُ أمَلُ |
سدَّد الله الخُطَى، وبارَكَ في الجُهود، وحقَّق الآمال، ووفَّقَنا لصالِح الأقوال والأعمال، إنه خيرُ مسؤُول، وأكرَمُ مأمُول.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 114].
بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بهَدْيِ سيِّد المُرسَلين، إنَّه جوادٌ كريمٌ، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم؛ فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إن ربِّي لغفورٌ رحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله أَولَانا نِعمًا غِداقًا، وحبَانَا اعتِصامًا واتِّفاقًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ نبيِّنَا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه أزكَى البريَّة قَدرًا وأعظمُها أخلاقًا، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِه وصحبِه المُدبَّجِين مِن المكارِمِ أطواقًا، والباذِلِين للآخرة مُهَجًا وأشواقًا ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، ولتكُن تقوَى الله على الدوامِ حافِزًا لكم على الاجتِماع والاعتِصام، ونَبذ الفُرقة والانقِسام.
أمة الإسلام:
إنَّ الحِفاظَ على النَّسيج الاجتماعيِّ في الأوطان والأمة واجِبٌ دينيٌّ، ومقصِدٌ شرعيٌّ، وعدمُ بثِّ الفُرقة والاختِلافات، والتشتُّت والانقِسامات، والشَّائِعات والافتِراءات.
أمة الإيمان:
وبهذه المُناسَبةِ العظيمةِ، والمُصالَحة الكريمة يُنوَّهُ بجُهودِ هذه البلادِ المُبارَكة المملكة العربية السعودية؛ فهي مُنذ تأسِيسِها وهي تُولِي قضايا الإسلام والمُسلمين في كل مكانٍ الاهتِمامَ والعِناية، والحِرصَ والرِّعاية، وتجعَلُ عِلاجَ قضايا الأمة مِن أُسُسها وثوابتِها الرَّاسِخة.
وما البيانُ الصادِرُ عن خادمِ الحرمَين الشريفَين الملكِ سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - إلا أنمُوذجٌ مُشرِقٌ لمواقِفِ هذه البلاد المُبارَكة، فهي اليدُ الحانِية، والبَلسَمُ الشافِي لجِراحاتِ الأمة، وقد عبَّر باهتِمامٍ بالِغٍ عن حِسِّه الإيمانيِّ، ووِجدانهِ الإسلاميِّ والإنسانيِّ الكبير، وما أبانَه - رعاه الله وأيَّدَه - مِن سُرورِه وترحِيبِه وكلِّ مُسلمٍ بهذه الخُطوةِ المُبارَكة، وتأييدِه لها، وأمَلِه أن يتمَّ تجديدُها والبِناءُ عليها لفترةٍ أطوَل؛ ليتسنَّى لجميعِ الفُرقاء العملُ على تحقيقِ الأمنِ والسلامِ للشعبِ الأفغانيِّ المُسلمِ الأبِيِّ.
فهنيئًا لكم أشِقَّاءَنا الأعِزَّاء بهذه الهُدنة المُسدَّدة، ويا بُشراكُم بهذه المُصالَحة المُبارَكة التي تجعَلُ مِن خلافِ الأشِقَّاء سحابَةَ صَيفٍ عما قريبٍ تنقَشِع.
وإنَّنا مِن مِنبَر المسجِدِ الحرامِ لنَدعُو إخوانَنا الأشِقَّاء مِن أبناءِ شَعبِ أفغانِستان المُسلم - وقد وفَّقَهم الله إلى هذه الخُطوة الميمُونة - إلى الاستِمرار ومُواصَلَة وتوثِيقِ روابِط الأُخوَّة، والتعاوُن معًا للمُحافظة على المُقدَّرات والمُكتسَبات، وبِناءِ مُستقبَل بلادِهم، وجَعل مصلَحة وطنِهم فوقَ كلِّ الاعتِبارات، مُفوِّتِين الفُرصةَ على المُغرِضِين والمُتربِّصِين، مُرتَقِين عالِيًا بمعانِي أُخوَّتهم وقِيَمهم الدينيَّة، ولُحمَتهم الوطنيَّة.
لتأخُذ أفغانُنا المُسلمةُ وضعَها اللَّائِقَ بها في منظومتها الإسلاميَّة والعالميَّة، وأن يجِدُوا في دعوةِ خادمِ الحرمين الشريفين - وفَّقه الله - مِن مُنطلَق الرسالة الإسلاميَّة في بُعدِها الإسلاميِّ الكبير، والإنسانيِّ العميق، والحضاريِّ الوَثِيق، وقِيَمها العُليا الحاضِنة للجميع أُسوةً حسنةً، وأنموذجًا يُحتفَى حولَ مطالِبِها الأخويَّة المُشفِقة والمُحِبَّة، والداعِمة لكل خيرٍ وتصالُحٍ في بلادِ الأفغان، وفي كل مكانٍ.
والله المسؤُول أن يُوفِّقَ الإخوةَ الأفغانَ إلى ما فيه مصلَحةُ بلادِهم، وأن يُصلِحَ ذاتَ بينهم، ويُحقِّقَ لهم الأمنَ والسلامَ والاستِقرارَ، وسائِرَ بلادِ المُسلمين، وأن يجزِيَ خادمَ الحرمين الشريفين وولِيَّ عهدِه خيرَ الجزاء على حِرصِهم على نُصرة قضايا الإسلام والمُسلمين في بلاد الأفغان وفي كل مكانٍ، وأن يجعلَه في موازين أعمالِهم الصالِحة، إنه جوادٌ كريمٌ.
هذا، وصلُّوا - رحِمَكم الله - على خَيرُ الورَى، كما أمرَكم بذلك ربُّكم - جلَّ وعلا -، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّد الأولِين والآخرِين، ورحمةِ الله للعالَمين نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، واحمِ حَوزَةَ الدِّين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا، اللهم وفِّقه لِما تُحبُّ وتَرضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه، اللهم اجزِه خيرَ الجزاء وأوفاه جزاءَ ما قدَّم ويُقدِّمُ للإسلام والمُسلمين، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه وأعوانَهم إلى ما فِيه عِزُّ الإسلام وصَلاحُ المُسلمين، ووفِّق قادةَ المُسلمين إلى تحكيمِ شرعِك، واتِّباع سُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النار.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفِر لنا ولوالِدِينا وجميعِ المُسلمين الأحياءِ مِنهم والميتين.
اللهم كُن لإخوانِنا في فلسطين، وفي بلاد الشام، وأصلِح حالَ إخوانِنا في العراق، وفي اليمَن، ووفِّق رِجالَ أمنِنا، واحفَظهم، ووفِّقهم، وتقبَّل شُهداءَهم، وعافِ جَرحاهم، واشفِ مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام.
سُبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عمَّا يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله رب العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

اغتِنامُ
الفرص والأوقات
ألقى فضيلة الشيخ عبد
الله بن عبد الرحمن البعيجان - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "اغتِنامُ
الفرص والأوقات"، والتي تحدَّث فيها عن ضرورةِ اغتِنامِ الأوقاتِ في طاعةِ
الله تعالى، وعدمِ تضييعِ الحقوقِ والواجِباتِ فيها، وأنَّ موسِمَ الإجازة
الصيفيَّة ليس كلُّه للهوِ والمُتعة والترفِيه، بل يجِبُ اغتِنام العبدِ لوقتِه
فيما يُرضِي اللهَ تعالى ويُقرِّبُه مِنه.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ خَيرَ الحديثِ كِتابُ الله، وخَيرَ الهَدي هَديُ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ بِدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.
عباد الله:
أُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله؛ فهي وصيَّةُ الله للأولين والآخرين، ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131].
معاشِر المُسلمين:
اتَّقُوا اللهَ تعالى، وبادِرُوا أعمارَكم بأعمالِكم، وحقِّقُوا أقوالَكم بأفعالِكم؛ فإنَّ حقيقةَ عُمر الإنسان ما أمضَاه في طاعةِ الله، والكيِّسُ مَن دانَ نفسَه وعمِلَ لما بعد المَوت، والعاجِزُ مَن أتبَعَ نفسَه هواها، وتمنَّى على الله الأمانِي.
|
إذا هبَّتْ
رِياحُكَ فاغتَنِمْهَا |
|
فإنَّ لكلِّ
خافِقةٍ سُكُونُ |
|
ولا تَغفَلْ عن
الإحسَانِ فِيهَا |
|
فمَا تَدرِي
السُّكُونُ متَى يَكُونُ |
عباد الله:
قد ودَّعتُم شهرَ رمضان، موسِمَ الفضل والطاعة والغُفران. فلَيتَ شِعرِي! مَن المقبُولُ فنُهنِّيهِ .. ومَن المردُودُ فنُعزِّيه!
تقبَّل الله طاعتَكم، وغفرَ ذنوبَكم، وضاعَفَ لكم الأجرَ.
ثم استقيمُوا إلى الله وتقرَّبُوا مِنه؛ فإنَّ الاستِقامةَ على الطاعةِ مِن علاماتِ قَبُول العمل، وما تقرَّبَ عبدٌ إلى الله بشيءٍ أحَبَّ إليه مما افتَرَضَه عليه، ولا يزالُ العبدُ يتقرَّبُ إلى الله بالنَّوافِلِ حتى يُحبَّه؛ فمَن تقرَّبَ إليه بشِبرٍ تقرَّبَ إليه ذِراعًا، ومَن تقرَّبَ إليه ذِراعًا تقرَّبَ إليه باعًا، ومَن أتاه يمشِي أتاه هروَلَة.
فحافِظُوا على الفرائِضِ، ولا تَهجُرُوا القرآن، واحرِصُوا على قِيامِ اللَّيل.
فعن سُفيان بن عبد الله الثَّقفيِّ - رضي الله عنه - قال: قُلتُ: يا رسولَ الله! قُل لي في الإسلام قَولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدَك؟ قال: «قُل: آمَنتُ بالله، ثم استَقِم».
ألا وإنَّ مِن هَديِ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -: صِيامَ سِتَّةٍ مِن شوال؛ فعن أبي أيوب الأنصاريِّ - رضي الله عنه -، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن صامَ رمضانَ ثم أتبَعَهُ سِتًّا مِن شوال، كان كصِيامِ الدَّهرِ».
ومعنى ذلك: أنَّ الحسنةَ لما كانت بعشر أمثالِها؛ كان صِيامُ شهر رمضان بعشرةِ أشهُر، وصِيامُ ستةٍ بشهرَين، فذلك صِيامُ سنَة.
معاشِر المُسلمين:
الزمنُ كالمالِ .. كلاهُما يجِبُ الحِرصُ عليه، والاقتِصادُ في إنفاقِه وتدبيرِ أمرِه، وإذا كان المالُ يُمكنُ جَمعُه وادِّخارُه، بل وتنميتُه، فإنَّ الزمنَ عكسُ ذلك؛ فكلُّ دقيقةٍ ولحظةٍ ذهبَت لن تعُودَ إليك أبدًا ولو أنفَقتَ ما في الأرض جميعًا.
وإذا كان الزَّمنُ مُقدَّرًا بأجَلٍ مُعيَّنٍ، وعُمرٍ مُحدِّدٍ لا يُمكن أن يُقدَّم أو يُؤخَّر، وكانت قِيمتُه في حُسن إنفاقِه؛ وجَبَ على كل إنسانٍ أن يُحافِظَ عليه، ويستعمِلَه أحسنَ استِعمال، ولا يُفرِّطَ في شيءٍ مِنه قلَّ أو كثُر.
ولكي يُحافِظَ الإنسانُ على وقتِه يجِبُ أن يعرِفَ أين يصرِفُه؟ وكيف يصرِفُه؟ ألا وإنَّ أعظمَ المصارِفِ وأجَلَّها: طاعةُ الله - عزَّ وجل -؛ فكلُّ زمنٍ أنفَقتَه في تلك الطاعة لن تندَمَ عليه أبدًا.
عباد الله:
العُمرُ يسير، والزمانُ قصير، وما مضَى فات، وكل ما هو آتٍ آت، والعُمرُ كلُّه موسِمُ طاعةٍ، فلا مجالَ للتفريطِ فيه، وكلُّه لحظةُ امتِحانٍ واختِبار، فلا مجالَ للتقصِيرِ فيه والانتِظار، وبهذا العُمر اليسير يستطيعُ الإنسانُ أن يشتَرِي الخُلُودَ الدائِمَ في الجِنان، والبقاءَ الذي لا ينقَطِعُ مع الزمان، وفي المُقابِل فإنَّ مَن فرَّطَ في العُمر وقعَ في الهلاكِ والخُسران.
فينبغي للعاقِلِ أن يعرِفَ قَدرَ عُمره، وأن ينظُر لنفسِه في أمرِه، فيغتَنِمَ ما يفُوتُ استِدراكُه، فربما بتضيِيعه هلاكُه.
معاشِر المُسلمين:
إنَّ الإجازةَ الصيفيَّة التي تعيشُونَها فُرصةٌ للرَّاحة ولقضاءِ الحقوق والفوائِت، والتزوُّد للمُستقبل العاجِلِ والآجِلِ، وليست إجازةً لتعطيلِ الواجِبات، وإضاعةِ الحقوقِ والاستِغراق في الشَّهوات، وزيادة المُتراكِمات، وإثقالِ الكواهِلِ بالأحمال والتَّبِعات.
فاتَّقُوا اللهَ في أهلِيكم وأولادِكم، ربُّوهم على الحِرصِ على الوقتِ وبَذلِه فيما ينفَع؛ مِن علمٍ أو عملٍ، مِن كسبٍ حلالٍ أو طاعةٍ وعبادةِ ذِي الجَلال، فتلك هي تربيةُ الرِّجال.
إنَّ تربيةً ناشِئةً على هَدرِ الأوقاتِ والطاعاتِ يُعوِّدُهم على تضييعِ الحقوقِ والواجِبات، وعدمِ تحمُّل الأمانةِ والمسؤوليَّات، وعلى اللامُبالاة وعدمِ المُقاومةِ لمراحِلِ الحياةِ، والفراغُ يَؤُولُ بهم إلى خطرِ الفتنِ والأهواء، والانحِراف والبلاء.
عباد الله:
إنَّ الله سيسألُكم عن أوقاتِ العُمر فيما أفنَيتُمُوها، فلن تزُولَ قَدَما عبدٍ يوم القِيامة حتى يُسألَ عن أربعٍ: عن شَبابِهِ فيمَ أفنَاه، وعن عُمره فيمَ أبلاه، وعن مالِهِ مِن أين اكتَسَبَه وفيمَ أنفَقَه، وعن علمِهِ ماذا عمِلَ فِيه. فإذا جاء المرءُ للحسابِ، وانتصَبَ على قدَمَيه حافيًا عارِيًا بلا حِجاب، ينتظِرُ السُّؤالَ ويستعِدُّ للجواب، فسُئِلَ عن عُمره فيمَ أفناه، وعن شبابِه فيمَ أبلاه، يا لله! ما أعظمَ الهَول! وما أشدَّ الخَطْبُ!
فيجِبُ أن يتساءَل كلُّ واحدٍ مِنَّا إذا وُجِّهَ له هذا السُّؤال، ماذا سيخطُرُ بِبالِهِ؟ وما هو العملُ الذي قد هيَّأَه طِيلةَ شبابِه؟
فأعِدُّوا - عباد الله - للسُّؤال جوابًا، وللجوابِ صوابًا.
جعَلَني الله وإيَّاكُم مِمَّن يستمِعُ القَولَ فيتَّبِعُ أحسَنَه، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18].
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفَى، وسلامٌ على عبادِه الذين اصطَفَى.
عباد الله:
إنَّ العاقِلَ لا يرضَى أن يُضيِّعَ لحظاتِ أنفاسِه وهي تنقُصُ مِن عُمره تضيعُ سبَهلَلًا لا في أمرِ الدنيا ولا في أمر الآخرة، وإنَّ الفراغَ نعمةٌ إذا حسُنَ استِغلالُه، ونقمةٌ إذا ضاعَ استِعمالُه.
عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نِعمتانِ مغبُونٌ فيهما كثيرٌ مِن الناسِ: الصَّحةُ والفراغُ».
فتبذيرُ الأوقاتِ غَبنٌ ونقصٌ في الدينِ، وضعفٌ وسخافةٌ في الرأي، قد ابتُلِيَ فيه كثيرٌ مِن الناسِ. فاتَّقُوا اللهَ في أنفُسِكم ورعِيَّتِكم، واغتَنِمُوا الفُرصَ واحرِصُوا عليها.
عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لرجُلٍ وهو يعِظُه: «اغتَنِم خمسًا قبلَ خمسٍ: شَبابَك قبل هَرَمِك، وصحَّتَك قبل سَقَمِك، وغِناكَ قبل فقرِك، وفراغَك قبل شُغلِك، وحياتَك قبل مَوتِك».
أيها المُربُّون! أما أنه لا حرجَ في المُتعةِ والترفِيه والتسلِية والاستِجمام مِن غير إسرافٍ ولا مُنكَر، ولا تضييعٍ للحقوقِ والواجِبات؛ فإنَّ ذلك مِن المُتعة والمُباحات، وفيه تجديدٌ للطاقة وتنشيطٌ للنفسِ، ولكن مِن غير هَدرٍ وتبذيرٍ للأوقاتِ الثَّمِينة، ومِن غير إدمانٍ وإفراطٍ في الغَفلَة؛ فإنَّ الأمةَ بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى طاقاتِ وأوقاتِ أبنائِها، فسدِّدُوا وقارِبُوا.
وبعدُ .. معاشِر المُسلمين:
إنَّ ما يجرِي بين المُسلمين مِن الشِّقاقِ والتنافُر، والصِّراع والتناحُر مِن أعظم المواجِع، وأفظَع المصائِب والفواجِع، وأشدِّ الخُطُوب، وأثقَل الكُرُوب على القُلُوب، وإنَّ حقنَ دماءِ المُسلمين وصِيانةَ أعراضِهم وأموالِهم مِن مقاصِدِ الشَّرع ومُسلَّماتِ الدينِ القَويم، ومُتقَضَيات المنطِقِ السَّليم.
وإنَّ العالَم الإسلاميَّ اليوم يتطلَّعُ إلى تحقيقِ السلام بين إخواتِنا الأفغانيِّين، ويُرحِّبُ بالهُدنةِ بعدَهم بعدما حلَّ بهم مِن وَيلات الحروبِ والصِّراعاتِ، والفُرقةِ والنِّزاعات التي قد أنَّ تحتَ وَطأتِها الأطفالُ والثَّكالَى، واستنجَدَ تحت هَدمِها الأبرياءُ بالمَولَى تعالى.
أيها الإخوة الأفغان:
الصُّلحُ خَيرٌ، فاتَّقُوا الله وأصلِحُوا، واعفُوا واصفَحُوا، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10]، ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: 43].
فالتنازُلُ عن المصالِحِ مِن أجل حَقنِ دماءِ المُسلمين فضلٌ عظيمٌ، ومصلَحةٌ كبيرةٌ، وشجاعةٌ وبطُولةٌ. فاحقِنُوا دماءَ شعبِكم وأمَّتِكم، وأصلِحُوا ذاتَ بينِكم، وتعاوَنُوا على البِرِّ والتقوَى، ولا تعاوَنُوا على الإثمِ والعُدوان.
جمعَ الله شَملَكم، ووحَّد كلمتَكم، وأصلَحَ ذاتَ بينِكم، وألَّفَ بين قُلوبِكم، وأطفَأَ نِيرانَ الفتنةِ والعُنفِ في بلادِكم.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان يا ربَّ العالمين.
اللهم اجعَل هذا البلَدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورِنا، اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا بتوفيقِك، وأيِّده بتأيِيدك، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِهما للبِرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقهما لما فيه خيرٌ للإسلام والمُسلمين، ولما فيه صلاحُ البلاد والعباد يا رب العالمين.
اللهم احفَظ حُدودَنا، وانصُر جُنودَنا يا قويُّ يا عزيز.
اللهم لك الحمدُ على ما وفَّقتَ مِن صيامِ شهر رمضان وقِيامِه، وتلاوةِ كتابِك العزيز، اللهم تقبَّله مِنَّا يا رب العالمين، اللهم تقبَّله مِنَّا يا رب العالمين، واجعَله خالِصًا لوجهِك الكريم، مُوجِبًا للفَوزِ لدَيك في جنَّاتِ النَّعِيم برحمتِك يا أرحم الراحِمِين.
عباد الله:
صلُّوا وسلِّمُوا على مَن أمَرَكم الله بالصلاةِ والسلامِ عليه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم برحمتِك يا أرحم الراحمين.
خطب الحرمين الشريفين
ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "من حقوق النَّفس تزكيتُها"، والتي تحدَّث فيها عن تزكِية النُّفوس وطهارتُها، وأنَّ أكبر حقوقِ النَّفسِ على صاحِبِها تزكيتُها، ثم ذكَرَ ملامِحَ عِظَم تزكيةِ النُّفوس في ضوءِ القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة المُطهَّرة، وكلامِ أهلِ العلمِ.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقوا الله - عباد الله - حقَّ التقوَى، وراقِبُوه في السرِّ والنَّجوَى.
أيُّها المسلمون:
صلاحُ الخلقِ وقِوامُ أمرِهم بإعطاءِ كلِّ ذي حقِّ حقَّه، وذلك هو العدلُ الذي قامَت به السماواتُ والأرضُ، وعليه قِيامُ الدنيا والآخرة.
ولكلِّ نفسٍ على صاحِبِها حقٌّ هو مسؤُولٌ عنه يوم الدين؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «وإنَّ لنفسِكَ عليك حقًّا»؛ رواه أحمد.
وأكبرُ حقوقِ النَّفسِ: تزكيتُها، وبه حِفظُها مِن الخِصالِ الذَّميمَة؛ فالنَّفسُ أمَّارةٌ بالسُّوء، ولها شرٌّ يُستعاذُ مِنه؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «أعوذُ بك مِن شرِّ نفسِي»؛ رواه أحمد.
وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في فاتِحةِ خُطبِه: «ونعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفُسِنا»؛ رواه الترمذي.
فلا مناصَ مِن إصلاحِها، والله يُحبُّ لعبادِه ذلك؛ قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6].
أي: بواطِنَكم وظواهِرَكم.
ولعظيمِ أمرِ تزكِية النُّفوس كانت إحدَى مقاصِدِ بِعثةِ الرُّسُل - عليهم السلام -؛ فإبراهيمُ وإسماعيل - عليهما السلام - دعَوَا اللهَ أن يبعَثَ في هذه الأمةِ رسولًا منهم يُزكِّيهم، فقال: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [البقرة: 129].
ومُوسى - عليه السلام - أرسَلَه الله إلى فِرعون وقال له: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ [النازعات: 17، 18].
وبعَثَ الله نبيَّنا مُحمدًا - صلى الله عليه وسلم - مُزكِّيًا للعباد؛ قال - سبحانه -: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [الجمعة: 2].
وبذلك امتَنَّ الله على عبادِه المُؤمنين فقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: 164].
والدَّاعِيةُ يدعُو النَّاسَ إلى الله وإن دَنَت منزلتُهم؛ طمعًا في تزكيتِهم وهدايتِهم؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ [عبس: 1- 3].
والفلاحُ كلُّه إنَّما هو في تزكِية النَّفس، والخَيبةُ والخسارةُ في عدمِها، وعلى هذا أقسَمَ الله أطوَلَ قسَمٍ في كتابِه، ثم قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9، 10].
قال قتادةُ - رحمه الله -: "قد أفلَحَ مَن زكَّى نفسَه بطاعةِ الله وصالِحِ الأعمالِ".
وهذا ما أجمَعَت عليه الرِّسالاتُ؛ قال - سبحانه -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: 14- 19].
ومِن صِفاتِ المُؤمنين: تزكِيةُ أنفُسِهم؛ قال - سبحانه -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 4].
قال ابنُ كثيرٍ - رحمه الله -: "هو زكاةُ النُّفوس وزكاةُ الأموال، والمُؤمنُ الكامِلُ هو الذي يتعاطَى هذا وهذا".
ومَن زكَتْ نفسُه فقد منَّ الله عليه وأكرَمَه؛ قال - سبحانه -: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 21].
والجنَّةُ في الآخرة جزاءُ مَن أصلَحَ نفسَه؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41].
والدَّرجاتُ العُلَى مِنها جزاءُ مَن تزكَّى؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ [طه: 75، 76].
والسعيُ لتحقيقِ التَّزكِية فرضٌ على جميعِ العِباد، وذلك بامتِثالِ أوامِرِ الله واجتِنابِ نواهِيه؛ فإنَّ المقصد الأعظَم في الأوامِر والنَّواهِي - بعد تحقيقِ العبوديَّة لله - تزكيةُ الأنفُس وإصلاحُها.
وأعظمُ أمرٍ تزكُو به النُّفوسُ: توحيدُ الله بعبادتِه وحدَه لا شريكَ له، ولا زكاةَ للخلقِ إلا بالتوحيدِ؛ قال - سبحانه -: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: 6، 7].
قال شيخُ الإسلام - رحمه الله -: "وهي التوحيدُ والإيمانُ الذي به يزكُو القلبُ؛ فإنَّه يتضمَّنُ نفيَ إلهيَّة ما سِوَى الحقِّ مِن القلبِ، وإثباتَ إلهيَّة الحقِّ في القلبِ، وهو حقيقةُ (لا إله إلا الله)، وهذا أصلُ ما تزكُو به القُلوبُ".
والصلاةُ زكاةٌ للنَّفس، وطهارةٌ للعبدِ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].
وتُصلِحُ أهلَها، وتُذهِبُ عنهم الخطايا؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «أرأيتُم لو أنَّ نهرًا ببابِ أحدِكم يغتسِلُ مِنه كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ هل يبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟»، قالُوا: لا يبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ، قال: «فذلك مثَلُ الصَّلوات الخَمسِ يمحُو الله بهنَّ الخطايا»؛ متفق عليه.
وبالزَّكاةِ والصَّدقةِ نقاءُ النُّفوس وزكاؤُها؛ قال - سبحانه -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
والنَّجاةُ مِن النَّار جزاءُ مَن زكَّى نفسَه بمالِه؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: 17، 18].
والصَّومُ وِقايةٌ مِن آفاتِ النُّفوس وشُرورِها، ووِجاءٌ لأهلِه مِن الفواحِشِ؛ قال - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
وفي الحجِّ تزكُو النُّفوس؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].
والمقبُولُ مِن الحُجَّاج يعُودُ طاهِرَ النَّفس كيوم ولَدَتْه أمُّه؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن حَجَّ لله فلم يرفُث ولم يفسُق رجَعَ كيوم ولَدَتْه أمُّهُ»؛ متفق عليه.
وطاعةُ الله في حقوقِ المخلُوقين تُصلِحُ القلبَ وإن كانت ثقيلةً على النَّفسِ؛ قال - سبحانه -: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: 28].
والله - سبحانه - بيدِهِ صلاحُ القلوبِ وطهارتَها؛ قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 49].
والدُّعاءُ عبادةٌ عظيمةٌ، وبه يُدرِكُ العبدُ مطلُوبَه، ومِن دُعاءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم آتِ نفسِي تقوَاها، وزكِّها أنت خَيرُ مَن زكَّاها»؛ رواه مسلم.
والإكثارُ مِن ذِكرِ الله به انشِراحُ الصَّدر وطهارةُ القلبِ؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
ومَن اشتغَلَ بالقُرآن العظيم تلاوةً وتدبُّرًا وعملًا وتعلُّمًا وتعليمًا صلَحَت نفسُه وانقادَت له؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 57].
قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "القُرآنُ هو الشِّفاءُ التامُّ مِن جميعِ الأدواءِ القلبيَّة والبدنيَّة، وأدواءِ الدنيا والآخرة".
والعلمُ النَّافِعُ يُزكِّي أهلَه؛ قال - سبحانه -: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 9].
ولا يزالُ العلمُ بصاحِبِه حتى يبلُغَ مُنتهَى التزكِية ويكون مِن أهل الخشيَة؛ قال - سبحانه -: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28].
وقراءةُ سِيَر العُلماء والنُّبَلاء تحدُو بالنَّفسِ للتأسِّي بهم واللُّحُوق برَكبِهم، ومَن نظَرَ في سِيَر السَّلَف الصالِح ظهَرَ له تقصيرُ نفسِه.
وبصلاحِ القلبِ وسلامتِه صلاحُ ظاهرِ العبدِ وباطنِه، ومَن جاهَدَ نفسَه ظفَرَ بمقصُودِه.
ودوامُ مُراقبةِ الله يُكمِّلُ أهلَه، فيُدرِكُ منازِلَ المُحسِنين، وزكاةُ النَّفس موقوفةٌ على مُحاسبتِها، فلا تزكُو ولا تصلُحُ إلا بالمُحاسَبَة، وبذلك يطَّلِعُ العبدُ على عيُوبِ نفسِهِ ويسعَى إلى إصلاحِها.
وغضُّ البصَر مما تزكُو به الأنفُس؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: 30].
قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن استَطاعَ الباءَةَ فليتزوَّج؛ فإنَّه أغَضُّ البصَرِ، وأحصَنُ للفَرْج، ومَن لم يستطِع فعليه بالصِّيام؛ فإنَّه له وِجاء»؛ متفق عليه.
وصِيانةُ النَّفسِ عن فضُولِ النَّظَر والكلامِ مِن دواعِي تزكيتِها.
قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "وأكثرُ المعاصِي إنما تولُّدُها مِن فضُول الكلامِ والنَّظَر، وهما أوسَعُ مداخِل الشَّيطان؛ فإنَّ جارِحَتَيهما لا يمَلَّان ولا يسأَمَان".
والمرءُ على دينِ خليلِه، فلينظُر أحدُكُم مَن يُخالِل، والصُّحبةُ الصالِحةُ خَيرُ عَونٍ للعبدِ على بُلوغِ المعالِي؛ فإن غفَلَ ذكَّرُوه، وإن ذكَرَ أعانُوه.
وفي زيارةِ المقابِرِ وتذكُّر المَوتِ حياةُ النُّفُوس واستِقامتُها.
والتوبةُ تُزكِّي العبدَ وتُطهِّرُه؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ العبدَ إذا أخطأَ خطيئةً نُكِتَ في قلبِهِ نُكتةٌ سَوداء، فإن هو نَزَعَ واستغفَرَ وتابَ صُقِلَ قلبُه»؛ رواه الترمذي.
والنَّفسُ والأعمالُ لا تزكُو حتى يُزالَ عنها ما يُناقِضُها، ولا يكون الرَّجُلُ مُتزكِّيًا إلا مع تركِ الشَّرِّ؛ فالتزكيةُ وإن كان أصلُها النَّماء والبركةُ وزيادةُ الخَير، فإنما تحصُلُ بإزالةِ الشَّرِّ، فلهذا صارَ التزكِّي يجمعُ هذا وهذا.
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
فأصلُ التزكِية كتابُ الله وسُنَّةُ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، بطاعةِ الله واتِّباع هَديِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو سبيلُ الله ودينُه وصِراطُه المُستقيم، وبذلك زكاةُ الأنفُس وصلاحُها وفلاحُ الخلق وعِزُّهم.
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: 18].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولجميعِ المُسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشكرُ على توفيقِهِ وامتِنانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له تعظِيمًا لشأنِه، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا.
أيُّها المسلمون:
تغيُّرُ أحوال العِباد صلاحًا وفسادًا، ورخاءً وشدَّةً، وأمنًا وخوفًا تَبَعٌ لتغيير ما في نفوسِهم؛ قال - سبحانه -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
وكلُّ ما يُصيبُ العِبادَ فمنشَؤُه مِن أنفُسِهم؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: 165].
ومَن أصلَحَ سريرتَه أصلَحَ الله له علانيتَه، ومَن أصلَحَ ما بينَه وبين الله أصلَحَ الله ما بينَه وبين الناسِ، ومَن عمِلَ لآخرتِه كفَاه الله أمرَ دُنياه، والمُؤمنُ وَجِلٌ، يجمعُ بين إحسانٍ وخوفٍ، فيسعَى لإصلاحِ نفسِه وتزكيتِها، ولا يتمدَّحُ بذلك فيدَّعِي زكاءَها وطهارتَها؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32].
ثم اعلَموا أنَّ الله أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَمِ التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدين، الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بجُودِك وكرمِك يا أكرَم الأكرَمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا رخاءً، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]، ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
اللهم وفِّق إمامَنا لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، ووفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المسلمين للعمل بكتابِك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أمِّن حُدودَنا، واحفَظ بلادَنا، واصرِف عنها كلَّ شرٍّ ومكرُوهٍ، اللهم مَن أرادَنا أو أرادَ الإسلامَ أو المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعَل كيدَه في نَحرِه يا قويُّ يا عزيز.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ العظيمَ الجليلَ يذكُركم، واشكُرُوه على آلائِه ونِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

صلاحُ
القلبِ
ألقى فضيلة الشيخ أسامة
بن عبد الله خياط - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "صلاحُ القلبِ"، والتي تحدَّث فيها عن صلاحِ القلبِ وطهارتِه ونقائِه، وأنَّه
يتوقًّفُ عليه صلاحُ الجوارِح أو فسادُها؛ فإنَّه ملِكُ الجوارِح كلِّها،
مُبيِّنًا أثَرَ الأعمال الصالِحة في استِقامةِ القلبِ والجوارِح، والمعاصِي في
فسادِه وانحِرافِه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الذي خلقَ فسوَّى، والذي قدَّر فهدَى، أحمدُه - سبحانه - على آلاءٍ تعُمُّ ونِعمٍ تَترَى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مُلكُ السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثَّرَى، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه كان يُكثِرُ الدُّعاء بتثبيتِ القلبِ على الدينِ والهُدى، ويُحذِّرُ مِن شُرور النَّفسِ والشيطانِ والهوَى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه الأئمةِ الأبرار الأطهار النُّجَبا.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، وأنيبُوا إليه، وابتَغُوا إليه الوسيلةَ بطاعتِه، وطلبِ مرضاتِه، والاستِمساكِ بالذي أوحَى به إلى نبيِّه - صلواتُ الله وسلامُه عليه - مِن قبل أن يأتِيَ يومٌ لا بيعٌ فيه، ولا خُلَّةٌ، ولا شفاعةٌ، واحذَرُوا أسبابَ سخَطِه المُوجِبةَ لأليمِ عقوبتِه، المُقصِيَة عن رحمتِه، ونزول الجنَّة دار كرامتِه.
عباد الله:
إنَّ صلاحَ حالِ المرءِ، واستِقامةَ أمرِه، وسدادَ نهجِه، وعلوَّ كعبِه، ورُقِيَّ شأنِه، وطِيبَ حياتِه، وحُسنَ عاقبتِه مُتوقِّفٌ على صلاحِ عضوٍ بجسَدِه، مُرتهَنٌ بطهارَتِه ونقائِه، مُنبَعِثٌ مِن صحَّتِه وسلامتِه، ذلك هو القلبُ الذي أخبَرَ رسولُ الهُدَى - صلواتُ الله وسلامُه عليه - عن عِظَم شأنِه، وعُمقِ أثَرِه، وقوَّةِ سُلطانِه بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: «ألا وإنَّ في الجسَدِ مُضغةً إذا صلَحَت صلَحَ الجسَدُ كلُّه، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسَدُ كلُّه، ألا وهي: القلبُ ..» الحديث؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" مِن حديثِ النُّعمانِ بن بشيرٍ - رضي الله عنهما -.
وهو دليلٌ بيِّنٌ على أنَّ صلاحَ القلبِ رأسُ كلِّ خيرٍ ينعَمُ به العبدُ، وأنَّ فسادَه رأسُ كلِّ شرٍّ يبأَسُ ويشقَى بِهِ؛ ذلك أنَّه حين يكون القلبُ سليمًا ليس فيه إلا محبَّةُ الله تعالى، ومحبَّةُ ما يُحبُّه، وخشيتُهُ - سبحانه وتعالى -، وخشيةُ التردِّي فيما يُبغِضُه، فإنَّ حركاتِ الجوارِحِ كلَّها تصلُحُ عندئذٍ، وينشَأُ عن ذلك في نفسِ صاحِبِها باعِثٌ يبعَثُ على اجتِنابِ المحظُورات، والتَّجافِي عن المُحرَّمات، واتِّقاءِ الشُّبُهات مخافةَ الوقوعِ في هذه المُحرَّمات.
وحين يكونُ القلبُ مُتَّبشعًا لهواه، مُعرِضًا عن مرضاةِ مولاه؛ فإنَّ حركاتِ الجوارِحِ كلَّها تفسُدُ حينئذٍ، وتنحرِفُ بصاحِبِها وتَحِيدُ به عن الجادَّة، وتصرِفُه عن الحقِّ، وتصُدُّه عن سبيلِ الله، وتحمِلُه على التلوُّثِ بأرجاسِ الخطايا، والولوغِ في المُشتبهات؛ فاستِقامةُ القلبِ سببٌ لاستِقامةِ الإيمانِ.
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمامُ أحمدُ في "مسنده" بإسنادٍ حسنٍ، عن أنسٍ بن مالكٍ - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتَّى يستقيمَ قلبُه ..» الحديث.
واستِقامةُ الإيمانِ إنَّما تكونُ باستِقامةِ أعمالِ الجوارِح، التي لا تستقيمُ إلا باستِقامةِ القلبِ، ولا يستقيمُ القلبُ إلا حين يكونُ عامِرًا مُمتلِئًا بمحبَّةِ الله ومحبَّةِ طاعتِه، وكراهةِ معصِيتِه، ولا يتحقَّقُ له هذا إلا حين يكونُ القلبُ قائِمًا بعبوديَّته لله تعالى، هو ورعيَّتُه - أي: الجوارِح - بالقِيامِ بما يجِبُ عليه، وبتركِ ما يحرُمُ عليه.
فأما ما يجِبُ على القلبِ مِن أعمالٍ: فمِثلُ: الإخلاص لله، والتوكُّل عليه، والإنابةِ إليه، والمحبَّة له، والاستِعانة به، والخُضوع والانقِياد لأمرِه، والخوفِ والرَّجاء والصبرِ والتصديقِ الجازِم.
وأما ما يحرُمُ عليه فهو الكُفرُ؛ كالشَّكِّ، والنِّفاقِ، والشِّرك، وتوابِعِها، وتحرُمُ عليه المعصِية؛ كالرِّياء، والعُجب، والفخرِ، والخُيلاء، والقُنُوط مِن رحمةِ الله، واليأسِ مِن رَوحِ الله، والأمنِ مِن مَكرِ الله، والفرَحِ والسُّرور بأذَى المُسلمين، والشَّماتةِ بمصائِبِهم، ومحبَّةِ أن تشِيعَ الفاحِشةُ بينهم، وتوابِع هذه الأمور، التي هي - كما قال الإمامُ ابن القيِّم - رحمه الله -: "أشدُّ تحريمًا مِن الزِّنَا وشُربِ الخَمر وغيرهما مِن الكبائِرِ وغيرِها.
وهذه الأمورُ ونحوُها قد تكون صغائِر في حقِّه، وقد تكون كبائِر بحسبِ قوَّتِها، وغِلظَتها، وخِفَّتها، ودِقَّتِها. ومِن الصغائِر أيضًا: شهوةُ المُحرَّمات وتمنِّيها، وإن لم يُواقِعها.
وهذه الآفاتُ إنما تنشَأُ مِن الجَهل بعبوديَّة القلبِ، وتركِ القِيامِ بها، فإذا جهِلَها - أي: جهِلَ ما يجِبُ على القلبِ مِن الإخلاصِ والتوكُّل والإنابةِ وغيرها - امتلَأَ بأضدادِها ولا بُدَّ، وبحسبِ قِيامِه بها يتخلَّصُ مِن أضدادِها". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
ألا وإنَّ مِن أعظم الأدوِية لأمراضِ القلبِ مِن شُبهةٍ أو شهوةٍ: الاستِمساكَ بكِتابِ الله تعالى، وبسُنَّة رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، والاعتِصامَ بهما، والاهتِداءَ بهَديهِما، والعملَ بما جاءَ فيهما، والتحاكُمَ إليهما في الجَليل والحَقير؛ فقد قال - عزَّ مِن قائلٍ -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 57]، وقال - عزَّ اسمُه -: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].
وكذلك مِنها: دوامُ ذِكرِ الله تعالى، والضَّراعةُ إليه، وسُؤالُه أن يُثبِّتَ القلوبَ على دينِه، كما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكثِرُ في دُعائِه أن يقول: «اللهمَّ مُقلِّبَ القلوبِ! ثبِّت قلبِي على دينِكَ»؛ أخرجه الإمامُ أحمد في "مسنده"، والترمذي في "جامعِه" بإسنادٍ صحيحٍ.
ومِن الأدوِيةِ كذلك: الاجتِهادُ في الطاعاتِ الظاهرة والباطِنة، وتركُ المُحرَّمات الظاهرة والباطنة، ومِن أعظمِها ضررًا: النَّظرُ إلى ما حرَّمَ الله؛ فالنظرُ داعِيةٌ إلى فسادِ القلبِ.
قال بعضُ السلَف: "النَّظرُ سهمُ سُمٍّ إلى القلبِ".
فلهذا أمَرَ الله بحفظِ الفُرُوج، كما أمَرَ بغَضِّ الأبصارِ التي هي بواعِثُ إلى ذلك، فقال - سبحانه -: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ..﴾ [النور: 30، 31] الآية.
الوزَّكاةُ في الآيةِ: هي التقوَى والطَّهارةُ والنَّقاء، فمَن تزكَّى فقد أفلَحَ فدخَلَ الجنَّة.
والزَّكاةُ مُتضمِّنةُ حُصول الخَير، ودفعَ الشَّرِّ، فإذا حصَلَ ذلك أورَثَ المُتزكِّي نورًا وهُدًى وبصيرةً نافِذة، ومعرفةً، وقوةَ القلبِ وثباتَه وإقدامَه، وذلك كلُّه مِن أظهَر وفوائِد غضِّ البصَرِ عما حرَّمَ الله.
ومِن الأدوِية النَّافِعة التي يُصلِحُ الله بها مرَضَ القلوبِ: العقُوباتُ الشرعيَّةُ كلُّها، فإنَّها - كما قال بعضُ أهل العلم -: "العُقُوباتُ الشرعيَّةِ مِن رحمةِ الله بعبادِه ورأفتِه بِهِم، الدَّاخِلَة في قولِه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
فمَن ترَكَ هذه الرحمةَ النَّافِعةَ لرأفةٍ يجِدُها بالمريضِ، فهو الذي أعانَ على عذابِهِ وهلاكِهِ، وإن كان لا يُريدُ إلا الخَيرَ؛ إذ هو في ذلك جاهِلٌ، كما يفعلُهُ بعضُ النِّساء والرِّجال الجُهَّال بمرضاهم، وبمَن يُربُّونَه مِن أولادِهم وغيرِهم في تركِ تأديبِهم وعقوبتِهم على ما يأتونَه مِن الشرِّ، ويترُكُونَه مِن الخَير؛ رأفةً بهم، فيكون ذلك سببَ فسادِهم وعداوتِهم وهلاكِهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2].
فإنَّ دينَ الله هو طاعتُه وطاعةُ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، المبنِيُّ على محبَّتِه ومحبَّةِ رسولِه - عليه الصلاة والسلام -، وأن يكون الله ورسولُه أحَبَّ إليه مما سِواهُما؛ فإنَّ الرأفةَ والرحمةَ يُحبُّهما الله ما لم تكن مُضيِّعةً لدينِ الله.
والشيطانُ يُريدُ مِن الإنسان الإسرافَ في أمورِه كلِّها، فإنَّه إن رآه مائِلًا إلى الرحمةِ زيَّنَ له الرحمةَ، حتى لا يُبغِضَ ما أبغَضَه الله ولا يغار لما يغارُ اللهُ مِنه، وإن رآه مائِلًا إلى الشدَّة، زيَّن له الشدَّة في غيرِ ذاتِ الله، حتى يترُكَ مِن الإحسانِ والبِرِّ واللِّينِ والصِّلةِ والرَّحمةِ ما يأمُرُ الله به ورسولُه - صلى الله عليه وسلم -، ويتعدَّى في الشدَّة، فيزيدَ في الذمِّ والبُغضِ والعِقابِ على ما يُحبُّه الله ورسولُه - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا يترُكُ ما أمرَ الله به مِن الرحمةِ والإحسان، وهو مذمُومٌ مُذنِبٌ في ذلك، وهذا يُسرِفُ فيما أمَرَ الله به ورسولُه مِن الشدَّة حتى يتعدَّى الحُدودَ، وهو مِن إسرافِه في أمرِه؛ فالأولُ مُذنِبٌ، والثانِي مُسرِفٌ، والله لا يُحبُّ المُسرِفين، فليقُولَا جميعًا: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 147]". اهـ.
وهذا الكلامُ فيما يتعلَّقُ بالعقوبات الشرعيَّة وأثَرها في مُعالَجَة القلوبِ هو مِن نفائِسِ ودُرَر كلامِ شيخِ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وجزاه هو وعلماء الأمةِ خَيرَ الجزاء.
نفَعَني الله وإياكم بهدي كتابه، وبسنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أقولُ قَولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّة المُسلمين من كل ذنبٍ، إنه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمدُه - سبحانه -، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملِكُ الحقُّ المُبين، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه إمامُ المُرسَلين، وخاتمُ النبيِّين، ورحمةُ الله للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهِرين، وصحابتِه الغُرِّ الميامِين، والتابِعِين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى أبَدِ الآبِدِين.
أما بعد .. فيا عباد الله:
قال الحسنُ - رحمه الله - لرجُلٍ: "داوِ قلبَك؛ فإنَّ حاجةَ الله إلى العِباد صلاحُ قلوبِهم".
ومعناه - كما قال الإمامُ ابن رجبٍ - رحمه الله -: "أنَّ مُرادَه منهم ومطلُوبَه: صلاحُ قلوبِهم، فلا صلاحَ للقلوبِ حتى يستقِرَّ فيها معرفةُ الله وعظمتُه ومحبَّتُه وخشيتُه ومهابتُه ورجاؤُه والتوكُّل عليه، وتمتلِئ مِن ذلك، وهذا هو حقيقةُ التوحيدِ، وهو معنَى قولِ: لا إله إلا الله، فلا صلاحَ للقُلوبِ حتى يكون إلَهُها الذي تألَهُه وتعرِفُه وتُحبُّه وتخشَاه هو الله وحدَه لا شريكَ له، ولو كان في السماواتِ والأرضِ إلهٌ يُؤلَّهُ سِوَى الله لفسَدَت بذلك السماواتُ والأرضُ، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 22].
فعُلِمَ بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَم العُلويِّ والسُّفليِّ معًا حتى تكون حركاتُ أهلِها وحركاتُ الجسَدِ تابِعةً لحركةِ القلبِ وإرادتِه، فإن كانت حركتُه وإرادتُه لله فقد صلَحَ وصلَحَت حركاتُ الجسَد كلِّه، وإن كان حركةُ القلبِ وإرادتُه لغَيرِ الله فسَدَ وفسَدَت حركاتُ الجسَد بحسبِ فسادِ حركةِ القلبِ". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واعمَلُوا على القِيامِ بكلِ ما يكونُ به صلاحُ القلوبِ وعافيتُها وصحَّتُها وسلامتُها مِن الأمراضِ التي تُطفِئُ نورَها، وتُفسِدُ طُهرَها ونقاءَها، وتُفتِّرُ عزيمتَها، وتُضعِفُ هِمَّتَها، وتُنكِّسُ سَيرَها إلى الله، فتُعقِبُها حيرةً وضلالًا وخُسرانًا.
ألا وصلُّوا وسلِّمُوا على خاتمِ رُسُلِ الله مُحمدِ بن عبد الله؛ فقد أُمِرتُم بذلك في كِتابِ الله؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا خَيرَ مَن تجاوَزَ وعفَا.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واحمِ حَوزةَ الدين، ودمِّر أعداءَ الدين، وسائِرَ الطُّغاة والمُفسِدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصلِح قادَتَهم، واجمَع كلمَتَهم على الحقِّ يا رب العالمين.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسنَّةَ نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك المؤمنين المجاهدين الصادقين.
اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ، ووفِّقه لما تُحبُّ وترضَى يا سميعَ الدُّعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خَيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى ما فيه صلاحُ العِباد والبِلاد يا مَن إليه المرجِعُ يوم المعاد.
اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلُك في نُحور أعدائِك وأعدائِنا، ونعوذُ بك مِن شُرورِهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورهم، ونعوذُ بك مِن شُرورِهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورهم، ونعوذُ بك مِن شُرورِهم.
اللهم أصلِح لنا دينَنَا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعَل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا من كل شر.
اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أردتَّ بقومٍ فتنةً فاقبِضنا إليك غيرَ مفتُونين.
اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم أحسِن عاقبَتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم احفَظ جنودَنا المُرابِطين على الحدِّ الجنوبيِّ، اللهم احفَظهم مِن بين أيدِيهم، ومِن خلفِهم، وعن أيمانِهم، وعن شمائِلِهم، اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّرًا، اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّرًا، اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّرًا، اللهم انصُر بهم دينَك، وأعلِ بهم كلمتَك يا رب العالمين، اللهم سدِّد رميَهم، اللهم سدِّد رميَهم، وانصُرهم على عدوِّهم يا رب العالمين، اللهم اكتُب أجرَ الشَّهادة لمَن ماتَ مِنهم، اللهم اكتُب له أجرَ الشَّهادة، اللهم واشفِ مَن جُرِحَ مِنهم، اللهم اشفِ جرحاهم، اللهم اشفِ جرحاهم يا رب العالمين.
اللهم اشفِ مرضانا، وارحَم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، واختِم بالباقِيات الصالِحات أعمالَنا.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8]، ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
وصلِّ الله وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

النهي عن مجالسة العصاة
ألقى فضيلة الشيخ
صلاح البدير - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "النهي عن مجالسة العصاة"، والتي تحدَّث فيها عن أهلِ
البِدَع والمُنكَرات، وأنَّه لا يجوز مُجالسَتهم وتكثير سوادِهم؛ بل يجِبُ
الإنكارُ عليهم إن قَدِرَ العبدُ على الإنكار، وإن عجَزَ عنه فيجِبُ عليه
المُفارقَة؛ لئلا يكون مُشارِكًا لهم في الوِزرِ.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله حمدًا يُوافِي نعمَه وعطاياه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ولا معبُودَ بحقٍّ سِواه، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه ونبيُّه وصفِيُّه ونجِيُّه ووليُّه ورضِيُّه ومُجتَبَاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه صلاةً دائمةً ما انفَلَقَ صُبحٌ وأشرَقَ ضِيَاه.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمُون:
اتَّقوا الله بالسعيِ إلى مراضِيه، واجتِنابِ معاصِيه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أيها المُسلمُون:
النَّأْيُ عن مُجالسَةِ العُصاة ومُفارقتُهم، ومُجانبةُ ساحَتهم، واعتِزالُ أماكِنهم، والالتِفافُ عن صُحبتِهم، واجتِنابُ السفر معهم دليلُ صحَّة النَّظَر ونُور البصِيرة.
|
إنَّ السلامةَ مِن ليلَى وجارَتِها |
|
ألا تمُرَّ بوادٍ مِن بَوادِيهَا |
والقلوبُ ضعيفة، والشُّبضهُ خطَّافة، والفتنُ تمُوجُ، وذُو البصيرة يجتَنِبُ مُجالَسَةَ مَن يُمرِضُون القلوبَ ويُفسِدُون الإيمان، ويحذَرُ مِن مُصاحَبة المفتُونين الزَّائِغِين عن السنَّة، والمائِلِين عن الفضيلة والحِشمة وأخلاق المُسلمين.
|
إذا أنتَ لم تسقَمْ وصاحَبْتَ مُسقَمًا |
|
وكُنتَ له خِدنًا فأنتَ سَقِيمُ |
ومَن جلَسَ مجلِسَ قومٍ وفيه معصِيةٌ أو بِدعةٌ، وجَبَ عليه أن يُنكِرَ عليهم بالحِكمة والكلمة الطيبة والموعِظة الحسنة، والدليل المُوضِحِ للحقِّ المُزِيل للشُّبهَة، فإن قَدِرَ أن يُنكِرَ ولم يُنكِر كان شريكًا في الوِزرِ، وإن عجَزَ عن الإنكارِ عليهم وجَبَ عليه أن يُفارِقَ مجلِسَهم؛ لأنَّ المُجالَسَةَ والمُداخَلَة تُوجِبَان الأُلفةَ والمُتابَعَة، والإغضاءَ عن المُنكَر، والمودَّةَ في القلوبِ، وقد لا تُخطِئُه الفتنة.
قال عمرُو بن قيسٍ: "لا تُجالِس صاحِبَ زَيغٍ فيزيغَ قلبُك".
قال - جلَّ في عُلاه -: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: 140].
قال الطبريُّ: "وفي هذه الآية الدلالةُ الواضِحة على النَّهي عن مُجالسَة أهلِ الباطِلِ مِن كل نوعٍ مِن المُبتدِعة والفَسَقة عند خوضِهم في باطِلِهم".
وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "لا يجوزُ لأحدٍ أن يحضُر مجالِسَ المُنكَر باختِياره لغير ضرورةٍ، كما في الحديثِ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخِر فلا يجلِس على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ».
ورُفعَ لعُمر بن عبد العزيز قومٌ يشرَبُون الخَمرَ، فأمَرَ بجَلدِهم. فقِيل له: إنَّ فيهم صائِمًا، فقال: "ابدَأُوا به، أما سمِعتُم اللهَ يقُولُ: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: 140]؟!".
بيَّن عُمرُ بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنَّ اللهَ جعلَ حاضِر المُنكَر كفاعِلِه، ولهذا قال العُلماء: إذا دُعِيَ إلى وليمةٍ فيها مُنكَر - كالخَمر والزَّمر - لم يجُزْ حُضورُها؛ وذلك أنَّ الله تعالى قد أمَرَنا بإنكارِ المُنكَر بحسبِ الإمكان، فمَن حضَرَ باختِيارِه ولم يُنكِر فقد عصَى اللهَ ورسولَه بتركِ ما أمَرَه.
وإذا كان كذلك، فهذا الذي يحضُرُ مجالِسَ الخَمر باختِيارِه مِن غير ضرورةٍ، ولا يُنكِرُ المُنكَر كما أمَرَه الله، هو شريكُ الفُسَّاق في فِسقِهم، فيلحَقُ بهم". اهـ كلامُه - رحمه الله تعالى -.
أيها المُسلمون:
لا تُكثِّرُوا سوادَ أهل البِدع والباطِل والمعصِية، ولا تكونُوا يومًا في عَديدِ أصحابِ الفتنة والمُفسِدين.
فعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - "أنَّ أُناسًا مِن المُسلمين كانُوا مع المُشرِكين يُكثِّرُون سوادَ المُشرِكين على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيأتِي السَّهمُ فيُرمَى، فيُصيبُ أحدَهم فيقتُلُه، أو يضرِبُه فيقتُلُه، فأنزَلَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 97]"؛ أخرجه البخاري.
ومَن حضَرَ مجالِسَ المُنكَر استِئناسًا بهم، أو فرَحًا بأفعالِهم، أو رضِيَها، أو دعَا إليها، أو أيَّدَها، أو أيَّدَ المواقِعَ العنكبوتيَّة المشبُوهة، والصفحات الخبيثة، والمواقِع الإباحيَّة، والمواقِع المُعادِية لدينِنا وعقيدتِنا وأخلاقِنا وبادِنا، ومهَرَ لها علامةَ الرِّضا والتأييد؛ فقد كثَّر في سوادِهم، وصارَ مِن عِدادِهم.
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ فاستغفِرُوه، إنه كان للأوابِين غفُورًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله آوَى مَن إلى لُطفِه أوَى، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له دَاوَى بإنعامِه مَن يئِسَ مِن أسقامِه الدوَا، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنَا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه صلاةً تبقَى، وسلامًا يَترَى.
أما بعدُ .. فيا أيها المسلمون:
اتَّقُوا الله وراقِبُوه، وأطيعُوه ولا تَعصُوه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أيها المُسلمون:
لا تُجاهِرُوا بالمعاصِي، ولا تستحِلُّوا ما حرَّم الله تعالى، ولا تغتَرُوا بفتاوَى المُتساهِلِين، وأنصافِ المُتفقِّهين الذين يُفتُون بلا إيقانٍ ولا إتقانٍ، ويَمِيلُون إلى طرفِ الانحِلال بدَعوَى التيسير والوسطيَّة والاعتِدال، ومَن أظهَرَ المعصِية وجاهَرَ بها فقد أغضَبَ ربَّه، وهتَكَ سِترَه، واستخَفَّ بعقوبتِه، وآذَى عبادَ الله المُؤمنين.
فاتَّقُوا الله - يا أهلَ الإسلام -، ولا تغتَرُّوا بالنَّعماءِ والرَّخاء، ولا تستعِينُوا بالعطايا على الخطايا، ولا تُجاهِرُوا بالعِصيان، وقد أنعَمَ الله عليكم بعيشٍ رخِيٍّ، وشرابٍ رضِيٍّ، والناسُ مِن حولِكم يقتُلُهم الجُوعُ الأغبَر، والموتُ الأحمَر.
وصلُّوا على أحمدَ الهادِي شفيعِ الورَى طُرًّا؛ فمَن صلَّى عليه صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا.
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن الآلِ والأصحابِ، وعنَّا معهم يا كريمُ يا وهَّاب.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل بلادَ المُسلمين آمنةً مُطمئنَّةً مُستقِرَّةً يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمَين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما فيه عِزُّ الإسلام وصلاحُ المُسلمين يا رب العالمين.
اللهم انصُر جُنودَنا المُرابِطِين المُجاهِدين على ثُغورِنا وحُدودِنا يا رب العالمين، اللهم احفَظ رِجالَ أمنِنا، اللهم احفَظ رِجالَ أمنِنا، واجزِهم خيرَ الجزاءِ وأوفاه يا رب العالمين.
اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وارحَم موتانا، وفُكَّ أسرانا، وانصُرنا على مَن عادانا.
اللهم اجعَل دُعاءَنا مسمُوعًا، ونداءَنا مرفوعًا يا كريمُ يا عظيمُ يا رحيمُ.
خطب الحرمين الشريفين

حفظ الوقت
ألقى فضيلة الخطيب: الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حفظ الوقت"، والتي تحدَّث فيها عن حفظِ الأوقاتِ وتنظيمِها، والاهتِمام بلحظاتِ العُمر وعدم تضيِيعها فيما لا ينفَعُ العبدَ في دُنياه وأُخراه، مُبيِّنًا أنَّ مِن أعظم ما يهدِرُ أوقات العِباد في الآونة المُتأخِّرة وسائلُ التواصُل وأدواته وشبكاته وحساباته، مُبيِّنًا بعضَ مزاياها، ومُحذِّرًا مِن عيوبِها.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله المُتفرِّد بالبقاء والدَّوام، الملكِ القُدُوس السلام، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه، غافِرُ الذنبِ، وقابِلُ التَّوب، شديدُ الانتِقام، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً تُبلِّغُ رِضوانَ الله ودارَ السلام، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه خاتمُ النبيين وسيِّدُ الأنام، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابِه السابِقين إلى الإسلام، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا على الدَّوام.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى الله، فاتَّقُوا الله - رحِمَكم الله -، واعلَمُوا أنَّ مِن علامات توفيق الله للعبد وعُنوان سعادته: تيسير الطاعة، ومُوافقة السنَّة، وصُحبةَ أهل الصلاح، وحُسن الأخلاق، وبَذل المعروف، وصِلة الرَّحِم، وحفظَ الوقت، والاهتِمام بأمور المُسلمين.
ثم بعد ذلك - حفِظَكم الله - أليس ألَذَّ مِن العافية؟ ولا أَمَرَّ مِن الحاجة؟ ولا أنفَعَ مِن ترك المعاصِي؟ ولا حسبَ أرفعُ مِن الأدب؟ ولا مُروءةَ لمَن لا صِدقَ له؟ ولا كرَمَ لمَن لا حياءَ له؟ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].
أيها المُسلمون:
في موسِم الإجازات يحسُنُ الحديثُ عن الوقت في حفظِه، وتنظيمِه، وحُسن الاستِفادة مِنه، ومُحاسبة النَّفس عليه.
فلقد قالُوا: "إنَّ أعظمَ المَقتِ إضاعةُ الوقتِ".
وقالُوا: "ليس الوقتُ مِن ذهب، بل هو أغلَى مِن الذهب، وأغلَى مِن كل جوهَرٍ نَفيسٍ".
الوقتُ هو الحياةُ، وهو العُمرُ، والإنسانُ يفدِي عُمرَه بكل غالٍ وثَمينٍ.
وقالت الحُكماء: "مَن أمضَى يومًا مِن عُمره في غير حقٍّ قضَاه، أو فرضٍ أدَّاه، أو مجدٍ أصَّلَه، أو فعلٍ حميدٍ حصَّلَه، أو علمٍ اقتَبَسَه فقد ظلَمَ نفسَه، وعقَّ يومَه، وخانَ عُمرَه".
وإنَّ توزيعَ فرائض الإسلام على الأوقاتِ يُؤكِّدُ ضرورةَ حفظِ الدَّقائِق والساعات مع حركة الكَون ودوران الفلَك.
وقد نُقِلَ عن بعضِ السَّلَف أنه كان يُسمِّي الصلوات الخمس "ميزان اليوم"، ويوم الجمعة "ميزان الأسبُوع"، وشهرَ رمضان "ميزان العام"، والحجَّ "ميزان العُمر"، كلُّ ذلك مُحاسبةٌ دقيقة، وتنبيهٌ حصِيفٌ؛ ليسلَمَ له يومُه، وأسبُوعُه، وعامُه، وعُمرُه.
ومِن المُؤسِف المُهلِك أن ترَى مَن لا يُبالِي في إضاعة وقتِه سُدًى، بل إنَّهم يسطُون على أوقاتِ الآخرين ليُقطِّعُوها باللَّهو الباطِل، والأمور المُحقَّرَة.
أيها الإخوة:
وحديثُ الإجازة والوقت وتنظيمِه، والعُمر وحفظِه يبعَثُ على النَّظَر في وافِدٍ جديدٍ، شغلَ الأوقات، ودخلَ وتدخَّلَ في أدقِّ التفصِيلات في حياةِ النَّاسِ وشُؤونِهم، إنه ما يُعرفُ بـ "الشبكة العنكبوتية" ومواقِعِها، ومجموعاتها، وحساباتها، وأدواتِ التواصُل الاجتماعيِّ المُنبَثِقة عنها.
أيها المُسلمون:
إنَّ الشبكة العنكبوتية وما تنتَظِمُه مِن المواقِعِ والمجموعات والأدوات، وما تستبطِنُه مِن معلُومات، وما يتعلَّقُ بكل ذلك وما يلتحِقُ به ذلك كلُّه مِن أفضل ما أنتَجَتْه البشريَّة لتقريبِ المسافات، وبناء العلاقات، وتوثيقِ الصِّلات، وضبط الأوقات، والاتصال بجميع الجِهات، وثراء المعلومات، وتوظيف كل ذلك في الأعمال الصالِحة، والمسالِك النَّافِعة، والمشارِيع المُثمِرة.
وتلك نِعمٌ عظيمةٌ تستوجِبُ الشُّكرَ، ومِن أعظم الشُّكر استِعمالُها والاستِعانةُ بها على طاعةِ الله وابتِغاء مرضاتِه، ونفع النَّفس والناس، وحُسن توظيف الوقتِ وتنظيمِه مِن خلالِها.
غيرَ أنَّ هذه الوسائِل والأدوات والمواقِع مِن نظرٍ آخر مِن أعظم ابتِلاءات العصر على العامَّة والخاصَّة، على حدِّ قولِه - عزَّ شأنُه -: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35].
معاشِرَ المُسلمين:
مَن أنشَأَ له موقعًا، أو فتحَ له حسابًا في هذه الأدوات والشبَكات، فقد فتَحَ على نفسِه بابَ المُحاسبة، وليستحضِر عُمومَ هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49].
المُسلمُ - رعاكم الله - مُحاسَبٌ على أوقاتِه، وعلى آرائِه ووسائلِه ومُشاركاتِه، وما رأَتْه عيناه، وما سمِعَتْه أُذُناه، وما عمِلَتْه يداه.
فحاسِبْ نفسَك - يا عبدَ الله -، ولا تُكثِر التنقُّل مِن حسابِ فُلان إلى حسابِ فُلان، ومِن موقعِ فُلان إلى موقعِ فُلان، ولا تُضيِّع وقتَك، واحرِص على ما ينفَعُك، ودَع عنك الشَّتات، واحفَظ نفسَك مِن الضَّياع.
أرأيتَ كيف يكون الابتِلاء وصَرف الأوقات حينما يكون أول ما يفتَحُ عليه المرءُ عينَيه في يومِه هو هذه الأدوات، وآخرُ ما يُغمِضُ عليه قبل النَّوم هو هذه المواقِع؟! أيُّ ابتِلاءٍ أعظمُ مِن هذا الابتِلاء؟! مُتابعاتٌ في الليل والنهار، والنُّور والظَّلام.
إنه بلاءٌ عظيمٌ حين تستحوِذُ هذه الأجهِزة على مُجمَل الأوقات وجميل الساعات، تصرِفُ عن جليلِ الأعمال، وتحُدُّ مِن التواصُل مع مَن ينبَغِي التواصُلُ معه مِن الوالِدَين، والأقرَبِين، والمُقرَّبين. فكيف إذا كانت المُشاغَبَات والمُشاكَسات مع المُغرِّدين مُقدَّمةً على النَّفس، وعلى حقوقِ الوالِدَين والأهل والأولاد وكل ذي حقٍّ؟!
أيُّ بلاءٍ .. وأيُّ فتنةٍ حينما يتعطَّلُ جهازُ هذا المُبتلَى، فتراه يُصابُ بالذُّهُول، ويشعُرُ بالعُزلة والاغتِراب، والوحدة والضَّجَر؟!
أليس مِن البلاءِ أن يكون إمساكُ الطلاب بهذه الأجهِزة، وعُكوفهم عليها أكثرَ وأحسَن مِن إمساكِهم بالكتابِ والقلَم، ومِن ثَمَّ فلا تراهم يُحسِنُون قراءةً، ولا كتابةً، ولا تعبيرًا؟!
أليس مِن البلاء أن ترى أبوَين أو زوجَين أو صديقَين في مكان نُزهةٍ وابتِهاجٍ، أو في مجلسِ أُنسٍ وانبِساط، لكنَّهما مُتقابِلان وكأنَّهما صنَمَان، أو جِسمان مُحنَّطان؛ الرُّؤوسُ مُنكَّسة، والأبصار شاخِصة نحو شاشات الهواتِف والأجهِزة، وكأنَّهم ذوو قلوبٍ لا يفقَهُون بها، وأعيُنٍ لا يُبصِرُون بها، وآذانٍ لا يسمَعُون بها، تساوَى في ذلك المُثقَّفُ والجاهِلُ، والكبيرُ والصغيرُ، والذَّكَرُ والأُنثَى. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كم أخَذَت هذه الأجهِزة والأدوات مِن الوقتِ والتفكير والتركيز والحُضُور؟! إنها سيطرةٌ مُخيفة، وانصِرافٌ مُذهِلٌ، وانشِغالٌ خطيرٌ.
كم مِن الناسِ فقَدُوا الإحساسَ، وفقَدُوا المُتعةَ، وفقَدُوا الفائِدةَ، وأهدَرُوا الأوقات؟! يُرسِلُون، ويكتُبُون، ويستقبِلُون، ويُغرِّدُون، ويجتمِعُ عندهم رُكامٌ مِن الرسائِل شُهورًا بعد شُهور دون أن تجِد مَن ينفُضُ عنها الغُبار.
وكم من هؤلاء المُبتَلَين يخدَعُ نفسَه في مواقِع فيها قُرآنٌ كريم، وحديثٌ شريفٌ، وكلامٌ لأهل العلمِ والاختِصاص مُفيد، وحِكَم وتوجيهات، ولكنَّه لم فتَحها، وربما كان الرابِطُ معطُوبًا وهو لا يدرِي.
ومِن عظيمِ الابتِلاءِ: أن يتحدَّثَ مُتحدِّثٌ عن أخلاقيَّاتٍ لا يفعَلُها، أو ينهَى عن ممنُوعاتٍ وهو يرتَكِبُها.
أيها الإخوة:
ولمزيدٍ مِن التأمُّل والنَّظَر، فإنَّ المُتابِع يرَى أنَّ هذه الأدوات والأجهِزة قد أضعَفَت نُفوسَ بعض الفُضلاء مِن طلبة العلمِ، وأصحابِ المقامات الرفيعة والمسؤوليَّات، وذوي الاختِصاصات العلمية والفنية. نعم، إنَّهم حينما يكونُون رُموزًا وقُدواتٍ فالتوجُّه إليهم أعظَم، وحُسنُ الظنِّ بهم أكبَر.
لقد وقعَ بعضُ هؤلاء الكِرام في عثَراتٍ ما كان ينبَغي أن يقعُوا فيها؛ فترَى هذا الرجُل الكريم يُبرِزُ ما يتلقَّاه مِن مدائِح، يُغرِّدُ بها، ثم يُسارِعُ إلى تدويرِها وتردِيدِها وإعادتِها، كما يتحدَّثُ عن مُقابلاتِه ومُؤتمراتِه وإنجازاتِه، وكان حقُّه أن يتسامَى ويترفَّع عن هذه الصَّغائِر، وتطلُّب أضواء الشُّهرة الخادِع والمُهلِك، كما قد يسترسِلُ في كثرة التغريدات والتعليقات والمُتابعات في قضايا ومسائِل ينقُصُها التمحيص، والتثبُّت، والمُراجَعة، وقد علِمَ أنَّ خطأَ هذه المسالِك أكثرُ مِن صوابِها، ومَن غرَّدَ في كل وادٍ فقد سفِهَ نفسَه، وأشغَلَ العِباد.
ناهِيكم بما يُطرَحُ مِن أفكارٍ هشَّة لمُشكِلاتٍ كِبار، ورُؤَى فجَّة في قضايا خطيرة، وحلولٍ ضعيفةٍ لمسائل شائِكة كلُّها تحتاجُ إلى سهر الليالي، وإلى دراساتٍ ومُؤتمراتٍ، وخُبراء ومُتخصِّصين.
ثم تأمَّلُوا الابتِلاء فيما يظهرُ مِن التهافُت على التغريدِ فيما يُعرفُ بالوَسم حول قضيَّةٍ مُعيَّنة، فيخوضُ فيها مَن يخوضُ، ثم ينساقُ بعضُ هؤلاء الفُضلاء مع العامَّة؛ طلبًا للمُكاثَرة من غير روِيَّةٍ ولا تبصُّر.
أيها المُسلمون:
ومِن المآسِي: أن يسلُك بعضُ المغمُورين مسالِك إزجاء بعض عبارات المَدِيح لمَن يستحِق أو لا يستحِق، بغرضِ أن يظهرَ اسمُه، ومِن ثَمَّ يسعَى في إعادة هذه التغريدات؛ ليتردَّد اسمُ هذا المغمُور ويزدادَ مُتابِعُوه على حسابِ هؤلاء الفُضلاء وسُمعتِهم.
وقد أرشَدَ نبيُّنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُحثَى في وجوه هؤلاء المدَّاحِين التُّراب، وهذا يقُودُ - حفِظَكم الله وسدَّدَكم - إلى مَن يُفاخِرُ به مَن يُفاخِرُ بكثرة المُتابِعِين والمُردِّدين، وتزدادُ المأساةُ - إن صحَّ ذلك - أنَّ سُوقَ المُتابِعين مفتُوحة لمَن يُريدُ الشِّراء، أو سُوقَ مَن يُردِّدُون التغريدات ويُعيدُون نشرَها، وأكثرُ الناسِ في هذا البابِ - ولو حرَصتَ - يضُرُّون ولا ينفَعُون، ويُسيئُون ولا يُحسِنُون.
ويزدادُ الأمرُ خُطورةً حينما يكون هذا المَديحُ والإبرازُ في الأعمال الخيريَّة، وأعمال البِرِّ، والأعمال الصالِحة، والمشارِيع النافِعة، فيُبالِغُ هذا المُبتلَى في تصويرِها ونشرِها في أوضاعٍ مُختلِفةٍ، وأحوالٍ مُتفاوِتةٍ، ومواقِع مُتعدِّدةٍ، فيذكُرُ تفاصيلَ أعمالِه وعباداتِه؛ مِن صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍّ، وعُمرةٍ، وصدقاتٍ، وأمرٍ بالمعروف، ونهيٍ عن المُنكَر، ودعوةٍ إلى الله، ومُحاضراتٍ، وكلِماتٍ، ومُؤتمراتٍ، ومشرُوعاتٍ، وغير ذلك مما يُوقِعُ في الرِّياء والسُّمعة بقصدٍ أو بغير قصدٍ، وقد يُؤدِّي إلى فسادِ هذه المشارِيع وإجهاضِها والعبَثِ بها.
ألا يخشَى هذا المُحسِنُ على نفسِه أن يكون ممَّن يفعلُ الخيرَ وليس له مِن أجرِه نصِيب؟!
وتأمَّلُوا قولَ الفُضَيل بن عِياضٍ - رحمه الله -: "المُنافِقُ هو الذي يصِفُ الإسلامَ ولا يعملُ به".
وقد علِمَ أهلُ الإسلام بقولِ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يُحبُّ العبدَ التقيَّ النقيَّ الغنيَّ الخفيَّ»؛ رواه مسلم في "صحيحه".
و«أولُ مَن تُسعَّرُ بهم النَّارُ ثلاثةٌ: قارِئٌ ومُجاهِدٌ ومُنفِقٌ»؛ هذا الحديثٌ أيضًا في "صحيح مسلم".
وما ذلك إلا لِما تزيَّنُوا للناسِ بما يجِبُ فيه مِن الإخلاصِ والإخفاءِ قَدرَ الإمكان.
ويقولُ الحسنُ البصريُّ - رحمه الله -: "أحرَزُ العمَلَين مِن الشيطان عملُ السِّرِّ".
وكم كان يحرِصُ السَّلَفُ الصالِحُ على أن يكون للرجُلِ خبِيئةٌ مِن عملٍ صالِحٍ لا يعلَمُ به أقربُ المُقرَّبِين إليه.
وقد يُخشَى على بعضِ هؤلاء الكِرام، الذي قد يكون نالَ شيئًا مِمَّا يبتَغِيه مِن شُهرةٍ ومُتابعةٍ، يُخشَى عليه أن يخسَرَ صفاءَ القلب، ونقاءَ السَّريرة، وعملَ الآخرة.
معاشِر الأحِبَّة:
ثم انظُرُوا إلى ما تمتَلِئُ به هذه الأجهِزة والأدوات والمواقِع مِن الإشاعات، والدِّعايات، والأحاديث الموضُوعة، والفتاوَى المقلُوبة التي لا سنَدَ لها ولا مصدر، ولا خُطُم لها ولا أزِمَّة.
ومِن الخطأ البَيِّن: أن يظنَّ بعضُ مَن جعلَ له اسمًا مُستعارًا أنَّ ذلك يُبيحُ له الكذِبَ والتزويرَ ونقلَ ما لا صحَّة له، ولا حقيقةَ له، والوقعَ في الأعراض، وهذا حرامٌ ولا يجوز؛ فالله - سبحانه - مُطَّلِعٌ على الأسماء والحقائق، وعليمٌ بذاتِ الصُّدور.
معاشِر الأحِبَّة:
وإذا كان السفرُ هو الذي يُسفِرُ عن أخلاق الرِّجال، فإنَّ هذه الأدوات بتغريداتِها ومُتابعاتِها أصبَحَت تُسفِرُ عن أخلاقِ الناسِ مُجتمعاتٍ وأفرادًا، إنَّها الأجهزة والأدوات التي دخَلَت وتدخَّلَت وكشَفَت وفضَحَت أدقَّ التفاصيل في حياةِ الأفراد والأُسر، في أفراحِهم وأتراحِهم وأسفارِهم وتنقُّلاتِهم ومآكلِهم ومشارِبِهم، وكل تصرُّفاتِهم، ومُتغيِّرات حياتِهم.
أيها الإخوة:
التعلُّقُ الدائِمُ بهذه الأجهِزة أثَّر تأثيرًا كبيرًا على العلاقات الاجتِماعيَّة، والتواصُل المُثمِر مع الأهل والأقارِب، وكل مَن تُطلَب صِلَتُه ومُواصَلتُه، حتى انقلَبَت في كثيرٍ مِنها إلى أدواتِ تقاطُع لا أدواتِ تواصُل.
وبعدُ .. رعاكُم الله:
فإذا رأيتَ الرَّجُلَ يمشِي بين الناسِ مرفُوعَ الرأس، فاعلَم أنَّه لا يحمِلُ مِن هذه الأجهِزة شيئًا، وعُنوانُ صفحات الرَّجُل وشِعارُ موقِعِه، ونغَمَاتُ هاتِفِه مئِنَّةٌ مِن عقلِه، وقَلَّ مَن دخلَ في معارِك كلاميَّة، وحواراتٍ شبكيَّة أن يُفلِح.
ونعوذُ بالله مِن علمٍ يُفضِي إلى الجهل، ومِن حوارٍ ينتهي إلى حُمقٍ، ومِن جدلٍ يُوقِع في سَفَهٍ، ولن تزُولَ قدَمَا عبدٍ يوم القِيامة حتى يُسألأَ عن عُمره فيمَ أفناه.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 13، 14].
نفَعَني اللهُ وإياكم بالقرآن العظيم، وبِهَديِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِرُوه، إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله يمحُو الزلَّات ويصفَح، مَن اعتصَمَ به حفِظَه ومَن لاذَ به أفلَح، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه، نعمُه مُحيطة بعبدِه ما أمسَى وما أصبَح، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً هي النَّجاةُ والمربَحُ، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه دعَا إلى الهُدى ودينِ الحقِّ وأوضَح، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ وأصحابِه والتابِعين، ومَن سارَ على نهجِهم، واتَّبَعَ هديَهم وأصلَح، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدينِ.
أما بعد .. معاشِر المُسلمين:
كم عاكِفٍ على هذه الأدوات أهدَرَ الأوقات، وأضاعَ كثيرًا مِن المُهمَّات والأولويَّات، واشتغلَ بحواراتٍ ومُجادلاتٍ نتائِجُها التحريش، وإيغارُ الصُّدور، ولم يستفِد مِن موقعِه ومُتابعتِه سِوَى أن جمعَ فيه قِيلَ وقالَ.
الوقتُ - حفِظَكم الله - هو الحياةُ، وهو العُمر، فهل هانَ على المرء عُمرُه وحياتُه؟! لقد ظهرَ في هذه المواقِع والأدوات الرُّوَيبِضَة، وهو الرَّجُلُ التافِهُ يتكلَّمُ في أمور العامَّة والناسِ، لا قيمةَ له لا في العلمِ، ولا في الحِلمِ. ثم يُصبِحُ لهم مِن الأتباعِ والمُتابِعين والمُعجَبين ما تزدادُ به الفِتنةُ، وتضيعُ فيه أقدارُ الرِّجال، ومقاماتُ القامات.
يا عبدَ الله! إنَّ طُرقَ تعامُل كثيرٍ مِن الناسِ مع وسائِل الاتِّصال ورسائِلِه ينبَغي أن تكون أكثرَ وعيًا وحِكمةً، والتعلُّقُ الدائِمُ بهذه الأجهِزة أدَّى إلى إهمالِ مَن لا يجوزُ إهمالُه، والإساءةَ إلى مشاعِرِ مَن يجِبُ احتِرامُ مشاعِرِه.
أوقاتٌ تضيعُ بما لا ينفَع، وأولادٌ تُبنَى عقولُهم بما لا ينفَع، وأموالٌ تُصرَفُ بما لا ينفَع، وعباداتٌ تُفرَّغُ مما ينفَع.
ومما يستوقِفُ النَّظَر قولُ بعضِ الفُضلاء: درسٌ يحضُرُه اثنان أفضلُ وأكثرُ بركةً مِن مقطَعٍ يُشاهِدُه مليُونان.
ألا فاتَّقُوا الله - رحِمَكم الله -، فالمطلُوبُ ووقفةُ المُحاسَبة مِن أجل إحسانِ الاستِفادة مِن هذه الأجهِزة وتِقنيَّاتها، والاستِكثارِ مِن إيجابيَّاتها، وتقليلِ سلبيَّاتها، ولا يكونُ ذلك إلا بضبطِ الأوقاتِ، وتحديدِ أوقاتِ استِعمالِها، واختِيار ما يُؤخَذُ مِنها.
ولا يحفَظُ الوقتَ تمامَ الحِفظِ إلا التنظيم وحُسن الترتيب، فلا يطغَى غيرُ المُهم على المُهم، ولا المُهم على الأهم، ومعلومٌ أنَّ الوقتَ لا يتَّسِعُ لجميعِ الأشغال، ومَن شغلَ نفسَه بغير المُهم ضيَّعَ المُهمَّ وفوَّتَ الأهمَّ، ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 17، 18]، وكفَى بربِّك هادِيًا ونصِيرًا.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على الرحمةِ المُهداة، والنِّعمةِ المُسداة: نبيِّكُم مُحمدٍ رسولِ الله؛ فقد أمرَكم بذلك ربُّكم فقال - عزَّ قائِلٍ عليمًا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك: نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آله وأزواجِه وذريَّته، وارضَ اللهم عن الخلفاءِ الراشدين الأربعةِ: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِر الصحابة أجمعين، والتابِعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وإحسانِك وكرمِك يا أكرَمَ الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمُشركين، واحمِ حَوزةَ الدين، وانصُر عبادَك المُؤمنين، واخذُل الطُّغاةَ، والملاحِدَة، وسائرَ أعداءِ المِلَّة والدين.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسُنَّةَ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك الصالِحين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمُورِنا، واجعَل اللهم ولايتَنَا فيمن خافَك واتَّقاك واتَّبَع رِضاكَ يا رب العالمين.
اللهم أيِّد بالحقِّ والتوفيقِ والتسديدِ إمامَنا وولِيَّ أمرِنا، ووفِّقه لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِه للبِرِّ والتقوَى، وارزُقه البِطانةَ الصالِحةَ، وأعِزَّ به دينَك، وأَعلِ به كلمَتَك، واجعَله نُصرةً للإسلامِ والمسلمين، واجمَع به كلمةَ المُسلمين على الحقِّ والهُدى، ووفِّقه ووليَّ عهدِه وإخوانَه وأعوانَه للحقِّ والهُدى وكل ما فيه صلاحُ العباد والبلاد.
اللهم وفِّق وُلاةَ أمورِ المسلمين للعملِ بكتابِك، وبسنَّةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمَع كلمتَهم على الحقِّ والهُدَى يا ربَّ العالمين.
اللهم وأبرِم لأمةِ الإسلام أمرَ رُشدٍ يُعزُّ فيه أهلُ الطاعة، ويُهدَى فيه أهلُ المعصِية، ويُؤمَرُ فيه بالمعرُوف، ويُنهَى فيه عن المُنكَر، إنك على كل شيء قدير.
اللهم انصُر المُجاهِدين، اللهم انصُر المُجاهِدين الذين يُجاهِدُون في سبيلِك لإعزازِ دينِك، وإعلاءِ كلمتِك، اللهم انصُرهم في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين.
اللهم كُن لإخوانِنا المظلُومين والمُستضعَفين في كل مكانٍ، اللهم كُن لهم في فلسطين، وفي سُوريا، وفي درعا، وفي ليبيا، وفي اليمَن، وفي بُورما، وفي كل مكانٍ يا رب العالمين، اللهم ارحَم ضعفَهم، واجبُر كسرَهم، وأصلِح شأنَهم، وآوِ طريدَهم، وفُكَّ أسيرَهم، وانتقِم ممَّن ظلَمَهم، واجعَل كيدَه في نحره، واجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا ربَّ العالمين.
اللهم عليك باليهود الصهايِنة، اللهم عليك باليهود الصهايِنة المُحتلِّين؛ فإنهم لا يُعجِزونك، اللهم وأنزِل بهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القومِ المُجرمِين، اللهم إنا نَدرَأُ بك في نُحورِهم، ونعُوذُ بك من شُرورهم.
اللهم يا ذا الجُود والمَنِّ احفَظ علينا هذا الأمنَ، وسدِّد قيادتَه، وقوِّ رِجالَه، وخُذ بأيدِيهم، وشُدَّ مِن أزرِهم، وقوِّ عزائِمَهم، وزِدهم إحسانًا وتوفيقًا وتأييدًا وتسديدًا، اللهم واشفِ مرضاهم، وارحَم شُهداءَهم، وحافَظ أُسَرَهم وذريَّاتهم يا ربَّ العالمين.
اللهم وفِّقنا للتوبةِ والإنابةِ، وافتَح لنا أبوابَ القبُول والإجابة، اللهم تقبَّل طاعاتِنا ودُعاءَنا، وأصلِح أعمالَنا، وكفِّر عنَّا سيِّئاتنا، وتُب علينا، واغفِر لنا وارحَمنا، إنَّك أنت أرحمُ الراحمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ يذكُركُم، واشكُرُوه على نعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

مكافأة أهل الفضل
ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "مكافأة أهل الفضل"، والتي تحدَّث فيها عن مُبادلة أهل الفضل بالفضل، وأنَّ ذلك مِن مبادئ الإسلام وأخلاقِه، وقِيمة مِن قِيَمه العظيمة في التعامُل، مُبيِّنًا أوجُه مكافأة أهل الفضل والمعرُوف.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله له الحمدُ كلُّه، وله المُلكُ كلُّه، وله الفضلُ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له في السرِّ والجَهر، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه طاعتُه واجِبةٌ في كل أمر، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه ما أقبلَ ليلٌ وانشقَّ فجر.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
مِن مبادِئ الإسلام وأخلاقِه: مُبادلةُ أهل الفضل بالفضل، ومُقابلةُ الجَميل بالأجمل، وهذه قيمةٌ عظيمةٌ مِن قِيَم الإسلام في التعامُل، قال الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].
فالمُسلمُ لا ينسَى أهلَ الفضل عليه، ومَن أسدَى إليه معروفًا يذكُرُ إحسانَهم، ويشكُرُ جَميلَهم، ويُقدِّرُ عطاءَهم، كما لا ينسَى في زحمَةِ الحياةِ وصخَبِ أحداثِها مَن جمَعَتهم به علاقاتُ ودٍّ ورحمةٍ، وسابق عِشرةٍ، ولو شابَهَا يومٌ خلافٌ أو شَحناء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237].
ورسولُنا الكريمُ - صلى الله عليه وسلم - سيِّدُ أهل الوفاء، علَّمَنا أجملَ معانِي الإحسان؛ فقد اعترَفَ بفضلِ زوجِهِ خديجة بنت خُوَيلِد في حياتِها وحتى بعد مماتِها، وكان يُكثِرُ مِن ذِكرِها وشُكرِها والاستِغفارِ لها، ويقولُ: «إنَّها كانت وكانت»، وربما ذبَحَ الشاةَ ثم يُقطِّعُها أعضاءً، ثم يبعَثُها في صدائِقِ خديجَة.
ولما انتصَرَ المُسلمون في بدرٍ وأسَرُوا سبعين رجُلًا مِن قُريش، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان المُطعِمُ بن عدِيٍّ حيًّا ثم كلَّمَني في هؤلاء النَّتْنَى لتَرَكتُهم له»، مع أنَّ المُطعِم بن عدِيٍّ ماتَ كافِرًا، إلا أنَّ كُفرَه لم يكُن مانِعًا مِن ذِكرِ معروفِه الذي أسداه، وإكرامُه بما يستحِقُّ.
وقصصُ الأنبِياء تذخَرُ بمواقِفِ العِرفان لذوِي الفضل، ومِنها: ما جاء في قصَة مُوسَى - عليه السلام - ووالِدِ المرأتَين اللتَين سقَى لهما، قال تعالى: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ [القصص: 25]، فلقِيَ مُوسَى - عليه السلام - جزاءَ إحسانِه، وكافَأَه والِدُ الفتاتَين لفضلِه.
أعلَى الإسلامُ قَدرَ مَن أسدَى إليك معرُوفًا وإحسانًا، بل وأكَّد على مُكافأتِه؛ يقولُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يشكُرُ اللهُ مَن لا يشكُرُ الناسَ».
ومعناه: أنَّ الله لا يقبَلُ شُكرَ العبد على إحسانِه إليه إذا كان العبدُ لا يشكُرُ إحسانَ الناسِ ويكفُرُ معروفَهم؛ لاتِّصالِ أحدِ الأمرَين بالآخر.
ومِن معنى الحديث: أنَّ مَن كان مِن طبعِه وعادتِه كُفرانَ نعمةِ الناسِ، وتركَ الشُّكر لهم؛ كان مِن عادتِه كُفرُ نعمةِ الله وترك الشُّكر له.
ومِن معناه: أنَّ مَن لا يشكُر الناسَ كمَن لا يشكُر الله.
وصُور ردِّ الجَميل الذي يسعَى للوفاءِ به أهلُ الوفاء بالأقوال والأفعال والمشاعِر، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86].
فإذا ردَّ المُسلمُ التحيةَ بمثلِها أو أحسنَ مِنها، والمعروفَ بمثلِه أو أحسنَ مِنه، والكلمةَ الطيبةَ بمثلِها أو أحسنَ مِنها، والهديةَ بمثلِها أو أحسنَ مِنها صفَت قلوبُنا، وقوِيَت روابطُنا، وتعمَّقَت علاقاتُنا، وانحسَرَت دائرةُ الخلاف بيننا.
وأولُ خُطوةٍ في مُكافأة أهل الفضل: الاعتِرافُ بفضلِهم، والإقرارُ باستِحقاقِ شُكرِهم، وجَّه به نبيُّ الرحمةِ - صلى الله عليه وسلم -، ودعَا إليه، والوفاءُ بالعهد مِن حُسن الإيمان.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومَن أتَى إليكم معرُوفًا فكافِئُوه».
استقبَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عجُوزًا بحفاوةٍ وترحيبٍ، فلما خرَجَت سألَتْه عائشةُ - رضي الله عنها -، فقال: «يا عائشةُ! إنَّها كانت تأتِينا زمانَ خديجَة، وإنَّ حُسن العهدِ مِن الإيمان».
يسَّر الإسلامُ صُور مُكافأة أهل الفضل بما يستطيعُه المُسلم؛ بالكلمةِ الطيبةِ، والدعاءِ له بالخَير، ومُلاقاةِ المُسلم لأخِيه بطلاقَةِ الوَجهِ وبشاشَة النَّفسِ، وهذا مِن كمالِ الدين وشُموله وآدابِه ومحاسِنِه؛ لتبقَى المودَّةُ والأُلفةُ والمحبَّةُ.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحقِرنَّ مِن المعرُوفِ شيئًا ولو أن تلقَ أخاكَ بوَجهٍ طَلْقٍ».
الثَّناءُ بالحقِّ مِن صُور ردِّ الجَميلِ لأهل الفضل؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أُعطِيَ عطاءً فليَجزِ به، ومَن لم يجِد فليُثنِ؛ فإنَّ مَن أثنَى فقد شكَرَ، ومَن كتَمَ فقد كفَرَ، ومَن تحلَّ بما لم يُعطَ كان كلابِسِ ثَوبَي زُورٍ».
ومِن أجزَلِ صُور ردِّ الجَميل لذوِي الفضلِ: مُكافأتُهم بالدُّعاء لهم؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لم تجِدُوا ما تُكافِئُونَه فادعُوا له، حتى تعلَمُوا أن قد كافأتُمُوه».
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صُنِعَ إليه معرُوفٌ فقال لفاعِلِه: جزاكَ اللهُ خيرًا، فقد أبلَغَ في الثَّناء».
ومَن أقرَضَك مالًا، فمِن الجميل حُسن أداء الدُّيُون والوفاء والحَمد.
وفي حياةِ المُسلم فِئاتٌ مِن ذوِي الفضلِ معرُوفُهم قائِم، وفضلُهم دائِم، وإحسانُهم سابِغ، وأعظمُهم فضلًا رسولُ الأمة - صلى الله عليه وسلم - الذي أخرَجَنا الله به مِن الظُّلُمات إلى النُّور.
ومِن أكثَرِ الناسِ فضلًا على الإنسان وأحقِّهم عليه وفاءً: الوالِدان اللذَان أحسَنَا إليه وربَّيَاه صغيرًا.
وطُلابُ العلم عليهم واجِبُ الوفاء لمُعلِّمِهم بالدُّعاء له لفضلِه عليهم.
دعا أبو حَنيفة لشيخِه حمَّاد، ودعَا أبو يُوسف لشيخِه أبي حنيفَة.
قال الإمامُ أحمدُ بن حنبل - رحمهم الله جميعًا -: "ما بِتُّ مُنذ ثلاثين سنةً إلا وأنا أدعُو للشافعيِّ وأستغفِرُ له".
والزَّوجان بينهما معرُوفٌ مُترادِف، وجَميلٌ مُتقابِل، أسدَى كلُّ واحدٍ مِنهما للآخر زهرةَ حياتِه، وثمرةَ فُؤادِه، فحِفظُ العهد، وحُسنُ العِشرة، والتغافُلُ عن الزَّلَّات مِن ردِّ الجَميل؛ فإنَّ الحسناتِ يُذهِبنَ السيِّئات.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَفرَكُ مُؤمنٌ مُؤمنةً، إن كرِهَ مِنها خُلُقًا رضِيَ مِنها آخر».
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم، فاستغفِرُوه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدَ الشَّاكِرين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وليُّ الصَّابِرين، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه إمامُ المُتَّقين، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه أجمَعين.
أما بعد:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله.
إنَّ الحادِثَ الأليم الذي وقعَ قبل أيامٍ في مدينة بُرَيدَة، وأسفَرَ عن مقتَلِ رجُلِ أمنٍ عملٌ مأزُومٌ، يُنبِئُ عن جهلٍ وطَيشٍ وتِيهٍ.
وإنَّ هذا الفِكر الداعِشيَّ التكفِيريَّ يلفِظُ أنفاسَه وفي رَمَقِه الأخير، ونحن واثِقُون أنَّ فِكرَهم يتوارَى، وضلالَهم يتهاوَى، ومَن أرادَ تقوِيضَ أمنِنا، وزعزعَةَ استِقرارِنا فلن يُحقِّقَ أهدافَه، ولن يرُومَ مُرادَه، وسيبُوءُ بالخُسران المُبين بفضلِ الله، ثم بمُتابعَةِ وُلاةِ أمرِنا، ويقَظَةِ رِجالِ أمنِنا وعُلمائِنا.
ولقد استبشَرَ العالَمُ الإسلاميُّ عامَّةً والشعبُ الأفغانيُّ خاصَّةً بمُؤتمر السِّلم الذي دعَا إليه خادِمُ الحرمَين الشريفَين، وعقَدَتْه مُنظمةُ التعاوُن الإسلاميِّ بمكَّة المُكرَّمة، والذي حثَّ على نَبذ الاقتِتال والتفرُّق، والدعوةِ إلى الإصلاح واجتِماع الكلِمة، والردِّ إلى أحكامِ الشريعة عند الخُصُومة والتنازُع.
وهذه رسالةُ سلامٍ مِن مهبِطِ الوحيِ، تقتَضِي أن يلتقِطَ الأفغان مُبادرَةَ السلام، لاسيَّما العُلماء مِنهم بالعمل على إحلالِ السِّلم والاستِقرار في بلدِهم، وانتِشالِه مِن صِراعٍ أتَى على الأخضَر واليابِسِ.
قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: 55].
ألا وصلُّوا - عباد الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصَّحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا أرحَم الراحِمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر اللهم أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ بلادَنا وأرادَ الإسلامَ والمُسلمين بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم احفَظ ووفِّق رِجالَ أمنِنا وجُنودَنا المُرابِطين على الثُّغُور، اللهم كُن لهم مُؤيِّدًا ونصيرًا وظَهيرًا، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعملٍ، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعمل.
اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا مِن كل شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك فواتِحَ الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخرَه، ونسألُك الدرجات العُلى مِن الجنَّة يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك الهُدى والتُّقَى والعفافَ والغِنَى.
اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على مَن بغَى علينا.
اللهم اجعَلنا لك ذاكِرين، لك شاكِرين، لك مُخبِتين، لك أوَّاهِين مُنِيبِين.
اللهم تقبَّل توبتَنا، واغسِل حَوبَتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، وسدِّد ألسِنَتَنا، واسلُل سَخِيمَةَ قُلوبِنا.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا.
اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أعلنَّا وما أسرَرنا، وما أنت أعلمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّمُ وأنتُ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم ارحَم موتانا، واشفِ مرضانا، اللهم ارحَم موتانا، واشفِ مرضانا، واغفِر لوالدِينا يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى يا أرحم الراحمين.
اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين للعمل بكتابِك وتحكيمِ شرعِك يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

تأمُّلات
في سُورة يونس - عليه السلام -
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "تأمُّلات في سُورة يونس - عليه السلام -"، والتي تحدَّث فيها عن سُورة يونس - عليه السلام -، وما اشتمَلَت عليه مِن معانٍ وحِكَمٍ جليلةٍ، وفوائِد عظيمةٍ، ومُناسَبَاتٍ مُهمَّةٍ.
الخطبة الأولى
إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفُسنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له عزَّ عن الشَّبيه وعن النِّدِّ وعن المَثِيل وعن النَّظِير، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه بلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصَحَ الأمةَ، وجاهَدَ في الله حقَّ جِهادِه حتى أتاهُ اليَقين، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ وصحبِه أجمعين.
أما بعد .. أيها الناس:
أُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله تعالى؛ فهي سِتارُ الأمن يوم الفزَع، ولِباسُ السَّعادة والرِّضا عند الجَزَع، وهي البِشارةُ العُظمى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: 62- 64].
أيها المُسلمون:
إنَّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مُحمدُ بن عبد الله بن عبد المُطلب القُرشيُّ الهاشميُّ، أشرفُ الناسِ نسَبًا، وأحسَنُهم خَلقًا وخُلُقًا، طهَّرَه الله واصطفاه، وعرَفَ قومُه صِدقَه وأمانتَه مِن شبابِه بل مِن صِباه، لما بلغَ مِن العُمر أربعين بعثَه الله رحمةً للعالمين.
وإنَّ الله نظَرَ إلى أهل الأرضِ فمقَتَهم عربَهم وعجمَهم إلا بقايا مِن أهل الكِتاب، ونظَرَ في قلوبِ العباد فرأَى قلبَ مُحمدٍ خيرَ قلوبِ العباد، فاختارَه لرسالتِه.
نزلَ الوحيُ مِن السماء، وآذَنَ الله بصُبحٍ جديدٍ، وتسلَّلَ النُّورُ الموصُولُ بالسماء العُليا مِن غار حراء إلى مكَّة، فغمَرَ بيوتَ مكَّة وفِجاجَها، وسالَ في طُرقاتِها ونوادِيها، وتناثَرَ على وجوهِ الرَّائِحِين والغادِين.
وعجِبَ المُشرِكون أن ينزِلَ الوحيُ على رجُلٍ مِنهم، وكذَّبُوه وكانُوا في أمرٍ مرِيجٍ، وقالُوا: ساحِرٌ مجنُون، وقالُوا: أساطِيرُ الأولين، وقالُوا: ائتِ بقُرآنٍ غير هذا أو بدِّلْهُ.
وما زالَ القُرآنُ يُجادِلُهم في إثباتِ الرسالةِ وصِدقِ الرسول حتى نزلَت سُورةُ يُونس - عليه السلام -، سُورةٌ كاملةٌ في إثباتِ الرسالة، وصِدقِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -.
سُورةٌ نزلَت بمكَّة، وإنَّ للسُّور المكيَّة لعبِقًا وألَقًا، وفيها ما في السُّور المكيَّة مِن تقرير التوحيدِ، والبعثِ والجزاء، والرسالة والقُرآن، وبيان عاقِبة الفريقَين.
ومَن تأمَّلَ في هذه السُّورة خبَرَ نوحٍ وجَهرَه بالدعوة، وخبَرَ مُوسَى وقومِه واتِّخاذَهم بيوتَهم أماكِن للصلاة، علِمَ أنَّ هذه السُّورة مِن أوائِلِ ما نزلَ في مكَّة قبل أن يجهَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة.
وذواتُ ﴿الر﴾ خمسُ سُور، كلُّ سُورةٍ مِنها تحمِلُ اسمَ نبيٍّ، وهي: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والخامِسةُ الحِجرُ دِيارُ ثمود قوم صالِحٍ - عليه السلام -.
بِسمِ الله الرحمن الرحيم ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: 1، 2].
إنَّها البِشارةُ والنِّذارةُ، إنذارُ الناسِ وظيفةُ الرُّسُلِ وأتباعِهم إلى يوم القِيامة، إنذارُ الناس وبِشارةُ المُؤمنين لا يقتصِرُ الداعِيةُ على إحداهُما دون الأُخرى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 45- 47].
أيها المُسلمون:
آيةُ هذا الرسُول الكريم هذا القُرآنُ العظيمُ يتلُوه عليهم، ويقرَعُ به أسماعَهم، ويتحدَّاهم به: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 57، 58]، ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: 37- 40].
عن أبي هُريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما مِن الأنبِياء مِن نبيٍّ إلا قد أُعطِيَ مِن الآياتِ ما مِثلُه آمَنَ عليه البَشَرُ، وإنَّما كان الذي أُوتِيتُ وحيًا أوحَى اللهُ إلَيَّ، فأرجُو أن أكون أكثَرُهم تابِعًا يوم القِيامة»؛ رواه مسلم.
فالقُرآنُ مُعجِزةُ النبيِّ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: 15، 16].
وهذا مِن أعظمِ دلائِلِ نبُوَّتِه - عليه الصلاة والسلام -، فقد لبِثَ في قومِه أربعين سنةً قبل أن يُوحَى إليه، وهم يعرِفُون صِدقَه وأمانتَه، فلم يكُن ليَذَرَ الكذِبَ على النَّاس ويكذِبَ على الله، كما قال هِرقلُ في حديثِ أبي سُفيان الطويل.
أيها المُؤمنون:
وفي هذه السُّورة ذكَرَ اللهُ خبَرَ ثلاثةٍ مِن الرُّسُل الكِرام، وهم نُوحٌ ومُوسى ويُونس - عليهم وعلى نبيِّنا مُحمدٍ أفضلُ الصلاةِ والسلام -، ولما كانت السُّورةُ في إثباتِ الرسالة ناسَبَ أن يُذكَرَ هؤلاء الأنبِياء الثلاثة؛ فنُوحٌ أولُ رسولٍ بعَثَه الله إلى أهلِ الأرضِ بعد أن وقَعُوا في الشِّرك، وكانُوا قبل ذلك كلُّهم على التوحيد.
ورسالةُ مُوسَى - عليه السلام - أعظمُ رسالةٍ بعد القُرآن، ولهذا يقرِنُ الله بينَهما في مواضِعَ كثيرةٍ، كقولِه تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [القصص: 48، 49].
وأما يُونس - عليه السلام -، فإنَّه نبيٌّ كريمٌ بعثَه الله إلى أهل نَينَوَى، فلما كذَّبُوه لم يصبِر، وذهبَ مُغاضِبًا، فقال الله لنبيِّه مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ [القلم: 48].
ومُناسبةٌ أُخرى في ذِكرِ نُوحٍ ومُوسَى - عليهما السلام -، وهي: أنَّ الله ذكَرَ في هذه السُّورة قولَ المُشرِكين لنبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ [يونس: 20]، فناسَبَ أن يُذكَرَ نُوحٌ - عليه السلام -؛ فإنَّ الله لم يذكُر له في القُرآن مُعجِزةً وآيةً، كما ذكَرَ مُوسَى - عليه السلام - الذي آتاه الله تِسعَ آياتٍ بيِّناتٍ، ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 37]، ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الإسراء: 59].
ومُناسبةٌ أُخرى - أيها المُؤمنون -، وهي: اختِلافُ النِّهايات وعاقِبة أقوامِ الرُّسُل الثلاثةِ؛ فنُوحٌ - عليه السلام - كذَّبَه قومُه فأغرَقَهم الله ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: 40]، ومُوسى - عليه السلام - آمَنَت به بنُو إسرائيل، وكانُوا سوادًا عظيمًا، وكذَّبَه فِرعونُ وقومُه فأغرَقَهم الله، ويُونسُ - عليه السلام - آمَنَ قومُه أجمَعُون، وذلك أنَّه لما خرَجَ مِن بين أظهُرِهم، ورأَوا العذابَ الذي انعقَدَت أسبابُه جأَرُوا إلى الله وتضرَّعُوا إليه، فكشفَ الله عنهم العذابَ، ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [يونس: 98].
فكأنَّ السُّورةَ تقولُ لنبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: ليس عليك هُدى قومِك، وإنَّما عليك الدعوةُ والبلاغُ، وعاقِبةُ أمرِهم علينا، بل قالت السُّورةُ ذلك بأوضَحِ بيانٍ: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: 46].
ومُناسبةٌ أُخرى - أيها المُسلمون -، وهي: أنَّ نُوحًا ومُوسَى - عليهما السلام - مِن أُولِي العَزم مِن الرُّسُل الذين جمعُوا الاتِّباعَ والصَّبر، وأمَرَ اللهُ نبيَّه مُحمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يقتَدِيَ بهم: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35].
فنُوحٌ - عليه السلام - بقِيَ في قومِه يدعُوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، ودعاهم ليلًا ونهارًا فلم يزِدهم ذلك إلا فِرارًا، وما غيَّرَ ولا بدَّل.
ومُوسَى - عليه السلام - بعثَه الله إلى فِرعون داعِيًا، وكان مِن أمرِه ما كان، ثم لقِيَ مِن بنِي إسرائيل ما لقِي، وكان نبيُّنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - إذا أذاه قومُه قال: «يرحَمُ اللهُ مُوسَى، لقد أُوذِيَ بأكثَرَ مِن هذا فصَبَر».
فكأنَّ السُّورةَ تقولُ لنبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: اصبِر كما صبَرَ نُوحٌ ومُوسَى، ولا تكُن كصاحِبِ الحُوتِ، وهي أيضًا تقولُ لأتباعِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اصبِرُوا كما صبَرَ نُوحٌ ومُوسَى، ولا تيأسُوا ولا تُغادِرُوا مواقِعَكم.
ومِن لطيفِ العلمِ ومُلَحِه: أنَّ لكل واحدٍ مِن هؤلاء الرُّسُل الثلاثة خبَرًا مع الماء؛ فنُوحٌ أغرَقَ الله قومَه بماءٍ مُنهمِرٍ، وفجَّر الأرضَ عيونًا فالتَقَى الماءُ على أمرٍ قد قُدِر، وأنجاه الله ومَن معَه في الفُلك المشحُون على ذاتِ ألواحٍ ودُسُر.
ومُوسَى - عليه السلام - فلَقَ الله له البحرَ، وجاوَزَ ببني إسرائيل، ثم غرَّقَ الله فِرعونَ وقومَه.
ويُونسُ - عليه السلام - ركِبَ البحرَ في الفُلك المشحُون، وكان في بطنِ الحُوتِ في ظُلمةِ البحر في ظُلُماتٍ ثلاثٍ.
أيها المُؤمنون:
ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الرَّحيمُ الشَّفيقُ يدعُو قومَه، ويحرِصُ على هِدايتِهم، حتى لتكادُ نفسُه تذهَبُ عليهم حسرات، فيقولُ الله لهم: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [الحجر: 88]، ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 3]، ويقولُ له: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: 35].
ويقولُ الله في سُورة يُونس: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: 99، 100].
مُخطِئٌ مَن ظنَّ يومًا أنَّه يستطيعُ هدايةَ النَّاسِ أجمَعين، أو جمعَهم على كلمةِ الحقِّ الواحِدة، إنَّ هذا خِلافُ سُنَّة الله وتقديرِه، وخارِجٌ عن قُدرةِ البشَر: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: 118]، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: 35].
فالواجِبُ على الداعِية أن يقوم بما أمَرَه الله به، وأن يُبلِّغَ الدعوةَ إلى النَّاس، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: 48]، قُل كما أمَرَ الله نبيَّه أن يقُول: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: 104- 106].
وهذا في حقيقتِه غايةُ التثبيتِ واليَقين، قُل كما أمَرَ الله نبيَّه أن يقُول: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: 108، 109].
إنَّهما الأصلان العزيمان المُتلازِمان: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ اتِّباعُ الوحيِ والصَّبرُ على وَعثاءِ الطريقِ، ومَن جمعَ هذَين الأمرَين فقد سارَ على طريقِ الأنبِياء ودعوتِهم، ومَن نقَصَ مِنهما فقد نُقِصَ مِن أمرِ دعوتِه بقَدرِ ذلك.
وما وقَعَت فِرقٌ وأحزابٌ وجماعاتٌ مِن المُسلمين في التحريفِ والتبديلِ وتهوينِ التمسُّك بالشَّريعةِ إلا بتضييعِ أصلِ الاتِّباع، وما وقَعَت طوائِفُ في الغلُوِّ والخُروجِ إلا بتضييعِ الأصلِ الثانِي وهو الصَّبرُ، والهُدى هُدى الله الجامِع بين الصَّبر والاتِّباع ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: 109]، ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: 60].
﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: 15].
بارَك الله لي ولكم في القرآن والسنَّة، ونفَعَنا بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ الله تعالى لي ولكم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرحمنِ الرحيم، مالِك يوم الدين، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له الملِكُ الحقُّ المُبِين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الصادِقُ الأمين، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهِرين، وصحابتِه الغُرِّ الميامِين، والتابِعين ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
إنَّه لم يكُن أحدٌ أكرَم على الله مِن أنبِيائِه ورُسُله، ومع ذلك فإنَّ حياتَهم عمومًا وزمنَ بِعثَتهم خُصوصًا قد انقَضَت في مُخالطَة المُشركين ومُجادلَتهم، تضمُّهم المجالِس، وتجمعُهم المواقِف.
يسمعُ أنبِياءُ الله مِن أقوامِهم ما يكرَهُون، يرَون الشِّركَ ويُبصِرُون المُنكَر وهم له مُبغِضُون وشانِئُون، ومع أنَّهم أعرَفُ الناسِ بجلالِ الله وأغيَرُهم على حُرماته، إلا أنَّ ذلك لم يَثنِهم عن الدعوةِ والبيانِ، والنُّصحِ والرحمةِ، والصبرِ والدَّأَب في استِنقاذِ مَن سبَقَت له الرحمةُ، وخُطَّ اسمُه في كتابِ الفائِزِين.
ومع أنَّ الحُزن على فُشُوِّ المُنكَر مِن سِيما الصالِحين، ومِن دواعِي مثوبتِهم، إلا أنَّ الله أنكَرَ على نبيِّه التمادِي فيه؛ لئلا ييأَسَ ويترُك، ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ [فاطر: 8]، ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103].
إنَّ الكُفر والفِسقَ في هذه الحياةِ تُبتلَى به طائِفتان، فيُبتلَى المُتلبِّسُون بهما - عافانا الله وإياهم - كما يُبتلَى الصالِحون بالكافِرين والفاسِقين؛ لينظُرَ الله كيف يثبُتُون وينصَحُون ويُصلِحُون.
إنَّ مَن مَنَّ الله عليهم بالعيش في مُجتمعٍ مُحافِظٍ في غالِبِه قد يُصعَقُون إذا رأَوا مِن النَّقصِ ما لم يكُونُوا يعهَدُون، وما علِمُوا أنَّ خِيرةَ خلقِ الله وخُلَّصَ أصفِيائِه قد عايَشُوا ما هو أشدُّ على النَّفس وأنكَى، ومع ذلك قامُوا بواجِبِهم، وكانُوا يعلَمُون أنَّ ثِمارَ هذا العمل موكُولٌ إلى الله، وقد يزهُو الثَّمرُ وقد لا يَطِيبُ، إلا أنَّه في كل الأحوالِ لا مناصَ مِن النُّصحِ والدعوةِ، ولا محِيصَ عن الصَّبر والاحتِسابِ.
وإذا قامَ الإنسانُ بوسعِه فلا يُكلِّفُ الله نفسًا إلا وُسعَها، ورفعُ الحرَج مِن الله بعد استِنفادِ العبدِ وُسعَه لا قبلَه، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: 48]، ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: 67] إن لم تفعَل البلاغَ، أما الهِدايةُ فليس عليك هُداهم.
لا بُدَّ مِن توطينِ النَّفسِ على تحمُّل الأذَى والبيان، وعلى احتِسابِ الأجرِ ورحمةِ الخلقِ حتى المُخالِفين مِنهم والمُناوِئين، فقد قال الله عن نبيِّه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] لكل العالمين إنسِهم وجِنِّهم، برِّهم وفاجِرِهم.
وإنَّ لهذا الدين إقبالًا وإدبارًا؛ فالنقصُ لا يعني نهايةَ الدين والتديُّن، وإنَّما هي سُنَّةُ الله ومرحلةٌ مِن مراحِلِ أطوارِ هذه الأمة لحِكَمٍ يُريدُها الله؛ ليَمِيزَ الله الخَبيثَ مِن الطيِّبِ، وليَبتَلِيَ الله النَّاسَ أجمعين، ليعلَمَ المُؤمنين، ويمحَقَ الكافِرِين.
إنَّ إدراكَ هذه المعانِي والتي دلَّت عليها سُورةُ يُونس كفِيلٌ بتحقيقِ اليَقين والثَّبات، وباعِثٌ على سعَة الأُفُق، وتحقيقِ التوازُن في النَّظَر إلى الحوادِثِ، والتعامُل مع المُتغيِّرات، ويبقَى المنهجُ الهادِي: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: 109].
اللهم اجعَلنا مِن أهل طاعتِك ومحبَّتِك، وأتباعِ رسولِك الصابِرين المُوقِنِين.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على مَن أرسلَه الله رحمةً للعالمين، وهَديًا للناسِ أجمعين.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابَتِه وأزواجِه ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وارضَ عنَّا معهم برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلمين، واخذُل الطُّغاةَ والملاحِدةَ والمُفسِدين، اللهم انصُر دينَك وكِتابَك، وسُنَّة نبيِّك، وعِبادَك المُؤمنين.
اللهم مَن أرادَ الإسلامَ والمُسلمين ودِينَهم ودِيارَهم بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، ورُدَّ كيدَه في نَحرِه، واجعَل دائِرةَ السَّوء عليه يا رب العالمين.
اللهم انصُر المُجاهِدين في سبيلِك في فلسطين، وفي كل مكانٍ يا رب العالمين، اللهم فُكَّ حِصارَهم، وأصلِح أحوالَهم، واكبِت عدوَّهم.
اللهم إنا نسألُك باسمِك الأعظَم الذي إذا سُئِلت به أعطَيتَ، وإذا دُعِيتَ به أجَبتَ أن تلطُفَ بإخوانِنا المُسلمين في كل مكان، اللهم كُن لهم في فلسطين، وسُوريا، وفي العِراق، واليمَن، وبُورما، وفي كل مكانٍ، اللهم الْطُف بهم، وارفَع عنهم البلاءَ، وعجِّل لهم بالفرَج، اللهم أصلِح أحوالَهم، واجمَعهم على الهُدَى، واكفِهم شِرارَهم، اللهم اكبِت عدُوَّهم.
اللهم عليك بالطُّغاةَ الظالمين ومَن عاونَهم.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادمَ الحرمين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ به للبِرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه ونائِبَه وأعوانَهم لِما فيه صلاحُ العباد والبلاد.
اللهم احفَظ وسدِّد جُنودَنا المُرابِطين على ثُغورنا وحُدودِ بلادِنا، والمُجاهِدين لحِفظِ أمنِنا وأهلِنا ودِيارِنا المُقدَّسة، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا وحافِظًا.
اللهم انشُر الأمنَ والرخاءَ في بلادِنا وبلادِ المُسلمين، واكفِنا شرَّ الأشرار، وكيدَ الفُجَّار.
اللهم بارِك في مُؤتمر العُلماء الذين اجتَمَعُوا في مكَّة المُكرَّمة لتحقيقِ المُصالَحة الأفغانيَّة، وتحقيقِ الأمنِ والسِّلم والاستِقرار في أفغانِستان، ووفِّق المُؤتمِرِين وأهلَ بلادِهم كافَّةً حكومةً وشعبًا لما فيه مصلَحةُ بلادِهم، وإصلاحُ ذاتِ بينِهم، ووحدة صفِّهم، ونبذُ الفُرقة والخِلاف.
وشكَرَ الله لخادمِ الحرمَين الشريفَين حِرصَه ودعوتَه لهذا المُؤتمر عند بيتِ الله الحرام، ودعمَ المملكة لأمنِ واستِقرارِ أفغانِستان، والشُّكرُ لكل العُلماء مِن عالَمنا الإسلاميِّ لتحقيقِ الأمنِ وجمع الكلِمة.
اللهم ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ويسِّر أمورَنا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، اللهم اغفِر للمُؤمنين والمُؤمنات، والمُسلمين والمُسلمات، الأحياء مِنهم والأموات.
اللهم اغفِر لنا ولوالدِينا ووالدِيهم وذُريَّاتهم، وأزواجِنا وذريَّاتِنا، إنك سميعُ الدعاء.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم.
خطب الحرمين الشريفين

فضلُ التوكُّل على الله تعالى
ألقى
فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضلُ
التوكُّل على الله تعالى"، والتي تحدَّث فيها عن التوكُّل على الله تعالى
وفضلِه وأهميتِه في حياةِ الفردِ والأمةِ، وأنَّه لا سعادةَ للعبدِ إلا بتوكُّلِه
على الله - جلَّ وعلا -.
الخطبة الأولى
الحمدُ للهِ الذي مَن اتَّقاه وقاه، ومَن توكَّل عليه كفاه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه وأصحابهِ.
أما بعدُ .. فيا أيها الناس:
اتَّقُوا الله - جلَّ وعلا -، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
عباد الله:
في مثلِ هذا الزمن الذي تكاثَرَت تحدياتُه وعظُمَت مخاطِرُه، مخاطِرُ للأنفُس، مخاوِفُ على الذريَّة، صعوباتٌ في تحصيلِ الأرزاقِ، إلى ما لا ينتهي مِن المخاوِفِ التي تمُرُّ بالإنسان في هذا العصر مما لا يُحصَى، ولا على الناسِ يخفَى.
هنا تعظُمُ الحاجةُ وتشتَدُّ الضرورةُ إلى معرفةِ ما يُوصِلُ العباد إلى الهِمَم العالِية والعزائِم القويَّة؛ ليتحصَّلُوا بذلك على المصالِح المرجُوَّة، والمنافِع المُبتغاة.
إنَّ الإنسان متى كان على قوَّة بصيرةٍ وكمال يقينٍ بوعدِ الله - جلَّ وعلا -، فحينئذٍ لا يلتَفِتُ إلى ما يُخوِّفُه متى عمِلَ الأسبابَ، وتوكَّلَ على مُسبِّبِ الأسبابِ، بل إنَّه بذلك يفُوزُ بمقاصِدِه ويظفَرُ بكل مطالِبِه.
إنَّ العبدَ متى فوَّضَ أمرَه إلى الله - جلَّ وعلا -، وقطَعَ قلبَه عن العلائِقِ بالخلقِ، وقامَ بما شرَعَه الله - جلَّ وعلا - له مِن الأسبابِ الحسِّيَّة والشرعيَّة، صارَ ذا همَّةٍ عالِيةٍ قد وطَّأَ نفسَه على ركوبِ المصاعِبِ، وهانَت عليه الشدائِدُ؛ لأنَّه على يقينٍ جازِمٍ بوعدِ الله - جلَّ وعلا - له بقولِه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2، 3].
قال أحدُ السَّلَف: "لو أنَّ رجُلًا توكَّلَ على الله بصدقِ النيَّة، لاحتاجَ إليه الأُمراءُ فمَن دُونَهم". وكيف يحتاجُ ومولاهُ الغنيُّ الحميدُ؟!
إنَّ المُتوكِّل على الله، المُفوِّض إليه - سبحانه - أمورَه كلَّها، يرَى الدنيا والآخرة مُلكًا لله - عزَّ وجل -، والخلقَ عبيدًا لله، والأرزاقَ والأسبابَ كلَّها بيدِ الله، ويرَى قضاءَ الله نافِذًا في جميعِ خلقِه، ولهذا أمرَ الله - سبحانه وتعالى - عبادَه بالتوكُّل عليه، فقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: 58]، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23].
ومَن لم يُبالِ بهذه الأوامِرِ وأمثالِها في القُرآن وقعَ في المصائِبِ والشدائِدِ، ولم يظفَر بمطلُوبٍ، ويسلَم مِن مرهُوبٍ.
التوكُّلُ مُصطلَحٌ ذو معنًى عظيم، ومغزًى جليل، فالمُتوكِّلُ على الله - تبارك وتعالى - هو الذي يتَّخِذُه - سبحانه - بمنزلة الوكيل القائِمِ بأمرِه، الضامِنِ لمصالِحِه، الكافِي له مِن غير تكلُّفٍ ولا اهتِمامٍ.
المُتوكِّلُ على الله واثِقٌ بأنَّه لا يفُوتُه ما قُسِمَ له؛ فإنَّ حُكمَه - عزَّ شأنُه - لا يتبدَّلُ ولا يتغيَّرُ، يقولُ - سبحانه -: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: 22، 23].
ومِن معاني هذه الآية في التفسير: أنَّه - سبحانه - لم يكتَفِ بذِكرِ ضمانِ رِزقِ امخلُوق، بل أقسَمَ على تحقيقِ ذلك.
قال الحسنُ: "لعَنَ الله أقوامًا أقسَمَ لهم ربُّهم فلم يُصدِّقُوه".
ورُوِي أنَّ الملائِكةَ قالت عند نُزول هذه الآية: "هلَكَت بنُو آدم، أغضَبُوا الربَّ حتى أقسَمَ لهم على أرزاقِهم!".
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو توكَّلتُم على الله حقَّ توكُّلِه؛ لرَزَقَكم كما يرزُقُ الطيرَ، تغدُو خِماصًا وترُوحُ بِطانًا»؛ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وإسنادُه صحيحٌ.
المُتوكِّلُ على الله - جلَّ وعلا - صادِقُ الاعتِماد عليه في إسنادِ تسهيلِ الأمور، واستِجلابِ المصالِح ودفع المضارِّ، واثِقٌ بموعود الله، مُستَيقِنٌ بأنَّه بتفويضِ أمورِه إلى الله - جلَّ وعلا - يحصُلُ له المقصُود، ويندفِعُ عنه المرهُوب.
المُتوكِّلُ على الله يُفوِّضُ أمرَه إليه - سبحانه -؛ ثِقةً به، وحُسنَ ظنٍّ به - جلَّ وعلا -، فالمخلُوقُ المُتوكِّلُ يقطَعُ علاقتَه بغير الله، يقطَعُ النَّظرَ عن الأسبابِ بعد تهيئتِها والقِيام بها وفقَ المشرُوع، مُتبرِّئًا مِن الحَولِ والقوةِ إلا بالله العليِّ العظيمِ؛ لتفرُّده - سبحانه - بالخلق والتدبير، والضَّرِّ والنَّفع، والعطاءِ والمنعِ، وأنَّه ما شاءَ كان، وما لم يشَأ لم يكُن، قال - سبحانه -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30].
التوكُّلُ على الله اعتِمادٌ عليه - سبحانه - في كل الأمور، والأسبابُ إنَّما هي وسائِطُ مِن غير اعتِمادٍ عليها؛ فالعبدُ يُراعِي الأسبابَ الظاهِرةَ، لكن لا يُعوِّلُ بقلبِه عليها، بل يُعوِّلُ على الخالِقِ المُدبِّر، مع الاستِسلام لجَرَيان قضائِهِ وقدَرِه ومشيئتِه، ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 159].
عباد الله:
مَن حقَّقَ التقوَى، وصدَقَ في التوكُّل على المَولَى، فقد تحصَّلَ على أعظم المطالِبِ، وأجَلِّ المآرِبِ؛ فمَن فوَّضَ أمورَه إلى ربِّه، وتوكَّلَ على خالِقِه، مُوحِّدًا له، مُنيبًا إليه، أوَّاهًا تائبًا مُمتثِلًا طائِعًا؛ جعلَ له مِن كل همٍّ فرَجًا، ومِن كل ضِيقٍ مخرَجًا، ورَزَقَه مِن حيث لا يحتسِب، ونالَ الخيرات المُتكاثِرة، ووقاه الله كلَّ ضرٍّ وشرٍّ، وكان مآلُه الفلاح والظَّفَر، والنَّصر المُؤزَّر.
يقولُ - جلَّ وعلا - عن العبدِ الصالِحِ: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 44، 45].
ويقولُ - سبحانه - عن نبيِّه مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ومَن معَه: ﴿{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: 172- 174].
عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قالَها إبراهيمُ حين أُلقِيَ في النَّار، وقالَها مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - حين قالُوا له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ..﴾ الآية"؛ رواه البخاري.
ويقولُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قالَ إذا خرَجَ مِن بيتِه: بِسمِ الله، توكَّلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، يُقال له: كُفِيتَ وُوقِيتَ وتنحَّى عنه الشيطانُ»؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.
بارَكَ الله لنا فيما سمِعنا، أقولُ هذا القولَ، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا فيه كما ينبَغي لجلالِ وجهِه وعظيمِ سُلطانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رِضوانِه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمون:
أيها المُسلم! فوِّض أمرَك إلى الله، واصدُق في الاعتِماد عليه، واعمَل بما شُرِعَ لك مِن الأسباب، وثِقْ أنَّ الذي يُدبِّرُ الأمرَ مِن السماء إلى الأرضِ، العالِمُ بالسرائِرِ والضمائِر، المُحيطُ بالأمور مِن جميعِ الوُجوهِ، القادِرُ القُدرةَ التامَّة، ذو المشيئةِ الكامِلة يُحيطُك بلطيف علمِه، وحُسن تدبيرِه بما لا يبلُغُه علمُ مخلُوقٍ، ولا يُدرِكُه فهمُ حاذِقٍ.
فاشتَغِل بشأنِك، وتفرَّغ لعبادةِ ربِّك، وتيقَّن أنَّ مَن توكَّل عليه كفاه، وكان آمِنًا مِن الأخطار، مُطمئنَّ البال، مُنشَرِحَ الصَّدر، راضِيًا بالنتائِج المُترتِّبة على ما بَذَلَ مِن جُهدٍ وعملٍ.
|
إنَّ مَن كان ليس يَدرِي |
|
أفِي المحبُوبِ نفعٌ له أو المكرُوهِ |
|
لحَرِيٌّ بأن يُفوِّضَ ما |
|
يعجَزُ عنهُ إلى الذي يَكفِيهِ |
|
الإلهِ البَرِّ الذي هو بالرَّأفةِ |
|
أحنَى مِن أمِّهِ وأبِيهِ |
ثم إن الله - جلَّ وعلا - أمرَنا بالصلاةِ والسلامِ على النبيِّ الكريمِ.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبِنا محمدٍ، اللهم ارضَ عن الخُلفاء الراشدين، وعن الآلِ أجمَعين، وعن الصحابَة ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم مَن أرادَ المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، اللهم اجعَل دائرةَ السَّوء عليه يا رب العالمين، اللهم مَن أرادَنا أو أرادَ أحدًا مِن المُسلمين بسُوءٍ، أو أرادَ دينَنا بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعَل تدميرَه في تدبيرِه يا رب العالمين، اللهم سلِّط عليه جُندَك، اللهم سلِّط عليه جُندَك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انتقِم مِمَّن أرادَ بالمُسلمين سُوءًا، اللهم انتقِم مِمَّن أرادَ بالمُسلمين ودينِهم سُوءًا ومكرُوهًا يا رب العالمين، يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم فرِّج همَّنا وهمَّ كل مهمُوم مِن المُسلمين، اللهم نفِّس كُرُباتِ المُسلمين، اللهم نفِّس كُرُباتِ المُسلمين، اللهم احفَظ عليهم أمنَهم وأمانَهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفَظ عليهم أمنَهم وأمانَهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعَل لهم مِن كل ضِيقٍ مخرَجًا، اللهم اجعَل لهم مِن كل ضِيقٍ مخرَجًا، اللهم اجعَل لهم مِن كل ضِيقٍ مخرَجًا، ومِن كل همٍّ فرَجًا، اللهم ارزُقهم مِن حيث لا يحتسِبُون، اللهم ارزُقنا وارزُقهم مِن حيث لا يحتسِبُون.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادِمَ الحرمَين الشريفَين لِمَا تُحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّه وترضَاه، اللهم اجعَل عملَهما في رِضاك يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين لما فيه خيرُ رعاياهم في دينِهم ودُنياهم يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم اغفِر لنا وللمُسلِمين والمُسلِمات، اللهم اغفِر للمُؤمنين والمُؤمنات، والمُسلِمين والمُسلِمات، الأحياء منهم والأموات.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم مَن مكَرَ بالمُسلمين فامكُر به، اللهم واجعَل عليه دائِرةَ السَّوء يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم واجعَل حالَ المُسلمين خيرًا في حالِهم ومُستقبَلهم يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم احفَظ أجيالَ المُسلمين مِن الفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن، اللهم احفَظنا وإيَّاهم مِن الفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن، اللهم احفَظنا وإيَّاهم مِن الفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن يا حيُّ يا قيُّوم.
عباد الله:
اذكُروا الله ذِكرًا كثيرًا، وسبِّحُوه بُكرةً وأصيلًا.
خطب الحرمين الشريفين

مكانة
السنة النبوية
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "مكانة السنة النبوية"، والتي تحدَّث فيها عن السنَّة النبويَّة المُطهَّرة ومكانتها ومنزلتها في الدين، وأنَّها المصدر الثاني للتشريع، ثم بيَّن الواجِبَ على المُسلم تجاه أعداء الإسلام الذين يطعَنون في السنَّة ويُشكِّكُون فيها ويرُدُّون الأحاديثَ، ثم تحدَّث عن الأشهُر الحُرُم ووجوب تعظيمها، وطاعةِ الله فيها، واجتِنابِ المعصِية؛ فإن المعصِية إن عظُمَت فيها، فإنَّ الطاعة فيها مُعظَّمة.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا بين يدَي الساعةِ، مَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد رشَد، ومَن يعصِ اللهَ ورسولَه فإنَّه لا يضُرُّ إلا نفسَه، ولا يضُرُّ اللهَ شيئًا.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد .. فيا أيها المُسلمون:
إنَّ للسنَّة النبويَّة الشريفة مكانةً عاليةً كُبرى، ومنزلةً سامِيةً عُظمى؛ إذ هي المصدرُ الثاني مِن مصادر التشريع الإسلامي، فأحكامُنا الشرعيَّةُ التي أُمِرنا أن نعملَ بها إنَّما نستَقِيها مِن وحيِ ربِّنا الذي يشملُ: القرآنَ الكريمَ، والسنَّةَ المُطهَّرةَ.
ومما يدُلُّ على أنَّ السنَّة وحيٌ مِن الله: قولُه تعالى: ﴿{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾ [المائدة: 7]، وقولُه تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: 34].
قال أهلُ التفسير: "الحكمةُ: السنَّة".
والسنَّةُ - عباد الله - شارِحةٌ ومُفسِّرةٌ لكثيرٍ مِن الأحكام المُجمَلَة في القُرآن؛ فقد بيَّن - سبحانه - بأنَّه تكفَّل ببيانِ كتابِه فقال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 17- 19].
وبيانُه يكونُ على لسانِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].
فأين يجِدُ المُسلمُ في القرآن أنَّ الظُّهر والعصرَ والعِشاءَ أربعُ ركعات؟ وأين يجِدُ أيضًا مسائلَ الزكاة، وتفاصيلَ أحكام الحجِّ، وغيرَ ذلك؟
عن عِمران بن حُصَين، أنَّ رجُلًا أتاه فسألَه عن شيءٍ فحدَّثَه، فقال الرجُلُ: حدِّثُوا عن كتابِ الله ولا تُحدِّثُوا عن غيرِه، فقال: "إنَّك امرُؤٌ أحمقٌ! أتجِدُ في كتابِ الله أنَّ صلاةَ الظُّهر أربعًا لا يُجهَرُ فيها؟ وعدد الصلوات، وعدد الزَّكوات ونحوها؟"، ثم قال: "أتجِدُ هذا مُفسَّرًا في كتابِ الله؟ إنَّ الله قد أبهَمَ هذا، والسنَّةُ تُفسِّرُ ذلك".
وكما أنَّ السنَّة مُبيِّنةٌ ومُفصِّلةٌ لأحكامِ القُرآن، فهي تستقِلُّ ببعضِ الأحكام والتشريعات؛ كإيجابِ صدقةِ الفِطر، وتحريمِ الذَّهب والحَرير على الرِّجال، والنهي عن الجَمع بين المرأة وعمَّتها والمرأة وخالتِها.
فالواجِبُ علينا جميعًا - أيها المُسلمون - أن نتمسَّك بالكتاب والسنَّة، وألا نُفرِّق بينهما مِن حيث وجوب الأخذ بهما كلَيهما، وإقامة التشريع عليهما معًا؛ فإنَّ هذا هو الضمانُ لنا ألا نَزيغَ ولا ننحَرِف ولا نضِلَّ، كما بيَّن ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: «تركتُ فيكم أمرَين لن تضِلُّوا ما إن تمسَّكتُم بهما: كِتابَ الله وسنَّةَ نبيِّه»؛ رواه مالكٌ في "الموطأ".
أيها الإخوة:
لقد جاءت النصوص الشريعة مُبيِّنةً أن طاعةَ الرسولِ طاعةٌ لله، ومُؤكِّدةً على وجوبِ طاعة الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - واتِّباعه، والتحذير مِن مُخالفته وتبديل سُنَّته.
فمِن ذلك: قولُه تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]، وقولُه - عزَّ وجل -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].
وقولُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -: «عليكُم بسُنَّتي وسُنَّة الخُلفاء المهديِّين الراشِدين، تمسَّكُوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجِذ»؛ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مِن حديث العِرباض بن سارِية - رضي الله عنه -.
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: «فمَن رغِبَ عن سُنَّتِي فليس مِنِّي»؛ متفق عليه مِن حديث أنسِ بن مالكٍ - رضي الله عنه -.
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: «خَيرُ الحديثِ كِتابُ الله، وخَيرُ الهَديِ هَديُ مُحمدٍ»؛ أخرجه مسلم مِن حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
فلا يُمكن تطبيقُ الإسلام إلا بالرُّجوع إلى السنَّة، ولا إسلامَ للمرء بدون قَبُول السنَّة والعمل بها.
معاشِر المُسلمين:
ومما أخبَرَ عنه الصادِقُ المصدُوقُ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سيأتي مِن بعدِه أقوامٌ يرُدُّون أحاديثَه ويطعَنُون فيها؛ فعن المِقداد بن معدِي كَرِب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنِّي أُوتِيتُ القُرآن ومِثلَه معه، ألأا يُوشِكُ رجُلٌ شبعان على أريكَتِه يقولُ: عليكُم بهذا القُرآن، فما وجدتُم فيه مِن حلالٍ فأحِلُّوه، وما وجدتُم فيه مِن حرامٍ فحرِّمُوه»؛ رواه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد.
والواجِبُ على كل مُسلمٍ أن يحذرَ مِن دُعاة الضلالة الذين يرُدُّون أحاديثَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الثابِتة، ويُشكِّكُون في السنَّة ويطعَنُون فيها، ويقُولُون: أوامِرُ النبيِّ لا تلزَمُنا، ويُلبِّسُون على الناسِ ويدَّعُون أنَّهم يُظهِرُون الحقائِقَ، وهم في حقيقةِ الأمر يُروِّجُون الأباطِيل، ويُحارِبُون ثوابِتَ الدين، ويأتُون بالمُحدثات، ويُشكِّكُون في المُسلَّمات. وما أشدَّ هلَكَة مَن كان على هذا المسلَك الوَعِر.
قال الإمامُ أحمدُ - رحمه الله -: "مَن ردَّ حديثَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو على شفَا هلَكَة".
وقال الحسنُ البربَهَاريُّ - رحمه الله -: "وإذا سمِعتَ الرَّجُلَ يطعَنُ على الأثر، أو يرُدُّ الآثار، أو يُريدُ غيرَ الآثار، فاتَّهِمه على الإسلام، ولا تشُكَّ أنَّه صاحِبُ هوًى مُبتدِع".
أيها الإخوة:
لقد اتَّخذ الطعنُ في السنَّة صُورًا مُتعدِّدة، وطُرقًا مُتنوِّعة؛ فتارةً عن طريقِ الطَّعن في حُجِّيَّتها ومكانتِها، وتارةً عن طريقِ الطَّعن في الأسانيد بالهوَى وبغيرِ علمٍ، والتقليلِ مِن شأنِها، وتارةً عن طريقِ الطَّعن في منهَجِ المُحدِّثِين في النَّقد والجَرح والتعديل، وتارةً عن طريقِ الطَّعن في المرويَّات بالتشكيكِ فيها، وادِّعاء التناقُض والتعارُض بينها، وتارةً عن طريقِ مُحاكمتها للرأي، وأنَّها لا تتوافَقُ مع العقل والحِسِّ والذَّوق، وتارةً عن طريقِ مُحاكمتها إلى مقاييس بشريَّة، وأنَّها تتعارَضُ مع اكتِشافات العصر الحديثِ .. إلى غيرِ ذلك مِن أنواع الطُّعُون.
وفي الآونة الأخيرة واجَهَت السنَّة النبويَّة المُطهَّرة حربًا ضرُوسًا، وتعرَّضَت لحملات ضارِيةٍ مِن قِبَل أعداء الإسلام، وكلُّ ذلك حلقةٌ في سلسلة الموجة الشَّرِسَة مِن الهُجوم على الثوابِتِ وقطعيَّات الدين.
وينبَغي ألا يغِيبَ عنَّا - عباد الله - أنَّ التشكيكَ في مصادر التلقِّي أمرٌ قديمٌ، وخصوصًا السنَّة منذ الصدر الأول للإسلام، كما أنَّ المُعاصِرين الذين تصدَّوا للحُكم على السنَّة النبويَّة مِن خلال آرائِهم وتوجُّهاتهم لم يأتُوا بجديدٍ، وإنَّما هم امتِدادٌ لأهل الأهواء والبِدَع والزَّيغ مِن قبلِهم، الذين حكَى أهلُ العلم شُبُهاتهم، وتولَّوا الردَّ عليها.
أيها الإخوة:
إنَّ المُتأمِّل في ظاهرة الطَّعن في السنَّة، والنَّاظِرَ في أحوالِ أهلِها قديمًا وحديثًا، يتبيَّنُ له بجلاءٍ حقيقةُ هذه الدعوة الباطِلة، علاوةً على الدعوة الأُخرى الآثِمة، وهي: زعمُ إعادة قراءة التُّراث، ويُدخِلُون في التُّراث نصوصَ القُرآن الكريم برُؤيةٍ مُعاصِرةٍ مُختلفةٍ عن الحقِّ، يبُثُّون مِن خلالِها سمومًا وتشكيكاتٍ في الوحي، ويهدِفُون في نهايةِ الأمرِ إلى هَدمِ دينِ الإسلام القَوِيم.
وهنا يأتي السُّؤال المهمُّ الذي ينبغي أن يدُورَ في خلَدِ كلِّ مُسلمٍ: ما دَورُ المُسلمين في الدِّفاع عن السنَّة النبويَّة، وما موقِفُهم مِن أعدائِها والطاعِنين فيها؟
فالجوابُ يتلخَّصُ في الأمور التالِية:
أولًا: العنايةُ بالسنَّة جَمعًا وتنقيحًا وتصنيفًا، وحفظًا وتعليمًا ونشرًا.
ثانيًا: حثُّ الناس على التمسُّك بالسنَّة، والدعوةُ إلى تطبيقِها في حياةِ الأمة أفرادًا وأُسرًا ومُجتمعاتٍ ودُولًا.
ثالثًا: تربيةُ الأمة على محبَّة الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وإجلالِه وتوقيرِه وتبجِيلِه، ومعرِفة قَدرِه الشريف ومكانته العلِيَّة.
رابعًا: الاحتِسابُ على كل مُتنقِّصٍ للرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، أو طاعِنٍ في السنَّة، والتحذيرُ مِمَّن يدَّعي أنَّ نصوصَ القُرآن والسنَّة الصحيحة قابِلةٌ للنَّقض والاعتِراض، وعدم التساهُل معه، بل السعيُ في كشفِ أمرِه، وبيانِ زَيفِ عملِه.
فاللهم اجعَلنا مِن النَّاصِرين لدينِك، المُتَّبِعين لرِضوانِك، المُتمسِّكين بسنَّة نبيِّك، الذَّابِّين عنها، والدَّاعِين إليها.
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ الله لي ولكم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي رضِيَ لنا الإسلامَ دينًا، وأرسلَ إلينا رسولًا أمينًا، وأنزلَ إلينا نورًا مُبينًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له في ربوبيَّته وإلهيَّته وأسمائِه وصفاتِه، وأشهدُ أنَّ مُحمدً عبدُه ورسولُه أرسلَه بالهُدى ودينِ الحقِّ، فهدَى به مِن الضلالة، وأرشدَ به مِن الغِواية، وفتَحَ به أعيُنًا عُميًا، وآذانًا صُمًّا، وقلوبًا غُلفًا، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فمما يُطمئِنُ القلبَ ويسُرُّ الخاطِر: أنَّ الأمةَ المُسلِمةَ - بحمدِ الله - لا تخلُو في كل عصرٍ - ومِنه عصرُنا هذا - مِمَّن يُدافِعُ عن السنَّة وينشُرُها، ويعملُ على خدمتِها جمعًا وتحقيقًا وتخريجًا وشرحًا، وردًّا على خصومِها، وفضحًا لأعدائِها.
وإذا كان دَيدَنُ الصحابةِ الكِرامِ - رضي الله عنهم - الدِّفاع عن رسولِ الله في حياتِه، يُفدُّونَه بأنفسِهم وأموالِهم، ويُنافِحُون عنه، وقد ضرَبُوا أروعَ الأمثِلةِ في التضحِية والوفاء، حتى يقول قائِلُهم مُخاطِبًا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحرِي دُون نَحرِك".
كأنَّه أرادَ أن يقول: يا رسولَ الله! أنا أموتُ دُونَك، وأُنحَرُ ولا تُنحَر، أُقتَلُ ولا تُقتَلُ، دَعني أنا أُواجِهُ العدوَّ، أما أنت فامكُث وابقَ سالِمًا صحيحًا مُعافى.
إذا كانت هذه مواقِف الصحابة في الدِّفاع عن نبيِّهم في حياتِه، فأنصارُ الدين والمُنافِحون عن سنَّة سيِّد المُرسَلين - صلى الله عليه وسلم -، الذين جاءُوا مِن بعدِهم هم على شاكِلَتهم، يُحاكُونَهم في غَيرتِهم ونُصرتِهم سُنَّته، وذَودِهم عن حِياضِها، لِسانُ حالِهم: "سيبقَى أُسدُ الشَّرَى لمَن يطعَنُ في سنَّة خَير الوَرَى".
لا يَدَعُون مُفتَرٍ ينالُ مِنها إلا ذبُّوا عنها، ولا يعمِدُ أحدٌ إلى التشكيكِ فيها إلا وجدَ مَن يزجُرُه ويمنَعُه، ويكفُّه ويردَعُه؛ غضبَةً لربِّ الأنام، وحمِيَّةً لدينِ الإسلام.
عباد الله:
ومِن المعانِي القُرآنيَّة التي جاءت السنَّة المُطهَّرةُ ببيانِها: الأشهُرُ الأربعةُ الحُرُم الوارِدةُ في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].
فبيَّن إجمالَ هذه الآية النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في خُطبة حجَّة الوداع؛ فعن أبي بَكْرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ الزمانَ قد استَدارَ كهَيئَتِه يوم خلَقَ السماوات والأرض، السنةُ اثنا عشر شهرًا، مِنها أربعةٌ حُرُم، ثلاثةٌ مُتوالِياتٌ: ذُو القَعدة، وذُو الحجَّة، والمُحرَّم، ورجبُ شهرُ مُضَر الذي بين جُمادَى وشعبان»؛ رواه البخاري ومسلم.
كما بيَّن العُلماءُ أنَّ سببَ تسمِيتها حُرُمًا؛ لزيادةِ حُرمتها، وتحريمِ القِتالِ فيها.
أيها المُسلمون:
ها نحن قد أدرَكنا - بفضلِ الله - هذه الأشهُر الحُرُم؛ فما الواجِبُ علينا فيها؟
الواجِبُ هو امتِثالُ أمرِ الله تعالى باجتِنابِ الظُّلم فيها.
فعن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - في قولِه تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾: "في كلِّهنَّ، ثم اختصَّ مِن ذلك أربعةَ أشهُر فجعلهنَّ حرامًا، وعظَّمَ حُرماتهنَّ، وجعلَ الذنبَ فيهنَّ أعظَم، والعملَ الصالِحَ والأجرَ أعظَم".
وقال قتادةُ في قولِه: ﴿﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾: "إنَّ الظُّلمَ في الأشهُر الحُرُم أعظمُ خطيئةً ووِزرًا مِن الظُّلم فيما سِواها، وإن كان الظُّلمُ على كل حالٍ عظيمًا، ولكنَّ الله يُعظِّمُ مِن أمرِه ما يشاء".
والظُّلمُ الذي يحذَرُه المُسلمُ ثلاثةُ أنواعٍ؛ فعن أنسِ بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الظُّلمُ ثلاثةٌ: فظُلمٌ لا يغفِرُه الله، وظُلمٌ يغفِرُه، وظُلمٌ لا يترُكُه الله؛ فأما الظُّلمُ الذي لا يغفِرُه الله فالشِّركُ، قال الله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، وأما الظُّلمُ الذي يغفِرُه فظُلمُ العباد لأنفسِهم فيما بينهم وبين ربِّهم، وأما الظُّلمُ الذي لا يترُكُه الله فظُلمُ العباد بعضِهم بعضًا، حتى يَدِينَ لبعضِهم مِن بعضٍ»؛ رواه الطيالسيُّ والبزَّار.
فلنَستحضِر - عباد الله - حُرمةَ هذه الأشهُر وتعظيمَها؛ فإنَّ تعظيمَها مِن تعظيمِ الله - عزَّ وجل -، فقد قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
والمُسلمُ يُعظِّمُ الأشهُر الحُرُم خاصَّة بالتِزام حُدود الله تعالى فيها، وإقامة فرائِضِه، والحِرصِ على طاعتِه، وعدمِ انتِهاك محارِمِه وارتِكابِ مساخِطِه وتعدِّي حُدودِه.
ألا وصلُّوا وسلِّمُوا - رحِمَكم الله - على نبيِّكم الذي أُوحِيَ إليه فبلَّغ رسالةَ ربِّه ونصَحَ الأمة، وأدَّى ما عليه، وبذَلَ نفسَه وآثَرَ ما لدَيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وأزواجِه وذريَّته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارِك على مُحمدٍ وأزواجِه وذريَّته، كما بارَكتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، وانصُر عبادَك المُوحِّدين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل هذا البلَدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين، اللهم انصُر مَن نصَرَ الدين، واخذُل مَن خذَلَ عبادَك المُؤمنين.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، واجعَل ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقاك، واتَّبَع رِضاك يا رب العالمين، اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّه وترضَاه مِن الأقوال والأعمال، ولِما فيه خيرُ العباد والبلاد يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم ألِّف بين قلوبِ المُؤمنين، وأصلِح ذاتَ بينهم، واهدِهم سُبُل السلام، ووحِّد صُفوفَهم، واجمَع كلمتَهم على الحقِّ يا ربَّ العالَمين، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُّ يا عزيز.
اللهم كُن لإخوانِنا المُستضعَفين المُضطَهدين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين على الثُّغور، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا.
اللهم أنجِ المُستضعَفين مِن المُؤمنين، وارفَع الظُّلمَ والطُّغيانَ عنهم، واكشِف كُربَتَهم، واجعَل لهم مِن كل همٍّ فرَجًا، ومِن كل ضِيقٍ مخرَجًا، ومِن كل بلاءٍ عافِية.
اللهم أنزِل عذابَك الشديد وبأسَك الذي لا يُردُّ عن القَوم المُجرِمين على مَن تسلَّط عليهم وظلَمَهم يا قويُّ يا عزيز، اللهم عليك بهم فإنَّهم لا يُعجِزونَك، اللهم زلزِلِ الأرضَ مِن تحت أقدامِهم يا ربَّ العالمين.
وقومُوا إلى صلاتِكم يرحمكُم الله.
خطب الحرمين الشريفين

قُوَّة المُؤمن
ألقى فضيلة الشيخ علي بن
عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "
قُوَّة المُؤمن"، والتي تحدَّث فيها عن قُوَّة المُؤمن بإيمانِه بربِّه
واعتِصامِه بكتابِه - سبحانه - وسُنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، ثم قُوَّته بإخوانِه وتعاوُنه معهم على الخير، مُبيِّنًا مكانةَ هذه
الأُخُوَّة الإيمانيَّة في دين الإسلام، وما يرفعُ مِن شأنِها، وما يضُرُّها؛ لكي
يحرِصَ المُسلمُ على النافِع.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم، أحمدُ ربي وأشكُرُه على نعمِه التي نعلَمُ والتي لا نعلَمُ، فهو أهلٌ أن يُذكَر فلا يُنسَى، وأن يُشكَر فلا يُعصَى، وهو الغنيُّ الكريم، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له العليُّ العظيم، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه الذي فضَّلَه الله على العِباد بكل خُلُقٍ كريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه الهُداة إلى الصراط المُستقيم.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ بالتقرُّبِ إليه بمرضاتِه، وتركِ مُحرَّماتِه؛ فما فازَ إلا المُتَّقُون، وما خسِرَ إلا العُصاةُ المُفسِدُون.
أيها المُسلمون:
المُؤمنُ قويٌّ بإيمانِه، ثم هو قويٌّ بإخوانِه، المُسلمُ يركَنُ إلى إيمانِه بربِّه في الشدائِدِ والكُرُبات، ويعتصِمُ بإيمانِه بربِّه عند وُرود الشُّبُهات والشَّهَوات، ويستبصِرُ بإيمانِه في ظُلُمات الفتَن والمُلِمَّات، ويحفظُه الله بإيمانِه في حال الرَّخاء والصحة والفراغ مِن السُّقُوط والتردِّي في المُتَع المُحرَّمات، ويُحيِيه الله بإيمانِه في الدنيا الحياةَ المُباركةَ السعيدةَ المرضِيَّة، النافعةَ الحسنةَ العاقِلةَ، وينالُ بإيمانِه بربِّه أعلى الدرجات بعد الممات.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 9، 10].
وعن سَلمان - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «عجَبًا لأمرِ المُؤمن، إنَّ أمرَه كلَّه خيرٌ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمُؤمن؛ إن أصابَتْه سرَّاءُ شكَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضرَّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له»؛ رواه مسلم.
فالمُؤمنُ عزيزٌ سعيدٌ مُوفَّقٌ بإيمانِه، كما أنَّ المُؤمن قويٌّ بإخوانِه؛ فأخُوَّةُ الإسلام أقوَى مِن أخُوَّة القرابة بالنَّسَب، ولذلك ينقطِعُ التوارُثُ بين المُسلم والكافِر.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرِثُ المُسلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلمَ»؛ رواه البخاري ومسلم مِن حديث أسامة بن زيدٍ - رضي الله تعالى عنهما -.
فأُخوَّة الإسلام أعظمُ رابِطةٍ، وأشدُّ صِلةً ووشِيجَة؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71]، وقال - سبحانه -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10].
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «المُسلمُ أخُو المُسلم، لا يظلِمُه، ولا يخذُلُه»؛ رواه مسلم.
فأُخُوَّة الإسلام يكونُ بها التناصُر في الدين، والقُوَّةُ في الاجتِماع؛ قال الله تعالى لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: 62، 63].
وقال - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ [آل عمران: 102، 103].
وأُخُوَّة الدين يكونُ بها التعاوُن على تحقيقِ المصالِح، ودفع المفاسِد، وحفظِ المُجتمع مِن العادِيات والانحِراف؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].
وأُخُوَّة الإسلام يكون بها التراحُمُ والتعاطُف، والتكافُلُ والتكامُلُ في إيجادِ مطالِبِ المُجتمع وحاجاتِه، وانتِظام حياتِه.
قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مثَلُ المُؤمنين في توادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم كمثَل الجسَد الواحِد، إذا اشتَكَى مِنه عضوٌ تداعَى له سائِرُ الجسَد بالسَّهر والحُمَّى»؛ رواه البخاري ومسلم مِن حديث أبي موسى الأشعريِّ - رضي الله عنه -.
ومما تَطِيبُ به الحياةُ: شُيُوع المحبَّة بين المُسلمين؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسِي بيدِه؛ لن تدخُلُوا الجنةَ حتى تُؤمِنُوا، ولن تُؤمِنُوا حتى تحابُّوا، أوَلا أدُلُّكُم على شيءٍ إذا فعَلتُمُوه تحابَبتُم؟ أفشُواالسلامَ بينَكم».
معشَر المُسلمين:
لن تستقيمَ الحياةُ إلا بالقِيام بحُقوق أخُوَّة الإسلام، فالواجبات مِنها ما هو للربِّ - جلَّ وعلا -، وهو الواجِبُ الأعظمُ بتوحيدِ الله تعالى وعبادتِه، ومِنها ما هو للخلقِ.
وحُقوق المُسلمين عل ثلاثِ درجاتٍ:
أعلاها: الإيثار، وهو تقديمُ حاجة المُسلم وحقِّه على حقِّ النفسِ، وهذه الدرجةُ فازَ بها المُهاجِرُون والأنصارُ - رضي الله تعالى عنهم -، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
وهذا يتكرَّرُ في كل زمانٍ ومكانٍ إذا كمُلَ الإيمان، وقد حفِظَ التاريخُ صُورًا مِن ذلك الإيثار كثيرة في أزمِنةٍ مُختلِفة.
والدرجةُ الوُسطى مِن درجاتِ الأخُوَّة الإسلاميَّة: أن يُحِبَّ المُسلمُ لأخِيه ما يُحبُّ لنفسِه.
عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخِيه ما يُحبُّ لنفسِه»؛ رواه البخاري ومسلم.
وأدنَى درجات القِيام بحقِّ المُسلم: أن تكُفَّ شرَّك عنه، فلا تظلِمه في دمٍ ولا مالٍ ولا عِرضٍ، ولا تقَعُ بلِسانِك فيه ولا يدِك، ولا تبخَسه حقًّا له، ولا تمنَعه مِن حقٍّ له، مع بذلِ ما يُوفِّقُك الله له مِن الخَير.
قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذَرٍّ: «وأن تكُفَّ شرَّك على الناس؛ فإنَّ ذلك صدقةٌ مِنك على نفسِك».
أيها المُسلمون:
إنَّ أعظمَ ما يضُرُّ الأخُوَّة الإسلاميَّة: البِدَع المُضِلَّة؛ فالمُبتدِعُ يُبغِضُ مَن لا يُوافِقُه في بِدعتِه ويُحارِبُه، ولا يجمعُ قُلوبَ المُسلمين إلا عقيدةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابِته ومَن تبِعَهم بإحسانٍ، فهم المُتحابُّون في الله، وآخِرُهم يُحبُّ أوَّلَهم؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
ومما يضُرُّ أخُوَّة الإسلام: إيثارُ الدنيا على الآخرة، والتهافُت عليها، فقد صارَت عامَّةُ مُؤاخاةِ الناسِ عليها، والتباغُض على زُخرُفها ومتاعِها.
ومما يضُرُّ أخُوَّة الإسلام: التظالُم، وانتِشارُ هذا الظُّلم بمنعِ الحُقوقِ أو أخذ الحُقوقِ، فالنَّفسُ البشريَّةُ ترَهُ مَن يظلِمُها، وتنتقِمُ مِنه.
ومما يضُرُّ الإخاءَ الإسلاميَّ: الحسَدُ، فهو يحمِلُ على البغي والعُدوان.
ومما يضُرُّ الإخاءَ الإسلاميَّ: النَّظرُ إلى النَّفسِ بعَين الكمال، والنَّظرُ إلى الغَير بعن الاحتِقار والنَّقص، وأنتُم - معشَر المُسلمين - قد جمَعَت أبدانَكم فرائِضُ الإسلام في الحجِّ، والعُمرة، والجُمَع، وصلاةِ الجماعة، والأعياد.
فاجمَعُوا قلوبَكم على عقيدة السلَف الصالِح، وعلى القُرآن والسنَّة، وتذكَّرُوا أنَّكم راجِعُون إلى الله تعالى، وتارِكُون وراءَكم كلَّ ما كان يصُدُّكم عن الحقِّ، وموقُوفُون بين يدَي ربِّكم حُفاةً عُراةً غُرلًا ليس معكم إلا الحسنات والسيِّئات.
قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7، 8].
فاقدُمُوا بالحسنات، واحذَرُوا السيِّئات.
قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 133، 134].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآياتِ والذكرِ الحكيم، ونفَعَنا بهَديِ سيِّد المُرسَلين وقولِه القَويم، أقولُ قَولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم وللمُسلمين، فاستغفِروه، إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله على كل حال، ونعوذُ به مِن حال أهل النَّار الذين أوقَعَتهم أعمالُهم في الخِزيِ والنَّكال، أحمدُ ربِّيَ على عظيمِ النَّوال، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له الكبيرُ المُتعال، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم صَلِّ وسلِّم عليه، وعلى صحابتِه والآل.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله تعالى وأطيعُوه، واحذَرُوا مِن غضَبِه والجُرأة على معاصِيه.
عباد الله:
لقد قامَت عليكُم الحُجَّة، واستبانَت المحجَّة، وانقطَعَت الأعذارُ، فأقبِلُوا على العمل، ولا يغُرَّنَّكم الأمل؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [لقمان: 33].
وتذكَّرُوا الموتَ وما بعدَه مِن الأهوال التي لا يُنجِي مِنها إلا صالِحُ الأعمال.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «اذكُرُوا هاذِمَ اللذَّات» يعني: الموت.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابةِ أجمعين، اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ أصحابِ نبيِّك أجمعين، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحمَ الراحِمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذلَّ الكفرَ والكافرين يا رب العالمين، ودمِّر أعداءَ الدين إنك على كل شيء قدير.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك يا رب العالمين، اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك.
اللهم تولَّ أمرَ كل مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ، وأمرَ كل مُسلمٍ ومُسلمةٍ برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اكشِف وارفَع عن المُسلمين ما نزَلَ بهم مِن البلاءِ والكُرَب يا ربَّ العالمين، اللهم ارحَم ضعفَهم، اللهم تولَّ أمرَهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمِّن خائِفَهم، واشفِ مريضَهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألُك أن تُعِيذنا من شُرور أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالِنا، وأعِذنا مِن شرِّ كل ذي شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا مِن إبليس وجنوده وشياطينه وأتباعِه يا رب العالمين، إنَّك على كل شيء قدير.
اللهم عليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالشياطين السَّحَرة، اللهم أنزِل بهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين، اللهم أبطِل كيدَهم، اللهم أبطِل كيدَهم، وأبطِل مكرَهم، وادفَع شُرورَهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألُك أن تغفِر لنا ذنوبَنا إنَّك أنت الغفورُ الرحيم، نسألُه مِن الخير كلِّه عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام نسألُك أن تُثبِّت قلوبَنا على طاعتِك، اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدين برحمتِك يا أرحم الراحمين، إنَّك على كل شيء قدير.
اللهم وفِّق عبدَك خادمَ الحرمين الشريفين، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عمَلَه في رِضاك يا رب العالمين، اللهم أعِنه على كل خيرٍ، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عمَلَه في رِضاك، اللهم أعِنه على كل خيرٍ، اللهم اجعَلهما مِن الهُداة المُهتَدين، وانفَع بهما الإسلام والمُسلمين يا رب العالمين.
اللهم احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكرُوهٍ يا رب العالمين.
اللهم عليك بالبِدع المُضِلَّة التي أضَلَّت يا رب العالمين الكثيرَ مِن المُسلمين، اللهم عليك بالبِدع.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تدفَعَ عنَّا الغلا، اللهم ادفَع عنَّا الغلا والوبا، والرِّبا والزِّنى، والزلازِلَ والمِحَن، وسُوءَ الفتن ما ظهَرَ مِنها وما بطَنَ برحمتِك يا أرحم الراحِمين.
اللهم احفَظ جُنودَنا، اللهم احفَظ جُنودَنا يا رب العالمين، اللهم احفَظهم بحفظِك إنَّك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألُك أن تتولَّى أمورَهم، وأن تحفَظَ لهم ما يخافُون عليه إنَّك على كل شيء قدير، وأن تتقبَّل موتاهم في الشُّهداء، وأن تشفِي مرضاهم إنَّك على كل شيء قدير.
عبادَ الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا الله العظيمَ الجليلَ يذكُركُم، واشكُروه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

فاطمةُ الزَّهراء قُدوةُ
النساء
ألقى فضيلة الشيخ خالد بن علي الغامدي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فاطمةُ الزَّهراء قُدوةُ النساء"، والتي تحدَّث فيها عن القُدوات التي ينبغي أن يحذُو حذوَها
المُسلِمون، وينهَجُون نهجَها؛ فإنَّ التاريخَ حافِلٌ بالقُدوات الكثيرة، وأعظمُهم
رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والمُقدَّمُون بعدَه - عليه الصلاة والسلام - هم آلُ بيتِه، ومِن بينهنَّ امرأةٌ مِن أعظم
نساءِ العالَمين، وهي فاطمةُ بنتُ الرسولِ - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث
عرَّج على ذِكرِ فضائِلِها وبيانِ منزلتِها ومكانتِها في دينِنا، ووجوبِ اقتِداءِ
النساءِ وتأسِّيهنَّ بها.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي جعلَ أمةَ الإسلام خيرَ الأُمم، وأفاضَ عليها ما لا يُحصَى مِن ألوان النِّعم والكرَم، وجعلَ منهم أئمةً ونُجومًا بهم يُقتَدَى ويُهتَدَى في ظُلُمات الأحداث والأمر المُدلهِمّ، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه، وأُثنِي عليه الخيرَ كلَّه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له جادَ بالفضائل والبركات والخير العَمِم، وأشهدُ أن سيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه الخليلُ المُصطفى، والرسولُ المُجتبَى، قالَ بالحقِّ والصِّدقِ وبه عدَلَ وحكَم، صلَّى الله عليه وعلى آلِه السادة الطيبين، وصحابتِه الأئمةِ المهديِّين، والتابِعِين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا دائمًا مزيدًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله - وراقِبُوه، واستَشعِرُوا عظمتَه وجلالَه في كل وقتٍ وحين، فهو - سبحانه - أقربُ إليكُم مِن حبلِ الوَرِيد، ولن يُعجِزَ اللهَ أحدٌ ولن يُعجِزَه هربًا، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].
أيها المُسلمون:
إنَّ تربية الأمة على الأخلاق الفاضِلة والقِيَم النبيلة مِن خلال الاقتِداء بالقُدوات الصالِحة المُؤثِّرة، والاهتِداء بها في الخطاب والمنهَج والتطبيقِ مِن أعظم العوامِلِ والأُسس التي تُساهِمُ مُساهمةً عميقةً في بناءِ الشخصيَّة المُسلِمة المُعتَزَّة بدينِها وثوابتِها وانتِمائِها وتاريخِها، والتي نحن أحوَجُ ما نكونُ إليها في زمانِنا هذا.
ولأهمية عامِلِ القُدوة الصالِحة وأثَره الفاعِلِ في التكوين والتربية والبِناء، أمَرَ الله نبيَّه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يصبِرَ كما صبَرَ أُولُو العَزم مِن الرُّسُل، وقال له: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90].
وضرب الله لنا بدائِعَ النماذِج لقُدواتٍ هم غُرَرٌ في جَبين الزَّمان؛ كالأنبِياء - عليهم السلام -، ومُؤمن آل فِرعون، ولُقمان العبد الصالِح الحكيم، ومريم بنت عِمران، وامرأت فِرعون، وغيرهم كثير.
بَيْدَ أنَّ أعظمَ القُدوات الذين أشادَ الله تعالى بهم هو سيِّدُنا ونبيُّنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وآله وسلم -، الذي قال الله فيه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21].
فالنبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - هو قُدوةٌ مُطلقةٌ بلا حُدودٍ زمانيَّةٍ ولا مكانيَّةٍ، في أقوالِه وأفعالِه، وأخلاقِه وسيرتِه وتقريراتِه، دقَّت أم جلَّت.
وقد سَرَت هذه القُدوةُ النبويَّةُ المُبارَكة إلى ذُريَّته وزوجاتِه، وقد صحَّ في الخَبَر الأمرُ بالصلاةِ عليه وعلى ذُريَّته وأزواجِه، فأصبَحُوا كذلك قُدوةً للعالَمين، قال الله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: 32]، وقال - سبحانه -: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33].
هذا، وإنَّ مِن أجَلِّ القُدوات النبويَّة مِن أهل بيتِه الشريفِ ابنتَه السيِّدة الفاضِلة الشريفة فاطِمة الزَّهراء - رضي الله عنها وعن أمِّها المُبارَكة خديجة -، وصلى الله على أبِيها وسلَّم.
إنَّ الحديثَ عن القُدوة النبويَّة "فاطِمة" حديثٌ مُغدِقُ الثِّمار، عظيمُ الشَّأن، له حلاوةٌ وطلاوةٌ، ورِيٌّ ونماءٌ، ورَونَقٌ وبهاءٌ، يُنبِّهُ الغافِلين والمُنبَهِرين اللاهِثِين وراء السَّراب: أن هلُمُّوا .. فها هنا الجلال والكمال والطُّهر والنَّقاء .. ها هنا القُدوةُ النبويَّة التي اختارَها الله على علمٍ؛ لتكون غيثًا للناسِ في زمانِ جَدْبِ الأخلاق والقِيَم والحياء، وواحةً غنَّاءَ للأمة في صحراء الشَّهوات والشُّبُهات، وفقرِ النُّفوس وتهافُتِها وتفاهَتها.
اختارَ الله هذه السيِّدة المُبارَكة على علم، وأودَعَ في شخصيَّتها مِن الفضائِل والكمالات ما زكَّاها به ورقَّاها في درجاتِ العِزِّ والشَّرَف. تربَّت - رضي الله عنها - في بيتِ النبُوَّة، وتخرَّجَت بمدرسةِ أبِيها النبيِّ الأعظَم - صلى الله عليه وآله وسلم -، وتعلَّمَت مِن مِشكاةِ الرِّسالة، ونهَلَت مِن علمِ وفقهِ زوجِها الإمامِ عليٍّ - رضي الله عنه -. فحازَت أعلَى المقامات، وتشرَّفَت بأعظَم الثَّناء، وسطَّرَ لها التاريخُ أنبَلَ المواقِف، وأفخمَ الوقائِع في تعامُلِها مع ربِّها وأبِيها، وزوجِها ومُجتمعِها.
فمَن ذا يلحَقُ شأوَها .. ومَن ذا يُسامِيها مِن نساءِ الدُّنيا؟!
وُلِدَت - رضي الله عنها - قبل البِعثة النبويَّة بخمسِ سنواتٍ في مكَّة، وقُريشٌ تبنِي الكعبةَ، وأمُّها خديجةُ بنتُ خُوَيلِد أحَبُّ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى قلبِه، وصاحِبةُ المواقِفِ المشهُودة المشهُورة.
كانت فاطِمةُ - رضي الله عنها - أصغَرَ بناتِ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأحبَّهنَّ إلى قلبِه؛ لأنَّها صحِبَتْه منذ نُعومةِ أظفارِها ولم تُفارِقه، وشهِدَت الأحداثَ الكُبرَى في حياتِه، ورأَت مِن أحوالِ أبِيها وأمورِه العَجَب، وشارَكَتْه مُعاناتِه وآلامَه وأحزانَه وهمومَ الدعوة.
رمَى المُشرِكُون سَلَا الجَزُور على رأسِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ساجِدٌ عند الكعبَة، فجاءَت فاطِمةُ مُسرِعةٌ وهي صغيرةُ السنِّ، فأزالَت القَذَرَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وفي غَزوة أُحُد أُصِيبَ خدُّ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، وسالَ دمُه بغَزارَة، فجاءَت فاطمةُ - رضي الله عنها - وغسَلَت الدمَ عنه حتى كفَّ.
ومرَّةً أُخرى رمَى المُشرِكُون التُّرابَ على رأسِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فكانت فاطمةُ حاضِرةً، ونظَّفَت رأسَه الشَّريفَ وهي تبكِي، والنبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يُهدِّئُها ويقولُ: «لا تبكِي يا بُنَيَّة؛ فإنَّ الله ناصِرٌ أباكِ».
تعلَّمَت العلمَ مِن فِيِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، حتى صارَت مِن رُواة الحديث، وحديثُها في دواوِين السنَّة، وتخلَّقَت بأخلاق النبُوَّة، وتأدَّبَت بآدابِ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم -، وصارَ الناسُ إذا رأَوها تذكَّرُوا النبيَّ - عليه الصلاة والسلام -، حتى في مِشيَتها ما تُخطِئُ مِشيَتُها مِشيةَ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم -.
تقولُ عائشةُ - رضي الله عنها -: "ما رأيتُ أحدًا أشبَهَ سَمتًا ودَلًّا وهَديًا برسولِ الله في قِيامِها وقُعودِها مِن فاطمة بنت رسولِ الله".
كانت - رضي الله عنها - كريمةً على أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فما رآها قطُّ مُقبِلةً إليه إلا قامَ إليها، واحتَفَى بها، وأجلَسَها بجانِبِه، وقال: «مرحَبًا بابنَتِي».
وكان إذا أقبَلَ مِن سفرٍ، ثم عرَّجَ على ابنتِه فاطمة في بيتِها وسلَّم عليها ودعَا لها، ثم ذهَبَ إلى أزواجِه.
ومِن كرامتِها - رضي الله عنها - على أبِيها: أنَّه ضمَّها وضمَّ عليًّا والحسنَ والحُسَينَ، وألقَى عليهم الكِساءَ، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلُ بَيتِي، فأذهِب عنهم الرِّجسَ وطهِّرهم تطهِيرًا»؛ أخرجه أحمد والترمذي.
وبلَغَت منزلتُها ومكانتُها أن قال فيها النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّما فاطمةُ بَضعةٌ مِنِّي - يعني: قِطعة مِنِّي -، يَرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذِيني ما آذاها»؛ أخرجه الشيخان.
وفي راويةٍ: «يبسُطني ما يبسُطها، ويقبِضُني ما يقبِضُها»؛ أخرجها أحمد والحاكم.
وأبقَى الله سبَبَ ونسَبَ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها وفي ولدَيها الحسنِ والحُسينِ - رضي الله عن الجميع - كما ثبَتَ عند الحاكم والبيهقيِّ -: «كلُّ سبَبٍ ونسَبٍ مُنقطِعٌ يوم القِيامة إلا سبَبِي ونسَبِي».
ومِن كرامتِها - رضي الله عنها - ومنزلتِها: أنَّه نزلَ ملَكٌ مِن السماء لم ينزِل قطُّ، لكي يُبشِّر النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنَّ فاطمة سيِّدةُ نساء الجنَّة، وأنَّ الحسنَ والحُسينَ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّة؛ ولذلك شهِدَ لها أبُوها - صلى الله عليه وآله وسلم - أنَّها مِن خَير النساء، كما في "مُسند أحمد": «خَيرُ نساءِ العالَمين: مريمُ بنتُ عِمران، وخديجةُ بنتُ خُوَيلِد، وفاطِمةُ بنتُ مُحمد، وآسِيةُ امرأةُ فِرعون».
أيها المُسلمون:
لقد وضعَ الله في شخصيَّة فاطمة - رضي الله عنها - مِن الأسبابِ والعوامِلِ ما رفعَها الله به فوقَ نساءِ العالَمين، وجعَلَها قُدوةً عظيمةً للنِّساء في كل زمانٍ ومكانٍ.
وإضافةً إلى ما سبَقَ ذِكرُه مِن جوانِبِ عظمتِها، فقد كانت فاطمةُ - رضي الله عنها - امرأةً عابِدةً قانِتةً صوَّامةً قوَّامةً، قانِعةً باليسير، صابِرةً على حياتِها وشظَف العَيش وشِدَّته، حرِيصةً على طاعةِ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم - واتِّباع سُنَّته، قائِمةً لزوجِها بحقِّه وطاعتِه، لم يُحفَظ عليها - رضي الله عنها - زلَّةٌ أو خطأٌ، عظيمةُ الخوف والمُراقبَة لله، مُتدثِّرةٌ بثَوبِ الحياء والعِفَّة والتصَوُّن، لم يُؤثَر عنها كذِبٌ في الحديثِ، أو إخلافٌ لموعِد، أو تصرُّفٌ مَشِين.
تقولُ عائشةُ - رضي الله عنها -: "ما رأيتُ أحدًا أصدَقَ لهجةً مِن فاطمة، إلا أن يكون الذي ولَدَها".
وكانت - رضي الله تعالى عنها - طيِّبةَ المعشَر، كريمةَ المحتِد، مُحبَّبةً للناسِ كلِّهم، تحتفِظُ بعلاقاتٍ طيبةٍ مع الجميع حتى مع زوجاتِأبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقد كُنَّ يُحبِبنَها، ويُرسِلنَها أحيانًا إلى أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم - لتشفَعَ لهنَّ عنده في بعضِ الأمور.
عباد الله:
ومِن جوانِبِ عظمتِها - رضي الله عنها -: ما سطَّرَه التاريخُ بمِدادٍ مِن نُورٍ في قصةِ زواجِها بعليٍّ - رضي الله عنه -، فهل سمِعتُم بخَبَره؟ وكيف كان؟ وما مهرُها؟ وما جهازُ بيتِها؟
إنَّه حدَثٌ لم يشهَد التاريخُ مثلَه؛ فهو زواجُ سيِّدة نساءِ الجنَّة، ابنةُ سيِّد الأنبِياء - صلى الله عليه وآله وسلم -، وزوجُها هو عليٌّ - رضي الله عنه - رابِعُ الخُلفاء الراشِدين، ومِن أكابِرِ ساداتِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -، لقد كان عُرسُها عُرسًا سهلًا مُيسَّرًا مُتواضِعًا مع كل هذا المجدِ والشَّرَف.
تزوَّجَها عليٌّ - رضي الله عنه - بعد غزوة بدرٍ، ولم يكُن عنده مهرٌ، فأشارَ عليه النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُمهِرَها قيمةَ دِرعِه الحُطميَّة التي غنِمَها في بدرٍ، وبلَغَت قيمتُها في ذلك الوقتِ أربعمائة وثمانِين درهمًا تقريبًا، ثم أولَمَ عليها وليمةً مُبارَكةً على شاةٍ واحدةٍ.
وأما جهازُ بيتِها وأثاثُه، فتقولُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ - رضي الله عنها -: "جهَّزتُ فاطمةَ إلى عليٍّ، فما كان حَشوُ فِراشِهما ووسائِدِهما إلا اللِّيف".
ولقد أولَمَ على فاطمة، فما كانت وليمةٌ في ذلك الزمان أفضلَ مِن وليمتِه.
وقال جعفَرُ بن مُحمدٍ: "دخَلتُ بيتَ عليٍّ، فإذا إهابُ كبشٍ على دكَّةٍ، ووِسادةٌ فيها لِيفٌ، وقِربةٌ، ومُنخُلٌ، ومِنشَفةٌ، وقَدَحٌ".
هذا هو زواجُ فاطمة، وهذا هو بيتُها وأثاثُه، وهي ابنةُ سيِّد الخلقِ - صلى الله عليه وآله وسلم -.
عباد الله:
وبعد زواجِها كانت فاطمةُ - رضي الله عنها - مِثالًا للزوجةِ الرَّاضِيةِ القانِعةِ المُتحبِّبةِ إلى زوجِها، وقد كان يحصُلُ بينَهما ما يحصُلُ بين الزَّوجَين مِن خِلافٍ وتبايُنٍ في وجهاتِ النَّظَر، ولكنَّها - رضي الله عنها - لم تكُن لتتجاوَزَ أدبَها مع زوجِها عليٍّ، ولم يكُن عليٌّ - رضي الله عنه - ليظلِمَها، بل سُرعان ما يتراضَيَا؛ لكرامتِها عليه، ولما بينَهما مِن الحُبِّ الذي تذُوبُ معه كلُّ الخِلافاتِ.
وقد رزَقَها الله مِن عليٍّ: الحسنَ، والحُسينَ، ومُحسِنًا، وأمَّ كُلثُوم، وزينَب. وأمُّ كلثُوم هذه هي التي تزوَّجَها عُمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - بعد ذلك؛ رغبةً مِنه في مُصاهَرة أهل بيتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وقد كانت فاطمةُ - رضي الله عنها - ترعَى شُؤون أولادِها وزوجِها بنفسِها، وتقومُ بأعمالِ بيتِها، حتى أثَّرَ عملُ البيتِ في يدَيها، وتعِبَت مِن ذلك ولاقَت شِدَّةً، فذهَبَت إلى أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم - تطلُبُ مِنه خادِمةً مِن السَّبي تُعينُها على أعمالِ البيتِ، فامتنَعَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام -، وقال: «واللهِ لا أُعطِيكِي وأدَعُ أهلَ الصُّفَّة». وأهلُ الصُّفَّة هم الفُقراء الذين لا مأوَى لهم.
فرجَعَت فاطمةُ - رضي الله عنها - إلى بيتِها، وإذا برسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأتِيها، فوجَدَها مع عليٍّ، فلاطَفَهما، ثم أرشَدَهما إلى أن يُسبِّحَا ويحمَدَا الله ثلاثًا وثلاثين، ويُكبِّرَا أربعًا وثلاثين عند النَّوم؛ فهو خَيرٌ لهما مِن خادِمٍ.
فرضِيَت فاطمةُ - رضي الله عنها -، وأسلَمَت لله ولرسولِه، وحافَظَت على هذا الذِّكر العظيم، فرَزَقَها الله بعد ذلك قوَّةً ونشاطًا وتحمُّلًا وصبرًا، ولم يترُك عليٌّ - رضي الله عنه - هذا الذِّكرَ ولا ليلةَ صِفِّين؛ فلذلك كان مِن أقوَى الرِّجال - رضي الله عنه -، وذلك كلُّه ببركةِ طاعةِ الله ورسولِه، وبركةِ ذِكرِ الله تعالى.
|
والمَجدُ يُشرِقُ مِن ثلاثِ مطالِعٍ |
|
في مهدِ فاطمةٍ فما أعلاها |
|
هي بنتُ مَن، هي زَوجُ مَن، هي أمُّ مَن؟ |
|
مَن ذا يُساوِي في الفَخَارِ أبَاهَا؟ |
|
هي أُسوةٌ للأمَّهاتِ وقُدوةٌ |
|
يترسَّمُ القَمرُ المُنِيرُ خُطاها |
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَنا بما فيه مِن الآياتِ والذِّكر الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائرِ المسلمين من كلِّ ذنبٍ، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي جعلَ في كل زمانٍ بقايا مِن أهل العلمِ والفضلِ والقُدوات، يُحيِي بشمائِلِهم القلوب، ويُجدِّدُ بعلمِهم ما اندَرَسَ مِن أمرِ الدِّين، والصلاةُ والسلامُ على الهادي البشير والسِّراج المُنِير، وعلى آلِه وصحابتِه والتابِعِين.
أما بعد .. يا أيها المُسلمون:
فإنَّ جوانِبَ العظمة والقُدوة في شخصيَّة السيِّدة الجليلة فاطِمة بنتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا ينقَضِي مِنها العجَب، ولا يُقضَى مِنها الأرَب، لكنَّنا نُشِيرُ إلى أنَّ أمرَ وفاةِ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم - كان له أعظمُ الأثَر على قلبِها وروحِها، واهتَزَّ له كيانُها هزَّةً عنيفةً، وهي الصابِرةُ المُحتسِبة، ولكنَّ الأمرَ كان شديدًا عليها، بل وعلى المُسلمين جميعًا.
وتبدأُ هذه القصةُ المُؤلِمةُ مُنذ أن ابتَدَأَ المرضُ الأخيرُ الذي ماتَ فيه النبيُّ الأعظمُ - صلى الله عليه وآله وسلم -، ففقَدَ الكونُ كلُّه هذه الرحمةَ المُهداة، وانقطَعَ خبَرُ السماء ووحيُ الله بموتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وقد ابتدَأَ مرضُ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في مطلَع شهرِ ربيعٍ الأول، في سنة إحدى عشرة مِن الهِجرة النبويَّة، وقد اشتدَّت عليه الحُمَّى وألمُ الرأس مُتأثِّرًا بالأكلَة التي أكلَها في خيبَر مِن الشاةِ المسمُومة التي سمَّتْها له المرأةُ اليهوديَّة؛ حيث قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما زِلتُ أجِدُ ألَمَ الطَّعامِ الذي أكَلتُ بخَيبَر، فهذا أوانُ وجدتُ انقِطاع أبهَري مِن ذلك السُّمِّ»؛ أخرجه البخاري.
وكانت مُدَّةُ مرضِه - صلى الله عليه وآله وسلم - قُرابة عشرة أيامٍ أو أكثر قليلًا، ويشتدُّ عليه الوجَع، ويُغمَى عليه - صلى الله عليه وسلم -، وتدخُلُ عليه ابنتُه فاطمةُ وهو في هذا الكربِ الشديدِ، فيعتصِرُ الحُزنُ قلبَها وتقولُ: "واكَربَ أبتَاه"، فيصحُو مِن إغمائِه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويقولُ: «ليس على أبِيك كَربٌ بعد اليوم».
ثم إنَّه دعاها وأسَرَّ لها أنَّه ميتٌ في هذا المرضِ، فبَكَت - رضي الله عنها - حُزنًا على فِراقِه، ثم أسَرَّ لها بسِرٍّ آخر، وهو: أنَّها أولُ أهلِه لُحوقًا به، فضحِكَت استِبشارًا.
فلما تُوفِّي النبيُّ - عليه الصلاة والسلام -، ودفَنَه الصحابةُ، قالت فاطمةُ لأنسِ بن مالكٍ: "كيف طابَت أنفُسُكم أن تحثُوا التُّرابَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟!".
وبقِيَت فاطمةُ - رضي الله عنها - بعد وفاةِ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم - ستَّة أشهُر، وهي محزُونةٌ مكمُودةٌ، تذُوبُ كما يذُوبُ المِلحُ في الماء مِن هَول هذه الفاجِعة، وذَبُلَت زهرةُ حياتِها، وانطَفَاَت شمعةُ بهجَتها، وتفطَّرَ قلبُها الرَّقيق، ولم يعُدْ فُؤادُها المكلُوم يتحمَّل فِراقَ أبِيها - صلى الله عليه وآله وسلم -، فوافاها الأجَل ليلةَ الثُلاثاء الثالثِ مِن رمضان في السنةِ التي تُوفِّي فيها أبوها - صلى الله عليه وآله وسلم -، وكان عُمرُها يوم تُوفِّيَت تسعًا وعشرين تقريبًا.
وتولَّى غسلَها وتكفينَها وتجيزَها زوجُها عليٌّ - رضي الله عنه -، وأسماءُ بنتُ عُمَيسٍ زوجُ أبي بكرٍ الصدِّيق - رضي الله عنهما -، ودفَنَها عليٌّ ليلًا في البَقِيع.
أيها المُسلمون:
لقد كانت فاطمةُ - رضي الله عنها - رمزًا للحياء والسِّتر والعِفَّة في حياتِها، وحتى عند وفاتِها - رضي الله عنها -، فقد كانت جنائِزُ النِّساء في عهدِها يُلقَى على الواحِدةِ مِنهنَّ ثوبًا، ثم يُصلَّى عليها وتُحمَلُ إلى المقابِر، وقد يصِفُ الثوبُ أعضاءَ جِسمِها، وقد تنكشِف.
فكانت فاطمةُ - رضي الله عنها - مِن حيائِها تكرَهُ ذلك ولا يُعجِبُها، وتتمنَّى شيئًا يستُرُ المرأةَ في جنازتِها، وذكَرَت ذلك لمَن حولَها مِن النِّساء قبل وفاتِها، فاقتَرَحَت عليها أسمءُ بنتُ عُمَيس شيئًا رأَتْه في الحبَشَة، وهي: أن يُجعَلَ على النَّعش شيئًا مُقوَّسًا مِن جَريدِ النَّخل، ويُطرَح عليه الثَّوب، وتُوضَع المرأةُ تحتَه فلا يصِفُ أعضاءَها، ففرِحَت بذلك فاطمةُ - رضي الله عنها - وقالت: "ستَرتِينِي ستَرَكِ الله".
فكانت فاطمةُ - رضي الله عنها - هي أولُ امرأةٍ يُصنَعُ نعشُها على هذه الصِّفة التي نُشاهِدُها اليوم في نَعشِ النساءِ. فما أبرَكَ هذه السيِّدة الجليلة، وما أعظمَ خيرها على الأمة في حياتِها وبعد مماتِها.
أمة الإسلام:
حُقَّ لهذه السيِّدة الجليلة أن تكون أعظمَ قُدوةٍ لنساءِ الأمة، ونِبراسًا يُنيرُ الطريقَ، ومِثالًا فخمًا بديعًا يُحتَذَى ويُقتَدَى في الحياءِ والحِشمة والعفافِ، وما أروَعَ أن تكون سيرتُها وشمائِلُها تُعطِّرُ وتُجمِّلُ مجالِسَ السَّمر، ومُنتدياتِ العلم، وتكون مُقرَّرًا في مناهِجِ التربيةِ والتعليمِ، وبناءِ القُدواتِ.
وإنَّ الواجِبَ علينا أن نعرِفَ لهذه السيِّدة المُبارَكة حقَّها، ونُعظِّمَها، ونتَّخِذها قُدوةً، ولا يجوزُ لنا أبدًا أن نغلُو فيها، ونرفعَها فوقَ منزلتِها، أو أن نخترِعَ لها مِن الفضائِل ما لم يصِحَّ. فكَم قد كذَبَ عليها الكذَّابُون والأفَّاكُون! وكم قد اختَلَقُوا وافتَرَوا عليها وعلى زوجِها عليٍّ وأبنائِه ما هُم مِنه براءٌ، والمنهجُ الحقُّ هو الوسَطُ بين الغُلاة المُفرِطين والجُفاةِ المُقصِّرين.
فرضِيَ الله عن فاطِمة بنت رسولِ الله، وعن أمِّها المُبارَكة خديجة، وصلَّى الله على أبِيها النبيِّ الأعظَم سيِّد ولدِ آدم، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
عباد الله:
صلُّوا وسلِّمُوا على رسولِ الله؛ فقد أمَرَكم بذلك الله؛ حيث قال في مُحكَم تنزيلِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وثبَتَ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليها بها عشرَ صلواتٍ».
فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على نبيِّنا وحبيبِنا وسيِّدنا وقُدوتِنا مُحمدٍ، وعلى آلِه وأزواجِه وذريَّاتِه وصحابَتِه الكرامِ، وخُصَّ مِنهم: أبا بكرٍ الصدِّيق، وعُمرَ الفارُوق، وعُثمانَ ذَا النُّورَين، وعليًّا أبا الحسَنَين، والتابِعِين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك وعبادَك الصالِحين.
اللهم انصُر إخوانَنا المُسلِمين المُستضعَفين في كل مكانٍ، اللهم انصُر إخوانَنا المُسلِمين المُستضعَفين المظلُومين في كل مكانٍ، اللهم انصُر إخوانَنا المُجاهِدين في فلسطين، وفي العراق، وفي اليمَن، وفي كل مكان.
اللهم انصُر إخوانَنا المُجاهِدين المُرابِطِين على الحدود، اللهم كُن لهم عونًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظهيرًا بقُوَّتِك يا قويُّ يا عزيز.
اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّقه ونائِبَه لِمَا فيه صلاحُ البلادِ والعبادِ، واجعَلهم مفاتِيحَ للخَير، مغالِيقَ للشرِّ برحمتِك يا أرحمَ الراحمين.
اللهم اغفِر لنا ولوالِدِينا، ولِلمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتِك يا أرحمَ الراحمين.
اللهم ارفَعنا ولا تضَعنا، وأكرِمنا ولا تُهِنَّا، وكُن معنا ولا تكُن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا برحمتِك يا أرحمَ الراحمين.
وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا مُحمدٍ، وآلِهِ وصحبِه أجمعين.
خطب الحرمين الشريفين

مُحاسبة النَّفس
ألقى فضيلة الشيخ علي بن
عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "مُحاسبة
النَّفس"، والتي تحدَّث فيها عن محاسَبَة النفسِ ووجوبِ محاسَبَةِ ما يخطُرُ
بالقلبِ مِن خطَرَاتٍ، وما يلفِظُ به اللسانُ مِن كلماتٍ؛ فبِهذا فلاحُ العبدِ في
الدنيا، ونجاتُه مِن العذابِ في الآخرة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِّئات، وسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، ضاعَفَ بفضلِه الحسنات، ورفعَ لأصحابِها الدرجات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يُعجِزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماوات، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه أيَّده الله بنصرِه وبالمُعجِزات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه السابِقين إلى الخيرات.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله تعالى بالتقرُّب إليه بما يُرضِيه، والابتِعادِ عما يُغضِبُه ويُؤذِيه؛ فقد أفلَحَ وفازَ من اتَّقَى، وخابَ وخسِرَ من اتَّبعَ الهوَى.
عباد الله:
اعلَمُوا أن فلاحَ الإنسان وسعادتَه في التحكُّم في نفسِه، ومُحاسبتها ومُراقبتها في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ، في الأقوال والأفعال؛ فمن حاسَبَ نفسَه وتحكَّم في أقواله وأفعاله وخطَرَاته بما يحبُّ الله ويرضَى فقد فازَ فوزًا عظيمًا.
قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41]، وقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: 201]، وقال تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة: 2].
قال المُفسِّرون: "أقسمَ الله بالنفس التي تلومُ على التقصيرِ في الواجِبات، وتلومُ على اقتِرافِ بعضِ المُحرَّمات، فتلومُ كثيرًا؛ حتى يستقيمَ أمرُها".
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يُؤمنُ بالله واليوم الآخر، فليقُل خيرًا أو ليصمُت»؛ رواه البخاري ومسلم.
وهذا لا يكونُ إلا بمُحاسَبَة النفس.
وعن شدَّاد بن أوسٍ - رضي الله تعالى عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الكيِّسُ مَن دانَ نفسَه وعمِلَ لما بعد الموت، والعاجِزُ مَن أتبَعَ نفسَه هواها وتمنَّى على الله»؛ حديثٌ حسنٌ.
وقال عُمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "حاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبُوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنوا، وتأهَّبُوا للعرضِ الأكبر".
وقال ميمونُ بن مِهران: "المُتَّقِي أشدُّ مُحاسبةً لنفسِه مِنَ الشريكِ الشَّحيحِ لشرِيكِه".
وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: "إنَّ المؤمنَ يرَى ذنوبَه كأنه في أصلِ جبلٍ يخافُ أن يقَعَ عليه، وإنَّ الفاجِرَ يرَى ذنوبَه كذُبابٍ طارَ على أنفِه فقال به هكذا - أي: أطارَه بكفِّه -"؛ رواه البخاري.
والمؤمنُ يُحاسِبُ نفسَه ويُراقِبُها ويُقيمُها على أحسَنِ الأحوال؛ فيُحاسِبُ نفسَه على الأفعال، فيُجاهِدُها في العباداتِ والطاعاتِ ليأتيَ بها كاملةَ الإخلاصِ، نقيَّةً سليمةً من شوائِبِ الابتِداعِ والرياءِ، والعُجْب بالعمل، مُبتغِيًا بعملِه وجهَ الله والدارَ الآخرة.
ويُحاسِبُ نفسَه ليُوقِعَ العملَ الصالِحَ، ويفعلَه مُوافِقًا لسُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع الالتِزامِ بدوام العمل، واستِمراره بلا انقِطاع.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: 6]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: 2، 3]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31].
وعن سُفيان الثوريِّ قال: "ما عالَجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من نيَّتي؛ لأنها تتقلَّبُ علَيَّ".
وقال الفضلُ بن زياد: سألتُ الإمامَ أحمد عن النيَّة في العمل، قلتُ: كيف النيَّة؟ قال:"يُعالِجُ نفسَه إذا أرادَ عملًا لا يُريد به الناس".
وعن شدَّاد بن أوسٍ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن صلَّى يُرائِي فقد أشرَكَ، ومَن صامَ يُرائِي فقد أشرَكَ، ومَن تصدَّقَ يُرائِي فقد أشرَكَ»؛ رواه أحمد في "المسند"، والحاكم، والطبراني في "الكبير".
ويُحاسِبُ نفسَه في نُطقِه وكلامِه، فلا يُطلِقُ لِسانَه في الكلام بالباطِل والمُحرَّم من الألفاظِ، وليتذكَّر أنه قد وُكِّل به ملَكَان يكتُبانِ كلَّ ما نطَقَ به لِسانُه، وكلَّ ما عمِلَ من عملٍ، فيُثابُ على ذلك أو يُعاقَبُ، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: 10- 12]، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18].
عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: "يكتُبُ كلَّ ما تكلَّم به من خيرٍ وشرٍّ، حتى إنه ليكتُبُ قولَه: أكَلتُ، شرِبتُ، ذهَبتُ، جِئتُ، رأَيتُ".
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الرجُلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن رِضوان لا يُلقِي لها بالًا يرفعُه الله بها درجات، وإن العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن سخَط الله لا يُلقِي لها بالًا يهوِي بها في جهنَّم»؛ رواه البخاري.
وقال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "والله الذي لا إله إلا هو؛ ما على الأرض أحقُّ بطُولِ سجنٍ من اللِّسان".
وكان أبو بكرٍ - رضي الله عنه - يأخُذُ بلِسانِه ويقول: "هذا الذي أورَدَني الموارِد".
كما يجبُ على المُسلم أيضًا أن يُحاسِبَ نفسَه ويُجاهِدَها في الخطَرَات والوارِدات على القلب، والوساوِس؛ فإن مبدأَ الخير والشرِّ من خطَرَات القلوب ووارِداتها، فإن تحكَّم المُسلمُ في الوارِدات على قلبِه، ففرِحَ بوارِدات الخير، واطمأنَّ لها ونفَّذَها، أفلحَ وفازَ، وإن طرَدَ وساوِسَ الشيطان ووارِداته، واستعاذَ بالله من وساوِسه، نجا وسلِم من المُنكرات والمعاصِي.
وإن غفِلَ عن وساوِسه وتقبَّلَها أوردَه الشيطانُ المُحرَّمات، قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: 36].
وأمَرَ الله بالاستِعاذة في سُورة الناس من هذا العدوِّ المُبين. قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "إنَّ الشيطانَ جاثِمٌ على قلبِ ابنِ آدم، فإذا سَهَا وغفِلَ وسوَسَ، وإذا ذكرَ اللهَ خنَس".
وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الشيطانَ واضِعٌ خَطْمَه على قلبِ ابنِ آدم، فإن ذكرَ اللهَ خنَس، وإن نسِيَ التَقَمَ قلبَه، فذلك الوسواس الخنَّاس»؛ رواه أبو يعلَى الموصِلي.
فالحِفظُ من الذنوبِ برصدِ وساوِس الشيطان أولًا، والاحتِراسِ مِن نزَغَاته، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].
وعدمُ القُربِ مِنها بمُحاسبةِ النَّفسِ عند أول أسبابِها؛ فمَن حاسَبَ نفسَه وجاهَدَها كثُرَت حسناتُه، وقلَّت سيئاتُه، وخرَجَ مِن الدنيا حمِيدًا، وبُعِثَ سعِيدًا، وكان مع النبي - عليه الصلاة والسلام - الذي أرسَلَه الله شهِيدًا، ومَن اتَّبعَ هواه، وأعرضَ عن القرآن، وارتكَبَ ما تشتَهِيه نفسُه، واستلَذَّ الشهوات، وقارَفَ الكبائِرَ، وأعطَى الشيطانَ قِيادَه أوردَه كلَّ إثمٍ عظيمٍ، وخُلِّدَ معه في العذابِ الأليم.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: 28].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، ونفعَنا بهدي سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقولُ قَولي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم وللمُسلمين، فاستغفِروه.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي يُحيِي بالقُرآن القلوب، ويقبَلُ الحسناتِ ويعفُو عن السيِّئات، أحمدُ ربي وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له علَّامُ الغيوب، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى الخيرات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه أعلام الهُدى ومصابِيحِ الدُّجَى.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله تعالى حقَّ التقوَى؛ فهي المُدَّخَرُ في الدنيا والأُخرى.
عباد الله:
إنَّ القلبَ الحيَّ هو الذي تسُرُّه حسنتُه، وتسوؤُه سيِّئتُه، والقلبُ الميِّتُ هو الذي لا يتألَّمُ بالمعصِية، ولا يُحِسُّ بها، ولا يفرَحُ بحسنةٍ ولا طاعةٍ، ولا يشعُرُ بالعُقوباتِ على الذنوبِ، فتغُرُّه الصحةُ وإقبالُ الدنيا عليه، وقد يظُنُّ النِّعمَ كرامةً له، قال الله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: 55، 56].
وفي الحديثِ: «تُعرضُ الفتنُ على القلوبِ كما يُعرضُ الحصيرُ عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أنكرَها نُكِتَت فيه نُكتةٌ بيضاء، وأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَت فيه نُكتَةٌ سوداء، حتى تصيرَ القلوبُ على قلبَين: قلبٍ أبيض كالصَّفا، لا تضُرُّه فتنةٌ ما دامَت السماواتُ والأرضُ، وقلبٍ أسود مِربَادّ كالكُوزِ مُجخِّيًا - أي: منكُوسًا - لا يعرِفُ معروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا إلا ما أُشرِبَ من هواه».
وأمراضُ القلوبِ كلُّها تُمرِضُ القلب أو تُميتُه بالكلية إذا لم يُحاسِبِ المرءُ نفسَه.
ومن الحَزمِ والخيرِ للمرءِ أن يُحاسِبَ نفسَه في اليوم والليلة والجُمعة والشهر والسنة؛ ليعلَم مِن حيث أُتِي، ويتوبَ ويستدرِكَ ما فرَطَ منه، عسَى أن يُحمَدَ سعيُه، ويُوفَّقَ لحُسن الخاتِمة.
والمُؤمنُ حيُّ القلب، نافِذُ البصيرة، إن أُعطِيَ شكَر، وإن أذنَبَ استغفَر، وإن ابتُلِيَ صبَر؛ ففي قلبِ المُؤمن واعِظٌ يُوقِظُه من الغفلة، ويُحذِّرُه من المَهلَكَة.
وفي الحديث: "خطَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خطًّا مُستقيمًا، بجانبَيه خطوطٌ، وعلى رأسِه داعٍ وفوقَه واعِظ، فالخطُّ المُستقيمُ: صراطُ الله، والداعِي على رأسِه: كتابُ الله، والذي يعِظُ فوقَه: واعِظُ الله في قلبِ كلِّ مُؤمنٍ، والخُطوطُ عن يَمينِه وشِمالِه: طُرقُ الضلال".
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى علَيَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين المهديِّين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين، وعن التابِعِين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحَمَ الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافرين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين يا رب العالمين.
اللهم أحسِن عاقِبَتنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوبين مِن المُسلمين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين مِن المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفِر لنا ذنوبَنا ما علِمنا مِنها وما لم نعلَم برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم فقِّهنا والمُسلمين في دينِك يا أرحم الراحمين، يا عليمُ يا حكيم.
اللهم أحسِن عاقِبَتنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا ومِن عذابِ الآخرة يا رب العالمين.
اللهم تولَّ أمرَ كلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ، وتولَّ أمرَ كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ.
اللهم إنا نسألُك أن تُؤمِّن خوفَ المُسلمين، اللهم ارفَع ما بهم مِن الشدائِد والكُرُبات، وما نزل بهم مِن المصائِبِ يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألُك أن تُصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان، اللهم ثبِّت قلوبَنا على طاعتِك، واغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلمُ به منَّا، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح اللهم ولاةَ أمورِنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّق عبدَك خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، وأعِنه على كلِّ خيرٍ يا رب العالمين، اللهم وارزُقه الصحةَ والعافِيةَ إنك على كل شيء قدير، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لما تحبُّ وترضَى، ولِما فيه الخيرُ يا رب العالمين، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعَلهما مِن الهُداة المُهتَدين يا أرحم الراحمين.
احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكروه، اللهم احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكروه، اللهم احفَظ جنودَنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألُك أن تُعيذَ المُسلمين مِن البِدع ما ظهر منها وما بطَن برحمتِك يا أرحم الراحمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا الله العظيمَ الجليلَ يذكُركم، واشكُروه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

وسائل
تعظيمِ الله تعالى
ألقى فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "وسائل تعظيمِ الله تعالى"، والتي تحدَّث فيها عن تعظيمِ الله - جلَّ وعلا -، ووسائلِ تعظيمِ الله تعالى واستِشعار هذه العظمةِ.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الكبير المُتعال، ذي العظمة والجلال، يسجُدُ له مَن في السماوات والأرض طَوعًا وكَرهًا وظِلالُهم بالغُدُوِّ والآصال، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له لا نِدَّ له ولا مِثال، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه عظيمُ الأخلاق وطيِّبُ الخِصال، وخَيرُ مَن تقرَّبَ إلى الله بالإعظام والإجلال، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى أصحابِه والآل، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ما تجدَّدَت البُكُور والآصال.
أما بعدُ .. معاشِرَ المؤمنين:
اتَّقُوا اللهَ حقَّ التقوَى، واشكُرُوه على نعمِه التي لا تُعدُّ ولا تُحصَى، وتذكَّرُوا قولَ الحقِّ - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أمةَ الإسلام:
إنَّ تعظيمَ الله - جلَّ جلالُه، وتقدَّسَت أسماؤُه - أصلٌ في تحقيق العبوديَّة؛ فالإيمانُ بالله مبنيٌّ على التعظيم والإجلال، فلا يصِحُّ الإيمان، ولا يستقيمُ الدِّين إلا إذا مُلِئَ القلبُ بتعظيمِ ربِّ العالمين، وكلَّما ازدادَ المرءُ بالله علمًا ازدادَ له تعظيمًا وإجلالًا.
فهذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخبِرُ عن حالِ الرُّوح الأمِين جبريل - عليه السلام - عند ربِّه، فيقول: «مرَرتُ ليلةَ أُسرِيَ بِي بالملأ الأعلَى، وجِبريلُ كالحِلسِ البالِي مِن خشيَةِ الله» - يعنِي: كالثَّوبِ البالِي -؛ خشيةً وتعظيمًا وإجلالًا لله تعالى.
وأما الملائكةُ الكرامُ فكانُوا إذا تكلَّم - سبحانه - بالوحيِ، أرعَدُوا مِن الهَيبَةِ حتى يلحَقَهم مثلُ الغَشيِ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: 23].
وأخبَرَ - صلى الله عليه وسلم - مِن تعظيمِ الملائكةِ لخالِقِها أنَّه «ما في السماوات السَّبع موضِعُ أربعةِ أصابِع إلا ومَلَكٌ واضِعٌ جبهَتَه ساجِدًا لله تعالى».
وأما رُسُلُ الله وأنبياؤُه - عليهم السلام -، فإنَّهم لما عرَفُوا اللهَ حقَّ معرفتِه عظَّمُوه حقَّ تعظيمِه، ودعَوا أقوامَهم إلى خشيَتِه، والخوفِ مِن عذابِه ونِقمتِه، فقال نوحٌ - عليه السلام - لقومِه: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: 13، 14] أي: ما لكم لا تُعظِّمُونَه حقَّ تعظيمِه، وقد خلَقَكم أطوارًا، ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: 15، 16].
وفي "صحيح مسلم": قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَطوِي الله - عزَّ وجل - السماواتِ يوم القِيامة، ثم يأخُذُهنَّ بيدِه اليُمنَى، ثم يقولُ: أنا المَلِك .. أين الجبَّارُون؟! أين المُتكبِّرُون؟! ثم يَطوِي الأرضِين بشِمالِه، ثم يقولُ: أنا المَلِك .. أين الجبَّارُون؟ أين المُتكبِّرُون؟!».
﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104].
وفي "الصحيحين": جاء حَبرٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا مُحمد! إنَّ الله تعالى يُمسِكُ السماوات يوم القِيامة على إصبَع، والأرَضين على إصبَع، والجِبالَ والشجرَ على إصبَع، والماءَ والثَّرَى على إصبَع، وسائِرَ الخلقِ على إصبَع، ثم يهُزُّهنُّ فيقولُ: أنا المَلِك، أنا المَلِك. فضحِكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ تعجُّبًا مما قالَ الحَبْر، تصديقًا له، ثم قرأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67].
إنَّه الله ذُو الجلال والإكرام، ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]، يغفِرُ ذنبًا، ويكشِفُ كربًا، ويُغنِي فقيرًا، ويهدِي ضالًّا، ويشفِي مريضًا، ويُعافِي مُبتلًى، ويقبَلُ تائبًا، وينصُرُ مظلُومًا، ويُقيلُ عثْرَة، ويستُرُ عَورَة، ويُؤمِّنُ رَوعَة، يخفِضُ القسطَ ويرفَعُه، يُرفعُ إليه عملُ الليل قبل عمل النَّهار، وعملُ النَّهار قبل عمل الليل، حِجابُه النُّور لو كشَفَه لأحرقَت سُبُحات وجهِه ما انتهَى إليه بصَرُه مِن خلقِه، يمينُه ملأَى لا تُغيضُها نفَقَة، سحَّاء الليل والنَّهار، أرأيتُم ما أنفَقَ مُنذ خلَقَ الخلقَ؛ فإنَّه لم يغِض ما في يَمينِه.
وفي الحديثِ القُدسيِّ: يقولُ الربُّ - جلَّ جلالُه -: «يا عبادِي! لو أنَّ أوَّلَكم وآخرَكم، وإنسَكم وجنَّكم قامُوا في صَعيدٍ واحدٍ فسألُونِي، فأعطَيتُ كلَّ إنسانٍ مسألتَه، ما نقَصَ ذلك مما عندِي إلا كما ينقُصُ المِخيَطُ إذا أُدخِلَ البحر»؛ رواه مسلم.
إنَّه الله ذُو الجلال والإكرام، مُستوٍ على عرشِه، يُكلِّمُ ملائكتَه، ويُدبِّرُ أمرَ عبادِه، ويسمَعُ أصواتَ خلقِه، ويرَى أفعالَهم وحركاتِهم، ويُشاهِدُ بواطنَهم كما يُشاهِدُ ظواهِرَهم، يُعِزُّ مِن خلقِه مَن يشاءُ، ويُذِلُّ مَن يشاء، بيدِه الخَيرُ، وهو على كل شيءٍ قدير، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].
إنَّه الله ذُو الجلال والإكرام، عظيمٌ في ربوبيَّته، عظيمٌ في ألوهيَّته، عظيمٌ في أسمائِه وصِفاتِه، عظيمٌ في مُلكِه وخلقِه، عظيمٌ في حِكمتِه ورحمتِه، عظيمٌ في تدبيرِه شُؤون خلقِه، عظيمٌ في الفصلِ بين عبادِه، وكلُّ عظمةٍ في الوجود فهي دليلٌ على عظمةِ خالِقِها ومُدبِّرِها.
قال أبو القاسِم الأصبهانيُّ: "العظمةُ صِفةٌ مِن صِفاتِ الله لا يقومُ لها خلقٌ، والله تعالى خلقَ بين الخلق عظمةً، يُعظِّمُ بها بعضُهم بعضًا؛ فمِن النَّاسِ مَن يُعظَّمُ لمالٍ، ومِنهم مَن يُعظَّمُ لفضلٍ، ومِنهم مَن يُعظَّمُ لعلمٍ، ومِنهم مَن يُعظَّمُ لسُلطان، ومِنهم مَن يُعظَّمُ لجاهٍ، وكلُّ واحدٍ مِن الخلق إنَّما يُعظَّمُ لمعنًى دُون معنًى، والله - عزَّ وجل - يُعظَّمُ في الأحوالِ كلِّها، فينبغي لمَن عرَفَ حقَّ عظمة الله ألا يتكلَّم بكلمةٍ يكرَهُها الله، ولا يرتكِبَ معصيةً لا يرضاها الله؛ إذ هو القائِمُ على كل نفسٍ بما كسَبَت". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
إخوة الإيمان:
مهما اجتهَدَ الخلقُ في تعظيمِ الله تعالى، فإنَّهم عاجِزُون عن تعظيمِه كما ينبغي لجلالِه، فحقُّه - عزَّ وجل - أعظم، وقَدرُه أكبر، ولكنَّ المُؤمن يبذُلُ في ذل وُسعَه، والعظيمُ - سبحانه - لا يُخيِّبُ سعيَه، ولا يُضيِّعُ عملَه، ويَجزِيه على قليلِ العمل أعظمَ الجزاء وأوفاه.
وإنَّ مِن أعظم ما يُعينُ العبدَ على استِشعار عظمةِ خالِقِه: التأمُّل في عظيمِ أسمائِه وجليلِ صِفاتِه، والتفكُّر في آياتِه ومخلُوقاتِه الدالَّة على عظمةِ خالِقِها، وكمال مُبدِعِها، ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54].
بارَك الله لي ولكم في القرآنِ والسنَّة، ونفعَنا وإيَّاكُم بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه؛ إنه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يَلِيقُ بجلالِ ربِّنا وعظمتِه وكمالِه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ، وعلى مَن سارَ على نهجِه ومِنوالِه.
أما بعدُ .. معاشِر المُؤمنين:
إنَّ مَن عظَّم اللهَ تعالى وقَفَ عند حُدودِه، ولم يتجرَّأ على مُخالفتِه؛ فإنَّ عظمةَ الله تعالى تقتَضِي تعظيمَ حُرُماتِه، والاستِسلامَ لأمرِه ونهيِه، والتسليمَ لشريعتِه، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
والشعائِرُ جمع شَعِيرة، وهي: كلُّ ما أمَرَ الله به مِن أمورِ دينِه، ومِن أعظم هذه الشَّعائِر ما خصَّه الله تعالى في كتابِه، وعلى لِسانِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -؛ مِن تعظيمِ الشَّهر الحرام، والبلَد الحرام، وما يتعلَّقُ بذلك مِن مناسِك وشعائِر الحجِّ والعُمرة، مِن طوافٍ، وسعيٍ، ووقوفٍ، ومبيتٍ، ورميٍ، ويُجلِّلُ ذلك كلَّه شِعارُ التوحيدِ ودِثارُه: "لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلك، لا شريكَ لك".
أمة الإسلام:
لقد خصَّ الله تعالى مكَّة مِن بين سائر البلاد فحرَّمَها يومَ خلقَ الأرضَ والسماوات، وأضافَها - سبحانه - إليه؛ تعظيمًا لشأنِها، وإجلالًا لمكانتِها، وتوعَّدَ مَن نوَى الإخلالَ بأمنِ حرَمِه وهمَّ بالمعصِيةِ فيه أن يُذيقَه العذابَ الأليمَ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25]، فكيف بمَن تلبَّسَ بجُرمِه؟! فإنَّ أمرَه أعظم، ووعِيدَه أشدُّ، وهو - والعياذُ بالله - مِن أبغَضِ النَّاسِ إلى الله تعالى.
ففي "صحيح البخاري": أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثلاثةٌ ..»، وذكَرَ مِنهم: «.. مُلحِدٌ في الحَرَم».
أي: ظالِمٌ مائِلٌ عن الحقِّ والعدلِ بارتِكابِ الذنوبِ والمعاصِي في الحَرَم.
فيا أمة مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -! لا تزالُ هذه الأمة بخَيرٍ ما عظَّمُوا حُرمةَ مكَّة، وما عظَّمُوا الكعبةَ.
ففي "مسند الإمام أحمد": قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزالُ هذه الأمةُ بخَيرٍ ما عظَّمُوا هذه الحُرمةَ حقَّ تعظيمِها، فإذا ترَكُوها وضيَّعُوها هلَكُوا».
وإنَّ مِن تعظيمِ هذه الشَّعِيرة العظيمة: استِشعارَ هيبَة المشاعِر بتوحيدِ الله وطاعتِه، والتحلِّي بالرِّفقِ واللِّين والسَّكينة، والتِزامِ التعليمات والأنظِمة، والبُعد عن الفُسُوق والجِدال والخِصام، فلا مجالَ في هذه المشاعِر المُقدَّسة للشِّعارات الطائفيَّة أو السياسيَّة، وإنَّما جُعِلَت هذه الشَّعائِر للإكثارِ مِن ذِكرِ الله تعالى، واستِغفارِه ودُعائِه، ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 198- 200].
حُجَّاج بيت الله الحرام:
إنَّ مِن نعمةِ الله تعالى على عبادِه المُؤمنين أن سخَّر لبيتِه مَن يقومُون على خدمتِه، والعنايةِ به ورِعايتِه؛ فشرَّفَ الله بلادَ الحرمَين المملكةَ العربيةَ السعوديةَ، فقامَت بذلك خَيرَ قِيامٍ، وبذَلَت وُسعَها، وسخَّرَت أجهزتَها وإمكاناتها، وهيَّأَت أسبابَ التسهيلِ والرَّاحة، والأمن والسلامة.
فجزَى الله خيرًا خادمَ الحرمَين الشريفَين ووليَّ عهدِه الأمين على ما يُولِيانِه مِن عنايةٍ خاصَّةٍ، ورِعايةٍ للحُجَّاج والمُعتمِرين والزَّائِرين.
أدامَ الله أمنَ هذه البلاد وأمانَها، وعِزَّها ورخاءَها.
ثم اعلَمُوا معاشِر المُؤمنين أنَّ الله أمرَكم بأمرٍ كريمٍ، ابتدَأ فيه بنفسِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجُودِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، واحمِ حَوزةَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتِك نستَغيثُ، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلنا إلى أنفُسنا طرفةَ عينٍ.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوبين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ برحمتِك وفضلِك يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق إمامَنا بتوفيقِك، وأيِّده بتأيِيدِك، اللهم هيِّئ له البِطانةَ الصالحةَ الطيبةَ المُبارَكةَ التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى برحمتِك يا أرحَم الراحِمين، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لتحكيمِ شرعِك واتِّباع سُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً على عبادِك المُؤمنين.
اللهم ثقِّل بالحسنات موازِينَ كلِّ مَن خدَمَ حُجَّاجَ بيتِك الحرام، اللهم ثقِّل بالحسنات موازِينَ كلِّ مَن خدَمَ حُجَّاجَ بيتِك الحرام برحمتِك يا رب العالمين، وبارِك له في عملِه، وارضَ عنه يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ويسِّر أمورَنا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا.
اللهم وفِّق حُجَّاجَ بيتِك الحرام، اللهم وفِّق حُجَّاجَ بيتِك الحرام، وتقبَّل مِنهم حجَّهم وسائرَ أعمالِهم، اللهم رُدَّهم إلى أهلِيهم سالِمِين غانِمين برحمتِك وفضلِك وجُودِك يا أرحم الراحمين.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على حُدودِ بلادِنا، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا قويُّ يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام.
سُبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

فضل الحجِّ
وأيام العشر
ألقى فضيلة الشيخ عبد
المحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضل الحجِّ وأيام
العشر"، والتي تحدَّث فيها عن فضلِ قصدِ بيتِ الله الحرام للحجِّ والعُمرة،
وأنَّ ذلك مِن أفضل الأعمال الصالِحة، مُعدِّدًا أبرز فضائل هذه الشعيرة
المُبارَكة، ثم عرَّج على ذِكر مكانة أيام العشر من ذي الحجَّة وفضلِ العمل
الصالِح فيها.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقوا الله - عباد الله - حقَّ التقوَى، وراقِبُوه في السرِّ والنَّجوَى.
أيُّها المسلمون:
مواسِمُ الخيرات تتجدَّدُ على العباد فضلًا مِن الله وكرمًا؛ فما إن تنقَضِي شعيرةٌ إلا وتَلِيها عبادةٌ أُخرى، وها هي طلائِعُ الحُجَّاج قد أمَّت بيتَ الله العتيق، مُلبِّين دعوةَ إبراهيم الخليلِ - عليه السلام - بأمرِ الله له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27].
قصدُ البيت فرضٌ وقُربةٌ؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «أيها النَّاس! قد فرَضَ الله عليكُم الحجَّ، فحُجُّوا»؛ رواه مسلم.
الحجُّ عبادةٌ في الإسلام عظيمةٌ؛ فهو أحدُ أركان الإسلام، ومِن أجَلِّ الطاعاتِ وأحبِّها إلى الله.
سُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجِهادُ في سبيلِ الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌّ مبرُورٌ»؛ متفق عليه.
بِهِ محوُ أدرانِ الذنوبِ والخطايا؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «الحجُّ يهدِمُ ما كان قبلَه»؛ رواه مسلم.
وهو طُهرةٌ لأهلِه ونقاء؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حجَّ فلم يرفُث ولم يفسُق رجَعَ كيوم ولَدَتْه أمُّه»؛ متفق عليه.
بالحُجَّاج يُباهِي اللهُ ملائكتَه؛ قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ما مِن يومٍ أكثر مِن أن يُعتِقَ الله فيه عبدًا مِن النار مِن يومِ عرفة، وإنَّه ليدنُو ثم يُباهِي بهم الملائكةَ فيقُولُ: ما أرادَ هؤلاء؟»؛ رواه مسلم.
وليس للمُخلِصِ في حجِّه جزاءٌ إلا الجنَّة؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «العُمرةُ إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة»؛ متفق عليه.
الحجُّ مجمَعُ الإسلام الأعظَم، يربِطُ حاضِرَ المُسلمين بماضِيهم؛ ليعيشَ العِبادُ أمةً واحدةً مُستمسِكين بدينِهم، ولا طريقَ لذلك إلا بالاعتِصامِ بالكتابِ والسنَّة، والسَّير على منهَج سلَف الأمة.
في الحجِّ تتلاشَى فواصِلُ الأجناسِ واللغات والألوان، ويبقَى ميزانُ التفاضُل هو التقوى؛ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13].
وخَيرُ زادٍ يصحَبُه الحُجَّاجُ في نُسُكهم هو التقوَى؛ قال - سبحانه -: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
ومَن أمَّ البيتَ فحرِيٌّ به أن يلزَمَ ورَعًا يحجِزُه عن المعاصِي، وحِلمًا يكُفُّه عن الغضبِ، وحُسنَ عِشرةٍ لمَن يصحَب.
وأعظمُ ما يتقرَّبُ به العبادُ في حجِّهم: إظهارُ التوحيد في مناسِكِهم، وإخلاصُ الأعمال لله في قُرُباتهم؛ قال - سبحانه -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وإعلانُ وحدانيَّة الله في الحجِّ شِعارُ أهلِه، وبه شَرَفُهم: «لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والمُلك، لا شريكَ لك».
ومَن حجَّ مُوقِنًا بلِقاءِ ربِّه فليتمسَّك بتوحيدِ الله وإفرادِه بالعبادةِ حتى الممات؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110].
وتكبيرُ الله وتعظيمُه أنيسُ الحُجَّاج في طوافِهم وسعيِهم ورميِهم ونحرِهم، وفي ليلِهم ونهارِهم؛ لتبقَى القلوبُ مُتعلِّقةً بالله، نقيَّةً عن كل ما سِواه.
الحجُّ درسٌ في تحقيقِ الاتِّباع والتأسِّي بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا نُسُك ولا عبادةَ إلا بما وافَقَ هَديَه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «لتأخُذُوا مناسِكَكم؛ فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعد حجَّتِي هذه»؛ رواه مسلم.
والاتِّباعُ دليلُ الصدقِ والإيمانِ والمحبَّة؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31].
وكلُّ عبادٍ على خلافِ هَديِه - عليه الصلاة والسلام - فإنَّ الله لا يقبَلُها.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن عمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا هذا فهو ردٌّ»؛ رواه مسلم.
ومِن مقاصِدِ الحجِّ العُظمى: إقامةُ ذِكرِ الله والإكثارُ مِنه.
قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: "إنَّما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ، وبين الصفا والمروة، ورميُ الجِمار لإقامةِ ذِكرِ الله".
فذِكرُ الله تعالى يُصاحِبُ الحُجَّاجَ كلَّما أقامُوا أو ارتَحَلُوا، وإذا هبَطُوا أو صعِدُوا، ولا يزالُ مُرافِقًا لهم حتى انقِضاء نُسُكهم؛ قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]، وأفضلُ الحُجَّاج أكثرُهم لله ذِكرًا.
الحجُّ طاعةٌ يصحَبُها طاعات، ملِيءٌ بالمنافِعِ والعِبَر والآيات؛ ففيه إخلاصُ القلبِ لله تعالى، وتسليمُ النفسِ له عبوديَّةً ورِقًّا.
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "الحجُّ مبناهُ على الذُّلِّ والخُضوعِ لله، ولهذا اختصَّ باسمِ النُّسُك".
وفي الحجِّ يأتلِفُ المُسلمون، وتَقوَى أواصِرُ المحبَّة بينَهم، فيظهرُ للخلق عظمةُ الإسلام وفضلُه؛ قال - سبحانه -: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: 63].
وفي اجتِماع الحُجَّاج في موقِفٍ واحدٍ إعلامٌ وتذكيرٌ بفضلِ هذه الأمة وعلوِّ شأنِها، وزِينةُ الحُجَّاج إظهارُ جمالِ أخلاقِهم، وبِهِ ينالُون أعالِيَ الدرجات؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].
وفيه توطِينُ النَّفسِ على الصَّبر.
قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: نرَى الجِهادَ أفضلَ العمل، أفلا نُجاهِد؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا، لكُنَّ أفضلُ الجِهاد حجٌّ مبرُورٌ»؛ رواه البخاري.
والمُسلمُ يعتزُّ بدينِه، وينأَى بنفسِه عن أفعالِ الجاهليَّة وسُلُوكِهم، وفي الحجِّ تأكيدٌ على ذلك تِلوَ تأكيد.
قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "استقرَّت الشريعةُ على قصدِ مُخالفةِ المُشركين، لاسيَّما في المناسِكِ".
وكلُّ ساعةٍ في العُمر إن لم تُقرِّب المرءَ مِن ربِّه أبعَدَتْه، والعبادُ في سعيٍ حثيثٍ إلى الله، ويتجلَّى للمرءِ ذلك في شعائِرِ الحجِّ ومناسِكِه، إن فرَغَ مِن عبادةٍ نصَبَ إلى أُخرى؛ قال - سبحانه -: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ [الشرح: 7].
وهذا نهجُ المُسلم إلى الممات؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99].
والطاعةُ تزيدُ صاحِبَها افتِقارًا لربِّه وإخباتًا، فيشهَدُ فضلَ الله عليه بها، ويستغفِرُه على التقصيرِ فيها؛ قال - سبحانه -: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199].
ومَن كفَّ نفسَه عن المحظُورات في حجِّه، حرِيٌّ به أن يكُفَّها عن المعاصِي في كل زمانٍ ومكانٍ.
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
فثمرةُ الحجِّ إصلاحُ النَّفس وتزكيتُها، والظَّفرُ برِضا الله تعالى، والفوزُ بجنَّات النعيم، ويتحقَّقُ ذلك للحاجِّ إن أدَّى حجَّه بنيَّةٍ صالِحةٍ خالِصةٍ، وعلى علمٍ وبصيرةٍ، ومِن نفقةٍ طيبةٍ، وملأَ قلبَه ولِسانَه بذِكرِ الله، ولازَمَ في حجِّه الإحسانَ إلى الخلقِ ونفعَهم مع حُسن الخُلق معهم.
ومَن أحسَنَ في حجِّه، وابتَعَد عن قوادِحِه عادَ مِنه بأحسَن حالٍ، وانقَلَبَ إلى أطيَبِ مآلٍ، وأمارةُ القَبول فِعلُ الحسنة بعد الحسنة، وتركُ التفاخُر والعُجبِ بالطاعة.
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولجميعِ المُسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشكرُ على توفيقِهِ وامتِنانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له تعظِيمًا لشأنِه، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا.
أيُّها المسلمون:
التفاضلُلُ بين الليالِي والأيام داعٍ لاغتِنامِ الخير مِنها، وعمَّا قريبٍ تحِلُّ بنا أفضلُ الأيام عند الله.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «أفضلُ أيامِ الدنيا أيامُ العشر»؛ رواه ابن حبان.
أقسَمَ الله بليالِيها فقال: ﴿وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1، 2].
وكلُّ عملٍ صالحٍ فيها أحبُّ إلى الله ما لو كان في غيرِها؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «ما مِن أيامٍ العملُ الصالِحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله مِن هذه الأيام العشر». قالُوا: يا رسولَ الله! ولا الجِهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «ولا الجِهادُ في سبيلِ الله، إلا رجُلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ فلم يرجِع مِن ذلك بشيءٍ»؛ رواه أبو داود.
فأكثِرُوا فيها مِن العمل الصالِح، مِن ذكرِ الله، وتلاوةِ كتابِه العظيم؛ قال - عزَّ وجل -: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28].
ومما يُستحبُّ في العشر: صِيامُ التسعة الأُولَى مِنها، وخُصَّ مِنها يوم عرفة لغَير الحاجِّ بمزيدٍ مِن الفضل؛ فصِيامُه يُكفِّرُ السنةَ الماضِيةَ والباقِيةَ.
ومِن العمل الصالِحِ فيها: المزيدُ مِن البِرِّ والإحسانِ إلى الوالِدَين والنَّاسِ، وصِلةِ الرَّحِم، والصدقةِ، والإكثارِ مِن نوافِلِ العبادات.
فالسَّعيدُ مِن اغتَنَمَ مواسِمَ الخيرات قبل فواتِها، وبادَرَ بالأعمال الصالِحة ونافَسَ السابِقين فيها، والحياةُ مغنَمٌ للعباد، والمُوفَّقُ مَن عُدَّ في المُحسِنين.
ومِن الأعمال الصالِحة: ذَبحُ الأُضحِية يوم العِيد وأيام التشريق، ومَن أرادَ أن يُضحِّي فلا يأخُذ مِن شَعرِه ولا مِن أظفاره ولا مِن بشرتِه شيئًا بعد دخول شهر الحجَّة حتى يُضحِّي، أما الوكيلُ على الأُضحِية أو المُضحَّى عنه، فلا يلزَمُه شيءٌ مِن ذلك.
ثم اعلَموا أنَّ الله أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَمِ التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدين، الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بجُودِك وكرمِك يا أكرَم الأكرَمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا رخاءً، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم سلِّم الحُجَّاج والمُعتمِرين، واحفَظهم بحفظِك، واكلأهم برعايتِك، وأعِدهم إلى بِلادِهم سالِمين غانِمين مأجُورين، واجعَل حجَّهم مبرُورًا، وسعيَهم مشكُورًا يا شكُور يا غفُور.
اللهم وفِّق إمامَنا لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، ووفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المسلمين للعمل بكتابِك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق وأعظِم الأجرَ والمثُوبةَ لكلِّ مَن خدَمَ الحُجَّاج والمُعتمِرين، وارفَع درجاتِهم في عليِّين، وفرِّج كُرُوبَهم يا قويُّ يا عزيز.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
اللهم أمِّن حُدودَنا، واحفَظ جنودَنا، وانصُرهم بنصرِك القويِّ العزيزِ يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ العظيمَ الجليلَ يذكُركم، واشكُرُوه على آلائِه ونِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

من نفَحات
الحجِّ
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن
جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "من نفَحات الحجِّ"،
والتي تحدَّث فيها عن تفضيلِ الله تعالى لبعضِ الأعمالِ والأماكِن والأزمانِ، وذكَرَ
مِن ذلك: الصلاة في المسجد الحرام، وأيام العشر مِن ذي الحجَّة، مُبيِّنًا ما
خصَّها الله تعالى به مِن فضائِلَ ومزايا وأعمالٍ صالِحةٍ وقُربات، فينبغي للعبد
ألا يُفوِّتَ هذه النَّفَحات المُبارَكة؛ عسَى أن يكون مِن المُفلِحين.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله - حقَّ التقوَى، وتمسَّكُوا مِن الإسلام بالعُروة الوُثقَى، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
إخوة الإسلام:
اقتَضَت حكمةُ البارِي - سبحانه - أن تكون أمةُ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أقلَّ الأُمم عُمرًا في هذه الدنيا؛ فأعمارُها قصيرة مُقارنةً بأعمار الأُمم السابِقة لها.
فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعمارُ أُمَّتي ما بين الستِّين إلى السبعين، وأقلُّهم مَن يجوزُ ذلك».
وروى أبو يَعلَى في "مسنده" مِن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مُعترَكُ المنايا بين الستِّين إلى السبعين».
ومع كونِ هذه الأمة أقصر عُمرًا مِمَّن سبَقَها مِن الأُمم، لكنَّ الله تفضَّلَ عليها بما لم يتفضَّل به على الأُمم قبلَها، وأكرَمَها بما لم يُكرِم به غيرَها؛ فقد عُوِّضَت ببركةِ أعمالِها، فأعطاها الله أعمالًا كثيرةً مُباركةً في الثواب، وشرَعَ لها قُرُباتٍ نافعةً ذات أجرٍ عظيمٍ وثوابٍ عَميمٍ، متى استثمَرَها المُسلمُ انتفَعَ نفعًا عظيمًا، وطالَ عُمرُه في الطاعة؛ بحيث يُحصِّلُ أجورًا عظيمةً على أعمالٍ قليلةٍ، ويكسِبُ حسناتٍ كثيرةً في وقتٍ يسيرٍ، وكان الأصلُ أن يستغرِقَ أداؤُها زمنًا يفُوقُ عُمرَه المحدُود.
وبذلك يكون عُمرُه الفعليُّ للعبادة أطولَ مِن عُمره الحقيقيِّ، وإذا كان ذلك كذلك فينبغي على العبدِ أن يستثمِرَ وقتَه ليُحقِّقَ أكبرَ قَدرٍ مِن الإنتاجيَّة في عُمرٍ أقلَّ، ويُثرِيَ عُمرَه بالخير والطاعات والمنافِع.
والمُسلمُ - عباد الله - يحرِصُ على حياتِه لا لذاتِها، ولكن ليكسِبَ أكبرَ قَدرٍ مُمكنٍ مِن الحسنات، ويستثمِرَ أوقاتَه المحدُودة بالعمل الصالِح الذي يرفعُ درجاتِه في الجنَّة، ويضرِبَ بسهمٍ في جميعِ مجالات الخير وأبوابِ البِرِّ، فينالَ أعظمَ الأجر عند ربِّه الكريم، داعِيًا إيَّاه أن يجعلَه مِمَّن حسُنَ عملُه؛ فالعِبرةُ بحُسن العمل لا بطُول العُمر.
فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «خَيرُ النَّاسِ مَن طالَ عُمرُه وحَسُنَ عملُه»؛ رواه الترمذي مِن حديث عبد الله بن بُسْرٍ - رضي الله عنه -.
ومِن الشواهِد البيِّنة، والأمثِلة الدالَّة على تعويضِ الله هذه الأمةِ عن قِصَر أعمارِها: أنَّ هناك أيامًا وليالِي مُبارَكة، وأوقاتٍ ثمينة، وأماكِن فاضِلة، وأعمالًا كريمة تتضاعَفُ فيها الحسنات وتعظُمُ أجورُها؛ كليلةِ القَدر، وعشرِ ذي الحجَّة، وأداء حجَّةٍ مبرُورةٍ، وصِيامِ عاشُوراء، وصِيامِ يوم عرفة، والصلاة في المسجِد الحرام، وقراءة القرآن، وصلاة الجماعة، وصِلةِ الرَّحِم، وغير ذلك مما جاءَت به النُّصوصُ الشرعيَّة.
وإليكم مثالًا واحدًا يتجلَّى مِن خلالِه كيف تتضاعَفُ أجُورُ بعض الأعمال، فتكون مربَحًا عظيمًا في حسناتِ المُسلم؛ فهذا هو المسجِدُ الحرامُ له مزِيَّةٌ ليست لغيرِه، وهي: مُضاعفةُ أجر الصلاةِ فيه أكثرَ مِن غيرِه، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابرٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِواه إلا المسجِد الحرام، وصلاةٌ في المسجِد الحرام أفضلُ مِن مائةِ ألفِ صلاةٍ»؛ رواه أحمد وابن ماجه.
قال بعضُ العُلماء: "فحُسِبَ ذلك على هذه الرواية، فبلَغَت صلاةٌ واحِدةٌ في المسجِدِ الحرامِ عُمرُ خمسٍ وخمسين سنة وستة أشهُر وعشرين ليلة، وصلاةُ يومٍ وليلةٍ في المسجِدِ الحرامِ - وهي خمسُ صلواتٍ - عُمرُ مائتَي سنة وسبعٍ وسبعين سنة وتسعة أشهُر وعشرِ ليالٍ"، واللهُ يُضاعِفُ لمَن يشاءُ، والله ذُو الفضل العظيم.
ومما يجدُرُ ذِكرُه هنا - أيها الإخوة -: أنَّ كثيرًا مِن أهل العلم يرَى أنَّ مُضاعفةَ الصلاة يشمَلُ الحرَمَ كلَّه، وأنَّ جميعَ بِقاع مكَّة تُسمَّى المسجِد الحرام.
عباد الله:
ومِن فضلِ الله على الأمة كذلك: أن شرَعَ لها موسِمًا عظيمًا مِن التجارة الرابِحة يتنافَسُ فيه المُتنافِسُون، ويربَحُ فيه العامِلُون، ويجتمعُ فيه شرفُ الزمان وشرفُ المكان؛ أما الزمان: فالأشهُرُ الحُرُم، وهي: ذو القَعدة، وذو الحجَّة، والمُحرَّم، ورجب، وأما شرفُ المكان: فهذه مكة البلدُ الحرام، أقدَسُ بُقعةٍ على وجهِ الأرض، وهي مقصِدُ كل عابِدٍ وذاكِرٍ، حرَّمَها الله على خلقِه أن يسفِكُوا فيها دمًا حرامًا، أو يظلِمُوا فيها أحدًا، أو يصِيدُوا صيدَها، أو يقطَعُوا شجَرَها.
في هذه الأجواء المُبارَكة يأتي موسِمُ حجِّ بيتِ الله العتيق، الذي جعلَ الله قُلوبَ الناسِ تهوِي إليه وترِقُّ لذِكرِه، وتخشَعُ عند رُؤيتِه؛ إجلالًا لله، وتعظيمًا لشعائِرِه.
وها هي قوافِلُ الحَجيجِ تتقاطَرُ على البيتِ العتيق مِن كل فجٍّ عميق، مُلبِّين نِداءَ خليلِ الله إبراهيم - عليه السلام - الذي أمرَه الله بقولِه: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27].
أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله شرَعَ لعبادِه مواسِمَ الخيرات؛ ليغفِرَ لهم الذُّنوبَ ويُجزِلَ لهم الهِبات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له شرَعَ الشرائِعَ وأحكمَ الأحكام، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه أفضلُ مَن صلَّى وصام، ووقَفَ بالمشاعِرِ وطافَ بالبيتِ الحرام، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فها نحن - عباد الله - قد أظلَّنا موسِمٌ عظيمٌ، وأيامٌ مُباركةٌ كريمةٌ، هي أيامُ العشر الأول مِن ذي الحجَّة، هذه الأيام التي هي أفضلُ أيامٍ خلقَها الله على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا، كما بيَّن ذلك - صلى الله عليه وسلم -.
إنَّها أيامُ خيرٍ وفوزٍ وفلاحٍ؛ فمَن أدرَكَها وتعرَّضَ لنفَحَاتِها؛ سعِدَ بها، وهي فُرصةٌ عظيمةٌ للتزوُّد والاغتِنام، واستِدراكِ ما فات، وموسِمُها مُشترَكٌ بين الحاجِّين والقاعِدين.
فعلينا - عباد الله - أن نُرِيَ اللهَ مِن أنفُسِنا خيرًا، خاصَّةً في هذه الأيام العشر التي أقسَمَ الله بها في كتابه، فقال - عزَّ مِن قائلٍ -: ﴿وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1، 2].
وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فضلَها بقولِه: «ما العملُ في أيامٍ أفضلَ مِنها في هذه»، قالُوا: ولا الجِهاد؟ قال: «ولا الجِهاد، إلا رجُلٌ خرَجَ يُخاطِرُ بنفسِهِ ومالِهِ فلم يرجِع بشيءٍ»؛ رواه البخاري.
وفي روايةٍ: «ما مِن أيامٍ أعظمُ عند الله ولا أحَبُّ إليه العملُ فيهنَّ مِن هذه الأيام العشر، فأكثِرُوا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ»؛ رواه أحمد.
وليُعلَم: أنَّه مِن الفِطنةِ والفقهِ: أن يختارَ المُسلمُ مِن الأعمال الصالِحة أحبَّها إلى الله تعالى فيتقرَّبَ إليه بها، فالعملُ في العشر محبُوبٌ أيًّا كان نوعُه؛ فيُشرعُ فيها التسبيحُ والتهليلُ، والتكبيرُ والذكرُ، والاستِغفارُ وقراءةُ القرآن، والصيامُ والصدقةُ، والدعاءُ، وبِرُّ الوالِدَين، وصِلةُ الأرحام، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المُنكَر، والتوبةُ إلى الله، والاهتِمامُ بالأعمال القلبيَّة، ومِنها: الصدقُ، والإخلاصُ، والصفحُ، والعفوُ، والتخلُّصُ مِن الحقدِ والشَّحناء والبغضاء، وسائر المعاني المرذُولة التي لا يُحبُّها الله - عزَّ وجل -.
معاشِر المُسلمين:
وإذا كانت المُسارعةُ بالخيرات محمودةً مطلوبةً في كل آنٍ وحينٍ وكل مكانٍ، فإنَّ حُدوثَ ذلك في الأماكن المُفضَّلة والأماكِن الشريفة أكثرُ فضلًا وخيرًا، وأعظمُ أجرًا.
فتعرَّضُوا - عباد الله - لنَفَحات الجليل، واغتَنِمُوا أوقاتَكم، وافعَلُوا الخير؛ فعسَى أن تُدرِكَ المرءَ نفحةٌ مِن نفَحَات الكريم، فيسعَدَ بذلك سعادةً ما بعدها شقاء.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على مَن أمَرَكم ربُّكم بالصلاةِ عليه، فقال - عزَّ مِن قائلٍ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى أزواجِه وذريَّته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارِك على مُحمدٍ وعلى أزواجِه وذريَّته، كما بارَكتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدين، الأئمة المهديين، والصحابة أجمعين، والتابِعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، واخذُل الطُّغاةَ والمُفسِدين، واجعَل هذا البلَدَ آمنًا مُطمئنًّا رخاءً وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، ووفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّه وترضَاه مِن الأقوال والأفعال وكريم الخِصال.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ الإسلام والمُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء، اللهم انصُر إخوانَنا المُستضعَفين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين على الثُّغور، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا.
اللهم سلِّم الحُجَّاج والمُعتَمِرين، وأعِنهم على أداء مناسِكِهم، واغفِر ذنبَهم، وآتِهم سُؤلَهم، واجعَل حجَّهم مبرُورًا، وسعيَهم مشكُورًا.
اللهم زوِّدنا مِن التقوَى، ووفِّقنا لاغتِنامِ الأيام العشر، واكتُب لنا فيها عظيمَ الثوابِ ووافِرَ الأجر.
اللهم ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
خطب الحرمين الشريفين

منافعُ الحجِّ
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "منافعُ الحجِّ"، والتي تحدَّث فيها عن شعيرةِ الحجِّ المُبارَكة، وما يكتنِفُها مِن منافِع وحِكَم، مُبيِّنًا أهمَّ هذه المنافِع.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الذي جعلَ مواسِمَ الخيرات لعبادِه مربَحًا ومغنَمًا، وأوقات البركات والنَّفَحات لهم إلى رحمتِه طريقًا وسُلَّمًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له مُعترِفًا بعبوديَّتي له مُعظِّمًا، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه، وصفِيُّه وخليلُه، وخيرتُه مِن خلقِه، بلَّغ رسالةَ ربِّه التي نزلَ بها الرُّوحُ الأمينُ مِن السما، فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آل بيتِه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه أمهات المُؤمنين، وعلى أصحابِه والتابِعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ما لاحَ برقٌ وما غيثٌ همَا، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى اللطيف الخبير، وخشيَته في جهرِنا وإسرارِنا، وخَلوَتنا وجَلوَتنا؛ فإنَّه ما اتَّقَى اللهَ أحدٌ فخسِرَ وخاب، ولا خشِيَه أحدٌ فذلَّ وخاف، ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: 62، 63].
حُجَّاج بيتِ الله الحرام:
ها أنتم ترتقِبُون مُشرئبِّين موسِمًا مِن أعظم مواسِم العام، ونُسُكًا مِن خير مناسِكِ الدين، إنَّه: حجُّ بيت الله الحرام، والوقوفُ بعرَصَاتِه، والانكِسار للرؤوف الرحيم عشِيَّة عرفة، والتلبِية، وذِكرُ الله، ورميُ الجِمار، وذبحُ الهَدي، والطواف، والسعي.
إنَّه لشعُورٌ عامِرٌ بالترقُّب لاستِلهام روحانيَّة العجِّ والثَّجِّ، والتجرُّدِ مِن المَخِيط، وتعظيمِ شعائِرِ الله التي بها تخلِيةُ القُلوب وتحلِيتُها، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
حُجَّاج بيت الله الحرام:
لقد شرعَ الله الحجَّ لعبادِه، وأحاطَه بكثيرٍ مِن المقاصِد والمنافِعِ التي لا غِنَى لأمةِ الإسلام عن تأمُّلِها وسَبرِ أغوَارِها؛ فما أمرَ الله إبراهيمَ الخليلَ - عليه السلام - أن يُؤذِّنَ في الناس بالحجِّ إلا لتبدأ غايةُ النداء وحِكَمُه ومنافِعُه، ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 27، 28].
إنَّها منافِعُ الحجِّ وحِكَمُه، نعم .. المنافِعُ التي ترفعُ شأنَ الأمة، وتصقُلُ أفئِدتَها. إنَّها منافِعُ أُخرويَّةٌ، وأُخرى دنيويَّة.
وإنَّ مِن أعظم تلكم المنافِع الأُخرويَّة للحاجِّ ما يُوثِّقُ صِلَتَهم بالله خالِقِهم دون شائِبةٍ تشُوبُها؛ ليتمحَّضَ لدَيهم توحيدُ الله الخالِص دون قادِحٍ أو شارِخٍ، حيث يتجلَّى ذلكم في التلبِية الخالِصة مِن شوائِبِ الشِّرك والأنداد، بإثبات الربوبيَّة والألوهيَّة له وحدَه دون سِواه؛ إذ كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه يرفَعُون أصواتَهم بها: «لبَّيكَ اللهم لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلك، لا شريكَ لك».
فالحجُّ - عباد الله - ميدانٌ رحبٌ لاستِلهام معنى العبوديَّة، وتجريد التوحيد للواحِدِ - سبحانه -، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: 30، 31].
ثم يمضِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد رفعِ صوتِه بالتلبِية في بيانِ منفعةٍ عُظمَى مِن منافِعِ الحجِّ الأُخرويَّة، بإبرازِ أهمية الاقتِداءِ به، واتِّباع سُنَّته، وأثر ذلكم في استِقامة العابِد، وصحَّة عبادتِه وخُلُوِّها مِن درَن البِدعة والإحداثِ في الدين؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: «خُذُوا عنِّي مناسِكَكم»؛ رواه مسلم.
كما أنَّ مِن منافِعِ الحجِّ - عباد الله -: تربيةَ المرء المُسلم على أطرِ نفسِه على الإخلاصِ لله أطرًا، الإخلاصِ والصِّدقِ الخالِيَين مِن الرِّياء والسُّمعَة؛ فإنَّ الرِّياءَ والسُّمعة ليسَا محصُورَين في حالِ رخاءِ المرءِ وترفُّهِه، بل إنَّ مظِنَّة الرِّياء والسُّمعة في حال تفَثِه وشعَثِه وتواضُعِه، لا يقِلُّ خطرًا ومُضِيًّا إلى النفسِ الضعيفة عمَّا سِواه.
فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد حجَّ مُتجرِّدًا مِن المَخِيط في إزارٍ ورِداءٍ، أشعَث مُتخشِّعًا، تفِثًا، راكبًا ناقته تارةً، وماشِيًا تارةً أُخرى، ومع ذلك لهَجَ لسانُه لربِّه بما يرجُو مِنه أن يكفِيَه شرَّ هذه الآفَة، حين كان يُردِّدُ في حجِّه قائِلًا: «اللهم حِجَّةً لا رِياءَ فيها ولا سُمعَة»؛ رواه ابن ماجَه.
حُجَّاج بيت الله الحرام:
مِن منافِعِ الحجِّ المُبارَكة: استِشعارُ المُسلمين محمَدة التيسير ورفع الحرَج، في مُقابِل معرَّة الغلُوِّ والتنطُّع، وأثر ذلكم على واقِعِ الناسِ في دينِهم ومعاشِهم؛ فما كان اليُسرُ في شيءٍ إلا زانَه، ولا نُزِعَ مِن شيءٍ إلا شانَه.
اليُسرُ واللِّينُ والسُّهولةُ علامةُ فقهٍ وخُلُقٍ حسنٍ، تمثَّلَ ذلكم جلِيًّا في حجِّ المُصطفَى - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه في جانِبِ اليُسر والتيسير ما سُئِلَ يوم النَّحر عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعَل ولا حرَج»؛ رواه البخاري ومسلم.
وكان - صلواتُ الله وسلامُه عليه - يقولُ: «نحَرتُ ههنا، ومِنَى كلُّها منحَر، فانحَرُوا في رِحالِكم، ووقَفتُ ههنا، وعرفةُ كلُّها موقِف، ووقَفتُ ههنا، وجمعٌ كلُّها موقِف»؛ رواه مسلم.
وأما في جانِبِ ذمِّ الغلُوِّ والتنطُّع والتحذيرِ مِنهما، فقد قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غداةَ العقَبَة وهو على ناقَتِه: «الْقُط لِيَ حَصَا»، فلَقَطتُ له سبعَ حصَيَات هنَّ حصًا خَذَف، فجعَلَ ينفضُهنَّ في كفِّه ويقولُ: «أمثالَ هؤلاء فارمُوا»، ثم قال: «يا أيها النَّاس! إيَّاكُم والغلُوَّ في الدين؛ فإنَّما أهلَكَ مَن كان قبلَكم الغلُوُّ في الدين»؛ رواه ابن ماجَه.
ألا فاتَّقُوا الله - حُجَّاج بيت الله الحرام -، وأرُوا اللهَ مِن أنفُسِكم في هذه العرَصَات المُبارَكة، واغتَنِمُوا استِلهامَ منافِعِ الحجِّ المُبارَكة؛ اقتِداءً بالنبيِّ المُصطفى، والرسولِ المُجتبَى، خيرِ مَن حجَّ بيتَ الله الحرام - صلواتُ الله وسلامُه عليه -، ثم توِّجُوا منافِعَ حجِّكم المُبارَك بخُلُق السَّكينة والرَّزانَة والرِّفق؛ فإنَّ المرء بلا سَكينة كالطَّعام بلا مِلح.
ولتَقتَدُوا في ذلكم بمَن قال: «خُذُوا عنِّي مناسِكَكم»؛ فإنَّ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إنَّه دفَعَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوم عرَفَة، فسمِعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وراءَه زجرًا شديدًا، وضربًا، وصوتًا للإبِل، فأشارَ بسَوطِه إليهم وقال: «أيها النَّاس! عليكُم بالسَّكينة؛ فإنَّ البِرَّ ليس بالإيضَاع»؛ رواه البخاري.
والمُرادُ بالإيضاع أي: الإسراع.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للفارُوق - رضي الله عنه -: «يا عُمر! إنَّك رجُلٌ قويٌّ، لا تُزاحِم على الحَجَر فتُؤذِي الضَّعيف، فإن وجَدتَ خلوةً فاستَلِمه، وإلا فاستقبِله وكبِّر»؛ رواه أحمد.
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيهِ من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين والمُسلمات من كل ذنبٍ وخَطيئةٍ، فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّ ربي كان غفورًا رحيمًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يُحبُّ ربُّنا ويرضَى، وأُصلِّي وأُسلِّمُ على أشرَفِ خلقِه أجمَعين.
وبعد:
فيا أيها النَّاس .. ويا حُجَّاج بيت الله الحرام! لقد أكرَمَ الله أمةَ الإسلام بنِعمةِ يُسر الوُصُول إلى بيتِه العتيق، وبلُوغ رِحابِه على هيئةٍ لم يُدرِكها أسلافُنا الأولون؛ إذ كانُوا يغيبُون الزمانَ الطويلَ، يقطَعُون فيه الفيافِيَ والقِفارَ، والمفاوِزَ والبِحارَ، فلا يدري ذَوُوهم أأحياءٌ هم أم أموات، حتى إنَّ قاصِدَ طريقِه لهُو شبِيهٌ بالمفقُود، والعائِدُ مِنه إنَّما هو كالمولُود.
ولقد ظلَّ الحَجِيجُ على هذه الحالِ دهرًا طويلًا، حتى هيَّأَ اللهم لهم مِن أسبابِ الحياةِ ما تغيَّرَت به الأحوال، واختُصِرَت به الطرقُ والأزمان، حتى أصبَحَ ذوُو الحاجِّ يرَونَه ويسمَعُون صوتَه حال وقوفِه في عرفات، والمشعَر الحرام، ومِنَى، والمسجِدِ الحرام.
كما قيَّضَ الله - بفضلِه وكرمِه - هذه البلادَ المُبارَكة لتكون راعِيةً للحرمَين الشريفَين وقاصِدِيهما، وهي تفخَرُ بذلكم أيَّما فخرٍ، وتشرُفُ به أيَّما شرَف؛ خدمةً لحُجَّاج بيت الله، وزُوَّار مسجِدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ابتِداءً مِن إمامِها ووليِّ أمرِها خادمِ الحرمَين الشريفَين ووليِّ عهدِه وعضِيدِه، وانتِهاءً بآحادِ أهلِها وأفرادِهم، كلُّهم يرَون خدمةَ الحرمَين الشريفَين شرفًا ووِسامًا لا يُساوَمُون عليهما؛ إذ يبذُلُون الغالِيَ والنَّفيس في كل ما مِن شأنِه راحةُ مَن وطِئَت أقدامُهم أرضَهم الطيبةَ المُبارَكة.
فلكُم عليهم - حُجَّاج بيت الله الحرام - الإكرام والتيسير والإشعار بأنَّ كل حاجٍّ إنَّما هو في بلدِه الثاني، مُعزَّزًا مُكرَّمًا منذ قُدومِه إلى عودتِه سالِمًا مُتقبَّلًا - بإذن الله -.
كما أنَّ لهم عليكم انتِظامَكم في أداء المناسِك دون تشويشٍ أو إخلالٍ بمقاصِدِه، أو الخروجِ عنها بشِعاراتٍ عِبِّيَّةٍ، وغاياتٍ لا تمُتُّ للحجِّ بصِلةٍ.
تقبَّل الله مِن الحُجَّاج حجَّهم، وأجزَلَ الأجرَ والمثوبةَ لكلِّ مَن كانت له يدٌ في خدمتِهم، والسعيِ إلى راحتِهم، قيادةً وعلماء ومُوجِّهين ورِجال آمنٍ، وشعبًا كريمًا محروسًا - بإذن الله -، إنَّ ربِّي قريبٌ مُجيب.
هذا وصلُّوا - رحِمَكم الله - على خيرِ البريَّة، وأزكَى البشريَّة: محمدِ بن عبد الله صَاحِبِ الحَوضِ والشفاعةِ؛ فقد أمَرَكم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسِه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقُدسِه، وأيَّه بكم - أيها المُؤمنون -، فقال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ صاحِبِ الوَجهِ الأنوَر، والجَبِين الأزهَر، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ صحابةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وكرمِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الشركَ والمُشركين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِّك وعبادَكَ المُؤمنين.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين، ونفِّس كَربَ المكرُوبِين، واقضِ الدَّيْنَ عن المَدينِين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، وسلِّم الحُجَّاج والمُسافِرين في برِّك وبحرِك وجوِّك يا رب العالمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا، واجعَل ولايتَنا فيمن خافَك واتَّقَاك، واتَّبعَ رِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه مِن الأقوالِ والأعمالِ يا حيُّ يا قيوم، اللهم أصلِح له بِطانتَه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم، ويسِّر لهم حجَّهم، ورُدَّهم إلى أهلِهم سالِمين غانِمين يا رب العالمين.
اللهم ما سألنَاك مِن خيرٍ فأعطِنا، وما لم نسألك فابتَدِئنا، وما قصُرَت عنه آمالُنا مِن الخيراتِ فبلِّغنا.
سُبحان ربِّنا ربِّ العِزَّة عمَّا يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

وصايا للحُجَّاج والمُعتمِرين
ألقى فضيلة الشيخ صلاح البدير - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "وصايا للحُجَّاج والمُعتمِرين"، والتي تحدَّث فيها عن مناسِكِ الحجِّ ومِنَّة الله تعالى على عبادِه فيها بالتيسير والتوفيق، ثم وجَّه بعضَ النصائِح والوصايا المهمة للحُجَّاج والمُعتمرين والزائِرين.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله حمدًا يُوافِي نعمَه وعطاياه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ولا معبُودَ بحقٍّ سِواه، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه ونبيُّه وصفِيُّه ونجِيُّه ووليُّه ورضِيُّه ومُجتَبَاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه صلاةً دائمةً ما انفَلَقَ صُبحٌ وأشرَقَ ضِيَاه.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمُون:
اتَّقوا الله بالسعيِ إلى مراضِيه، واجتِنابِ معاصِيه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أيها المُسلمُون:
لقد هبَّ النَّيسمُ الرَّقيقُ العليلُ نقيًّا زكِيًّا، مُضمَّخًا بعبَقِ شعائِرِ الحجِّ ومشاعِرِه، وعلائِمِه ومعالِمِه وفرُوضِه، وحرَم الله الآمِن الذي أوسَعَه كرامةً وبهاءً وجمالًا، وعظمةً وقداسةً وجلالًا.
وهذه أفاوِيجُ الحَجيج تؤُمُّ البيتَ العتيق، وتُلبِّي مِن كل فجٍّ عميق، وتفِدُ مِن كل طرَفٍ سحِيق، تغمُرُهم سيُولُ الأفراح، وتغشاهم فُيُوض الانشِراح.
وهذه وفودُ الله التي أقبَلَت على ربِّها مُسارِعة، وبسَطَت أكُفَّ الذلِّ ضارِعة، ففاضَت عباراتُهم، وارتفَعَت دعواتُهم.
|
إليكَ إلهِي قد أتَيتُ مُلبِّيَا |
|
فبارِك إلهِي حجَّتِي ودُعائِيَا |
|
قصَدتُك مُضطرًّا وجِئتُك باكِيَا |
|
وحاشاك ربِّي أن ترُدَّ بُكائِيَا |
|
أتَيتُ بلا زادٍ وجودُك مطمَعِي |
|
وما خابَ مَن يهفُو لجُودِك ساعِيَا |
أيها المُلسلمون:
قدِّسُوا الحرَم، وعظِّمُوا حُرمتَه، وراعُوا مكانتَه، وصُونُوا هيبتَه، والتزِمُوا بالأنظمة والتعليمات، واحذَروا ما يُعكِّرُ صفوَ الحجِّ، أو يُخالِفُ مقاصِدَه، أو يُنافِي أهدافَه.
وليس الحجُّ موضِعًا للخصُومات والمُنازعات والمُجادلات، ولا مكانًا للتجمهُرات والمُظاهَرات والمَسِيرات، ولا موقِعًا للشِّعارات والحِزبيَّات والعصبِيَّات، والحجُّ أجَلُّ وأسمَى وأعلَى مِن أن يكون مسرَحًا للخِلافات الحِزبيَّة والمذهبِيَّة، وموطِنًا للنِّزاعات الطائفيَّة والسياسيَّة.
أيها الحُجَّاج والعُمَّار:
تعلَّمُوا فقهَ الحجِّ وشُروطَ إجزائِه، وصفةَ أدائِه قبل أن تتلبَّسُوا بالإحرام وتقصُدُوا البيتَ الحرام، وكَم مِن حاجٍّ ركِبَ مِن الأمر أجسَمَه وأعظمَه حتى بلَغَ الديارَ المُقدَّسَة، ثم شرَعَ في أداء نُسُكِه فإذا هو لا يُدرِكُ أحكامَه، ولا يُحسِنُ إتمامَه، فعادَ إلى وطنِه وقد تركَ رُكنًا، أو أسقَطَ شرطًا، أو أهمَلَ فرضًا، أو ارتكَبَ محظُورًا، أو أتَى محذُورًا.
معاشِر الحُجَّاج والعُمَّار والزُّوَّار:
عقيدةُ الإسلام جمَعَتكم، وفريضةُ الحجِّ نظَمَتكم، وأواصِرُ الدين وحَّدَتكم. فتراحَمُوا وتعاطَفُوا وتعاوَنُوا، ولا تدافَعُوا ولا تزاحَمُوا ولا تقاتَلُوا. ارحَمُوا الضعيفَ، وأرشِدُوا الضالَّ، وساعِدُوا العاجِزَ المُحتاجَ، وعليكُم بالرِّفق والتمهُّل والترسُّل، ولِينِ الجانِبِ والمُسامَحَة وترك المُزاحَمة.
وتجلبَبُوا السَّكينة، واستشِعرُوا الخشيةَ، والزَمُوا الوقارَ والمُلاطَفة، وإيَّاكُم والجِدالَ والمِراءَ والمُلاحاة، واحذَرُوا المُنازَعَة والتلاسُنَ والخِصامَ واللَّغَا مِن الكلام، واجتنِبُوا قولَ الخَنَا والفُحش، واللَّغوَ والهُجرَ والسِّباب، والتنابُزَ بالألقاب.
وصُونُوا حجَّكم عن أرجاسِ الشِّرك، وأرجاسِ البِع والمُحدثات، واجتنِبُوا اللَّغوَ، وارمُوا الجِمارَ بالحصَى الصِّغار التي على قَدر الباقِلَّاء أو النَّواة أو الأنمُلة، وإيَّاكُم ومُجاوَزة حدِّ الشَّرع، وتأسَّوا بالحبيبِ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم - في نُسُككم وأعمالِ حجِّكم.
وأكثِرُوا مِن التوبةِ والاستِغفار، وأظهِرُوا التذلُّلَ والانكِسارَ، والنَّدامةَ والافتِقار، والحاجةَ والاضطِرار؛ فإنَّكم في مساقِطِ الرَّحمة، ومواطِن القَبُول، ومظِنَّات الإجابةِ والمغفِرَة والعِتقِ مِن النَّار.
تذكَّرُوا جلالةَ المكان، وشرَفَ الزمان، وتذكَّرُوا قولَ الحبيبِ المحبُوبِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حجَّ فلم يرفُث ولم يفسُق رجَعَ كيوم ولَدَتْه أمُّه»، «والحجَّةُ المبرُورةُ ليس لها جزاءٌ إلا الجنَّة».
تلقَّى اللهُ دُعاءَكم بالإجابة، واستِغفارَكم بالرِّضا، وحجَّكم بالقَبُول، وجعلَ سعيَكم مشكُورًا، وذنبَكم مغفُورًا، وحجَّكم مبرُورًا.
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ فاستغفِرُوه، إنه كان للأوابِين غفُورًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله آوَى مَن إلى لُطفِه أوَى، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له دَاوَى بإنعامِه مَن يئِسَ مِن أسقامِه الدوَا، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنَا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه صلاةً تبقَى، وسلامًا يَترَى.
أما بعدُ .. فيا أيها المسلمون:
اتَّقُوا الله وراقِبُوه، وأطيعُوه ولا تَعصُوه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أيها المُسلمون:
يوم عرفة يومٌ شريفٌ مُنيفٌ كريم، وعيدٌ لأهل الموقِفِ عظيم. يومٌ تُعتَقُ فيه الرِّقاب .. يومٌ تُسمَعُ فيه الدعواتُ وتُجاب .. يومٌ كثُرَ فيه خيرُ ربِّنا وطابَ.
وما مِن يومٍ أكثر مِن أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِن النَّار مِن يوم عرفة، وإنَّه ليدنُو ثم يُباهِي بهم الملائكةَ فيقُولُ: ما أرادَ هؤلاء؟
وأفضلُ الدعاء بركة، وأجزَلُه إثابة، وأعجَلُه إجابة دُعاءُ يوم عرفة. فاجتهِدُوا فيه بالتضرُّع والثَّناء والدُّعاء.
ويُستحبُّ صِيام يوم عرفة لغَير الحاجِّ، وصِيامُه يُكفِّرُ السنةَ الماضِيةَ والباقِيةَ.
ويُستحبُّ التكبيرُ عقِبَ الصلواتِ المفرُوضات مِن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والمسبُوق ببعضِ الصلاة يُكبِّرُ إذا فرَغَ مِن قضاءِ ما فاتَه، ويُكبِّرُ الحُجَّاجُ ابتِداءً مِن ظُهر يوم النَّحر.
أيها المُسلمون:
كبِّرُوا في الأرجاء والأنحاء .. كبِّرُوا في البُنيان والخلاء .. كبِّرُوا في العُمران والفضاء .. كبِّرُوا في الصباح والمساء .. كبِّرُوا حتى يبلُغ تكبيرُكم عنانَ السَّماء: الله أكبرُ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وصلُّوا على أحمدَ الهادِي شفيعِ الورَى طُرًّا؛ فمَن صلَّى عليه صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا.
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن الآلِ والأصحابِ، وعنَّا معهم يا كريمُ يا وهَّاب.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل بلادَ المُسلمين آمنةً مُطمئنَّةً مُستقِرَّةً يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمَين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما فيه عِزُّ الإسلام وصلاحُ المُسلمين يا رب العالمين.
اللهم انصُر جُنودَنا المُرابِطِين المُجاهِدين على ثُغورِنا وحُدودِنا، اللهم احفَظ رِجالَ أمنِنا، واجزِهم خيرَ الجزاءِ وأوفاه يا رب العالمين.
اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وارحَم موتانا، وفُكَّ أسرانا، وانصُرنا على مَن عادانا.
اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم وسعيَهم، اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم وسعيَهم، اللهم اجعَل حجَّهم مبرُورًا، وسعيَهم مشكُورًا، وذنبَهم مغفورًا، اللهم تقبَّل مساعِيَهم وزكِّها، وارفَع درجاتهم وأعلِها، وبلِّغهم مِن الآمال مُنتهاها، ومِن الخيرات أقصاها.
خطب الحرمين الشريفين

منزلة الأخلاق في الإسلام
ألقى
فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة عرفة بعنوان: "منزلة
الأخلاق في الإسلام"، والتي تحدَّث فيها عن توحيدِ الله تعالى، وأنَّه دعوةُ
الرُّسُل جميعًا، ثم عرَّج على ذِكر أركان الإيمان وأركان الإسلام، مُؤكِّدًا على اهتِمام
الإسلام بفضائلِ الأخلاق، وبيَّن بذِكرِه مواضِع مِن القرآن الكريم والسنَّة
النبويَّة المُطهَّرة عِظَم منزلة الأخلاق في دين الله تعالى، داعيًا جميعَ فِئات
الأمة إلى إعطاءٍ هذا الموضُوع أهميةً عُظمَى.
الخطبة الأولى
الحمدُ للهِ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالِكِ يوم الدين، تفضَّل على العباد بأنواع الأرزاقِ والدلالة على أفضل الأخلاق، فتعالَى اللهُ الملِكُ الحقُّ لا إله إلا هو ربُّ العرش الكريم، واعلَمُوا أنَّ الله يعلَمُ ما في أنفُسِكم فاحذَرُوه، واعلَمُوا أنَّ الله غفورٌ حليم، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ الخلَّاقُ العليم، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه وصَفَه ربُّه فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابهِ وأتباعِه الذين سارُوا على طريقتِه في التعامُل الحسَن والخُلُق الكريم.
أما بعدُ .. فيا أيها المُؤمنون:
اتَّقُوا الله بالاستِجابة لأوامِرِه، وتعليقِ القُلوبِ به - سبحانه - محبَّةً وخوفًا ورجاءً؛ فإنَّ مَن اتَّقَى أفلَح وفازَ دُنيا وآخرة، ومَن اتَّقَى اللهَ هُدِيَ إلى الحقِّ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: 28]، وقال - سبحانه -: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 189]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 172].
وقال - جلَّ وعلا - عن إبراهيم - عليه السلام -: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 16].
وإنَّ مِن تقوَى العبدِ لربِّه أن يُوحِّدَ اللهَ - جلَّ وعلا - في عبادتِه، فلا يصرِف شيئًا مِن العبادة لغيرِ الله، كما قال - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 21، 22]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5].
وقال ربُّنا - جلَّ وعلا -: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14].
وجميعُ الأنبياء والرُّسُل جاءوا بالتوحيد، وفي مُقدِّمتهم أُولُو العزم مِن الرُّسُل: نوحٌ، وإبراهيمُ، ومُوسى، وعيسى، وخاتمُ الأنبِياء مُحمدٌ - صلواتُ الله عليهم أجمعين -، فكلُّ الأنبِياء يقُولُون لأنبيائِهم: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 65].
ثم جعلَ الله العاقِبةَ الحميدةَ لأهل التوحيد وأتباعِ الرُّسُل، وجعلَ العُقوبةَ على مَن خالَفَ طريقَهم، قال - سبحانه -: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [النحل: 36].
وهذا التوحيدُ الخالِصُ الذي دعا إليه الأنبِياءُ بإفراد الله بالعِبادة هو معنى شهادة أن "لا إله إلا الله"، قال - سبحانه -: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163]، وقال - جلَّ وعلا -: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد: 30]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 51- 55].
عباد الله:
والفوزُ والنَّجاةُ يحصُلان بتحقيقِ هذه الشَّهادة مع شهادة أنَّ "مُحمدًا رسولُ الله" - صلى الله عليه وسلم -؛ بحيث يُطاعُ أمرُه، ويُصدَّقُ خبَرُه، ولا يُعبَدُ الله إلا بما جاء به، أرسلَه الله للناسِ جميعًا؛ ليُخرِجَهم مِن الظُّلمات إلى النُّور، ومِن الضلالةِ إلى الهُدى، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28]، وقال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 45- 47].
أيها المُؤمنون:
يُبشِّرُكم ربُّكم - جلَّ وعلا - بالفضلِ الكبيرِ فيقُول: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: 25]، ويقولُ - جلَّ شأنُه -: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 82].
وإنَّ الإيمانَ مبنيٌّ على أركانٍ فسَّرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: «أن تُؤمِنَ بالله، وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسُلِه، واليومِ الآخِرِ، والقَدَر خيرِه وشرِّه»، كما ذكَرَ أركانَ الإسلام بقولِه: «الإسلامُ: أن تشهَدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصلاةَ، وتُؤتِي الزَّكاة، وتصُومَ رمضان، وتحُجَّ البيتَ إن استَطعتَ إليه سبيلًا».
والصلاةُ مِن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتَين؛ فهي العملُ الذي يدلُّ على الإسلام، وهي صِلةٌ بين الإنسانِ وربِّه، يُناجِي فيها العبدُ إلهَه وخالِقَه - سبحانه -، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال - سبحانه -: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، وقال - جلَّ وعلا -: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: 170].
وأما الزَّكاةُ فتكونُ بإخراجِ جُزءٍ يسيرٍ مِن المال؛ مرضاةً للربِّ، ومُواساةً للفُقراء، ومُساهمةً في المنافِعِ العامَّة المذكُورة في مصارِفِ الزَّكاة، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 110]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: 56].
كما أنَّ مِن أركان هذا الدين: صِيامَ شهر رمضان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].
والرُّكنُ الخامِسُ: حجُّ بيت الله الحرامِ لمَن استطاعَ إليه سبيلًا، قال - جلَّ وعلا -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال - سبحانه -: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حجَّ فلم يرفُث ولم يفسُق؛ رجَعَ مِن ذنوبِه كيوم ولَدَتْه أمُّه».
أيها المُؤمنون:
لقد أُمِرنا بالاقتِداءِ بنبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - في مناسِكِ الحجِّ، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «لتأخُذوا عنِّي مناسِكَكم».
بل أُمِرنا بالاقتِداءِ به والسَّير على هَديِه وطريقتِه - صلى الله عليه وسلم - في كل عباداتِنا، ورتَّبَ الله - سبحانه - على ذلك محبَّتَه، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، وقال - سبحانه -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].
ولقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أكمَلِ الأخلاق وأفضلِ الآداب، كما وصَفَه ربُّه - جلَّ وعلا - بقولِه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وبقولِه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159].
ووصَفَت أمُّ المُؤمنين عائشةُ - رضي الله عنها -، وصَفَت خُلُقَه فقالت: "كان خُلُقُه القُرآن".
وصُورةُ الإسلام الحقيقية تشتَمِلُ على أعلَى الأخلاق، وأحسَن التعامُلات.
فما أحوَجَ الخلق اليوم إلى اعتِماد الأخلاقِ في مُعاملاتِهم الماليَّة، وأنظِمتهم الاقتِصاديَّة والسياسيَّة، ومناهِجِهم العلميَّة، وطرائِقِهم البحثيَّة، ولن تتمكَّن أمةٌ مِن تشكِيلِ مُواطِنِين صالِحِين إلا بزراعة الأخلاقِ في نفوسِهم؛ فالأخلاقُ تحفَظُ الحُقوقَ، وتُقيمُ النُّفوسَ والمُجتمعات على أكمَل نَهجٍ. فما أشدَّ حاجة العالَمِ إلى اعتِماد المعايير الأخلاقيَّة في كل مجالات الحياة.
ولقد كانت خطبةُ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم - في يوم عرفة تُؤكِّدُ أُسسَ الأخلاق؛ حيث نهَى - صلى الله عليه وسلم - عن الاعتِداءِ على الآخرين فقال: «إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكُم حرامٌ».
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا ترجِعُوا بعدِي كُفَّارًا يضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ».
وهذا - أيها المُؤمنون - أحدُ محاسِنِ دينِ الإسلام، الذين جاء بالحثِّ على الأخلاقِ الفاضِلةِ؛ ففي "الصحيحين": أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ مِن خيارِكم أحسنكم أخلاقًا».
مما يُظهِرُ فضلَ دينِ الإسلام، وكمالَ شريعتِه، وسُمُوَّ مقاصِدِه، فهو يحفَظُ المصالِح، ويدرأُ المفاسِد، ويدعُو لعِمارةِ الكَون، ونفعِ الخلقِ، ويُقرِّرُ مبدأَ التآخِي بين المُسلمين، ونشر الرحمةِ والمودَّة فيما بينَهم، والحثِّ على نشر الخَيرِ والمعروف، والبَذل والعطاء، والكفِّ عن ظُلم أي أحدٍ مِن الناسِ، وتركِ العُدوان عليهم.
ولقد كانت أمةُ الإسلام أمةً واحدةً تجتمعُ على الهُدى، مُعتمِدةً على الكتاب والسنَّة، بعيدةً عن الأهواء والبِدَع، سامِيةً عن الشِّقاقِ والبَغضاء، تتَّجِه لربٍّ واحدٍ - سبحانه -، وتتَّبِعُ نبيًّا واحدًا - عليه الصلاة والسلام -، وتهتَدِي بكتابٍ واحدٍ، وهو القرآنُ العظيمُ، وتُصلِّي لجهةٍ واحدةٍ، وهي الكعبةُ المُشرَّفة، وتحُجُّ لبيتٍ واحدٍ، وتُؤدِّي نُسُكًا واحدًا، وتتناصَرُ بعدلٍ ورحمةٍ وتكافُلٍ.
ومما حثَّت الشريعةُ عليه مِن الأخلاقِ: اختِيارُ الاٌوال الجميلة، والألفاظ الحسَنة، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ [الإسراء: 53]، وقال - سبحانه -: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83].
ومما جاءت به: الترغيبُ في صِدقِ الأقوال والأفعال، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما جاءت الشريعةُ بالأمر بالوفاءِ بالعُقُود والعهُود، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال - سبحانه -: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34].
وأمرَ الله تعالى بالإحسانِ إلى الوالدَين، والقرابةِ والجِيران، فقال - عزَّ وجل -: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]، وقال - جلَّ شأنُه - في حقِّ الوالدَين: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23، 24].
وأمرَ الله - سبحانه - بحُسن العِشرة بين الزَّوجَين فقال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].
وكان مِن خُطبة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في عرفة قوله: «واستَوصُوا بالنِّساء خيرًا».
بل أمرَت الشريعةُ بالإحسانِ إلى الخلقِ، والعدلِ بينهم، فقال - جلَّ وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90]، وقال - سبحانه -: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 56].
ونهَى الله - عزَّ وجل - عن الغِشِّ وتطييفِ المكاييل، فقال: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الأنعام: 152].
وأمرَ بالمُحافظة على الأمانات وأدائِها إلى أهلِها، فقال - جلَّ وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]، وأثنَى الله على المُؤمنين بقولِه - سبحانه -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].
كما أثنَى على أهل الإيثار، فقال - جلَّ شأنُه -: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
وأثنَى على أهل الصدقات والنفقات في سبيلِ الخير، فقال - سبحانه -: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92].
واستَمِع - أيها المُسلم - لنماذِج مِن آيات القُرآن في ثوابِ أهل الأخلاق الفاضِلة؛ حيث قال - جلَّ وعلا -: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 133، 134].
أيها المُسلمون:
لقد فتَحَ الله لعبادِه بابَ التوبة؛ ليتجاوَزَ بفضلِه عن ذنوبِ العِباد، كما قال - عزَّ وجل -: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 70]، وقال - عزَّ وعلا -: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: 82].
ويومُكم هذا - أيها المُسلمون -، إنَّ يومَكم هذا مِن مواسِمِ التوبة، ومِن مواطِنِ المغفِرة؛ فقد أخرجَ الإمامُ مُسلم في "صحيحه": أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما مِن يومٍ أكثر مِن أن يُعتِقَ الله فيه عبيدًا مِن النَّار مِن يوم عرفة، وإنَّه ليدنُو ثم يُباهِي بهم الملائكةَ».
كيف لا؟ وهذا يومٌ عظيمٌ أنزلَ الله فيه قولَه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فعندها كمُلَت الأخلاق، وتمَّت الشريعةُ المُشتملةُ على الفضائلِ العالِيةِ والمحاسِنِ الشريفةِ.
وانظُر - أيها المُسلم - مِن نماذِج ذلك: سُورة الحُجرات؛ حيث نهَى الله فيها عن تصديقِ الشَّائِعات، وأمرَ بالإصلاحِ بين المُتخاصِمَين، وردِّ الباغِي عن الحقِّ، ونهَى عن السُّخرية بالخلقِ، والتنابُز بالألقابِ، وسُوء الظنِّ، والتجسُّس، والغِيبة، والتكبُّر.
فالعالَمُ أجمع مدعُوٌّ إلى قراءة القرآن الكريم؛ ليتعرَّفَ على أعلَى درجاتِ الأخلاق، كما قال - سبحانه -: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: 9].
ولذا كان مِن خُطبة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في عرفة: «لقد ترَكتُ فيكُم ما لن تضِلُّوا بعدِي إن اعتصمتُم به: كتاب الله».
وكان مما دعَا إليه كتابُ الله اجتِماعُ كلمة المُسلمين، والحذَرُ مِن البغي والخِداع والخيانة، وأخذُ العِظة والعِبرة بمآلات مَن سبَقَ مِن الخوَنة والظالمين.
إنَّ مُراعاةَ الضوابِطِ الأخلاقيَّة الإسلاميَّة في التعامُلات الماليَّة تزدهِرُ به التِّجارة، وينمُو به الاقتِصاد؛ لبِناء ذلك على ثقةِ الناسِ بعضِهم بأخلاقِ بعضٍ، ولذا جاء في الشرع العظيم تحريمُ الغشِّ، والرِّبا، وأكل أموال الآخرين بالباطِل، والجهالة في البيُوع، والقِمار والميسِر، وأمرَ الله بتوثيقِ الحقوق.
وإنَّ مما أمرَ به الشرعُ مما له صِلةٌ بالأخلاق: طاعة ولاةِ الأمور؛ لما له مِن أثرٍ عظيمٍ في حفظِ النِّظام العام، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
فتلتَزِمُ الأمةُ بطاعةِ الله ورسولِه - صلى الله عليه وسلم -، وتجتمِعُ تحت لِواءِ قادتِها ووُلاتِها، بعيدةً عن المُنازعةِ والمُنابَذة، مُؤدِّيةً للواجِبات، ومُنتهِيةً عن المُخالفات، آمِرةً بالمعروف، ناهِيةً عن المُنكَر، فكانت بذلك خيرَ أمةٍ أُخرِجَت للناسِ، فتنالُ ما وعَدَ الله به مِن النصر، والرزق، والخير، والاجتِماع بعيدًا عن لَوثاتِ الفتن ودُعاتها مهما تلوَّنوا وتقلَّبُوا.
عباد الله:
ولئِن كان الحِفاظُ على الأخلاقِ مطلوبًا في جميع البِقاع، فهو في هذه البِقاع آكَد، وليس مِن الخُلُق الفاضِل جَعلُ موسِمِ الحجِّ موطِنًا للشِّعارات، أو المُظاهرات، أو الدعوة إلى الأحزاب والحركات، فقد أكَّد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في خُطبة عرفة بأنَّ كلَّ شيءٍ مِن أمر الجاهليَّة موضُوعٌ تحت قدَمَيه.
أيها العالَم أجمع:
إنَّ التِزامَ الأخلاق يُهيِّئُ أحسَنَ سُبُل للحياة والعيش الكريم.
فيا قادة الأمة .. يا عُلماء الشريعة .. يا أيها المسؤولون .. يا أيها المُربُّون الأفاضِل .. يا أيها الآباء والأمهات .. يا أيها الإعلاميُّون! نحن مدعُوُّون جميعًا لإعطاء موضُوع الأخلاقِ ما يستحِقُّه مِن أهمية، وعلينا أن نُربِّيَ النفوسَ عليه، بواسِطة جَعل النُّفوس تستشعِرُ مُراقبةَ الله تعالى، وترتبِطُ بالقرآن الكريم، والسنَّة النبوية، وتُؤمِّلُ حُسنَ العاقِبة دُنيا وآخرة عند تمسُّكها بالأخلاق الفاضِلة.
حُجَّاج بيت الله الحرام:
بعد أن خطَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في عرفة، أمرَ بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فصلَّى الظهرَ مقصورةً ركعتَين، ثم أقامَ فصلَّى العصرَ مقصورةً ركعتَين، ثم وقفَ في عرفة على ناقتِه يذكُرُ الله - جلَّ وعلا - ويدعُوه حتى غربَ قُرصُ الشَّمس، ثم ذهبَ إلى مُزدلِفة، وكان يُوصِي أصحابَه ويقولُ: «يا أيها الناس! عليكُم بالسَّكينة والوقار؛ فإنَّ البِرَّ ليس بالإيضاع» أي: الإسراع.
فلما وصَلَ مُزدلِفة صلَّى المغربَ ثلاثًا والعشاءَ ركعتَين جمعًا وقصرًا، وباتَ بمُزدلِفة، وصلَّى الفجرَ بها في أول وقتِها، ثم دعا اللهَ إلى أن أسفَرَ، ثم ذهبَ إلى مِنًى فرمَى جمرةَ العقبة بعد طلُوع الشمس بسبعِ حصَيَات، وذبَحَ هَديَه وحلقَ، ثم طافَ طوافَ الإفاضة، وبقِيَ في مِنى أيام التشريقِ يذكُرُ اللهَ - عزَّ وجل -، ويرمِي الجَمَرات الثلاث بعد الزوال، ويدعُو عند الصُّغرى والوُسطى، ورخَّصَ لأهل الأعذار في تركِ المَبِيتِ بمِنى.
وسُنَّةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: المُكثُ بمِنًى إلى اليوم الثالِثِ عشر - وهو الأفضل -، وأجازَ التعجُّلَ في الثانِي عشر، فلما فرَغَ مِن حجِّه وأرادَ السفرَ إلى المدينة، طافَ بالبيتِ - صلى الله عليه وسلم -.
حُجَّاج بيت الله الحرام:
إنَّكم في موطِنٍ شريفٍ، وزمانٍ فاضِلٍ، تُرجَى فيه مغفِرةُ السيئات، وإجابة الدعوات؛ ولهذا أفطَرَ - صلى الله عليه وسلم - في حجِّه؛ ليتفرَّغَ للذِّكرِ والدُّعاء.
فأكثِرُوا مِن دُعاء ربِّكم الكريم لكم ولمَن تُحبُّون ولمَن له عليكم حقٌّ، وللمُسلمين عامَّة بأن يُصلِحَ الله أحوالَهم، وأن يجمعَ كلمتَهم على الحقِّ، ولا تنسَوا الدُّعاءَ لمَن أحسنَ إليكم، كما في الحديث: «مَن صنَعَ إليكم معروفًا فكافِئُوه، فإن لم تجِدُوا فادعُوا له».
وإنَّ مِمن أحسَنَ للمُسلمين مَن يقُومُ بخِدمة الحرمَين الشريفَين، ويسهَرُ على راحة ضيُوف الرحمن، وفي طليعَتهم: خادمُ الحرمَين الشريفين، ووليُّ عهدِه، فادعُوا اللهَ لهم.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، يا ذا الجلال والإكرام نسألُك أن تُوفِّقَ خادمَ الحرمَين الشريفَين الملِكَ سلمان بن عبد العزيز، اللهم كُن معه مُؤيِّدًا وناصِرًا ومُعينًا على كل خيرٍ، اللهم جازِه خيرَ الجزاء على ما يُقدِّمُه مِن الخير والإحسان، اللهم بارِك في وليِّ عهدِه الأمير مُحمد بن سَلمان، اللهم شُدَّ عضُدَه به، واجعَله سببَ خيرٍ للأمة كلِّها.
اللهم تقبَّل مِن الحَجيج حجَّهم، اللهم تقبَّل مِن الحَجيج حجَّهم، ويسِّر لهم أمورَهم، واكفِهم شرَّ مَن أرادَ بهم سُوءً، اللهم أعِدهم لبُلدانهم سالِمين غانِمين قد غُفِرَت ذنوبُهم، وقُضِيَت حوائِجُهم.
اللهم اغفِر للمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، وألِّف ذاتَ بينهم، وأصلِح قلوبَهم، وتولَّ شأنَهم، وآمِنهم في أوطانِهم، واهدِهم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام.
خطب الحرمين الشريفين

فضل يوم النَّحر
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة عيد الأضحى بعنوان: "فضل يوم النَّحر"، والتي تحدَّث فيها عن أعيادِنا أهل الإسلام، مُبيِّنًا ما خصَّ الله تعالى عبادَه المُسلمين بعيدَي الفِطر والأضحَى، كما ذكَرَ فضلَ يوم النَّحر وأيام التشريق، ونبَّه معاشِر الحُجَّاج إلى باقِي أعمال الحجِّ هذا اليوم والأيام التالِية.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخَيرَ الهَدي هَديُ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ بِدعة، وكلَّ بِدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر خلقَ الخلقَ وأحصاهم عددًا، وكلُّهم آتِيه يوم القِيامة فردًا .. الله أكبر إلهًا واحدًا صمَدًا، لم يتَّخِذ صاحبةً ولا ولدًا .. الله أكبر عزَّ سُلطانًا ومجدًا، وتعالَى مُلكًا وجَدًّا .. الله أكبر عنَت الوجوهُ لعظمته، وخضَعَت الخلائِقُ لقُدرتِه .. الله أكبر ما ذكَرَه الذاكِرُون، واستغفَرَه المُستغفِرُون .. والله أكبر ما هلَّل المُهلِّلُون، وكبَّر المُكبِّرُون.
الله أكبر عدد ما هلَّ هلالٌ وأدبَر .. الله أكبر عدد ما بزَغَ فجرُ يومٍ وأنوَر .. الله أكبر عدد ما لبَّى مُلبٍّ وكبَّر .. الله أكبر عدد ما حجَّ حاجٌّ واعتمَر .. الله أكبر عدد ما أهلَّ بالتوحيد وأقَرَّ .. الله أكبر عدد ما أتَى البلدَ الحرامَ واستقَر .. الله أكبر عدد ما طافَ بالبيتِ العتيقِ ووقَّر .. الله أكبر عدد ما ذبَحَ قرابِين وشكَر.
الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسُبحان الله بُكرةً وأصيلًا.
أيها المُسلمون:
اتَّقُوا اللهَ دهرَكم، وأخلِصُوا له سِرَّكم وجَهرَكم، واذكُروا نعمةَ ربِّكم؛ إذ بُلِّغتُم وأُمتِعتُم بهذا الموسِم المُبارَك، وهذه الأيام العشر الفاضِلة حتى أدرَكتُم نهايتَها بعد أن ربِحتم غنيمتَها، وها هي تُتوَّجُ بأكبر أعياد الإسلام الذي أشرَقَ نورُه فعمَّ البِشرُ جميعَ الأنام، فاليوم هو آخرُ أيام العشر، وخاتمُ الأيام المعلُومات، إنَّه أفضلُ الأيام عند الله وأعظمُها، يومٌ عظيمٌ مجيد، وعيدٌ كريمٌ بهيج، يُدعَى "يوم الحجِّ الأكبر"، و"يوم النَّحر"، تتلُوه أيامٌ ثلاثةٌ معدُودات.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «أعظمُ الأيامِ عِندَ الله: يوم النَّحر، ثم يوم القَرِّ»؛ رواه أبو داود.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يوم الفِطر ويوم النَّحر وأيام التَّشريق عِيدُنا أهل الإسلام»؛ رواه أبو داود وغيرُه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أمة الإسلام:
هذا عِيدُنا كما بيَّن ذلك نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إنَّ لكل قومٍ عِيدًا، وهذا عِيدُنا»؛ متفق عليه.
وقد جعلَ الله تعالى لكل أمةٍ منسَكًا، وجعلَ لهذه الأمة عِيدَين: عِيدَ الفِطر، وعِيدَ الأضحَى الذي نحن فيه الآن، ونعيشُه اليوم.
فهنيئًا لكم - يا أمة الإسلام - بهذَين العِيدَين اللَّذَين خصَّكما الله بهما، فلكل أمةٍ عِيد، ونحن هذا عِيدُنا.
عيدُ اليوم عيدُ الأضحَى يزدانُ بما خُصَّ به مِن قُرُباتٍ عظيمة، وما يقَعُ فيه مِن أعمالٍ جليلةٍ مِن الحُجَّاج والمُقيمين في الأمصار؛ ففيه ذِكرٌ وتكبيرٌ، وصلاةُ عيد، وذبحُ أُضحيةٍ وهَديٍ لله، وهو عيدُ محبةٍ وتآلُفٍ ووِئام، وصِلةٍ واجتِماعٍ وسلام، وإظهارُ ذلك يوم العِيد مِن إعلان الشعائِر وتعظيمِها، وذلك دلالةٌ على تقوَى القلوبِ لعلَّام الغيُوب.
فاجعَلُوا - عباد الله - يومَ عِيدكم يومَ فرحٍ وهناءٍ، يوم سعادةٍ وصفاء، لا يوم فُرقةٍ وبغضاء، ولا قطيعةٍ وشَحناء، بل تغافَروا، وتصافَحُوا، وتوادُّوا، وتحابُّوا، وتعاوَنوا على البرِّ والتقوَى لا على الإثم والعُدوان. صِلُوا الأرحام، وارحَموا الضُّعفاءَ والأيتام، وتخلَّقُوا بأخلاق وآداب الإسلام.
وهذا اليوم المُبارَك تجتمعُ فيه عباداتٌ لا تجتمعُ في غيرِه، فحُجَّاجُ بيت الله اليوم الجِمار يرمُون، والهَديَ ينحَرون، ورُؤوسَهم يحلِقُون، وبالبيتِ يطُوفُون، وبالصفا والمروة يسعَون، وأهلُ البُلدان اليوم يُكبِّرُون، وفي المُصلَّى يجتمِعُون، وصلاةَ العيد يُؤدُّون، وأُضحياتِهم يذبَحُون.
ما أجلَّ شأنَهم، وأعظمَ قَدرَهم، إنَّهم جميعًا مُسلِمون بدينٍ واحدٍ يدينُون، ولربٍّ واحدٍ يعبُدون، ولرسولٍ واحدٍ يتَّبِعون، ولقبلةٍ واحدةٍ يتَّجِهُون، ولكتابٍ واحدٍ يقرأون، ولأعمالٍ واحدةٍ يُؤدُّون. هل هناك وحدةٌ أعظم مِن هذه الوحدة - أيها المُوحِّدون -؟! ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أمة الإسلام:
لقد شرَعَ الله لنا في موسِمِ الحجِّ عباداتٍ جليلة، وجعلَ لنا شعائِر عظيمة، وحثَّنا تعالى على تعظيمِها، وجعلَ ذلك علامةً على تقوَى القلوب، فقال - سبحانه -: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وفي إضافة التقوَى إلى القلوبِ بيانُ أنَّها محلُّها ومنشؤُها، وكفَى بهذا حثًّا على إصلاحِها والاهتِمام بها، وإذا صلَحَ القلبُ بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلَح الجسدُ كلُّه بالطاعة والتسليم والإذعان لربِّ العالمين.
عباد الله:
والحجُّ في شعائِرِه وأعمالِه وزمانِه ومكانِه يُرسِّخُ التوحيدَ في القلوب، وهو دليلٌ على إيمانِ مَن أدَّاه على الوجهِ المطلُوب، ومَن تأمَّلَ أذكارَ الحجِّ وجدَ فيها مِن توحيدِ الله تعالى وتعظيمِه وإجلالِه ما يُعلِّقُ القلوبَ به - سبحانه - وحدَه لا شريكَ له، ففي كل منسَكٍ ذِكرٌ ودُعاءٌ وتوحيدٌ.
فعندما يُحرِمُ الحاجُّ يُهِلُّ بالتوحيد قائلًا: "لبَّيك اللهم لبَّيك" أي: طاعةً بعد طاعةٍ، وإجابةً بعد إجابةٍ، وهذا دليلٌ على الاستِسلام لله تعالة والانقِياد له.
وعندما يجأرُ قائلًا: "لبَّيك لا شريك لك"، ويختِمُ التلبِيةَ بقولِه: "لا شريكَ لك" فإنَّما يُنادِي بعزم العقد على ألا يجعلَ لله شريكًا، ولا يصرِفَ شيئًا مِن العبادة لغيرِه، وبما أنَّه يعتقِدُ أنَّ الله واحدٌ لا نِدَّ له ولا نظير، ولا شَبِيهَ ولا مثِيل، وأنَّه المُحيِي والمُميت، وأنَّه الخالِقُ الرازق، وأنَّه النافعُ الضار، وأنَّه استأثرَ بعلم الغيبِ وحدَه، وله الكمالُ المُطلَق، وهو على كل شيءٍ قدير، وأنَّه مالِكُ المُلك، ومُدبِّرُ الكَون، وهو وحدَه صاحبُ السُّلطان القاهِر في هذا العالَم، يتصرَّفُ في مُلكِه كيفما يشاءُ ويختار.
بما أنَّه يعتقِدُ ذلك فلا يُشرِكُ به شيئًا بأن يدعُو غيرَ الله مِن الأولياء والصالِحين، أو يسجُدَ لغير الله لا لصنمٍ، ولا لبشرٍ، ولا لحجرٍ، ولا لشجرٍ، ولا يذبَح لغير الله، ولا ينذُرُ لمخلُوقٍ أو يسألَه الشفاعةَ ويتوكَّل عليه، أو يعتقِدَ فيه الضُّرَّ والنفعَ، والعطاء والمنع، والتصرُّف في الكَون، كلُّ ذلك مما يحذَرُه المُوحِّدُ الذي قال: "لبَّيك لا شريكَ لك".
كما أنَّه يحذَر مِن إتيان السَّحَرة والكُهَّان والمُشعوِذين، فهو أمرٌ مُحرَّمٌ لا شكَّ في تحريمِه، وسُؤالُهم وتصديقُهم وفعلُ ما يطلبُون مِن الذبح ونحوِه مِن الشِّرك الأكبر.
وعندما يقولُ الحاجُّ: "إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والمُلك" ففيها اعتِرافٌ لله بالحمد، وإقرارٌ بنعمتِه، واعتِرافٌ بمُلكِه؛ ولذا كان إلهَ الحق، وما سِواه مِن الآلهة باطل.
ومِن صُور التوحيد التي تتجلَّى في المناسِك: أنَّ الحاجَّ إذا طافَ بالبيت كبَّر عند رُكنه المُعظَّم، والتكبيرُ توحيدٌ وإقرارٌ بأنَّ الله تعالى أكبرُ مِن كل شيءٍ.
والسعيُ بين الصفا والمروة مِن الشعائِر العظيمة، فيرقَى الحاجُّ على الصفا ويقولُ: "لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ، وله الحمدُ، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحدَه أنجَزَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه" كم في هذا الذِّكر مِن التوحيدّ! فيُوحِّدُ الله تعالى ويُكبِّرُه، ثم يُهلِّلُه - سبحانه -، والتهليلُ هو أخصُّ ذِكرٍ للتوحيد.
وليُعلَم - عباد الله - أنَّ أصلَ الطوافِ بالصفا والمروة مأخُوذٌ مِن تطواف هاجَر وتردادها بين الصفا والمروة في طلبِ الماء، وهي مُتذلِّلةٌ خائفةٌ وجِلَة، مُضطرَّةٌ فقيرةٌ إلى الله، حتى كشَفَ الله كُربتَها، وآنسَ وحشتَها، وفرَّج شدَّتَها، وفجَّر لها ماءَ زمزم المُبارَك.
فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضِر فقرَه وذُلَّه وحاجتَه إلى الله في هدايةِ قلبِه، وصلاحِ حالِه، وغفران ذنبِه، وأن يلتجِئَ إلى الله تعالى ليُزيحَ ما هو به مِن النقائص والعيُوب، وأن يهدِيَه إلى الصراط المُستقيم، وأن يُثبِّتَه عليه إلى الممات، وأن يُحوِّلَه مِن حالِه الذي هو عليه مِن الذنوب والمعاصِي إلى حالِ الكمال والغُفران، والسداد والاستِقامة، كما فعلَ بهاجَر - عليها السلام -.
وفي عرفات ذلك الموقِف الذي خُصِّصَ لأخصِّ دلائِل التوحيد، وهو الدُّعاء، وأخصُّ دُعاءٍ في ذلك اليوم هو كلمةُ التوحيد: "لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ، وله الحمدُ، وهو على كل شيء قدير".
وفي مُزدلِفة يدعُو الحاجُّ ربَّه ويُكبِّرُه ويُهلِّلُه ويُوحِّدُه، وفي العودة إلى مِنى بعد مُزدلِفة لا يزالُ يُلبِّي حتى يرمِيَ جَمرةَ العقبة.
وفي رمي الجَمَرات أيام التشريق تكبيرٌ وموقِفٌ للدُّعاء طويل. وهكذا في كل مشعَرٍ مِن مشاعِر الحجِّ ذِكرٌ ودُعاءٌ وتوحيدٌ؛ لأنَّ غايةَ الحجِّ ترسيخُ التوحيد في القلوب.
فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
ومِن مظاهِر التوحيد - عباد الله - ما جاء في قولِ البارِي - سبحانه -: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: 34].
ومِن المعانِي المُستنبَطة مِن الآية الكريمة: توحيدُ الله تعالى؛ إذ تُذبَحُ الأُضحية على اسمِ الله، ولذلك سمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الأُضحية وكبَّر، وقال: «بسمِ الله والله أكبر».
كما أمرَه الله في قولِه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2] أي: وانحَر لربِّك، فإنهارُ الدم على اسمِ الله عبادةٌ عظيمةٌ مِن أفضل القُرُبات؛ لِما فيها مِن تعظيمٍ وتوحيدٍ، وخضوعٍ وتذلُّلٍ لله - سبحانه -، ولذلك كان ذبحُ الأُضحية أفضلَ مِن التصدُّق بثمنها.
عباد الله:
وكانت العربُ في الجاهليَّة قد انحرَفَت عن دينِ الخليلِ - عليه السلام - إلى عبادةِ الأوثان؛ إذ كانوا يتقرَّبُون لها بالذبح مِن دون الله تعالى، فلما بعثَ الله النبيَّ الخاتمَ - عليه الصلاة والسلام - أعادَ الحنيفيَّة ملَّة إبراهيم، ووجَّه الذبحَ لمَن يستحقُّ العبادةَ دون سِواه، فشُرِعَت الأضاحي والهدايا تُذبَح لله تعالى وعلى اسمِه، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: 162] أي: ذبحِي، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162، 163].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لعنَ الله مَن ذبَحَ لغير الله»؛ رواه مسلم.
فكانت الأُضحيةُ شعيرةً ظاهرةً، وسُنَّةً باقية، وهي دليلٌ على التوحيد أن يُذبَحَ لله تعالى ولا يُذبَح لغيرِه، وحُرِّمَت الذَّبيحةُ إذا ذُبِحَت لغير الله تعالى؛ كتعظيمِ الأصنام، أو الأشخاص، أو القبور، أو نحوِها، ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
عباد الله:
علينا أن نستشعِر ونحن نتقرَّبُ إلى الله بذبح الهدايا والأضاحِي أنَّه تعالى لا يصعَدُ إليه شيءٌ مِن لحمها الذي نذبَحُه، فالله غنيٌّ عنا وعن لحومِها، ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 37].
يبلُغُ إليه تقوَى قلوبِكم، ويصِلُ إليه إخلاصُكم له وإرادتُكم بذلك وجهَه؛ فإنَّ ذلك هو الذي يقبَلُه ويُجازِي عليه.
والواجِبُ علينا أن نُخلِصَ لله ونحن نتقرَّبُ إليه بهذه الأضاحِي وجميعِ القُرُبات، فلا رِياءَ ولا سُمعةَ ولا مُباهاة، وإنَّما توحيدٌ وإخلاصٌ لله، وبهذا يتبيَّنُ خطأُ مَن يحرِص على أن تُلتقَطَ له الصورُ وهو في حالِ العِبادة، يُصلِّي أو يدعُو أو يطُوف؛ ليرَى أهلُه وقرابتُه وأصحابُه عملَه ويمدَحُونه، أو يُحبُّ إذا رجعَ إلى بلدِه أن يُتلقَّى بـ "الحاج فُلان"، والثناء عليه بما قدَّم.
فلنحذَر ذلك - عباد الله -، فهو مما يشُوبُ العملَ ويُنافِي الإخلاص.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله - تبارك وتعالى -: أنا أغنَى الشُّركاء عن الشِّرك، مَن عمِلَ عملًا أشركَ فيه معي غيرِي تركتُه وشِركَه»؛ رواه مسلم.
إخوة الإسلام:
وعندما نتقرَّبُ إلى الله بهذه القرابين؛ مِن ذبح الضَّحايا والهدايا لله ربِّ العالمين، فإنَّنا نتذكَّرُ قُربانَ خليلِ الله إبراهيم - عليه السلام -، الذي أرادَ أن يُضحِّيَ بابنِه إسماعيل امتِثالًا لأمرِ الله، فكانت مُبادرتُه - عليه السلام - بتنفيذِ أمرِ ربِّه في ذبحِ ابنِه، وموقفِ ابنِه البارِّ مِن الرُّضوخ والصَّبر والاستِسلام، تذكِرةً لنا بالاستِسلام لله، والطاعة له والإذعان، وأنَّ الله تعالى يُكافِئُ العبد؛ فمَن تركَ شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا مِنه.
ومما يُستنبَطُ مِن الآية السابِقة كذلك: أنَّ قولَه - عزَّ وجل -: ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: 34] فيه طلبُ الخُضوع بالطاعة للإله الحق، والتذلُّل له بالإقرار بالعبودية.
والمغزَى الذي نستفيدُه مِن هذا: أن نستسلِمَ لحُكم الله وطاعته، وننقادَ له تعالى في جميع تكالِيفه، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 208]، فدخُولُهم في الإسلام دخولٌ شامِلٌ؛ بحيث لا يتخيَّرُون بين شرائِعِه وأحكامِه، فما وافقَ مصالِحَهم وأهواءَهم قبِلُوه وعمِلُوا به، وما لم يُوافِق ردُّوه أو تركُوه وأهمَلُوه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أمة الإسلام:
ما أعظم مرابِح مَن حجَّ البيت حجَّة مبرورة، وأكثر مغانِمه.
فعن ابن عُمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: جاء إلى النبيِّ أنصاريٌّ، فأقبَلَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «سَلْ عن حاجتِك، وإن شِئتَ أخبَرتُك»، قال: فذلك أعجَبُ إلَيَّ، قال: «فإنَّك جِئتَ تسألُني عن خُروجِك مِن بيتِك تؤُمُّ البيتَ الحرامَ، وتقولُ: ماذا لِي فيه؟ وجِئتَ تسألُ عن وقوفِك بعرفة، وتقولُ: ماذا لِي فيه؟ وعن رميِك الجِمار، وتقولُ: ماذا لِي فيه؟ وعن طوافِك بالبيتِ، وتقولُ: ماذا لِي فيه؟ وعن حلقِك رأسَك، وتقولُ: ماذا لِي فيه؟»، قال: إي والذي بعثَك بالحقِّ.
قال: «أما خُروجُك مِن بيتِك تؤُمُّ البيتَ، فإنَّ لك بكل وطاءةٍ تطَؤُها راحلتُك يكتُبُ الله لك بها حسنة، ويمحُو عنك بها سيئة، وأما وقوفُك بعرفة، فإنَّ الله - عزَّ وجل - ينزِلُ إلى السماء الدنيا، فيُباهِي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادِي جاءُوني شُعثًا غُبرًا مِن كل فجٍّ عمِيق، يرجُون رحمَتي، ويخافون عذابِي، ولم يرَوني، فكيف لو رأَوني؟! فلو كان عليك مِثلُ رمل عالِجٍ، أو مِثلُ أيام الدنيا، أو مِثلُ قَطر السماء ذنوبًا غسَلَ الله عنك، وأما رميُك الجِمار، فإنَّه مذخُورٌ لك، وأما حلقُك رأسَك، فإنَّ لك بكل شعرةٍ حسنة، فإذا طُفتَ بالبيتِ خرَجتَ مِن ذنوبِك كيوم ولَدَتْك أمُّك»؛ رواه الطبراني.
أقولُ هذا القَولِ، وأستغفِرُ الله لي ولكم، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي خلقَ فسوَّى، وقدَّر فهدَى، وشرعَ لنا مِن الدين هذه العبادات العظيمة لنُوحِّدَه ونُكبِّرَه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
ففي هذا اليوم الأغَر يوم النَّحر يتوجَّهُ الحُجَّاجُ إلى مِنى لرمي جَمرة العقبة بسبع حصَيَاتٍ مُتعاقِبات، فإذا فرَغَ الحاجُّ مِن رميِ جَمرة العقبة ذبَحَ هَديَه إذا كان مُتمتِّعًا أو قارِنًا، ويجوزُ الاشتِراكُ في الهَدي إن كان إبلًا أو بقرًا، أما الشاةُ فلا تُجزِي إلا عن شخصٍ واحدٍ، فإن عجَزَ عن الهَدي صامَ عشرةَ أيام ثلاثةً في الحجِّ وسبعةً بعد رجوعِه لبلدِه، ثم يحلِقُ الحاجُّ رأسَه أو يُقصِّرُه، ثم يتوجَّهُ إلى مكَّة ليطُوفَ طوافَ الإفاضة، وهو رُكنٌ مِن أركان الحجِّ لا يتمُّ الحجُّ إلا به؛ لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
وبعد الطواف يسعَى بين الصَّفا والمروَة إن كان مُتمتِّعًا، أم القارِنُ والمُفرِدُ فليس عليهما إلا سعيٌ واحدٌ.
ويحصُلُ التحلُّلُ الثاني بثلاثة أمور هي: رميُ جَمرة العقبة، والحلقُ أو التقصير، وطوافُ الإفاضة، فإذا فعلَ الحاجُّ هذه الأمور الثلاثة حلَّ له كلُّ شيءٍ حرُمَ عليه بالإحرام حتى النساء، وإن قدَّم أو أخَّر شيئًا مِنها فلا حرَجَ - إن شاء الله -؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - ما سُئِلَ يوم النَّحر عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افعَل ولا حرَج».
حُجَّاج بيت الله:
واتِّباعًا لهَدي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القائل: «خُذوا عنِّي مناسِكَكم»، فالحُجَّاجُ الليلةَ يبيتُون بمِنى، ويوم غدٍ هو اليوم الحادِي عشر مِن ذي الحجَّة أول أيام التشريق المُبارَكة، التي قال الله - عزَّ وجل - فيها: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203].
قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: "هي أيامُ التشريق".
وقال فيها - عليه الصلاة والسلام -: «أيامُ التشريق أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرٍ لله - عزَّ وجل -»؛ خرَّجه مسلم وغيرُه.
فأكثِرُوا - رحمكم الله - مِن ذكرِ الله وتكبيرِه في هذه الأيام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
لقد خطَبَ النبيُّ في الناس يوم النَّحر خُطبةً بليغةً، أعلَمَهم فيها بحُرمة يوم النَّحر وفضلِه عند الله، وحُرمة مكَّة على جميعِ البلاد، وأمرَ بأخذ مناسِكهم عنه، وقال: «لعلِّي لا أحُجُّ بعد عامِي هذا».
وعلَّمَهم مناسِكَهم، ونهَى الناسَ أن يرجِعُوا بعدَه كفَّارًا يضربُ بعضُهم رِقابَ بعضٍ، وأمرَ بالتبليغِ وأخبَرَ أنَّه «رُبَّ مُبلّضغٍ أوعَى مِن سامِع».
وقال في خُطبتِه تلك: «لا يَجنِي جانٍ إلى على نفسِه»، وقال: «إنَّ الشَّيطان أيِسَ أن يُعبَد ببلدِكم، ولكن سيكونُ له طاعةٌ في بعضِ ما تحتقِرُون مِن أعمالِكم، فيرضَى بها».
وقال: «اتَّقُوا اللهَ ربَّكم، وصلُّوا خمسَكم، وصُومُوا شهرَكم، وأدُّوا زكاةَ أموالِكم، وأطيعُوا ذا أمرِكم؛ تدخُلوا جنَّةَ ربِّكم».
وودَّعَ حينئذٍ الناس، فقالوا: "حجَّة الوداع"، كما خطَبَهم - صلى الله عليه وسلم - أيضًا أوسَطَ أيام التشريق خُطبةً عظيمةً بليغةً، بيَّن فيها حُرمةَ ذلك اليوم والشهر والبلَد، وبيَّن حُرمةَ الدم والعِرض التي اتَّفَقَت المِللُ على حُرمتها، وحذَّر فيها مِن الظُّلم والتعدِّي على المال، وأنَّه لا يحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلمٍ بغير طِيبِ نفسٍ مِنه.
وبيَّن في خُطبته تلك أنَّ الزمانَ استدارَ كهيئتِه يوم خلقَ السماوات والأرض، وأنَّ ربَّهم واحد، وأباهم واحد، وأنَّه لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأسود على أحمَر، ولا لأحمر على أسوَد إلا بالتقوَى.
معاشِر المُسلمين:
إنَّ نبيَّنا - عليه الصلاة والسلام - قد علَّمَنا مِن خلال حجَّته دروسًا عظيمة، وإرشاداتٍ جليلة تُعدُّ نبراسًا لنا في حياتِنا؛ فمِن ذلك: التأكيدُ على حُرمة المُسلم وتعظيم شأنِه، وإذا كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد نهَى عن ترويعِ المُؤمن، فكيف بما هو أعظمُ مِن ذلك؟!
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لزوالُ الدُّنيا أهوَنُ على الله مِن قتلِ رجُلٍ مُسلم».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو أنَّ أهلَ السَّماء والأرضِ اشتَرَكُوا في دمِ مُؤمنٍ لأكبَّهم الله في النَّار»؛ رواهما الترمذي.
وعن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما - قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يطُوفُ بالكعبة ويقول: «ما أطيَبَكِ وأطيَبَ رِيحَكِ، ما أعظمَكِ وأعظمَ حُرمتَكِ، والذي نفسُ مُحمدٍ بيدِه؛ لحُرمةُ المُؤمن أعظمُ عند الله حُرمةً مِنك مالِه ودمِه، وأن نظُنَّ به إلا خيرًا»؛ رواه ابن ماجه.
كما حرِصَ - صلى الله عليه وسلم - على حمايةِ الناسِ وعدم إيذائِهم أو إلحاق الضَّرر بهم، أو أن يرتكِبَ المرءُ فعلًا يُؤدِّي إلى انتِهاك حُرمتهم، فضلًا عن أن يُؤدِّي إلى قتلِهم.
فعن قُدامة بن عبد الله قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحر يرمِي جَمرةَ العقبة على ناقة صَهباء، لا ضربَ، ولا طردَ، ولا إليك إليك"؛ رواه أحمد.
ومعنى "إليك إليك" ابتعِد وتنَحَّ.
وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: أفاضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن عرفة وعليه السَّكينة، وردِيفُه أُسامة، وقال: «أيها الناس! عليكُم بالسَّكينة؛ فإنَّ البرَّ ليس بإيجافِ الخيل والإبل»؛ رواه أبو داود.
وقد أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - بقولِه: «يا عُمر! إنَّك رجُلٌ قويٌّ، لا تُزاحِم على الحَجر فتُؤذِي الضَّعيف».
وبِناءً على ذلك؛ نُذكِّرُ إخوانَنا الحُجَّاجَ الكِرام وهم يُتِمُّون المناسِك أن يُؤدُّوها بسَكينةٍ ووقار، وطُمأنينةٍ وخُشوع، وأن يُحافِظُوا على سلامةِ إخوانِهم المُسلمين، وأن يرفُقُوا بحالِهم، فيحذَرُوا التدافُع والتزاحُم وأذيَّة الخلق، وخاصَّةً في الطواف، وعند رمي الجَمَرات، والتنقُّل بين المشاعِر وأداءِ المناسِك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
واعلَمُوا - حُجَّاج بيت الله الحرام - أنَّ التأخُّر إلى اليوم الثالثِ عشر فيه استِنانٌ بسُنَّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو أفضلُ وأكملُ وأعظمُ أجرًا.
فقد رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للناسِ في التعجُّل، ولم يتعجَّل هو، بل أقامَ بمِنى حتى رمَى الجَمَرات في اليوم الثالثِ عشر بعد الزوال، ثم ارتحَلَ قبل أن يُصلِّي الظُّهر.
كما أنَّ التأخُّر لليوم الثالِثِ فيه إرفاقٌ للآخرين، ومصلَحةٌ لجُموع الحَجِيج؛ فخروجُ الناسِ كلِّهم في اليوم الثاني وتعجُّلهم جميعًا قد يُفضِي إلى المُزاحمَة والمشقَّة، وإلحاق الضَّر ببعضِهم.
عباد الله:
إنَّنا إذ نذكُرُ في هذا المقام إخوانَنا الحُجَّاج ونغبطُهم على ما يسَّرَ لهم، لنسألُ الله أن يتقبَّل منهم، وأن يُيسِّرَ أمورَهم، وأن يُعيدَهم إلى بُلدانهم سالِمين، وبالأجر غانِمين.
وعليهم أن يتذكَّرُوا أنَّ مِن خصائصِ البيتِ الحرامِ التي ميَّزه الخالِقُ العظيمُ بها أن جعلَه بيتَ الهُدى، ومنبَعَ الهداية والرشاد، كما قال تعالى في وصفِ بتِه المُحرَّم: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96].
فعلى مَن منَّ الله عليهم بحجِّ بيتِه الحرام أن يُترجِمُوا ما انتفَعُوا به في هذا الموسِمِ واقِعًا إذا رجعوا إلى ديارِهم، بأن يكونوا قُدوةً حسنةً، ويكونوا هُدًى لأهلِهم وأولادِهم وقرابَتهم وأصحابِهم، وأن لا يعودوا إلى المعاصِي والذنوبِ، بل يحرِصُوا أن تكون صحيفتُهم بيضاء ناصِعةً نقيَّةً.
وكيف يعودُ المرءُ لتلك القبائِح والمُوبِقات، وقد نالَ مِن الهُدى في حجِّه ما نال؟! فكما وفَّقَكم الله فاستَمتَعتم بالبيت الحرام، ووقَفتُم بعرفة، وأتَيتُم مُزدلِفةَ المشعرَ الحرامَ، فاشكُرُوا اللهَ على هداكم إليه، واتَّقُوه ولا تعصُوه، واستقيمُوا على شرعِه وتوبُوا إليه.
عباد الله:
وبعد أن منَّ الله علينا بأداء هذا النُّسُك العظيم، وبلوغ هذا العيد المُبارَك، وإظهار الفرَح به، فلنتذكَّر إخوةً لنا في الدين أصابَهم ما أصابَهم مِن قِبَل أعداءِ الدين مِن الاضطِهاد والتعذيب والتنكيل، يُذبَّحُون ويُحرَّقُون، وبالقصف يُقتَّلُون في شتَّى بِقاع الأرض، فيمُرُّ العيدُ بهم وقد حُرِمُوا الفرحة والسُّرور، ومُنِعُوا رؤيةَ أهلِيهم وقرابتهم وذوِيهم.
فنسألُ الله أن يُفرِّجَ همَّهم، ويُنفِّسَ كربَهم، وأن يُبدِّلَ خوفَهم أمنًا، وذُلَّهم عزًّا، وحُزنَهم فرحًا.
وإلى أخواتنا المُسلمات نقولُ: يا إماءَ الله .. يا شقائِقَ الرِّجال .. يا معشَرَ النساء! عليكُنَّ بتوحيد الله وطاعتِه، وتمسَّكن بشرع الله، واحرِصن على مرضاة ربِّكنَّ وطاعتِه، وحافِظن على حيائِكنَّ وعفافِكنَّ، وحِشمتكنَّ وحجابكنَّ، وابتعِدنَ عن التبرُّج والسُّفور والاختِلاط.
واعلَمن أنَّ مُحافظةَ المرأة على دينِها، وتربيتَها لنفسِها على الفضيلة ومكارمِ الأخلاق، ورعايتها لمَن تحت يدَيها مِن رعِيَّة وتنشِئتهم النشأة الصالِحة لهُو أعظمُ وسيلةٍ لمُواجهة أعداء الدين الذين يسعَون إلى تغيير هُويَّة المُجتمع المُسلم وإفساد أهلِه.
وتذكَّرن - أيها الأخوات - قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامَت شهرَها، وحفِظَت فَرجَها، وأطاعَت زوجَها؛ قيل لها: ادخُلِي الجنَّة مِن أي أبوابِ الجنَّة شئتِ»؛ رواه أحمد.
فإذا حقَّقَت المرأةُ هذه الشروط كانت موعودةً بدخول الجنة مِن أي أبوابِها الثمانية شاءَت.
وأنتُم - يا عباد الله - تذكَّرُوا أنَّ نبيَّكم قد أوصَى بالنساء والإحسانِ إليهنَّ، فاعمَلُوا بوصيَّة نبيِّكم، قُومُوا بما يجِبُ عليكم.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، اللهم ألِّف بين قلوبِنا، وأصلِح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبُل السلام، ونجِّنا مِن الظُّلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحِشَ ما ظهر مِنها وما بطَن، وبارِك لنا في أسماعِنا وأبصارِنا وقلوبِنا، وأزواجِنا وذريَّاتِنا، وتُب علينا إنَّك أنت التوَّابُ الرحيم، واجعَلنا شاكِرين لنعمِك، مُثنِين بها عليك، قابِلينَ لها، وأتمِمها علينا.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، واجعَل اللهم ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقاك واتَّبَع رِضاك يا أرحم الراحمين، اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّ وترضَى مِن الأقوال والأفعال، وخُذ بناصيتِه للبرِّ والتقوَى.
اللهم مَن أرادَ بلادَنا وسائِرَ بلاد المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، ورُدّض كيدَه في نحرِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم احفَظ بلادَ الحرمَين ومُقدَّسات المُسلمين مِن شرِّ الأشرار، وكيدِ الفُجَّار، ومِن عبَثِ العابِثين، وكيدِ الكائِدين، وعُدوان المُعتَدين.
اللهم اجعَل بلدَنا هذا آمنًا مُطمئنًّا سخاءً رخاءً، وسائرَ بلاد المُسلمين.
اللهم وأبرِم لهذه الأمة أمرَ رُشدٍ يُعزُّ فيه أولياؤُك، ويُذلُّ فيه أعداؤُك، ويُؤمرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المُنكَر يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم إنا نسألُك أن تنصُر إخوانَنا المُستضعَفين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين على الثُّغور، وحُماةَ الحدود، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا، اللهم أنزِل عليهم السَّكينةَ والصَّبر، وثبِّت أقدامَهم، وانصُرهم على القوم الكافِرين، اللهم عجِل فرَجَهم يا رحمن يا رحيم.
اللهم خُذ الطُّغاةَ المُتجبِّرين، واقمَعهم يا قويُّ يا عزيز، اللهم فرِّق شملَهم، وشتِّت جمعَهم، واجعَل دائرةَ السَّوء عليهم، وألقِ الرُّعبَ في قلوبِهم، اللهم إنَّهم لا يُعجِزونَك.
اللهم اغفِر لنا أجمعين، وتقبَّل منَّا صالِحَ أعمالِنا، وتجاوَز عن تقصِيرِنا، وأخرِجنا مِن ذنوبِنا كيوم ولَدَتنا أمَّهاتُنا.
لا تُفرِّق جمعَنا هذا إلا بذنبٍ مغفُور، وعملٍ مبرُور، وسعيٍ مشكُور يا رحيمُ يا غفور.
اللهم اهدِنا صراطَك المُستقيم، وارزُقنا الاستِقامةَ على شرعِك القويم، وثبِّتنا على الدين.
اللهم أحسِن عاقبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزي الدنيا وعذابِ الآخِرة.
اللهم أعِد علينا هذا العيد وعلى الأمة الإسلامية وهي ترفُلُ في ثوبِ العزَّة والكرامة، والنصر والتمكين يا رب العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

التحذير من مساوئ الأخلاق
ألقى فضيلة الشيخ صلاح البدير - حفظه الله - خطبة عيد الأضحى بعنوان: "التحذير من مساوئ الأخلاق"، والتي تحدَّث فيها عن فضل يوم النَّحر وأيام التشريق، ثم بيَّن اعتِقادَ أهل السنَّة والجماعة في الولاية والجماعة وتحذيرِهم مِن البِدَع والأهواء في ذلك، كما حذَّرَ مِن السِّباب والشَّتم والاختِلاف المُؤدِّي إلى التقاطُع والتدابُر، وغيرِ ذلك مِن مساوئ الأخلاق، وعرَّج في نهايةِ خُطبتِه على ذِكرِ أهمِّ أحكامِ الأُضحية وآدابِها.
الخطبة الأولى
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسُبحان الله بُكرةً وأصيلًا.
الله أكبر بُكرةً وعشيًّا، يغدُو بها القلبُ المُحبُّ رضِيًّا .. الله أكبر في الظلام إذا دجَا، وبدَا لنا القمرُ المُنيرُ بهِيًّا .. الله أكبر في الصباح إذا سرَى مِنه الضِّياءُ إلى القلوبِ نديًّا .. الله أكبر مَن يُدعَى، وأكرمُ مَن يرُجَى، وأعظمُ مَن يُنيلُ نوالًا .. الله أكبر محبَّةً وخضوعًا وتعظيمًا وإجلالًا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمدُ لله لا أبغِي به بدلًا، حمدًا يُبلِّغُ مِن رِضوانِه الأمَلا، أحمدُه أبلغَ الحمد وأكملَه وأتمَّه وأعظمَه وأشملَه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له أسبَغَ علينا جزيلَ نعمِه وألطافه العِظام، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى جميعِ الأنبِياء وآلِ كلٍّ وأتباعِهم الكِرام صلواتٍ مُتضاعِفاتٍ زاكِياتٍ دائِماتٍ بلا انفِصام.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمُون:
اتَّقوا ربَّكم؛ فقد فازَ المُتَّقِي، وخسِر المُسرفُ الشَّقي، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
أيها المُسلمُون:
هنيئًا لكم هذا اليوم المجيد .. هنيئًا لكم يوم العيد السعيد .. هنيئًا لكم يوم الحجِّ الأكبر .. هنيئًا لكم يوم النَّحر الأزهر .. هنيئًا لكم يوم الجَمع الأعظم.
|
هبَّ النَّسيمُ فأهدَى القلبَ أشواقَا |
|
وساقَ نحوِي مِن الأفراحِ ما ساقَا |
عن عبد الله بن قُرطٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ أعظمَ الأيام عند الله - تبارك وتعالى - يومُ النَّحر، ثم يومُ القَرِّ»؛ أخرجه أبو داود.
الوقوفُ في ليلتِه، والرميُ والنَّحرُ والطوافُ في صبيحته. فما أعظمَه مِن يومٍ، وما أكرمَه مِن جمعٍ.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُلسلمون:
منذ أن وطَّد بوانِي الدين وأرساها، وشادَ شُرَفَ الإسلام وأسماها إمامُ الحُنفاء، ووالِدُ الأنبِياء، وبانِي الكعبة المُعظَّمة إبراهيمُ الخليلُ - صلى الله عليه وسلم -، والوفودُ المُؤمنةُ تحِنُّ إلى البيت المُكرَّم، والبلدِ المُحرَّم، لا تقضِي مِنه وطَرًا، ولا تنته مِنه تعبُّدًا وتفكُّرًا ونظرًا.
فسُبحان الإله المعبُود الذي شرعَ لنا هذه الشعائِر، وهدانا لهذه المشاعِر والدلائِل، وشرَّفَنا بتلك المعالِم والعلائِم.
|
سُبحانَه ثم سُبحانٌ يعودُ لهُ |
|
وقبلَنا سبَّحَ الجُوديُّ والجُمُدُ |
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
مِن جلائِل النِّعَم، وقلائِد المِنَن، وأعظمِ مفاخِرِ الزمان ومكارمِه ومآثِرِه: أن خصَّ الله هذه البلادَ المُبارَكة بخدمة الحرمَين الشريفَين والمشاعِر المُقدَّسة، ورِعايةِ أمرِ الحجِّ والحَجيج، فقلَّدَها كرامتَه، وأعطاها قيادتَه، وأنالَها سيادتَه.
|
فأكرِم بها مِن نعمةٍ وعطيَّةٍ |
|
وأعظِم بها أعظِم بها ثم أعظِمِ |
وقد نذرَ ملوكُ هذه الدولة السنيَّة وأمراؤُها ورِجالُها أنفسَهم لخدمة الحَجِّ والحَجيج.
|
فساسُوا أمورَ الحجِّ خيرَ سياسةٍ |
|
لها اللهُ والإسلامُ والدينُ شاكِرُ |
|
وفينا لدينِ الله عِزٌّ ومنعَةٌ |
|
ومنَّا لدينِ الله سَيفٌ وناصِرُ |
ولكنَّ العدوَّ إذا رأَى نعمةً بهَتْ، وإذا رأَى عثْرةً شمَتْ، وإذا رأَى مأثرةً صمَتْ.
|
يُخفِي العداوةَ وهي غيرُ خفِيَّةٍ |
|
نظرُ العدوِّ بما أسرَّ يَبُوحُ |
|
خليلَيَّ للبغضاء عينٌ مُبِينةٌ |
|
وللحُبِّ آياتٌ تُرَى ومعارِفُ |
والعداءُ لهذه البلاد المُبارَكة، ومُحاولةُ زعزعة أمنِها واستِقرارِها هو عداءٌ لقبلة المُسلمين ومُقدَّساتهم وحُرماتهم، وحجِّهم ونُسُكهم، وعداءٌ للمُسلمين، على حدِّ القائِل:
|
ولستَ ملِيكًا هازِمًا لنَظيرِهِ |
|
ولكنَّه التوحِيدُ للشِّركِ هازِمُ |
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
مِن أصول أهل الإيمان، أصحابِ الحديثِ والسنَّة، حفَظة الدين وخزَنَته، وأوعِية العلمِ وحمَلَته: تعظيمُ الكتاب والسنَّة، الكتابُ عُدَّتُهم، والسنَّةُ حُجَّتُهم، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قُدوتُهم، يُعلِّمُون التوحيدَ والعقيدة، وينصُرون الشريعة، ويهدِمُون البِدَع الشَّنِيعة، وليس لهم متبُوعٌ يتعصَّبُون له إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعلَمُون أحوالَه، ويُعظِّمُون أقوالَه، يعتقِدُونها ويعتمِدُونها، ويُصدِّقُونها ويقبَلُونها، ويُسلِّمُون لها ولا يُعارِضُونها.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
إنَّكم تعيشُون في بُحبُوحةٍ مِن الأمن الشديد المديد، ورزقٍ مُخصِبٍ رفيهٍ غزيرٍ كثيرٍ رغيد، والناسُ مِن حولِكم يُسلَبُون قتلًا وأسرًا وسِباءً، ويُقاسُون بلاءً ووباءً، ويُكابِدُون غلاءً وجلاءً وفناءً. فاحفَظُوا أمنَكم ووطنَكم واستِقرارَكم، فكم مِن وطنٍ اختلفَت فيه الكلمة، وانحلَّ فيه عِقدُ الولاية، وسقَطَت مِنه هيبةُ الحُكم، فلا إمام ولا جماعة، فتقاتَلَ أهلُه، وتمزَّقَ شملُه، وضاعَ أمنُه، والأمنُ إذا اختلَّ عظُمَ فقدُه، وعسُرَ ردُّه.
قال عمرو بن العاصِ - رضي الله عنه - في وصيَّتِه لابنِه: "يا بُنيَّ! إمامٌ عادلٌ خيرٌ مِن مطرٍ وابِل، وإمامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ خيرٌ مِن فتنةٍ تَدُوم".
وقال عبدُ الله بن المُبارَك - رحمه الله تعالى -:
|
إنَّ الجماعةَ حبلُ الله فاعتَصِمُوا |
|
فإنَّها العُروةُ الوُثقَى لمَن دانَا |
|
الله يدفَعُ بالسُّلطانِ مُعضِلةً |
|
عن دينِنا رحمةً مِنه ورِضوانَا |
|
لولا الأئمةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ |
|
وكان أضعَفُنا نهبًا لأقوَانَا |
وإذا التَجَّت الأصوات، وتعالَت الصَّيحات كان أول مَن يركَبُ ثبَجَها، ويستثمِرُ حدَثَها أعداءُ المُسلمين، الذين قامَت سياساتُهم على الاستِخفافِ بحقوقِ المُسلمين، واستِباحة أموالِهم، واجتِياح بلادِهم، وتدميرِ اقتِصادِهم، ومُحاربة دينِهم، والإسلامُ إذا حارَبُوه اشتدَّ، وإذا ترَكُوه امتدَّ، لا يَضِيرُه مَن حادَ عنه وارتَدَّ، ولا يضُرُّه مَن لجَّ في عداوتِه واحتَدَّ، وبأسُ الله عن أعداء دينِه لا يُردُّ.
ومَن رامَ هُدًى في غير الإسلام ضلَّ، ومَن رامَ إصلاحًا بغير الإسلام زَلَّ، ومَن رامَ عِزًّا في غير الإسلام ذلَّ، ومَن رامَ أمنًا بغير الإسلام ضاعَ أمنُه واختَلَّ.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
السِّبابُ لِقاحُ الفتنة، والسِّبابُ لا يرُدُّ شارِدًا، ولا يجذِبُ مُعانِدًا، وإنما يزرَعُ ضغائِنَ وأحقادًا، ويزيدُ المُخالِفَ إصرارًا وعِنادًا.
وتتسارَعُ الأحداثُ في الأمة، فلا يسمَعُ الناسُ صيحةً أو وجبةً أو حادثةً، دانيةً أو قاصِيةً إلا طارُوا إلى الشبكَة العنكبويتة يتَّخِذُون تلك الأحداث أُسبوبةً يتسابُّون بها، ويتشاتَمُون عليها، يهرَعُون إلى مواقِع التواصُل الاجتماعيِّ ما بين حاذِفٍ وقاذِفٍ، وطاعنٍ ولاعِنٍ، وسابٍّ وشاتِمٍ إلا مَن رحِمَ الله، وقليلٌ ما هُم.
فيا مَن تُسطِّرُون اللَّعائِن والشتائِم، وتُطلِقُون التُّهَم والأحكام! ستُسألون عما تكتُبُون في يومٍ تجتمِعُ فيه الخلائِق، وتُوزَنُ فيه الأعمالُ والدقائِق، وتأتي كلُّ نفسٍ معها شاهِدٌ وسائِق.
يا مَن توارَى وراء شاشَةِ جِهازِه .. يا مَن استَتَرَ باسمٍ مُستعار، وتباعَدَ عن الأنظار، وصارَ يكِيلُ السبَّ والشّضتمَ لغيره! أنسِيتَ أنَّ الله يراك، وهو مُطَّلِعٌ على سرِّك ونجواك؟! وليس المُؤمنُ بالطعَّان ولا اللعَّان ولا الفاحِش ولا البذِيء.
فتُب مما كتَبَت يداك، وامحُ سبَّك أو أذاك، وتذكَّر قولَ خالِقِك ومولاك: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء: 53].
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
تعايَشُوا بالإسلام والسلام، والمحبَّة والوِئام، فلا تحلُو المُخالَطة إلا بحُسن المُعايَشَة، وأداء حقوق المُعاشَرة، وتحقيق العدل والنَّصَفة في المُعاملة.
ومَن كان في إيفاءِ ما يكونُ عليه مثلَ ما يكونُ في حفظِ ما يكون له؛ فقد أنصَفَ في القضاء، وعدَلَ بالسَّواء، والاستِقصاء يُورِثُ الاستِعصاء، والمُعاسَرة تُكدِّرُ المُعاشَرة، ومَن أخطاَ طريقَ التغافُل والتغاضِي والتسامُح كثُرَ مُعادُوه، وقلَّ مُصافُوه، وهجَرَه مُحِبُّوه، وزهِدَ فيه مُعاشِرُوه.
ومَن جهِلَ مواضِعَ رُشدِه، وتعثَّرَ في ذيُولِ جهلِه؛ ركِبَ متنَ الفجُور في الدعاوَى والمُنازعَات، والكذِبِ في الشكاوَى والخُصُومات، واختارَ الجفاءَ على الإخاء، والعداءَ على الولاء، والمُخاشَنة على المُلايَنة، تُعاشِر فيُعاسِر، وتُقارِب فيُحارِب، وتُحالِف فيُخالِف، وتُلاحِق فيُفارِق.
ونبيُّنا وسيِّدُنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقاطَعُوا، ولا تدابَرُوا، ولا تباغَضُوا، ولا تحاسَدُوا، وكونُوا عبادَ الله إخوانًا»؛ أخرجه مسلم.
ومَن بسَطَ للناسِ فِراشَ التوقير، ومدَّ لهم بِساطَ التقدير، والتمَسَ لهم الحُجَجَ والمعاذِير ولو مع الإساءة له والتقصير، عاشَ في النفوسِ مُعظَّمًا، وعلى الألسُن مُبجَّلًا.
|
وكنتُ إذا عقَدتُ حِبالَ قومٍ |
|
صحِبتُهُمُ وشِيمَتِيَ الوفاءُ |
|
فأُحسِنُ حين يُحسِنُ مُحسِنُوهم |
|
وأجتَنِبُ الإساءةَ إن أساءُوا |
|
أشاءُ سِوَى مشيئتِهم فآتِي |
|
مشيئتَهم وأترُكُ ما أشاءُ |
وقد قيل: "في إغضائِك راحةُ أعضائِك".
وقيل: "الأديبُ العاقِلُ هو الفطِنُ المُتغافِل".
فتعافَوا بينَكم، وتجاوَزُوا عمَّن أساءَ إليكم، واخرُجوا مِن ضِيقِ المُناقَشَة إلى فُسحة المُسامَحَة، ومِن شدَّة المُعاسَرة إلى سُهولة المُعاشَرة، واطوُوا بِساطَ التقاطُع والوحشة، وصِلُوا حبلَ الأُخُوَّة والمودَّة والقَرابة، واقبَلُوا المعذِرة؛ فإنَّ قبُول المعذِرة مِن محاسِنِ الشِّيَم، وإذا قدَرتُم على المُسيء فاجعَلُوا العفوَ عنه شُكرًا لله للقُدرة عليه.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
لا خُلدَ في الدنيا يُرتجَى، ولا بقاءَ فيها يُؤمَّل.
|
وما الناسُ إلا راحِلٌ وابنُ راحِلِ |
|
وما الدَّهرُ إلا مرُّ يومٍ وليلةٍ |
وما المَوتُ إلا نازِلٌ وقريبُ .. وما نفَسٌ إلا يُباعِدُ مولِدَا، ويُدنِي المنايا للنٌّفوسِ فتخرُجُ.
ما أسرعَ الأيام في طيِّنا، تمضِي علينا ثم تمضِي بنا، فأيقِظُوا القلوبَ مِن مراقِدِ غفَلاتِها، واعدِلُوا بالنُّفوس عن موارِدِ شهواتها، وحافِظُوا على الصلوات الخمس المكتُوبات المفرُوضات، ولا تُفرِّطُوا في الفرائِضِ والواجِبات، ولا تستخِفُّوا بالحُرُمات، ولا تُجاهِرُوا بالمُنكَرات.
واعلَمُوا أنَّكم في أيامِ مُهَل مِن ورائِها أجَل، يحُثُّه عجَل، فمَن لم ينفَعه حاضِرُه فعازِبُه عنه أعوَز، وغائِبُه عنه أعجَز، وإنَّه لا نومَ أثقَلُ مِن الغفلَة، ولا رِقَّ أملَكُ مِن الشَّهوة، ولا مُصيبةَ كمَوتِ القلب، ولا نذيرَ أبلَغُ مِن الشَّيبِ، ولا مصِيرَ أسوأُ مِن النَّار.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ فاستغفِرُوه، إنه كان للأوابِين غفُورًا.
الخطبة الثانية
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمدُ لله العليِّ الكبير، اللطيف الخبير، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له خلقَ كلَّ شيءٍ فأحسَنَ التقدير، ودبَّر الخلائِقَ فأحسَنَ التدبير، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنَا محمدًا عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، والسِّراجُ المُنير، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه صلاةً مُتضاعِفةً دائمةً إلى يوم الدين.
أما بعدُ .. فيا أيها المسلمون:
اتَّقُوا الله وراقِبُوه، وأطيعُوه ولا تَعصُوه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أيها المُسلمون:
الأُضحيةُ قُربةٌ جليلة، ونَسِيكةٌ عظيمة، ومعلَمٌ وشعيرةٌ، والأُضحيةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ غيرُ واجِبة، ولا يُستحبُّ تركُها لمَن يقدِرُ عليها، ولا يُجزِئُ في الأُضحِية إلا الأنعام، وأفضلُها البَدَنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شِركٌ في بدَنة، ثم شِركٌ في بقرة، والشِّركُ في البدَنة والشِّركُ في البقرة والشاةُ الواحدةُ يُجزِئُ كلُّ واحدٍ مِنها عن الرجُل وأهلِ بيتِه.
ولا يُجزِئُ في الأضاحِي إلا جَذَع ضأنٍ وثنِيُّ سِواه، فالإبلُ خمسُ سنين، والبقرُ سنتان، والمعز سنة، والضأنُ ستةُ أشهُر، وأفضلُها أحسَنُها وأسمَنُها، وأعظَمُها وأكمَلُها، وأطيَبُها وأكثرُها ثمنًا.
وحاذِرُوا العيوبَ المناِعةَ مِن الإجزاء؛ فلا تُجزئُ المَعيبة عيبًا بيِّنًا مِن مرضٍ، أو عَوَرٍ، أو عرَجٍ، أو عجَفٍ، أو عمَى بصر، واستشرِفُوا العينَ والأُذُن، ولا تُضحُّوا بالخَرقاء، ولا الشَّرقاء، ولا المُقابَلة، ولا المُدابَرة، وهي المَعِيبةُ في أُذنها بقَطعٍ أو خَرقٍ أو ثقبٍ أو شقٍّ.
وأحسِنُوا الذِّبحة، وحُدُّوا الشَّفرة، واشحَذُوا المُديَة؛ ليكون أوحَى وأسهَل، ووجِّهُوا مذبَحَها إلى القبلة، وسمُّوا وكبِّرُوا، وكُلُوا وأهدُوا وتصدَّقُوا، ومَن كان ذبَحَ قبل الصلاة فليُعِد أُضحيتَه، ومَن لا فليذبَح على اسمِ الله.
تقبَّل الله ضحاياكم، ورضِيَ عنكم وأرضاكم، وحقَّق في الخَير مُناكم، وأسعَدَكم ولا أشقاكم، وعاوَدَتكم السُّعود ما عادَ عيدٌ، واخضَرَّ عُود.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أيها المُسلمون:
هذا يومُ التسامُح والتصافُح، فتصافَحُوا، وتسامَحُوا، وتراحَمُوا، وكُونوا عبادَ الله إخوانًا، ومَن غدَا مِنكم مِن طريقٍ فليرجِع مِن طريقٍ أُخرى إن تيسَّر له ذلك؛ اقتِداءً بسُنَّة سيِّد المُرسَلين - صلى الله عليه وسلم -.
أعادَ الله علينا وعليكُم هذه الأيام المُبارَكة أعوامًا عديدة، وأزمنةٍ مديدة، ونحن في صحَّةٍ وعافيةٍ وحياةٍ سعيدة.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل بلادَنا آمنةً مُطمئنَّةً، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمَين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما فيه عِزُّ الإسلام وصلاحُ المُسلمين يا رب العالمين.
اللهم احفَظ وُلاةَ أمرِنا، ورِجالَ أمنِنا، واجزِهم خيرَ الجزاء وأوفاه يا رب العالمين.
اللهم انصُر جُنودَنا المُرابِطِين على ثُغورِنا وحُدودِنا يا رب العالمين.
اللهم احفَظ حُجَّاج بيتِك الحرام، اللهم احفَظ حُجَّاج بيتِك الحرام.
اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وارحَم موتانا، وانصُرنا على مَن عادانا.
|
وأفضلُ الصلاةِ والتسليمِ |
|
على النبيِّ المُصطفَى الكرِيمِ |
|
مُحمدٍ خَيرِ الأنامِ العاقِبِ |
|
وآلِهِ الغُرِّ ذوِي المناقِبِ |
|
وصحبِهِ الأماجِدِ الأبرارِ |
|
الصَّفوةِ الأكابِرِ الأخيَارِ |
اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا وسيِّدنا مُحمدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه صلاةً تَبقَى، وسلامًا يَترَى إلى يوم الدين.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
خطب الحرمين الشريفين

حالُ
المُسلم بعد الحجِّ
ألقى فضيلة الشيخ عبد
الله بن عبد الرحمن البعيجان - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حالُ
المُسلم بعد الحجِّ"، والتي تحدَّث فيها عن إكمال النِّعمة وتمامِها بحجِّ
بيتِ الله الحرام، مُعبِّرًا عما يجِيشُ في نُفوس الحُجَّاج مِن مشاعِر فيَّاضَة،
مُبيِّنًا الواجِبَ على الحاجِّ بعد أن يُكمِلَ الله تعالى له نُسُكَه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي بنعمتِه تتمُّ الصالِحات، أحمدُه - سبحانه - وأستعينُه على كلِّ ما مضَى وما هو آت، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له تفضَّلَ على حُجَّاج بيتِه بتمامِ حجِّهم بعد أن وقَفُوا على صَعيدِ عرَفَات، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه بالهُدى والبيِّنات، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تبِعَهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأُوصِيكم - عباد الله - بتقوَى الله؛ فتقوَاه خيرُ لباسٍ وزاد، وأفضلُ وسيلةٍ إلى رِضا ربِّ العباد، ﴿يا .. تتقوا .. العظيم﴾.
حُجَّاج بيت الله الحرام:
بُشرَى لمَن
لبَّى النِّداءَ ويمَّمَا
صَوبَ البِقاعِ مُهلِّلًا
مُترحِّمًا
|
بُشرَى لمَن
لبَّى النِّداءَ ويمَّمَا |
|
صَوبَ البِقاعِ مُهلِّلًا
مُترحِّمًا |
هنيئًا لكُم - حُجَّاج بيت الله -؛ إذ هداكم الله وأكرَمَكم، ومنَّ عليكم فيسَّرَ لكم الحجَّ حين لم يقدِر عليه الكثيرُ مِن النَّاس.
هنيئًا لكم قد وُفِّقتُم لأداءِ مشاعِرِ الحجِّ، أحدِ أركان الإسلام الخمسَة، فلبَّيتُم النِّداء، وأحسَنتُم الأداء. هنيئًا لكم قد رُفِعَت الدرجاتُ، وغُفِرَت الذنوب، وكُفِّرَت الخطايا، وسُتِرَت العيُوب - بإذن الله علَّام الغيُوب -.
هنيئًا لكم أنفَقتُم المالَ، وصَرفتُم الأوقات، وبذَلتُم الجُهدَ والطاقات، وخُضتُم غِمارَ التَّعب والمشقَّة، وجُدتم بالغالِي والنَّفيس، تركتُم الأهلَ والأوطان؛ تلبيةً لنِداءِ ذي الجلال والإكرام.
جِئتُم فاجتَمَعتُم في أفضل مكان، وفي أشرَف زمان، تجرَّدتم مِن زينتِكم ولِباسِكم، وأقبَلتُم إلى الله شُعثًا مُلبِّين، وفي ذُلٍّ وسَكينةٍ مُنكسِرين، ولجَأتُم إليه وحدَه مُخلِصين، فأبشِرُوا فاللهُ أرحمُ الراحمين، وأكرمُ الأكرمين، وما مِن يومٍ أكثر مِن أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِن النَّار مِن يوم عرفة، وإنَّه ليدنُو ثم يُباهِي بأهل الموقِف ملائكتَه، فيقُولُ: «هؤلاء عبادِي، جاءُوني شُعثًا غُبرًا مِن كل فجٍّ عمِيقٍ، يرجُون رحمَتي ويخافُون عذابِي، فكيف لو رأَوني؟! فلو كانت ذنوبُكم كعدَد الرَّمل، وكزَبَد البَحر لغفَرتُها، أفيضُوا عبادِي مغفُورًا لكُم»؛ رواه ابن حبَّان.
|
فبُشرَاكُم يا
أهلَ الموقِفِ الذِي |
|
بِهِ يغفِرُ
اللهُ الذنوبَ ويرحَمُ |
|
فكَم مِن عتِيقٍ
فيه كُمَّلَ عِتقُهُ |
|
وآخرُ يُستسعَى
وربُّكَ أرحَمُ |
أيها المُسلمون:
يُودِّعُ الحُجَّاجُ بيتَ الله الحرام هذه الأيام ولِسانُ حالِهم: «عائِدُون آيِبُون تائِبُون، لربِّنا حامِدُون».
يحدُوهم الفرَحُ إلى أوطانِهم وبُلدانهم، قد قضَوا مناسِكَهم، وتخفَّفُوا مِن أثقالِهم، ﴿قل بفضل الله .. يجمعون﴾.
ولعلَّهم يعُودُون لأوطانِهم كيوم ولَدَتهم أمَّهاتُهم، فيرجِعُون بغنيمةٍ تستوجِبُ الحمدَ والشُّكرَ، قد غُفِرَ الذنبُ، وسُتِرَ العيبُ، وكُفِّرَت الخطايا.
فالحمدُ لله على كمالِه وجلالِه، والحمدُ لله الذي هدانا لهذا، وما كُنَّا لنَهتَدي لولا أن هدانا الله.
معاشِر الحُجَّاج:
إنَّ لكل إقبالٍ إدبارًا، ولكل جمعٍ تفرُّقًا وأخبارًا. فبعدما رأَينا الحُجَّاجَ يأتُون مِن كل فجٍّ عمِيقٍ، وبلدٍ سَحِيقٍ؛ ليشهَدُوا منافِعَ لهم، وتجمَّعَت الوفودُ الكثيرة، والجُمُوع الغفيرة في المشاعِر المُقدَّسة، قد اختلَفَت لُغاتُهم وألوانُهم وبُلدانُهم، وأجناسُهم وأعمارُهم، لكنَّ الإسلام لمَّ شملَهم، ووحَّد قبلتَهم ومناسِكَهم، مُحرِمُون بلباسٍ واحدٍ، ومُلبُّون بنِداءٍ واحدٍ، اجتمَعُوا في صَعيدٍ واحدٍ، قد ألَّفَ اللهُ بين قلوبِهم، ﴿لو أنفقت .. بينهم﴾.
وبعد قضاءِ النُّسُك وإذ بالجُمُوع الغَفيرَة، والأعداد الكَبيرَة تُودِّعُ المشاعِرَ بمشاعِر فيَّاضة، ولِسانُ حالِهم: لكَ يا منازِلُ في القلوبِ منازِلُ.
وتتفرَّقُ الجُموعُ في منظرٍ مهُولٍ ومُؤثِّر، ومشهَدٍ عظيمٍ ومُعبِّر، إنَّ هذا الفِراقَ بعد الاجتِماع خِلال وقتٍ طويلٍ ليُذكِّرُ بفِراقِ الدنيا، وتعاقُبِ الأجيَال جِيلًا بعد جِيل، جِيلٌ يُولَدُ ويُهنَّأُ به ويُستقبَل، وجِيلٌ يُودَّعُ ويُعزَّى فيه وينتقِل، و﴿كل .. فان .. والإكرام﴾.
معاشِر الحُجَّاج:
إنَّ في الحجِّ لموعظةً لمَن يتذكَّر، وللطاعة في النَّفسِ ثمرةٌ وأثَر؛ فالصلاةُ تنهَى عن الفحشَاء والمُنكَر، والحجُّ مورِدٌ ومنهَلٌ للتزوُّد مِن التقوَى، ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197].
فالعبادةُ إذا لم تُقرِّبْ مِن الله، وتُبعِد عن محارِمِ الله فإنَّ فيها دخَنًا أو مُخالفةً للدين، و﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27].
أيها الحاجُّ:
ما كان في ذمَّتك مِن فرضٍ فاقضِه، وما كان على وجهِ الأرضِ مِن خصمٍ فأرضِه، وما كان مِن حقٍّ فأدِّه، وأقِم فرائِضَ الله وفيها فجاهِد، والزَم سُنَّةَ رسولِ الله وعليها فعاهِد، واطلُب النَّجاةَ والخلاص، وجدِّد العهدَ مع الله بعزمٍ ووفاءٍ وإخلاص.
أيها الحُجَّاج:
إنَّ الله على كل شيء شهِيد، وما يلفِظُ مِن قولٍ إلا لدَيه رقيبٌ عتيد، وقد بُحَّت حناجِرُكم على رُؤوس الأشهَاد، تُردِّدُون كلمةَ التوحيد، وردَّدَت جبالُ مكَّة صدَى تلبِياتكم إلى يوم العِيد: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والمُلك، لا شريكَ لك".
فالبراءَ البراءَ مِن الشِّرك، فلا يقبَلُ الله عملًا فيه مِثقالُ ذرَّةٍ مِن الشِّرك، وقد قال - سبحانه -: «أنا أغنَى الشُّركاء عن الشِّرك، مَن عمِلَ عملًا أشرَكَ فيه معِيَ غيرِي تركتُه وشِركَه»؛ رواه مسلم.
فاعبُدُوا اللهَ ولا تُشرِكُوا به شيئًا، الزَمُوا شرعَكم، واحرِصُوا على ملَّتِكم.
وبعدُ .. أيها الناس:
إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، ألا لا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمر على أسوَد، ولا لأسوَد على أحمَر إلا بالتقوَى.
إنَّ الله قد حرَّم عليكُم دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم كحُرمة يوم النَّحر في شهرِ ذي الحجَّة، في البلد الحرام، ألا لا ترجِعُوا كفَّارًا يضرِبُ بعضُكم رَقابَ بعضٍ.
أيها الحُجَّاج:
تلكُم شِرعةُ ربِّكم، ووصيَّةُ نبيِّكم، فالزَمُوها ذلكم خيرٌ لكم عند بارِئِكم.
بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآيات والذِّكر الحكيم، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله على كمال الدين وتمام النِّعمة، وظهور المحجَّة، وسُطُوع الحُجَّة، وتمام الحَجَّة، حمدًا يُكافِئُ ترادُفَ آلائِه، والصلاةُ والسلامُ على رُسُلِه وأنبِيائِه.
حُجَّاج بيت الله الحرام:
إنَّ مِن علامات قبُول الطاعة: الاستِقامةَ والثباتَ والعُكُوفَ عليها، ومُحاسبَةَ النَّفس على التفريطِ والتقصيرِ فيها، تلكُم صِفاتُ المُؤمنين الخاشِعين المُخلِصِين، ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: 27].
ألا وإنَّ الاستِقامةَ هي حقيقةُ الاستِسلام والثباتِ على الدين، والصِّدقِ والوفاءِ.
فعن سُفيان بن عبد الله الثَّقفيِّ - رضي الله عنه - قال: قُلتُ: يا رسولَ الله! قُل في الإسلام قَولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدَك، قال: «قُل: آمَنتُ بالله، ثم استَقِم»؛ رواه مسلم.
الاستِقامةُ نجاةٌ مِن الخَوفِ، وأمانٌ مِن الهلَعِ والحَزَن، وبِشارةٌ عُظمَى، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30].
الاستِقامةُ مِن درجات الكمال، ولا يقدِرُ عليها إلا ذو العزم والخِصال، وقد قال ذُو العِزَّة والجلال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: 91، 92].
حُجَّاج بيت الله الحرام:
إنَّ مِن الواجِبِ على كل مُسلمٍ أن يحمَدَ اللهَ - عزَّ وجل - على ما منَّ به مِن أمنٍ وأمانٍ في هذه البلاد المُبارَكة، التي تستقبِلُ هذه الأعدادَ الكثيرةَ مِن المُسلمين مِن مُختلَفِ أنحاء العالَم، وتقومُ بضِيافتِهم، وتُهيِّئُ لهم المشاعِرَ في أحسن مُستوى، وتُقدِّمُ لهم الخدمات في أعلَى قدرٍ مُمكِن، وذلك تحت رِعايةٍ مُباشِرةٍ مِن خادمِ الحرمَين الشريفَين ووليِّ عهدِه الأمين - حفِظَهما الله -.
فالشُّكرُ والتقديرُ لوُلاة الأمر القائِمين على خِدمةِ الإسلام والمُسلمين، شكَرَ الله سعيَهم، وتقبَّل عملَهم، وكتبَ لهم ذلك في موازين حسناتهم.
أيها الحُجَّاج:
التَزِمُوا بالتنظيم والتعليمات التي تُساعِدُ في تحسين أداء الخدمات، وتُسهِّلُ عليكُم الإجراءات، وتُساهِمُ في توفيرِ الأمنِ واستِقرارِ الحياة، وارفَقُوا بأنفُسِكم، وتجنَّبُوا المُخالَفات.
جعلَ الله حجَّكم مبرُورًا، وسعيَكم مشكُورًا، وذنبَكم مغفُورًا، واعادَكم إلى أهلِكم وديارِكم سالِمين غانِمين مأجُورين.
نستودِعُ اللهَ دينَكم وأمانتَكم وخواتِيمَ أعمالِكم، زوَّدَكم الله التقوَى، وغفَرَ ذنوبَكم، وحقَّقَ آمالَكم، إنَّه سميعٌ مُجيب.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على خيرِ البريَّة، وأزكَى البشريَّة: مُحمدِ بن عبد الله؛ فقد أمَرَكم الله بذلك في قولِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلاد المُسلمين، اللهم اجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم آمنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورِنا، اللهم وفِّق لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِه للبِرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه خيرٌ للإسلام والمُسلمين، ولما فيه صلاحُ البلاد والعباد يا رب العالمين.
اللهم احفَظ حُدودَنا، وانصُر جُنودَنا، اللهم انصُرهم بنصرِك، وأيِّدهم بتأيِيدك، اللهم اشفِ مريضَهم، واجبُر كسِيرَهم، وتقبَّل موتاهم يا ربَّ العالمين.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذابَ النَّار.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنَّك أنت التوَّابُ الرحيم.
خطب الحرمين الشريفين

ألقى فضيلة الخطيب: الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الإخلاصِ في العمل"،
والتي تحدَّث فيها عن أهمِّ ما يجِبُ أن ينظُر فيه المُسلمُ، وهو تحقيقُ تقوَى
الله تعالى، مُبيِّنًا أنَّ ذلك لا يكون إلا بالنَّظَر في أعمال القُلوب، ثم ذكَرَ
أهمَّ أعمال القلوبِ ورأسَها، وهو الإخلاصُ لله تعالى في كل قولٍ وفعلٍ، كما
أورَدَ بعضَ الآيات والأحاديث النبويَّة والآثار السلفيَّة التي تدلُّ على وجوبِ
تحقيقِ الإخلاص.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله عمَّت رحمتُه كلَّ شيءٍ ووسِعَت، وتوالَت علينا نِعمُه واتَّسَعَت، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ذلَّت لعزَّته الرِّقاب وخضَعَت، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه دعَا إلى الله وجاهَدَ في سبيلِه حتى علَت كلمةُ التوحيد وارتفَعَت، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابِه، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ما توالَت هذه الوفود على هذا البيت الحرام وهلَّلَت وكبَّرَت، ودَعَت وتضرَّعَت، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى الله، فاتَّقُوا الله - رحِمَكم الله - وراقِبُوه، واعلَمُوا أنَّكم مُلاقُوه، واستيقظُوا مِن الغفلة والسِّنَة، واستمِعُوا القولَ واتَّبِعُوا أحسَنَه؛ فالسَّعيدُ مَن لم يزَل تائِبًا، والفائِزُ مَن كان للمعاصِي مُجانِبًا.
فما أنتم في هذه الدنيا مُخلَّدُون، ولا مِن رَيب المَنُون مُحصَّنُون، هيهَات هيهَات .. سوف يأتِيكم ما تُوعَدون، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9].
أيها المُسلمون:
حُجَّاج بيت الله الحرام! ها أنتُم فرَغتُم مِن أعمالِ حجِّكم، وأدَّيتُم مناسِكَكم. تقبَّل الله منَّا ومِنكم، وجعلَ حجَّكم مقبُولًا، وذنبَكم مغفُورًا، وسعيَكم مشكُورًا، وأعادَكم إلى بلادِكم وأهلِيكم سالِمين غانِمين، وفي رِعايةِ الله محفُوظين، وأصلَحَ بالَكم، وأحسَنَ مُنقلبَكم ومثواكم.
معاشِر الحُجَّاج:
ولعلَّكم وقد تنقَّلتُم في هذه العرَصَات المُقدَّسة، والمشاعِر المُعظَّمة، واجتهدتم في أعمالِكم وعباداتِكم، ترجُون مِن ربِّكم المغفرةَ والقبُول، ولقد قال ربُّ العِزَّة في هذه الأعمال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 37]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ويقولُ - جلَّ وعلا -: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197].
إنَّ أهمَّ ما يجِبُ أن ينظُرَ فيه المُسلمُ ويتفكَّرَ فيه - حفِظَكم الله - هو تحقيقُ التقوَى، ولا يكون ذلك إلا بالنظر في أعمال القلوب.
أعمالُ القلوب مِن أعظم أصول الإيمان وقواعِده العِظام، مِن محبَّة الله ومحبَّة رسولِه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وإخلاصِ الدينِ لله، والتوكُّل عليه، والصبرِ على حُكمه، والخوفِ مِنه، والرجاءِ فيما عندَه.
ولقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضغَة إذا صلَحَت صلَحَ الجسَدُ كلُّه، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسَدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ».
أيها المُسلمون .. أيها الحُجَّاج:
وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ أهمَّ أعمال القلوب ولُبَّها ومدارَها على الإخلاص.
وقد كان مِن تلبِية نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم حجَّةً لا رِياءَ فيها ولا سُمعَة»؛ رواه ابن ماجه.
فالإخلاصُ هو حقيقةُ الدين، وهو مضمُون دعوةِ الرُّسُل أجمعين: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: 5]، ويقولُ - جلَّ وعلا -: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: 3]، ويقولُ - عزَّ اسمُه -: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: 14].
وحقيقةُ الإخلاص: أن يكون سُكونُ العبد وحركاتُه لله تعالى خاصَّةً خالِصةً مُخلَصةً، ومِن علامات الإخلاص: السرُّ والكِتمانُ، فلا يُحبُّ المُخلِصُ أن يطَّلِعَ الناسُ على مثاقِيلِ الذرِّ مِن عملِه، كما أنَّه لا يُبالِي لو خرَجَ كلُّ قَدرٍ له مِن قلوبِ الناسِ ومكانة.
ولقد قال أهلُ العلم: "المُخلِصُ لا رياءً له، والصادِقُ لا إعجابَ له".
وقالُوا: "لا يتمُّ الإخلاصُ إلا بالصِّدقِ، والصِّدقُ لا يتمُّ إلا بالإخلاص، ولا يتِمَّان كلاهما إلا بالصبر".
ويقولُ عُمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "مَن خلُصَت نيَّتُه كفَاه الله ما بينَه وبين النَّاس".
ويقولُ سُفيان الثوريُّ - رحمه الله -: "ما عالَجتُ شيئًا أشدَّ مِن نيَّتي، إنها تنقلِبُ علَيَّ".
ويقولُ أبو سُليمان الدارانيُّ: "طُوبَى لمَن صحَّت له خطوةٌ واحدةٌ لا يُريدُ بها إلا الله تعالى".
ويقولُ أيوبُ السِّختيانيُّ: "ما صدَقَ عبدٌ قطُّ فأحبَّ الشُّهرة".
ويقولُ مُطرِّفُ بن الشِّخِّير: "كفَى بالنَّفسِ أن تذُمَّها على الملأ، كأنَّك تُريدُ بذِلِّها زينتَها"، قال: "وذلك عند الله سَفَه".
أي: أنَّ هذا المِسكين المغرُور يذُمُّ نفسَه أمامَ النَّاس وهو يُريد أن يُرِيَ النَّاسَ أنَّه مُتواضِع، وهو يبتَغِي مدحَ النَّاس.
معاشِرَ المُسلمين:
والإخلاصُ - حفِظَكم الله، وتقبَّل الله منَّا ومِنكم - سببٌ لعِظَم الجزاء والثواب، ولو قلَّ العمل وصغُر.
تأمَّلُوا حديثَ المرأةِ البَغِيِّ مِن بني إسرائيل التي رأَت كلبًا يطِيفُ برَكِيَّة، كادَ يقتُلُه العطَش، فنزَعَت مُوقَها فسَقَته، فغُفِرَ لها به؛ والحديثُ مُتَّفق عليه مِن رواية أبي هُريرة - رضي الله عنه -.
وتأمَّلُوا حديثَ الرَّجُل الذي كان يمشِي في طريقٍ، فوجَدَ غُصنَ شوكٍ على الطريقِ فأخَّرَه، فشكَرَ الله له فغفَرَ له؛ متفق عليه.
وتأمَّلُوا كذلك قصةَ الثلاثة أصحابِ الغَار، وهي في "الصحيحين" أيضًا.
وتأمَّلُوا حديثَ صاحبِ البِطاقة يوم القِيامة، حين يُنشَرُ له تسعةٌ وتسعون سِجِلًّا كلُّ سِجِلٍّ مدَّ البصَر، ثم يُخرَجُ له بِطاقةٌ فيا الشهادتان، فتُوضَعُ السِّجِلَّات في كِفَّة، والبِطاقةُ في كِفَّة، فطاشَت السِّجِلَّات وثقُلَت البِطاقة، ولا يثقُلُ مع اسمِ الله شيءٌ؛ أخرجه الحاكمُ، وقال: "صحيحٌ على شرط مُسلم"، ووافقَه الذهبيُّ.
يُصدِّقُ ذلك ويُوضِّحُه: حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - حين سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قائِلًا: مَن أسعَدُ الناسِ بشَفَاعتِك يا رسولَ الله؟ قال: «مَن قال: لا إله إلا الله خالِصًا مِن قلبِه»؛ رواه البخاري.
يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُعلِّقًا على هذه الأحاديث وأمثالِها: "هذه حالُ مَن أتَى بهذه الأعمال بإخلاصٍ وصِدقٍ، كما قالَها هذا الشخصُ صاحِبُ البِطاقة، وإلا فأهلُ الكبائِر الذين أُدخِلُوا النَّار كلُّهم كانُوا يقولُون: لا إله إلا الله، ولم يترجَّح قولُهم على سيئاتِهم كما ترجَّح قولُ صاحِب البِطاقة.
ومِثلُه حديثُ المرأة التي سقَت الكلبَ، فهي سقَتْه بإيمانٍ خالِصٍ كان في قلبِها فغُفِرَ لها، وإلا فليس كلُّ بغِيٍّ سقَت كلبًا يُغفَرُ لها، وكذلك الرَّجُلُ الذي أماطَ الأذَى عن الطريقِ، فهو نحَّى غُصنَ الشوك عن الطريقِ، فعلَه إذ ذاك بإيمانٍ خالِصٍ، وإيمانٍ قائِمٍ بقلبِه فغُفِرَ له بذلك".
قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: "فإنَّ الإيمانَ يتفاضَلُ بتفاضُل ما في القلوب مِن الإيمانِ والإخلاص".
وفي "السنن" عن عمَّار - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ العبد لينصَرِفُ مِن صلاتِه ولم يُكتَب له إلا نِصفُها، إلا ثُلثُها، إلا رُبعُها ..»، حتى قال: «إلا عُشرُها».
فالتفكيرُ ومحوُ الذنوبِ والغُفرانُ - حفِظَكم الله - لا يكونُ إلا بما يتقبَّلُ الله مِن الأعمال، و﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27].
معاشِر المُسلمين:
ومِن مُعينات الإخلاص - حفِظَكم الله -: تحقيقُ التوحيد، وصِدقُ التعلُّقِ بالله، وحُسنُ عبادتِه، والإكثارُ مِن عبادات السَّحَر مِن قِيامِ الليل، والأوراد، وصدقات السرِّ، والعبادة في الخَلَوَات، والإلحاح في الدُّعاء، ومُصاحبة الأخيار الصالِحين الناصِحين المُخلِصِين، والمُجاهَدة في ذلك كلِّه، فقد قال - عزَّ وجل -: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
وبعدُ .. حفِظَكم الله:
فإنَّ مِن لُطفِ الله ومِنَّتِه: أن جعلَ أعمالَ العبد المُعتادة وعاداتِه تنقلِبُ إلى عبادةٍ يُثابُ عليها إذا صحَّت نيَّتُه، وخلُصَ قصدُه؛ مِن الأكل، والنوم، والسَّفَر، والسَّمَر، والبيع والشِّراء، وغيرِها، كلُّها يُثابُ عليها العبدُ مع النيَّة الصالِحة، وقصد التقرُّب بها إلى الله ونفع عبادِه، والتقَوِّي بها على عبادةِ الله وتحقيقِ مراضِيه - سبحانه -.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 200- 202].
نفَعَني اللهُ وإياكم بالقرآن العظيم، وبِهَديِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله مُثِيب الطائِعِين جزيلَ الثواب، ومُجيبِ السَّائِلين وهو أكرَمُ مَن أجاب، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له يَجتَبِي إليه مَن يشاءُ ويهدِي إليه مَن أناب، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أرسلَه بأكمل دينٍ وأنزلَ عليه أشرَفَ كتاب، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ خيرِ آل، وعلى أصحابِه أصحاب، والتابِعين ومَن بإحسانٍ إلى يوم المآب.
أما بعد .. فيها أيها المُسلمون، حُجَّاج بيت الله:
ومع عِظَم الإخلاص وأهميَّتِه وشدَّتِه ودِقَّتِه، إلا أنَّ الله - بفضلِه ورحمتِه، ولُطفِه وتيسيرِه على عبادِه - قد شرَعَ مِن الأعمال ما هو ظاهِرٌ ومُعلَنٌ أمام الملأ؛ مِن صلاةِ الجماعة، وأعمال الحجِّ كلِّها، والصدقات المُعلَنة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المُنكَر، فإظهارُ هذا وأمثالِه لا يتعارَضُ مع الإخلاص، ولا يُشوِّشُ عليه، فالإخلاصُ محلُّه القلب، وهو سرٌّ بين العبد وبين ربِّه.
بل إنَّ مدحَ الناسِ وحمدَهم لعمل العبدِ لا يُشوِّشُ على الإخلاصِ، فقد قيل للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أرأَيتَ الرَّجُلَ يعملُ العملَ مِن الخَير ويحمَدُه عليه النَّاسُ؟ قال: «ذلك عاجِلُ بُشرَى المُؤمن»؛ متفق عليه.
ألا فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، اتَّقُوا اللهَ - حُجَّاج بيت الله -، واشهَدُوا منافِعَ حجِّكم، واذكُرُوا ربَّكم، واشكُرُوه على ما يسَّرَ مِن بلوغ بيتِه، وقضاء نُسُكِه.
ولعلَّكم شاهَدتم ما يُقدَّمُ مِن خدماتٍ ورِعايةٍ وعنايةٍ؛ فلقد شرَّفَ الله أهلَ هذه البلاد بلاد الحرمَين الشريفَين المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، شرَّفَها بخِدمة الحرمَين الشريفَين ورِعايتهما، يبذُلُون في ذلك الغالِيَ والنَّفيس؛ ليُؤدِّيَ حُجَّاجُ بيت الله وعُمَّارُه وزُوَّارُ مسجِد رسولِه - صلى الله عليه وآله وسلم -، ليُؤدُّوا مناسِكَهم وشعائِرَهم بيُسرٍ وأمانٍ واطمِئنان، كلُّ ذلك ابتِغاءَ فضلِ الله ومرضاتِه، بعيدًا عن المقاصِد الإعلاميَّة، والأغراض السياسيَّة، والفوائِد الاقتِصاديَّة، في مشاريع جبَّارة، وتوسِعاتٍ مُتتالِية في الحرمَين الشريفَين والمشاعِر، مشرُوعاتٌ وخدماتٌ لا تتناهَى، تنتظِمُ كلَّ المواقِع والأماكِن، في خُططٍ مدرُوسة، ورُؤَى بعيدة.
فالحمدُ لله على نعمِه، والشُّكرُ له على آلائِه.
تقبَّل الله منَّا ومنكم، وأعزَّ الإسلامَ وأهلَه، وجمَعَ كلمةَ المُسلمين على الحقِّ والهُدى، إنَّه سميعٌ مُجيب.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على الرحمةِ المُهداة، والنِّعمةِ المُسداة: نبيِّكُم مُحمدٍ رسولِ الله؛ فقد أمرَكم بذلك ربُّكم فقال - عزَّ قائِلٍ عليمًا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك: نبيِّنا مُحمدٍ الحبيبِ المُصطفى، والنبيِّ المُجتبَى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه أمهاتِ المُؤمنين، وارضَ اللهم عن الخلفاءِ الأربعةِ الراشدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الصحابةِ أجمعين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وإحسانِك يا أكرَمَ الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمُشركين، واخذُل الطُّغاةَ، والملاحِدَة، وسائرَ أعداءِ المِلَّة والدين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمُورِنا، واجعَل اللهم ولايتَنَا فيمن خافَك واتَّقاك واتَّبَع رِضاكَ يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا وولِيَّ أمرِنا بتوفيقِك، وأعِزَّه بطاعتِك، وأَعلِ به كلمَتَك، واجعَله نُصرةً للإسلامِ والمسلمين، ووفِّقه ووليَّ عهدِه وإخوانَه وأعوانَه لِما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بنواصِيهم للبرِّ والتقوَى، اللهم واجزِهم خيرَ الجزاء على ما قدَّمُوا ويُقدِّمُون في خِدمة الحرمَين الشريفَين، وتيسيرِهم الحجِّ والعُمرة والزِّيارة، وما يبذُلُونَه لعِمارة الحرمَين الشريفَين ورِعايتِهما مِن خدماتٍ.
اللهم وفِّق وُلاةَ أمورِ المسلمين للعملِ بكتابِك، وبسنَّةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمَع كلمتَهم على الحقِّ والهُدَى يا ربَّ العالمين.
اللهم أصلِح أحوال المُسلمين، اللهم أصلِح أحوال المُسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم، واجمَع على الحقِّ والهُدى والسنَّة كلِمتَهم، وولِّ عليهم خيارَهم، واكفِهم أشرارَهم، وابسُط الأمنَ والعدلَ والرَخاءَ في ديارِهم، وأعِذهم مِن الشُّرور والفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن.
اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم، اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم، اللهم واجعَل حجَّهم مبرُورًا، وسعيَهم مشكُورًا، وذنبَهم مغفُورًا، اللهم وأعِدهم إلى ديارِهم سالِمين غانِمين مقبُولين، إنَّك سميعٌ مُجيب.
اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ونفِّس كُروبَنا، وعافِ مُبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحَم موتانا.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
سُبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين
خطب الحرمين الشريفين
خطب الحرمين الشريفين

حالُ المُسلم بعد الحجِّ
ألقى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حالُ المُسلم بعد الحجِّ"، والتي تحدَّث فيها عن إكمال النِّعمة وتمامِها بحجِّ بيتِ الله الحرام، مُعبِّرًا عما يجِيشُ في نُفوس الحُجَّاج مِن مشاعِر فيَّاضَة، مُبيِّنًا الواجِبَ على الحاجِّ بعد أن يُكمِلَ الله تعالى له نُسُكَه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي بنعمتِه تتمُّ الصالِحات، أحمدُه - سبحانه - وأستعينُه على كلِّ ما مضَى وما هو آت، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له تفضَّلَ على حُجَّاج بيتِه بتمامِ حجِّهم بعد أن وقَفُوا على صَعيدِ عرَفَات، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه بالهُدى والبيِّنات، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تبِعَهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فأُوصِيكم - عباد الله - بتقوَى الله؛ فتقوَاه خيرُ لباسٍ وزاد، وأفضلُ وسيلةٍ إلى رِضا ربِّ العباد، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾[الأنفال: 197].
حُجَّاج بيت الله الحرام:
|
بُشرَى لمَن لبَّى النِّداءَ
ويمَّمَا |
|
صَوبَ البِقاعِ مُهلِّلًا
مُترحِّمًا |
هنيئًا لكُم - حُجَّاج بيت الله -؛ إذ هداكم الله وأكرَمَكم، ومنَّ عليكم فيسَّرَ لكم الحجَّ حين لم يقدِر عليه الكثيرُ مِن النَّاس.
هنيئًا لكم قد وُفِّقتُم لأداءِ مشاعِرِ الحجِّ، أحدِ أركان الإسلام الخمسَة، فلبَّيتُم النِّداء، وأحسَنتُم الأداء. هنيئًا لكم قد رُفِعَت الدرجاتُ، وغُفِرَت الذنوب، وكُفِّرَت الخطايا، وسُتِرَت العيُوب - بإذن الله علَّام الغيُوب -.
هنيئًا لكم أنفَقتُم المالَ، وصَرفتُم الأوقات، وبذَلتُم الجُهدَ والطاقات، وخُضتُم غِمارَ التَّعب والمشقَّة، وجُدتم بالغالِي والنَّفيس، تركتُم الأهلَ والأوطان؛ تلبيةً لنِداءِ ذي الجلال والإكرام.
جِئتُم فاجتَمَعتُم في أفضل مكان، وفي أشرَف زمان، تجرَّدتم مِن زينتِكم ولِباسِكم، وأقبَلتُم إلى الله شُعثًا مُلبِّين، وفي ذُلٍّ وسَكينةٍ مُنكسِرين، ولجَأتُم إليه وحدَه مُخلِصين، فأبشِرُوا فاللهُ أرحمُ الراحمين، وأكرمُ الأكرمين، وما مِن يومٍ أكثر مِن أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِن النَّار مِن يوم عرفة، وإنَّه ليدنُو ثم يُباهِي بأهل الموقِف ملائكتَه، فيقُولُ: «هؤلاء عبادِي، جاءُوني شُعثًا غُبرًا مِن كل فجٍّ عمِيقٍ، يرجُون رحمَتي ويخافُون عذابِي، فكيف لو رأَوني؟! فلو كانت ذنوبُكم كعدَد الرَّمل، وكزَبَد البَحر لغفَرتُها، أفيضُوا عبادِي مغفُورًا لكُم»؛ رواه ابن حبَّان.
|
فبُشرَاكُم يا أهلَ الموقِفِ
الذِي |
|
بِهِ يغفِرُ اللهُ الذنوبَ
ويرحَمُ |
|
فكَم مِن عتِيقٍ فيه كُمَّلَ
عِتقُهُ |
|
وآخرُ يُستسعَى وربُّكَ أرحَمُ |
أيها المُسلمون:
يُودِّعُ الحُجَّاجُ بيتَ الله الحرام هذه الأيام ولِسانُ حالِهم: «عائِدُون آيِبُون تائِبُون، لربِّنا حامِدُون».
يحدُوهم الفرَحُ إلى أوطانِهم وبُلدانهم، قد قضَوا مناسِكَهم، وتخفَّفُوا مِن أثقالِهم، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: 58].
ولعلَّهم يعُودُون لأوطانِهم كيوم ولَدَتهم أمَّهاتُهم، فيرجِعُون بغنيمةٍ تستوجِبُ الحمدَ والشُّكرَ، قد غُفِرَ الذنبُ، وسُتِرَ العيبُ، وكُفِّرَت الخطايا.
فالحمدُ لله على كمالِه وجلالِه، والحمدُ لله الذي هدانا لهذا، وما كُنَّا لنَهتَدي لولا أن هدانا الله.
معاشِر الحُجَّاج:
إنَّ لكل إقبالٍ إدبارًا، ولكل جمعٍ تفرُّقًا وأخبارًا. فبعدما رأَينا الحُجَّاجَ يأتُون مِن كل فجٍّ عمِيقٍ، وبلدٍ سَحِيقٍ؛ ليشهَدُوا منافِعَ لهم، وتجمَّعَت الوفودُ الكثيرة، والجُمُوع الغفيرة في المشاعِر المُقدَّسة، قد اختلَفَت لُغاتُهم وألوانُهم وبُلدانُهم، وأجناسُهم وأعمارُهم، لكنَّ الإسلام لمَّ شملَهم، ووحَّد قبلتَهم ومناسِكَهم، مُحرِمُون بلباسٍ واحدٍ، ومُلبُّون بنِداءٍ واحدٍ، اجتمَعُوا في صَعيدٍ واحدٍ، قد ألَّفَ اللهُ بين قلوبِهم، ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[الأنفال: 63].
وبعد قضاءِ النُّسُك وإذ بالجُمُوع الغَفيرَة، والأعداد الكَبيرَة تُودِّعُ المشاعِرَ بمشاعِر فيَّاضة، ولِسانُ حالِهم: لكَ يا منازِلُ في القلوبِ منازِلُ.
وتتفرَّقُ الجُموعُ في منظرٍ مهُولٍ ومُؤثِّر، ومشهَدٍ عظيمٍ ومُعبِّر، إنَّ هذا الفِراقَ بعد الاجتِماع خِلال وقتٍ طويلٍ ليُذكِّرُ بفِراقِ الدنيا، وتعاقُبِ الأجيَال جِيلًا بعد جِيل، جِيلٌ يُولَدُ ويُهنَّأُ به ويُستقبَل، وجِيلٌ يُودَّعُ ويُعزَّى فيه وينتقِل، و﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 26-27].
معاشِر الحُجَّاج:
إنَّ في الحجِّ لموعظةً لمَن يتذكَّر، وللطاعة في النَّفسِ ثمرةٌ وأثَر؛ فالصلاةُ تنهَى عن الفحشَاء والمُنكَر، والحجُّ مورِدٌ ومنهَلٌ للتزوُّد مِن التقوَى، ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197].
فالعبادةُ إذا لم تُقرِّبْ مِن الله، وتُبعِد عن محارِمِ الله فإنَّ فيها دخَنًا أو مُخالفةً للدين، ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27].
خطب الحرمين الشريفين

حقوق الوالدَين
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حقوق الوالدَين"، والتي تحدَّث فيها عن الحقوق التي أوجبَها الشرعُ على العباد؛ ويأتِي في أولِها: حقُّ الله تعالى، وحقُّ الوالدَين، وغير ذلك، وأكثَرَ مِن التذكيرِ بحقِّهما على الأبناء، مُبيِّنًا عِظَمَ برِّهما في الكتاب والسنة، ومُحذِّرًا مِن عقوقِهما.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي تفضَّل على عباده، وفصَّل لهم الحقوق والواجبات، ورضِيَ لهم الأعمال الصالِحات، وكرِهَ لهم السيئات، ووعدَ الصالِحِين بالخيرات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مُجيبُ الدعوات، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالمُعجِزات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبه الناصِرين لدين الله بالجهاد والحُجَج والبيِّنات.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله ولا تُضيِّعوا فرائِضَه، ولا تعتَدوا على حُدوده؛ فقد فازَ مَن اتَّقى، وخابَ مَن اتَّبعَ الهوى.
عباد الله:
اعلَمُوا أنَّ أعمال العباد لهم أو عليهم، لا ينفعُ اللهَ طاعةٌ، ولا تضُرُّه معصيةٌ، قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [الجاثية: 15]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40].
وقال - عزَّ وجل - في الحديث القُدسي: «يا عبادي! إنَّكم لن تبلُغُوا ضرِّي فتضرُّوني، ولن تبلغُوا نَفعِي فتنفَعوني. يا عبادي! إنَّما هي أعمالُكم أُحصِيها لكم، ثم أُوفِّيكم إياها؛ فمَن وجد خيرًا فليحمَد الله، ومَن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه»؛ رواه مسلم مِن حديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -.
وأداءُ الحقوق الواجبة على العبد نفعُها في آخر الأمر يعودُ إلى المُكلَّف بالثوابِ في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ [الأنبياء: 94]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: 30].
والتقصيرُ في بعض الحقوق الواجِبةِ على المُكلَّف، أو تضييعُها وتركُها بالكليَّة يعودُ ضررُه على الإنسان المُضيِّع للحقوق المشروعة في الدين؛ لأنه إن ضيَّع حقوقَ ربِّ العالمين فما ضرَّ إلا نفسَه في الدنيا والآخرة، فالله غنيٌّ عن العالمين، قال - عزَّ وجل -: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ﴾ [محمد: 38]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 111].
وحقُّ الربِّ الذي يجبُ حفظُه هو التوحيدُ، وقد وعَدَ الله عليه أعظمَ الثواب، قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ [ق: 31، 32].
ومَن ضيَّع حقَّ الله - عزَّ وجل - بالشرك به، واتخاذ وسائط يعبُدهم ويدعُوهم مِن دون الله لكشف الضُّرِّ والكُربات، وقضاء الحاجات، ويتوكَّل عليهم، فقد خابَ وخسِرَ وأشركَ باللهِ، وضلَّ سعيُه، لا يقبلُ الله منه عَدلًا ولا فِدية، ويُقال له: ادخُل النارَ مع الداخلين، إلا أن يتوبَ من الشرك.
وفي الحديث: «يُقال للرجل من أهل النار: لو أنَّ لك ما في الأرض هل تفتَدِي به من النار؟ فيقول: نعم. فيُقال له: قد أُمِرتَ بما هو أيسرُ من ذلك: ألا تُشرِك بالله شيئًا»؛ رواه البخاري.
ألا وإنَّ مِن ثوابِ الحسنةِ الحسنةَ بعدها، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾، ألا وإنَّ مِن عقوبةِ السيئةِ السيئةَ بعدها، قال - سبحانه -: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾.
ألا ومَن سلِمَت له صلواتُه الخمسُ سلِمَ له يومُه، ومَن سلِمَت له جُمعتُه سلِمَ له أسبوعُه، ومَن سلِمَ له رمضانُ سلِمَ له عامُه، ومَن أدَّى زكاةَ مالِه حفِظَ الله له مالَه وبارَك الله له فيه، ومَن سلِمَ له حجُّه فقد سلِمَ له عُمرُه، ومَن حفِظَ التوحيدَ ضمِنَ الله له الجنَّة.
وإن ضيَّع المُكلَّف الحُقوقَ، وترك حقوقَ الخلق الواجِبةَ فقد حرَمَ نفسَه مِن الثواب في الدنيا والآخرة، وإن قصَّر في بعضِها فقد حُرِم مِن الخير بقَدر ما نقصَ من القيام بحقوق الخلق.
والحياةُ تمضِي بما يلقَى الإنسانُ من شدَّة ورخاء، وحِرمان وعطاء، ولا تتوقَّفُ الحياةُ على نَيل الإنسان حقوقَه الواجِبة له، وعند الله تجتمِعُ الخُصوم، فيُعطِي اللهُ المظلومَ حقَّه مِمَّن ظلمَه وضيَّع حقَّه.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتُؤدُّن الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقادَ للشاة الجَلحاء مِن الشاة القَرناء»؛ رواه مسلم.
وأعظمُ الحقوق بعد حقِّ الله ورسوله: حقوقُ الوالدَين، ولعِظَم حقِّهما قرَنَ الله حقَّه بحقِّهما، فقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23، 24]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14].
وعظَّمَ الله حقَّ الوالدَين؛ لأنه أوجَدَك وخلقَك بهما، والأمُّ وجَدَت في مراحل الحمل أعظمَ المشقَّات، وأشرَفَت في الوضع على الهلاك، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15].
ورَضاعُ الطفل آيةٌ مِن آيات الله، والأبُ يرعَى ويُربِّي، ويسعَى لرزقِ الولد، ويُعالِجان مِن الأمراض، ويسهرَ الوالِدان لينام الولد، ويتعبَان ليستريح، ويُضيِّقان على أنفسهما ليُوسِّعَا عليه، ويتحمَّلان قذَارَةَ الولد ليسعَد، ويُعلِّمانه ليكمُلَ ويستقيم، ويُحبَّان أن يكون أحسنَ منهما.
فلا تعجَب - أيها الولَد - مِن كثرة الوصيَّة بالوالدَين، ولا تعجَب مِن كثرة الوعيد في عقوقهما.
ولن يبلغَ ولدٌ كمالَ البرِّ بالوالد مهما اجتهَدَ وبذَلَ إلا في حالةٍ واحدةٍ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يجزِيَ ولدٌ والدَه إلا أن يجِدَه مملوكًا فيشترِيَه فيُعتِقَه»؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
والوالِدان بابانِ مِن أبوابِ الجنة؛ مَن برَّهما دخَلَ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رغِمَ أنفُه، رغِمَ أنفُه، رغِمَ أنفُه». قيل: مَن يا رسولَ الله؟ قال: «مَن أدرَكَ أبوَيه عند الكِبَر أو أحدَهما ثم لم يدخُل الجنة»؛ رواه مسلم.
أيها المسلم:
إذا رضِيَ عنك والِداك فالربُّ راضٍ عنك؛ عن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «رِضا الله في رِضا الوالِد، وسخَطُ الله في سخَط الوالِد»؛ حديثٌ صحيحٌ رواه الترمذي، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "حديثٌ صحيحٌ".
وبرُّ الوالدَين هو طاعتُهما في غير معصِيَة، وإنفاذُ أمرهما ووصيَّتهما، والرِّفقُ بهما، وإدخالُ السرور عليهما، والتوسِعةُ عليهما في النفقة، وبَذلُ المال لهما، والشفقةُ والرحمةُ لهما، والحُزنُ لحُزنهما، وجَلبُ الأُنسِ لهما، وبرُّ صديقِهما، وصِلةُ وُدِّهما، وصِلةُ رحِمِهما، وكفُّ جميع أنواع الأذَى عنهما، والكفُّ عما نهَيَا عنه، ومحبَّةُ طُول حياتهما، وكثرةُ الاستِغفار لهما في الحياةِ وبعد الموت. والعقوقُ ضدُّ ذلك كلِّه.
وكثرةُ العقوق مِن أشراط الساعة، وفي الحديث: «إنَّ مِن أشراط الساعة أن يكون المطرُ قَيظًا، والولدُ غيظًا، وأن يفيضَ الأشرارُ فيضًا، وأن يغيضَ الأخيارُ غيضًا».
ومِن أعظم العقوق للوالدَين: تحويلُهما أو تحويلُ أحدهما إلى دار المُسنِّين، وإخراجُهما مِن رعاية الولد - والعياذ بالله -، وهذه ليست مِن أخلاق الإسلام، ولا مِن كرم الأخلاق والشِّيَم.
ومِن أعظم العقوق: التكبُّر على الوالدَين، والاعتداءُ عليهما بالضرب، أو الإهانة، والشتم، والحِرمان؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الجنةَ يُوجد ريحُها مِن مسيرة خمسمائة عام، ولا يجِدُ ريحَها عاقٌّ»؛ رواه الطبراني.
قال ربُّنا - تبارك وتعالى -: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآيات والذكر الحكيم، ونفَعَنا بهَدي سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفِروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القويُّ المتِين، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه الصادقُ الأمِين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله حقَّ التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقَى.
عباد الله:
إنَّ حقوق الوالدَين مع ما في القيام بها مِن عِظَم الأجور والبركة، فهي مِن مكارِم الأخلاق، وأكرم الخِصال التي يقوم بها مَن طابَت سريرتُه، وكرُمَ أصلُه، وزكَت أخلاقُه. وجزاءُ الإحسانِ الإحسان، والمعروفُ حقُّه الرعاية والوفاء، والجميلُ يُقابَلُ بالجميل، ولا يُنكِرُ المعروفَ والجميلَ إلا مُنحَطُّ الأخلاق، ساقِطُ المُروءة، خبِيثُ السَّريرة.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى عن عيسَى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: 32].
وعن يحيى - عليه السلام -: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: 14].
وقال عن الشقيِّ: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الأحقاف: 17].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله! مَن أحقُّ الناسِ بحُسن صَحَابَتي؟ قال: «أمُّك، ثم أمُّك، ثم أمُّك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك»؛ رواه البخاري ومسلم.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين، وإمام المُرسَلين نبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، اللهم وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الصحابةِ أجمعين، اللهم وارضَ عن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، زكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها.
اللهم إنَّا نعوذُ بك مِن مُنكَرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا ربَّ العالمين.
اللهم إنَّا نسألُك العفوَ والعافيةَ في دينِنا ودُنيانا، وأهلِنا ومالِنا، اللهم استُر عوراتِنا، وآمِن روعاتِنا، اللهم احفَظنا مِن بين أيدينا، ومِن خلفِنا، وعن أيمانِنا، وعن شمائِلِنا، ونعوذُ بك أن نُغتالَ مِن تحتِنا برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم إنَّا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا مِن إبليس وذريَّته وشياطينِه وجنودِه وأوليائِه يا ربَّ العالمين، اللهم إنَّا نعُوذُ بِك مِن شُرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ومِن شرِّ كل ذي شرٍّ يا ربَّ العالمين.
اللهم أحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا أرحم الراحمين.
اللهم فقِّهنا في الدِّين، اللهم فقِّه المُسلمين في الدِّين، اللهم أعِذ المُسلمين وذريَّاتهم مِن إبليس وذريَّته يا ربَّ العالمين، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم تولَّ أمرَ كلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنة، تولَّ أمرَ كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ.
اللهم اكشِف الكُرُبات واللأواء والشدَّة عن المُسلمين يا ربَّ العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم ارزُقنا والمُسلمين الاستِقامةَ على دينِك، والتمسُّكَ بسُنَّة نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
اللهم ادفَع عنَّا الغلا والوبا والرِّبا والزِّنا، والزلازِلَ والمِحَن، وسُوءَ الفتَن ما ظهَر مِنها وما بطَن برحمتِك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنَّا نعوذُ بك مِن شُرور أنفسِنا، ومِن سيئات أعمالِنا.
اللهم اقضِ الدَّينَ عن المَدينِين مِن المُسلمين، اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين يا ربَّ العالمين.
اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم يا ربَّ العالمين، برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبَّل مِن الحُجَّاج حجَّهم، اللهم ورُدَّهم سالِمين غانِمين مغفُورًا لهم إلى ديارِهم يا ربَّ العالمين، إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكرُوهٍ، اللهم احفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكرُوهٍ، ومِن ظُلم الظالِمين يا ربَّ العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، واجعَل الدائِرةَ يا ذا الجلال والإكرام على المُبتَدِعين البُغاة إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفَظ جنودَنا، اللهم احفَظ جنودَنا، اللهم احفَظهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفَظهم واحفَظ أهلَهم وأموالَهم برحمتِك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عمله في رِضاك يا ذا الجلال والإكرام، وأعِنه على كل خيرٍ يا أرحم الراحمين، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لما تحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، وأعِنه على كل خيرٍ يا ربَّ العالمين، اللهم وفِّقهما لما تُحبُّ وترضَى، ولما فيه الخيرُ للبلاد والعباد، اللهم اجعَلهما مِن الهُداة المُهتَدين يا ربَّ العالمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكُركم، واشكُروه على نِعمه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلم ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

شُكر الله
تعالى على أداء فريضة الحجِّ
ألقى فضيلة الشيخ أسامة
بن عبد الله خياط - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "شُكر الله تعالى على أداء
فريضة الحجِّ"، والتي تحدَّث فيها عن وجوبِ شُكر الله تعالى بعد نعمةِ
التوفيقِ إلى قضاءِ المناسِك، والفراغِ مِن أعمال الحجِّ والعُمرة في صحَّةٍ
وسلامةٍ وأمنٍ وصلاحِ حالٍ، مُبيِّنًا أنَّ هذا الشُّكر ينبغي أن يكون برجوع
الحاجِّ بحالٍ أفضل مِن الحال التي ذهَبَ بها؛ مِن زيادةٍ في الطاعة، وزُهدٍ في
الدنيا، ورغبةٍ في الآخرة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الذي جعلَ البيتَ مثابةً للنَّاسِ وأمنًا، أحمدُه - سبحانه - بشَّرَ قاصِديه بالحجِّ بالمغفرةِ التامَّة إحسانًا ومنًّا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُبلِّغُ السعدَ والحُسنَى، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه خيرُ النَّاسِ هَديًا وأكملُهم دينًا، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ وأصحابِه الذين كانوا حِرزًا لدينِه وحِصنًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واذكُروا أنَّكم موقُفون بين يدَيه، ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات: 35]، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 34- 37].
أيها المُسلمون:
إنَّ وقوفَ حاجِّ بيت الله في مقامِ الشُّكر لله ربِّ العالمين على ما منَّ به - سبحانه - مِن نعمٍ جليلةٍ، يأتِي في الطَّليعَةِ مِنها - بعد نعمةِ الإسلام -: التوفيقُ إلى قضاءِ المناسِك، وكذا الفراغُ مِن أعمال الحجِّ والعُمرة في صحَّةٍ وسلامةٍ وأمنٍ وصلاحِ حال، هذا حقٌّ واجِبٌ، وفرضٌ مُتعيِّنٌ عليه إذا أرادَ استِبقاءَ النِّعمة، واستِدامةَ الفضل، واتِّصالَ التكريم.
ذلك أنَّ الشُّكر موعُودٌ صاحِبُه بالمزيد، كما قال - عزَّ مِن قائِل -: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7].
وقد وجَّه - سبحانه - حُجَّاجَ بيتِه إلى ذِكرِه وشُكرِه والتضرُّع إليه، وسُؤالِه مِن خَيرَي الدنيا والآخرة عقِبَ قضاء المناسِك، فقال - عزَّ اسمُه -: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 200 - 202].
وفي هذا إيماءٌ بيِّنٌ، وإيضاحٌ جلِيٌّ لتأكُّد ذِكرِ الله تعالى عقِبَ الفراغِ مِن الطاعاتِ كلِّها، ومِن المناسِكِ خاصَّةً؛ شُكرًا لله تعالى، واعتِرافًا بنِعمِه السَّابِغة، وآلائِه الجَزِيلَة، وفِعالِه الجَمِيلَة؛ حيث وفَّقَ عبادَه إلى بلوغِ محابِّه ومراضِيه، وأسعَدَهم بطاعتِه، ومنَّ عليهم بإتمامِ ذلك والفراغِ مِنه على أكملِ أحوالِ الحاجِّ وأجمَلِها، وأبَرِّها وأتقاها.
في الآية الكريمة أيضًا: تحذيرٌ وتوجيهٌ؛ أما التحذيرُ: فمِن دُعاء الحُجَّاج ربَّهم أن يُؤتِيَهم مِن حُظوظِ الدُّنيا ما ينصرِفُون إليه، ويقتَصِرُون عليه، نائِين بأنفسِهم عما هو أعظمُ وأكمل، وأبقَى وأجمَل مِن المنازلِ والمقاماتِ في الدار الآخرة دار الخُلد، ودار المُتَّقين.
وأما التوجيه: فهو إلى دُعائِه - سبحانه - أن يُؤتِيَهم في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وأن يقِيَهم عذابَ النَّار؛ لأنَّ هذه الدعوةَ القُرآنيَّةَ الطيبةَ المُباركةَ جمعَت كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة، وصرَفَت كلَّ شرٍّ.
فإنَّ الحسنةَ في الدنيا - كما قال الإمامُ ابن كثيرٍ - رحمه الله - تشمَلُ كلَّ مطلُوبٍ دُنيويٍّ؛ مِن عافيةٍ، ودارٍ رَحبةٍ، وزوجةٍ صالِحةٍ، ورِزقٍ واسِعٍ، وعلمٍ نافعٍ، وعملٍ صالِحٍ، ومركبٍ هنِيئٍ، وثناءٍ جميلٍ.
وأما الحسنةُ في الآخرة فأعلاها: النَّظرُ إلى وجهِ الربِّ الكريمِ الرحمن، ودخولُ جنَّات النَّعيم والرِّضوان، والأمنُ مِن الفزَع الأكبَر في العرَصَات، وتيسيرُ الحسابِ، وغيرُ ذلك مِن أمور الآخرة الصالِحة التي يمُنُّ الله بها على أهل جنَّته ودارِ كرامتِه.
وأما النَّجاةُ مِن النَّار فهو يقتَضِي تيسيرَ أسبابِها في الدنيا؛ مِن اجتِنابِ المحارِم والآثام، وتركِ الشُّبُهات والحرام، ولهذا لم يكُن عجَبًا أن كانت هذه الدعوة الطيبة المُبارَكة أكثَر ما كان يدعُو به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمامُ أحمدُ في "مسنده" بإسنادٍ صحيحٍ، عن عبد العزيز بن سُهَيل أنَّه قال: سألَ قتادةُ أنسًا عن أكثر ما كان يدعُو به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يقولُ: «اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار».
وكان أنسٌ إذا أرادَ أن يدعُو بدعوةٍ دعَا بها، وإذا أرادَ أن يدعُو بدُعاءٍ دعَا بها فيه.
ثم كيف سيكون حالُ حاجِّ بيت الله فيما يستقبِلُ مِن أيام عُمرِه بعد أن منَّ الله عليه بإتمامِ حجِّه؟ فهل سينكُصُ على عقِبَيه فيتردَّى في وهدَة الشِّرك بالله تعالى بعد إذ أنارَ الله فُؤادَه، وأضاءَ جنَبَات نفسِه، وكشَفَ عنه غِطاءَ الجهالات الجاهِلة، والضلالات الضالَّة، فوجَّهه - سبحانه - للطوافِ ببيتِه الحرام، وحرَّم عليه الطوافَ بأي شيءٍ آخر سِواه؟
وهل سيعودُ إلى ارتِداء لِباسِ الإثم والفُسوق والعِصيَان، ومُبارَزة الملكِ الديَّان بالخطايا والآثام بعدما كسَاه ربُّه مِن لِباسِ الإيمان وحُلَ التقوَى خيرَ اللِّباسِ، وأبهَى الثِّياب؟
وهل سيعودُ إلى انتِهاجِ نهجِ الجُحود والنُّكران، فيترُك الحمدَ والشُّكرَ لربِّه بعد أن لهِجَ لِسانُه بهذا الشُّكر تلبيةً وتكبيرًا، وتهليلًا وتحميدًا، وتسبيحًا واستِغفارًا، وبعد أن عمِلَت جوارِحُه بهذا الشُّكر نَحرًا للهَديِ والأضاحِي، وإتمامًا للمناسِكِ وفقَ ما شرَعَه الله وسنَّه رسولُه - عليه الصلاة والسلام -؟
وهل سينسَى أو يتناسَى موقِفَه غدًا بين يدَي الله تعالى يوم البعثِ والحشر والنُّشُور، بعد إذ ذكَّرَه ربُّه يوم وقفَ هناك على ثَرَى عرفات داعِيًا ضارِعًا، راجِيًا خائِفًا وجِلًا، سائلًا إيَّاه الجنَّة، مُستعيذًا به مِن النَّار؟
عباد الله:
إنَّ على الحاجِّ أن يقِفَ مع نفسِه وقفاتٍ مُحكَمات؛ لتكون له منها عِظاتٌ بالِغات، وعهودٌ مُوثَّقات يأخُذهنَّ على نفسِه بدوامِ الإقبالِ على الخيرات، واستِمرار المُسارَعة إلى الباقِيات الصالِحات، واتِّصال البراءة مِن الشِّرك مِن الخطيئات، والثباتِ على ذلك حتى الممات، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 98، 99].
نفَعَني الله وإياكم بهَدي كتابه، وبسنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أقولُ قَولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّة المُسلمين مِن كل ذنبٍ، إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا، ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وصحبِه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد .. فيا عباد الله:
إنَّ الظَّفرَ بالموعُودِ لمَن حجَّ البيتَ حجًّا مبرُورًا ذلك الموعُود الذي جاء في حديثِ أبي هُريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العُمرةُ إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة»؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
إنَّ الظَّفر بهذا الموعُود ليقتَضِي أن يُراقِبَ الحاجُّ سَيرَ حياتِه بعد حجِّه، فيجهَدَ كلَّ جَهده في أن تكون حالُه بعد الحجِّ خيرًا مِن حالِه قبلَه، فتلك هي علامةُ الحجِّ المبرُور - يا عباد الله -، والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
ألا فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واعمَلُوا على مُجاهَدة النَّفسِ والهوَى والشيطان؛ تفوزُوا برِضا الربِّ الكريم الرحمن، وتحظَوا بدخول جنَّات النَّعيم والرِّضوان.
واذكُروا على الدَّوامِ أنَّ الله تعالى قد أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على خيرِ الأنامِ، فقال في أصدَقِ الحديثِ وأحسَنِ الكلامِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنَّك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنَّك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم عن خُلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا خَيرَ مَن تجاوَزَ وعفَا.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، واحمِ حَوزةَ الدين، ودمِّر أعداءَ الدين، وسائِرَ الطُّغاة والمُفسِدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصلِح قادَتَهم، واجمَع كلمَتَهم على الحقِّ يا ربَّ العالمين.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسنَّةَ نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك المؤمنين المجاهدين الصادقين.
اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ، ووفِّقه لما تُحبُّ وترضَى يا سميعَ الدُّعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خَيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى ما فيه صلاحُ العِباد والبِلاد يا مَن إليه المرجِعُ يوم المعاد.
اللهم أصلِح لنا دينَنَا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، واجعَل الموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ.
اللهم أحسِن عاقبَتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أردتَّ بقومٍ فتنةً فاقبِضنا إليك غيرَ مفتُونين.
اللهم اكفِنا بحلالِك عن حرامِك، وأغنِنا بفضلِك عمَّن سِواك.
اللهم زِدنا ولا تنقُصنا، وأعطِنا ولا تحرِمنا، وأكرِمنا ولا تُهِنَّا، وآثِرنا ولا تُؤثِر علينا.
اللهم اشفِ مرضانا، وارحَم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، واختِم بالباقِيات الصالِحات أعمالَنا.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8]، ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
وصلِّ الله وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

وقَفات
للعِبر والعِظات
ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "وقَفات للعِبر والعِظات"، والتي تحدَّث فيها عن انقِضاءِ عامٍ وحُلُولِ عامٍ هجريٍّ جديدٍ، وحضَّ على وجوب الوقوف مع النَّفسِ في نهايةِ العامِ؛ لكي ينظُر فيما سلَفَ مِن أعمالِه، ويُغيِّر مِن حالِه إلى الأفضَل - بإذن الله تعالى -، كما وجَّه التنبيهات المهمة للطُّلَّاب والطالِبات والمُعلِّمين وأولياءِ الأمور.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونتوبُ إليه، ونُثنِي عليه الخيرَ كلَّه ثناءً كثيرًا طيبًا مديدًا، مِلءَ الآفاق مُبارَكًا مزيدًا.
|
لك الحمدُ حمدًا أنتَ
وفَّقتَنا لهُ |
|
وعلَّمتَنا مِن حمدِكَ
النَّظمَ والنَّثْرَا |
|
لك الحمدُ حمدًا نبتَغِيهِ
وسيلَةً |
|
إلَيكَ لتجديدِ
اللَّطائِفِ والبُشرَى |
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلَ لنا مِن تصرُّم الزمانِ عِبَرًا عِظامًا، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه خيرُ مَن حاسَبَ نفسَه - بأبي هو وأمي - قُدوةً وإمامًا، صلَّى الله وبارَك عليه وعلى آله المُتألِّقين بُدورًا وأعلامًا، وصحبِه البالِغين مِن الهِمَّة الشَّمَّاء مجدًا ترامَى، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا ما تعاقَبَ الملَوَان ودامَا.
أما بعد .. فيا عباد الله:
اتَّقُوا الله ربَّكم، واحذَرُوا الغفَلات والاغتِرار، واعتبِرُوا بتقضِّي الدُّهور والأعمار، واتَّخذُوا تقوَاه - سبحانه - ألحَبَ سبيلٍ لكم ومنار؛ تفوزُوا - يا بُشراكُم - بالنَّعيم المُقيم وأزكَى القرار، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
معاشِر المُسلمين:
وبعد أن نعِمَ حُجَّاجُ بيت الله الحرام بموسمِ حجٍّ ناجحٍ ومُتميِّزٍ، نُجدِّدُ الشُّكرَ لله - سبحانه وتعالى -، فلله الحمدُ والشُّكرُ أولًا وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا.
وفي هذا الأوان الذي جدَحَت فيه يدُ الإملاق كأسَ الفِراق، وأوشكَ العامُ فيه على التَّمام والإغلاق، لا بُدَّ لأهل الحِجَى مِن وقَفات للعِبرةِ ومُراجعة الذات، وتجديدِ الثِّقة والثَّبات، والتفكُّر فيما هو آت.
|
عامٌ أهابَ به
الزَّمانُ فأقبَلَا |
|
يُزجِي المواكِبَ
بالأهِلَّةِ حُفَّلَا |
|
أسَرَ الحوادِثُ فهِيَ
في أحنائِهِ |
|
تأتِي وتذهَبُ في
الممالِكِ جُوَّلَا |
فمَن لم يتَّعِظ بزوال الأيام، ولم يعتبِر بتصرُّم الأعوام، فما تفكَّرَ في مصيرِه ولا أناب، ولا اتَّصَفَ بمكارِمِ أُولِي الألباب، قال المولَى الرحيمُ التواب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].
فالتأمُّلُ والتدبُّرُ في حوادِثِ الأيام وتعاقُبِها مطلبٌ شرعيٌّ، ولا ينِدُّ عن فهم الأحوذِيِّ الحقيقةُ القاطِعةُ السَّاطِعةُ كَونُ الآخرة أبدًا، والدُّنيا أمَدًا، وأعمالُنا فيها مشهُودة، وأعمارُنا معدُودة، وأقوالُنا مرصُودة، والودائِعُ مردُودة، والآجالُ محتُومة.
|
إنَّا لنَفرَحُ
بالأيامِ نقطَعُها |
|
وكلُّ يومٍ مضَى يُدنِي
مِن الأَجَلِ |
والمقامُ - يا عباد الله - لتبصيرِ النُّفوس وإرشادِها، وتصحيحِ عِثارِ المسيرة وتذليلِ كِئادِها، وتوجيهِ الأمة المُبارَكة شطرَ العلاء الوثَّاب، والحَزم الهادِفِ الغلَّاب. فما أحوجَ أمَّتنا في هذه السَّانِحة البينيَّة أن تنعطِفَ حيالَ أنوار البصيرة، فتستدرِكَ فرَطَاتِها، وتنعتِقَ مِن ورَطَاتها، وتُفعَمَ رُوحُها بمعانِي التفاؤُل السنيَّة، والرَّجاءات الربَّانيَّة، والعزائِم الفُولاذيَّة، وصوارِمِ الهِمَم الفتِيَّة؛ كي تفِيءَ إلى مراسِمِ الاهتِداء والقِمَم، وبدائِعِ الخِلال والقِيَم، على ضوء الموردِ المَعِين، والنَّبْع الإلهيِّ المُبين هَدي الوحيَين الشريفَين، مُستمسِكةً بالتوحيد والوحدة، مُعتصِمةً بالكتابِ والسنَّة على منهَج سلَف هذه الأمة؛ تحقيقًا لقَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «ترَكتُ فيكم أمرَين لن تضِلُّوا ما إن تمسَّكتُم بهما: كِتابَ الله وسُنَّتي»؛ أخرجه مالكٌ في "الموطأ".
أيها المُسلمون:
وفي زمانٍ كشَفَت فيه الفِتَنُ قِناعَها، وخلَعَت عِذارَها، إنَّا لنُرسِلُها هتَّافة، ونُكرِّرُها ردَّافة في ختامِ عامِنا الهِجريِّ، واستِشرافِ عامٍ جديدٍ بهِيٍّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
فهلُمُّوا - عباد الله - إلى تجديدِ الثِّقة، والتغيير الإيجابيِّ المُنعكِسِ بصِدقٍ وإخلاصٍ ورُسُوخٍ على صعِيد الواقع والتربية والسُّلُوك، التغيير الذاتيّ الذي يبنِي المُجتمعات، ويستشرِفُ الخيرَ للأجيال الصَّاعِدة؛ ليكون النَّجَحُ معقُودًا بنواصِيها، والمجدُ مُكتنِفًا مطاوِيها، ويكون ديدَنُها جمعَ الشَّمل، ودرءَ الفتن، ووأد الشُّبُهات، واستِشعار جلال الأُلفَة والجماعة، وما تقتَضِيه مِن السَّمع والطاعة.
أمة الإسلام:
وإنَّ مما يُثيرُ الأسَى أن نرَى أقوامًا مِن أبناءِ الأمة قذَفُوا بأنفسِهم في مراجِلِ الفتَن العَميَاء، والمعامِعِ الهَوجَاء، في بُعدٍ واضِحٍ عن الاعتِدال والوسطيَّة، وهذا تفريطٌ وجفاءٌ، وتنكُّرٌ واضِحٌ لسبيلِ الحُنفاء الأتقِياء.
وإنَّ تنكُّرَ هذه الفِئام لمبادِئ دينِهم، ولهَثِهم وراءَ شِعاراتٍ مُصطنَعة، ونِداءاتٍ خادِعةٍ، وأجِنداتٍ خطيرةٍ لَهُوَ الأرضيَّةُ المُمهِّدةُ للعدوِّ المُتربِّص، وأمثالُ هؤلاء جرَّأوا الخُصومَ الألِدَّاء على العبَثِ بمُقدَّسات الأمة ومُقدَّراتها، ومُمارسَة الإرهابِ المُتتابِع ضدَّ إخوانِنا في الأرضِ المُبارَكة فلسطين والمسجِد الأقصَى أمام سَمع العالَم وبصَرِه.
وفي خِتامِ عامٍ مُنصَرِمٍ وآخر مُستشرِف لنُجدِّدُ الثِّقةَ التي استقرَّت في السُّوَيداء وحُقَّت، وانداحَت في الرُّوح وترقَّت، بل ونستأنِسُ بها في هذا العالَم المُضطرِب ثِقةً وثيقةً، وبَيعةً صادقةً مُخلِصةً لوُلاةِ أمرِنا وأئمَّتنا وقادتِنا وعُلمائِنا، ولنكون لهم - بإذن الله - سنَدًا وظَهيرًا في مُواجهة الفتَن والتحديات، ودرء الشُّبُهات ودَحر الشَّهوات، في عالمٍ يمُوجُ بالمُتغيِّرات والأزمات.
أمة العلم والثِّقة:
وفي الوقتِ الذي تُشَنُّ فيه الحَمَلات على أجيالِنا لتفُتَّ في هِمَمهم، يجدُرُ بنا أن نُجدِّدَ الثِّقةَ في نفوسِ أبنائِنا وشبابِنا، وطُلَّابِنا وفتَياتِنا وهم يتوجَّهُون إلى صُروح العلوم والمعارِف للنَّهل مِن مَعين العلمِ والمعرِفة في بدايةِ عامٍ دراسيٍّ حافِلٍ بالمُعطيات والمُنجَزات.
فطُلَّابُنا سواعِدُ أوطانِنا، وركائِزُ نهضَتِنا، وهم الأملُ - بعد الله - في مُستقبَل البلاد الواعِدِ، مما يُؤكِّدُ مسؤوليَّة المُعلِّمين وأولياءِ أمور الطُلَّاب والطالِبات، والعِناية بالمناهِجِ والمباهِج التربوية، والتحصِين العقديِّ والفكريِّ والأخلاقيِّ، فتجديدُ الثِّقة عامِلٌ مِن أهمِّ عوامِلِ بِناء الشخصيَّة السوِيَّة.
ومعدُومُ الثِّقة لا تراهُ إلا مُضطرِبًا مُنهَزِمًا، مُحتارًا مُتردِّدًا، صاحِبُ الثِّقة يتَّسِمُ بالرسُوخ والثبات، لا ترُدُّه عن المُضِيِّ في أداء رِسالتِه في خدمةِ دينِه ووُلاةِ أمرِه ووطنِه نفَثَاتُ حاقِد، ولا نقدُ حاسِد، ولا تغريداتُ مأزُوم، ولا نعيقُ مهزُوم.
أما أدركَ هؤلاء أنَّ أنامِلَهم مُستنطَقة، وأيدِيَهم مُستشهَدة؟!
ألا ما أحوَجَ الأمة في خِتامِ عامِها إلى التوبةِ والاستِغفار والإنابة، وتجديدِ الثِّقة بربِّها - سبحانه - أولًا، ثم بأنفسِها وطاقاتِ أبنائِها، في مُنازلَة الأفكار المُتطرِّفة، ومُكافحَة فُلُول الغلُوِّ والإرهاب، ودُعاة التحرُّر والإقصاء والكراهِية، والشَّائِعات المُغرِضة، والظُّلم والقهر، والتسلُّط والعُنف، والهيمَنَة والتعالِي، والانهِزاميَّة والانحِلال.
والمُتنكِّرِين لدينِهم وهويَّتهم، الخائِنِين لأوطانِهم وبلادِهم، الخارِجين على وُلاة أمرِهم وأئمَّتهم، وتعزيزِ قِيَم التسامُح والحِوار والسلام، والاعتِدال والولاء والانتِماء، مُتسلِّحين بالاعتِصام بالكتاب والسنَّة، والسَّير على منهَج سلَف الأمة، مُستثمِرين مُقدَّرات العصر ومُعطياتِه ومُكتسَبَاتِه في جَمع الكلِمة ووحدة الصفِّ، ونَبذ الفُرقة والخِلاف، ونشر رسالة الإسلام الوسطيِّ المُعتدِل، وتقوية الوحدة الدينيَّة، واللُّحمة الوطنيَّة، جَمعًا بين الأصالة والمُعاصَرة؛ لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة.
ولنَثِق دائمًا أنَّه
|
على قَدْرِ أهل العزْمِ
تأتِي العزائِمُ |
|
وتأتِي على قَدْرِ
الكِرامِ المكارِمُ |
|
وتعظُمُ في عينِ
الصَّغيرِ صِغارُها |
|
وتصغُرُ في عينِ
العظيمِ العظائِمُ |
ألا فليكُن عامُ الأمة الجديدُ السعيدُ للتشاؤُم والتضاؤُل ناسِخًا، وللإحباطِ والتقاعُس فاسِخًا، ولتدأَب أن نكون بالتوكُّل على الله - عزَّ وجل - واستِمداد العزم والتوفيقِ مِنه كالنُّور الساطِع يُبدِّدُ الظُّلُمات، ويستحِثُّ للمكرُمات العزَمَات، وكالغَيث الهامِي النَّافِع يُحيِي مِن الأمل ما ذَبُل وفات؛ لنسعَدَ ونفُوز، وللنَّصر والتمكين نحُوز، وما ذلك على الله بعزيز.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
اللهم بارِك لنا في القُرآن العظيم، وانفَعنا بهَدْيِ سيِّد المُرسَلين، وثبِّتنا على السنَّة والجماعة والصراط المُستقيم يا جوادُ يا كريم، أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّةِ المُسلمين والمُسلِمات مِن جميعِ الذنُوبِ والخَطِيئات؛ فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّ ربِّي غفورٌ ودُود.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَن دعا بدعوتِه واهتَدَى بهُداه.
أما بعد .. فيا عباد الله:
اتَّقُوا الله حقَّ تُقاتِه، واسعَوا لطاعةِ ربِّكم ومرضاتِه؛ فالأعمالُ في انقِضاءٍ وانخِرام، والأعوامُ في إدبارٍ وانصِرام، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281].
إخوة الإيمان:
وإنَّ مما يبعَثُ الأملَ في النُّفوس، ويُثبِّتُ العزائِمَ قبل الرُّمُوس تجديدَ الثِّقة أنَّ بلادَ الحرمَين الشريفَين - حرَسَها الله -، وقد خصَّها الله بفضائِلَ جمَّة، وخصائِصَ كريمة ماضِيةٌ بكل ثِقةٍ في نُصرة قضايا الإسلام والمُسلمين في كل مكان، وخِدمةِ الحرمَين الشريفَين وقاصِدِيهما وضيُوف الرَّحمن - جعلَه الله في موازِينِها -، حريصةٌ على مُقدَّسات المُسلمين أشدَّ الحِرص.
ومَن أجدَرُ مِن بلادِ الحرمَين الشريفَين المملكة العربية السعودية، وهي التي تتمتَّعُ - بفضلِ الله - بالعُمق الدينيِّ، والثِّقَل العالميِّ، والعُمق الاستراتيجيِّ، والمكانة الدوليَّة المرمُوقة، وهي المُؤهَّلةُ دينيًّا وتأريخيًّا وحضاريًّا مِن حمل الرايةِ في الأزمَات الخانِقة، وذلك بإبرازِ النَّموذج الإسلاميِّ الحضاريِّ المُوفَّق بإشراقاتِه وجماليَّاتِه في كل مجالٍ مِن المجالات، ولا عزاءَ للمُغرِضين والشَّانِين والمُزايِدِين.
ألا فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، وابتَدِرُوا غُرَّة الشُّهور مِن العام بالقُرُبات، والصيامِ والطاعات، يقولُ - صلى الله عليه وسلم -: «أفضلُ الصِّيام بعد شهر رمضان: شهرُ الله المُحرَّم»؛ أخرجه مسلم.
وتذكَّرُوا - يا رعاكم الله - حُسنَ ثِقة صاحِبِ الهِجرة - بأبي هو وأمِّي - صلى الله عليه وسلم - بربِّه ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40]، «يا أبا بَكر! ما ظنُّكَ باثنَينِ اللهُ ثالِثُهما؟!».
الله أكبر .. إنَّها الثِّقةُ المُطلَقة بالنَّثر والتمكِين مهمَا احلَولَكَت الظُّلُمات، وكثُرَت التحديات، واللهُ المسؤولُ أن يتقبَّلَ مِنَّا ومِنكم صالِحَ الأعمال، ويُحقِّقُ لنا فيما يُرضِيه التطلُّعات والآمال.
هذا، وصلُّوا - رحِمَكم الله - على خير البرايا مِن الأُمم، الهادِي إلى الطريقِ الأَمَم، كما أمرَكم المَولَى الرحيم، فقال في كتابِه الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى علَيَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
|
وصلِّ
ربِّ على المُختارِ مِن مُضَرٍ |
|
ما
غرَّدَت فوقَ غُصنِ البَانِ وَرقاءُ |
|
والآلِ
والصَّحبِ والأتباعِ قاطِبةً |
|
ما
لاحَ بَرقٌ تلاه وَمضٌ وأصدَاءُ |
وارضَ اللهم عن الخُلفاءِ الراشِدِين، الأئمة المهديين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، وآل البيتِ الطيبين الطاهِرين، وعن الطاهرات أمهات المُؤمنين، وعنَّا معَهم برحمتِك يا أرحمَ الراحِمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، ودمِّر أعداءَ الدِّين، واحمِ حَوزَة الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح واحفَظ أئمَّتنا ووُلاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا خادمَ الحرمَين الشريفَين، اللهم وفِّقه لِما تُحبُّ وتَرضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه، اللهم اجزِه خيرَ الجزاء وأوفرَه كِفاءَ ما قدَّم للحرمَين الشريفَين وقاصِدِيهما، اللهم اجعَل ذلك في موازِين أعمالِه الصالِحة، اللهم شُدَّ أزرَه بوليِّ عهدِه يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم وفِّقهم لما تُحبُّ وترضَى يا ذا الجلال والإكرام.
ووفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين للعمل بكِتابِك، واتِّباع سُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم - يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم تقبَّل مِن حُجَّاج بيتِك الحرام حجَّهم، اللهم اجعَل حجَّهم مبرُورًا، وسعيَهم مشكُورًا، وذنبَهم مغفُورًا، وأعِدهم إلى بلادِهم سالِمين غانِمين مأجُورين غيرَ مأزُورين.
اللهم وفِّق رِجالَ أمنِنا، اللهم وفِّق رِجالَ أمنِنا، وجُنودَنا المُرابِطين على ثُغورِنا وحُدودِنا، اللهم سدِّد رميَهم، اللهم سدِّد رميَهم، واقبَل شُهداءَهم، وعافِ جَرحَاهم، واشفِ مرضاهم، ورُدَّهم إلى أهلِيهم مُنتصِرين غافِرين يا ربَّ العالمين.
اللهم اجعَل عامَنا الجديدَ عامَ خيرٍ وبركةٍ ونصرٍ وتمكينٍ للإسلام والمُسلمين في كل مكان، اللهم اختِم لنا عامَنا هذا برِضوانِك وغُفرانِك، والعِتقِ مِن نيرانِك.
اللهم اجعَل خيرَ أعمالِنا خواتِمَها، وخيرَ أعمارِنا أواخِرَها، وخيرَ أيامِنا يومَ نلقَاك.
اللهم وفِّق أبناءَنا وطُلَّابَنا وفتياتِنا، اللهم ارزُقهم النَّجاحَ والفلاحَ والصلاحَ يا حيُّ يا قيُّوم، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم كُن لإخوانِنا المُستضعَفين في دينِهم في كل مكان، اللهم أنقِذِ المسجِدَ الأقصَى، اللهم أنقِذِ المسجِدَ الأقصَى مِن براثِنِ الصَّهايِنةِ الغاصِبين المُعتَدين المُحتلِّين.
اللهم أصلِح حالَ إخوانِنا في العِراق، وفي اليمَن، وفي أراكان، وفي كل مكانٍ يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصُر إخوانَنا في بلادِ الشَّام، اللهم انصُر إخوانَنا في بلادِ الشَّام على الطُّغاة المُجرِمين الظَّالِمين يا قويُّ يا عزيز.
اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أنت اللهُ لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هدمٍ، ولا غرقٍ.
اللهم إنَّا نستغفِرُك إنَّك كنتَ غفَّارًا، فأرسِلِ السماءَ علينا مِدرارًا.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنَّك أنت التواب الرحيم، واغفِر لنا ولوالِدِينا وجميعِ المُسلمين والمُسلِمات، إنَّك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعَوات.
سُبحان ربِّك ربِّ العِزَّة عمَّا يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

فضائِلُ العبادات وتنوُّعها
ألقى
فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضائِلُ
العبادات وتنوُّعها"، والتي تحدَّث فيها عن فضائِلِ العبادات وما خصَّ الله
تعالى به هذه الأمةَ مِن تنوُّعِها وتعدُّد طرقِ أدائِها، كما أشارَ إلى أنَّ ذلك
لاختِلافِ أحوال النَّاس وقُدرتِهم على أداءِ العباداتِ.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي يسَّر الحجَّ وسائِر أنواع العِبادة، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له القائِل: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26]، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه قادَ الأمةَ إلى ذُرَى المجد والسِّيادة، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه أُولِي الفضل والرِّيادة.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله، فهي خيرُ زاد، وبها النَّجاة يوم المعاد، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
نِعمُ الله على عبادِه كثيرةٌ إن عدَّها عبدٌ أعجَزَه إحصاؤُها، والإسلامُ أعظمُ النِّعم الإلهيَّة، يُولَدُ المولودُ على الفِطرة، وينشَأُ في بيئةٍ يُعبَدُ الله فيها، ويُرفعُ الأذان، ويُقرأُ القرآن. فالحمدُ لله الذي هدانا لهذا.
ومِن أعظم توابِعِ نعمةِ الإسلام وفُروعِها: نِعمةُ تنوُّع العبادات وتعدُّدها، وهي نعمةٌ تحتضِنُ حِكمًا ربَّانيَّة، الطريقُ إلى الله هي واحدةٌ جامِعةٌ لكل ما يُرضِي الله، وما يُرضِيه مُتعدِّدٌ مُتنوِّعٌ بحسبِ الأزمان والأماكِن والأشخاصِ والأحوال؛ لاختِلافِ استِعداداتِ العباد وقوابِلِهم، وتخفيفًا عنهم وتيسيرًا، بما يتلاءَمُ مع قُدرتهم في المنشَطِ والمكرَهِ.
في تنوُّع الفرائِضِ والواجِبات مِن العبادات اختِبارٌ وابتِلاءٌ للمُؤمن على غلَبَته لهوَاه، فانتِقالُ العبد مِن عبادةٍ إلى أُخرى بحسبِ وقتِ كلٍّ مِنها دليلٌ على أنَّه عبدٌ حقيقيٌّ لله.
تتنوَّعُ العباداتُ بمقاصِدِها فتُحقِّقُ كلُّ عبادةٍ مِنها حِكمةً ربَّانيَّةً، ومقصِدًا تربويًّا؛ ففي الصلاةِ يقولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، وفي الزكاةِ يقولُ الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وفي الصيامِ يقولُ الله - عزَّ وجل -: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وفي الحجِّ يقولُ الله: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28].
تتنوَّعُ العباداتُ بمناسِكِها وطُرقِ أدائِها؛ فمَن عجَزَ بمرضٍ أو سفرٍ أو فقرٍ أو ضعفٍ عن عبادةٍ وجَدَ أجرَه في رُخصةٍ وعبادةٍ أُخرى؛ رِعايةً لظروف المُكلَّفين، ورفعًا للحرَجِ عنهم، وتيسيرًا وتسهيلًا لهم، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
راعَى الإسلامُ أحوالَ الفُقراء الذين ظنُّوا سبقَ الأغنياء لهم بفُضول أموالٍ يتصدَّقُون بها، قال الفُقراءُ: يا رسولَ الله! ذهبَ أهلُ الدُّثُور بالأجُور؛ يُصلُّون كما نُصلِّي، ويصُومُون كما نصُوم، ويتصدَّقُون بفُضُول أموالِهم، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أولَيسَ قد جعلَ الله لكم ما تصدَّقُون به؟ إنَّ بكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن مُنكَرٍ صدقة، وفي بُضعِ أحدِكم صدقة».
أصَّل الإسلامُ لمبدأ التخفيف؛ مُراعاةً لأحوال المُكلَّفين؛ فقد جاءت امرأةٌ مِن خثعَم فقالت: يا رسولَ الله! إنَّ فريضةَ الله على عبادِه في الحجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبُتُ على الرَّاحِلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: «نعم».
ومِن الأحاديثِ العظيمةِ التي تدلُّ على سعة رحمةِ الله وفضلِه، ومُراعاةِ أحوالِ المُكلَّفين: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مرِضَ العبدُ أو سافَرَ كُتِبَ له مِن الأجر مثلَما كان يعملُ صحيحًا مُقيمًا».
راعَى الإسلامُ أحوالَ المُكلَّفين مِن النِّساء؛ حيث تعجزُ المرأةُ على القِيام ببعضِ أعمالِ الرِّجال، فرتَّبَ على أعمالهنَّ أجرًا عظيمًا؛ تقديرًا لدورهنَّ، وقيمة أعمالهنَّ.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامَت شهرَها، وحصَّنَت فرْجَها، وأطاعَت زوجَها قِيل لها: ادخُلِي مِن أيِّ أبوابِ الجنَّة شِئتِ».
تتنوَّعُ العباداتُ بفضائِلِها، فتزيدُ كلُّ عبادةٍ في صحائِفِ أعمال المُسلم سجِلًّا مِن الخير، وفيضًا مِن الثوابِ والأجر الجَزيل، مِنها ما يُؤدِّي إلى محو الذنوبِ والخطايا؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما مِن امرِئٍ مُسلمٍ تحضُرُه صلاةٌ مكتُوبةٌ، فيُحسِنُ وضوءَها وخُشوعَها وركوعَها، إلا كانت كفَّارةً لما قبلَها مِن الذنوبِ ما لم يُؤتِ كبيرةً، وذلك الدهرَ كلَّه».
ومِنها ما يُحقِّقُ النَّماء؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقَصَ مالٌ مِن صدقة».
ومِنها ما يكون سببًا لدُخُول الجنَّة؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «والحجُّ المبرُورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة».
ومِنها ما يُجيرُ المُسلمَ مِن عذابِ النَّار؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلِجُ النَّارَ أحدٌ بكَى مِن خشيةِ الله حتى يعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرع، ولا يجتمِعُ غُبارٌ في سبيلِ الله ودُخانُ جهنَّم».
ومِن تنوُّع فضائِلِ الأعمال ما يرتفِعُ به المُسلمُ إلى مقامٍ سنِيٍّ لا يُجارَى؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ مِن أحبِّكم إلَيَّ وأقربِكم مِنِّي مجلِسًا يوم القِيامة أحاسِنكم أخلاقًا».
وتنوُّعُ أوقات العبادات وتنوُّعُ فضائِلِها يُحفِّزُ المُسلمَ إلى أن يستغرِقَ حياتَه في التنقُّل بين بساتين العبادة؛ فإنَّ الله - سبحانه - إذا أحبَّ عبدًا استعملَه في الأوقاتِ الفاضِلة بفواضِلِ الأعمال، وإذا مقَتَه استعملَه في الأوقاتِ الفاضِلة بسيِّئ الأعمال.
في تنوُّع العبادات مُدافعةٌ لبواعِثِ السَّآمة والملَل، يُنشِّطُ النَّفسَ، ويُفضِي إلى استِشعار المُتعَةِ واللذَّة في العبادة.
وهناك عباداتٌ فرديَّةٌ لها فضلٌ، وفيها حِكَمٌ؛ فهي تُقوِّي الصلةَ بالله، وتُربِّي على الإخلاص، والبُعد عن الرِّياء، وتزيدُ صفاءَ الرُّوح والأُنسَ بالله.
قال الحسنُ البصريُّ حينما سُئِل: ما بالُ أهل اللَّيل على وجوهِهم نُور؟ قال: "لأنَّهم خلَوا بربِّهم فألبَسَهم مِن نُورِه - سبحانه وتعالى -".
التوجُّهُ إلى الله بالدُّعاء تضرُّعًا وخيفةً مِن أجمل العبادات الفرديَّة، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ [الأعراف: 205].
الصِّيامُ لوجهِ الله عبادةٌ فرديَّة، وكلُّ عملِ ابنِ آدم له إلا الصَّوم، فإنَّه لله.
الصدقةُ الخفيَّة عبادةٌ فرديَّة، تبذُلُها يمينُ المُسلم ولا تعلَمُ شِمالُه ما أنفقَ.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «سبعةٌ يُظِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه ..»، وذكَرَ مِنهم: «.. ورجُلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما صنَعَت يمينُه».
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله على نِعمه ومِنَنه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له دلَّنا على التفكُّر في الكَون وعِبَره، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه طهَّر القلبَ مِن أمراضِه وعِلَله، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه السَّائِرين على نَهجِه وسُنَنه.
أما بعد:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله.
وكما عظُمَت العباداتُ الفرديَّة، فإنَّ للعبادات التي يجتمِعُ في أدائِها المُسلمون - كالصلاةِ والحجِّ وغيرِهما - فضائِلَ ومقاصِدَ لا تخفَى؛ مِنها: التوادُد والتحابُّ، ومعرفةُ أحوال بعضِهم، وإظهارُ عِزِّ المُسلمين، تعليمُ الجاهِل، وتعويدُ الأمة على الاجتِماع وعدم التفرُّق، والمُواساةُ والمُساواةُ ونبذُ الفوارِق الاجتِماعيَّة.
وفي تنوُّع العبادات ميدانٌ فسِيحٌ للعمل؛ فمِن النَّاسِ مَن يُفتَحُ له في عملٍ دون غيرِه، وكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له.
والنَّاسُ يتفاضَلُون في هذا البابِ، كما ذكَرَ العُلماءُ؛ فمِنهم مَن يكون العلمُ أيسَرَ عليه مِن الزُّهد، ومِنهم مَن يكون الزُّهدُ أيسَرَ عليه، ومِنهم مَن تكون العبادةُ أيسَرَ عليه مِنهما، فالمشروعُ لكل إنسانٍ أن يفعَلَ ما يقدِرُ عليه مِن الخير، كما قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وإذا علِمَ المُسلمُ وأدركَ عظيمَ نعمةِ تنوُّع العبادات لزِمَه أن يشكُرَ ربَّه عليها بالسَّعي فيها؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ ليرضَى عن العبدِ أن يأكُلَ الأكلةَ فيحمدَه عليها، أو يشرَبَ الشَّربةَ فيحمدَه عليها».
ألا وصلُّوا - عباد الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصَّحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك ومنِّك يا أكرمَ الأكرَمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعملٍ، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعمل.
اللهم إنا نسألك مِن الخير كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم إنا نسألك الهُدى والتُّقَى والعفافَ والغِنَى.
اللهم إنا نسألك فواتِحَ الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخرَه، ونسألُك الدرجات العُلى مِن الجنَّة يا رب العالمين.
اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا مِن كل شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على مَن بغَى علينا.
اللهم اجعَلنا لك ذاكِرين، لك شاكِرين، لك مُخبِتين، لك أوَّاهِين مُنِيبِين.
اللهم تقبَّل توبتَنا، واغسِل حَوبَتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، وسدِّد ألسِنَتَنا، واسلُل سَخِيمَةَ قُلوبِنا.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا.
اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أعلنَّا وما أسرَرنا، وما أنت أعلمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّمُ وأنتُ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن زوال نعمتِك، وتحوُّ عافيتِك، وفُجاءة نِقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلنا إلى أنفسِنا ولا إلى أحدٍ مِن خلقِك طرفةَ عين.
اللهم أحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم ابسُط علينا مِن بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورِزقِك.
اللهم بارِك لنا في أعمارِنا وأعمالِنا وأزواجِنا وذريَّاتنا وأموالِنا وأهلِنا، واجعَلنا مُبارَكين أينما كُنَا.
اللهم وفِّق إمامَنا لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، ووفِّق ووليَّ عهدِه لكلِّ خيرٍ يا رب العالمين، إنَّك على كل شيء قدير، ووفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين للعمل بكتابِك وتحكيمِ شرعِك يا أرحم الراحمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

فضلُ شهر الله المحرم
ألقى فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضلُ شهر الله المحرم"، والتي تحدَّث فيها عن شهر الله المحرم وتعظيمه وفضله، وما اختصَّه الله تعالى به مِن الإكثار مِن الصيام فيه بعد شهر رمضان.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفُسنا وسيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعدُ .. أيها المُسلمون:
اتَّقُوا اللهَ تعالى؛ فإنَّ تقواه أفضلُ مُكتسَب، وطاعتَه أعلى نسَب، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: 28].
أمةَ الإسلام:
لقد فضَّل الله تعالى بعضَ خلقِه على بعضٍ، اصطِفاءً مِنه واختِيارًا، وتشريفًا وتكريمًا، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: 68]، فاختارَ - سبحانه - مِن الأمكِنة مكَّة والمدينة، وبارَكَ حول بيت المقدِس، واختارَ مِن الأزمِنة أوقاتًا وأيامًا وشُهورًا يُفيضُ فيها على عبادِه بكرمِه وفضلِه، بما لا يُفيضُ في غيرِها؛ فالسَّعيدُ مَن اغتنَمَها بزيادة الطاعات والقُرُبات، وتعرَّضَ فيها للنَّفحات والبركات.
وإنَّ مما اختصَّه الله تعالى مِن الأزمِنة: الأشهُرَ الحُرم، التي نصَّ عليها في كتابِه، وحرَّمَها يوم خلَقَ السماوات والأرض، فقال - عزَّ مِن قائل -: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].
قال ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "إنَّ الله اختصَّ مِن الأشهُر أربعةَ أشهُر، جعلهنَّ حرامًا، وعظَّم حُرُماتهنَّ، وجعلَ الذنبَ فيها أعظم، والعملَ الصالِحَ والأجرَ أعظم".
وهذه الأشهُرُ الحُرُم بيَّنها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في خُطبتِه العظيمة في حجَّة الوداع، فقال: «إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقَ السماوات والأرض، السنةُ اثنا عشر شهرًا، مِنها أربعةٌ حُرُم، ثلاثةٌ مُتوالِيات: ذو القعدة، وذو الحجَّة، والمحرم، ورجبٌ شهرُ مُضَر الذي بين جُمادَى وشعبان»؛ رواه الشيخان.
فشهرُ الله المحرم عظَّمَه الله وشرَّفَه، وأضافَه - سبحانه - إلى نفسه، وقد كانت العرب في الجاهلية يُعظِّمونه، ويسمُّونه بشهرِ الله الأصم، من شدةِ تحريمِه وعظمتِه.
فيا معاشرَ المؤمنين:
إذا كان احترامَ الأشهرِ الحرم أمرًا متوارثًا عند أهل الجاهلية، أفلا يكون حريًّا بالمسلم الذي هداه الله تعالى، فرضِيَ باللهِ ربًّا وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبيًّا ورسولًا، أفلا يكون حريًّا به أن يُعظِّم ما عظَّمَه اللهُ ورسولُه؟ فيحجِزُ نفسَه عن الذنوبِ والعِصيان؟ وينأَى بها عن أسبابِ الإثمِ والعُدوان؟ وأن يترفَّع عن دوافعِ الهوى ومزالِقِ الشيطان؟
ولئِن كان ظُلمُ النفس مُحرَّمًا في كل حين، فهو في الأشهر الحرم أشد حرمة؛ لأنه جامعٌ بين الجُرأة على الله تعالى بارتكاب الذنوب والخطايا، وامتِهان حُرمةِ ما حرَّمه الله وعظَّمه.
وإنَّ من أعظم ظلم النفس: الإشراكَ بالله تعالى، كما قال لقمانُ لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]. فالإشراكُ بالله تعالى هو أعظمُ خطيئة، وهو الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبِهِ إن مات عليه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].
ومع عظمةِ اقترافِ الشرك، فإنَّ الجُرم يعظُم حينما يعلمُ ويُقِرُّ المُشرك أن الذي خلقه هو الله - جلَّ جلاله، وتقدست أسماؤه -.
ففي "الصحيحين" عن عبدِ الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الذنبِ أعظمُ عند الله؟ قال: «أن تجعلَ لله ندًّا وهو خلقك».
ومن ظلمِ النفسِ - يا عبادَ الله -: تركُ واجِبٍ أمرَ الله به، أو فِعلُ مُحرَّم يُوبِقُ الإنسانُ فيه نفسَه، ويتعدَّى فيه حقوقَ خالقه، ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1].
معاشرَ المسلمين:
إنَّ مِن عظيمِ فضلِ الله تعالى على عباده: أن جعلَ آخر شهر في العام شهر عبادةٍ وطاعة، وأوَّلَه شهر عبادةٍ وطاعة، فيفتَتِحُ المؤمنُ عامَه بطاعة الله، ويختتمه بطاعة الله.
وإنَّ من أعظمِ الأعمال التي يحرصُ عليها المسلم، في شهر الله المحرم وغيره: صدقَه وإخلاصَه في توحيد ربه، وإفرادَه بالعبادة وحده لا شريك له، والتقرُّب إليه بأداء الفرائض، والإكثارَ من النوافل، فمَن فعل ذلك فاز بمحبة الله - جلَّ جلاله -.
وفي الحديث القدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه، فإذا أحبَبتُه كنتُ سَمعَه الذي يسمعُ به، وبَصرَه الذي يُبصِرُ به، ويدَه التي يبطِشُ بها، ورِجلَه التي يمشِي بها، وإن سـألَني لأُعطينَّه، ولئِن استعاذَني لأُعيذنَّه»؛ رواه البخاريُّ في "صحيحه".
وإنَّ من أعظم النوافلِ أجرًا: صيام التطوع، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صام يومًا في سبيل الله، باعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»؛ رواه البخاريُّ ومسلم.
وخصَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك شهرَ الله المُحرَّم، فالصوم فيه من أفضل القربات، وأجلِّ الطاعات.
فقد أخرج مسلمٌ في "صحيحه": أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: أيُّ الصلاةِ أفضل بعد المكتوبة؟ وأيُّ الصيام أفضل بعد شهرِ رمضان؟ فقال: «أفضلُ الصلاةِ بعد الصلاةِ المكتوبة: الصلاةُ في جَوفِ الليل، وأفضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضان: صيامُ شهر الله المُحرَّم».
قال القرطبيُّ - رحمه الله -: "إنما كان صومُ المُحرَّم أفضلَ الصيام، مِن أجل أنه أول السنة المُستأنَفَة، فكان استِفتاحُها بالصوم الذي هو أفضلُ الأعمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].
بارَك الله لي ولكم في القرآنِ والسنَّة، ونفعَني وإيَّاكُم بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه؛ إنَّه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله عظيمِ الإحسان، واسعِ الفضل ِوالجُودِ والامتِنان، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابهِ أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ؛
معاشر المؤمنين:
فلليومِ العاشرِ من شهر الله المحرَّم فضلٌ عظيم، وحرمةٌ قديمة؛ فقد نجَّى الله تعالى فيه موسى - عليه السلام - مِن فرعون وقومه، فكان نبيُّ الله موسى - عليه الصلاة السلام – يصومُ يوم عاشوراء شُكرًا لله تعالى.
ففي "صحيح مسلم" عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدِمَ المدينة، فوجدَ اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما هذا اليومُ الذي تصومونه؟»، فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ، أنجَى الله فيه موسى وقومُه وغرَّق فرعونَ وقومَه، فصامَه موسى شُكرًا، فنحن نصومه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «فنحن أحقُّ وأَولَى بموسى منكم»، فصامَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرَ بصيامه.
وفي "صحيح البخاري"، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: ما رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتحرَّى صيام يومٍ فضله على غيره إلا هذا اليوم، يومَ عاشوراء.
ومن السنةِ - يا عبادَ الله - في صيام يوم عاشوراء، أن يُصام يومٌ قبله.
فقد أخرج مسلمٌ في "صحيحه" عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لئن بقيتُ إلى قابِلٍ لأصومنَّ التاسِع».
ولما سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن فضل صيامِ يومِ عاشوراء، قال: «أحتسِبُ على الله أن يُكفِّر السنةَ التي قبلَه» رواه مسلم.
وهذا من فضل الله علينا، أن جعل بصيام يومٍ واحد، تكفير ذنوب سنة كاملة، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: 74].
فنلحرص - معاشِر المؤمنين - على اغتِنام المواسِم المُباركة، التي يتنافسُ فيها المُتنافِسون، ويُقبِلُ فيها المُجِدُّون، فالكيِّسُ من دانَ نفسَه، وعمِلَ لِما بعد الموت، والعاجِزُ مَن أتبَعَ نفسَه هواها، وتمنَّى على الله - عزَّ وجل -.
ثم اعلَمُوا - معاشِر المُؤمنين - أنَّ الله أمرَكم بأمرٍ كريمٍ، ابتدَأ فيه بنفسِه، فقال - عزَّ مِن قائِلٍ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجُودِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، واحمِ حَوزةَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، رخاءً سخاءً وسائرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتِك نستَغيثُ، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلنا إلى أنفُسِنا طرفةَ عينٍ.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوبين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ برحمتِك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل عامَنا هذا عامَ أمنٍ وإيمان، عامرًا بالخيرات والبركات يا رفيعَ الدرجات، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ياحي ياقيوم، وفِّق إمامَنا بتوفيقِك، وأيِّده بتأيِيدِك، واجزه خيرَ الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لما تُحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لما تُحبُّ وترضَى، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم مَن أرادنا، وبلادَنا، وأمنَنا، ورجالَ أمننِا بسوء، فاجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودِ بلادنا، اللهم انصرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم انصرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم رُدَّهم إلينا سالِمين غانمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.
سُبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

مراقبة الله عزَ وجل
ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "مراقبة الله عزَ وجل"، والتي تحدَّث فيها عن فضل مراقبة الله تعالى في السر والعلن وأثرها على الفرد والمجتمع في إصلاحه، وأشار إلى أهمية المراقبة في الفتوى، ثم تكلَّم عن فضل شهر المحرم وصيام عاشوراء.
الخطبة الأولى
الحمدُ للهِ الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له في الآخرةِ والأولى، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه النبيُّ المصطفى، صلى الله عليه وعلى آلِه وأصحابهِ أهلِ الوفا والتقوى.
عبادَ الله:
أوصيكم ونفسي بتقوى الله - جلَّ وعلا -؛ فإن تقوى الله - جلَّ وعلا - فيها سلامة الشرور من مصائب الدنيا والأُخرى.
عبادَ الله:
من أسماءِ الله - جلَّ وعلا -: الرقيب، يقول - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ويقول - جلَّ وعلا -: ﴿وكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ [الأحزاب:52].
فهو - سبحانه - الرقيب المُطَّلِع على ما كنَّت الصدور، القائِمُ على كل نفسٍ بما كسبت، الحافظُ الذي لا يغيب عنه شيء، المُطَّلِعُ على الخلائق، يرى أحوالهم ويُحصي أعمالهم.
قال ابنُ القيم:
|
وهو القريبُ على الخواطِرِ واللَّوا |
|
حِظِ كيف بالأفعالِ والأركانِ |
وإنَّ استقرارَ هذا المعنى العظيم في قلبِ العبد، يجعله مُتيقنًا بدوامِ علمِ الله واطلاعه على ظاهرِه وباطنِه، فيثمرُ له ذلك علمًا جازمًا، بأن الله رقيبٌ عليه، ناظرٌ إليه، سامعٌ بقولِه، بصير بفعله، مُطلعٌ على عملِه في كل وقتٍ ولحظةٍ وفي كلِّ طرفةِ عين.
فالمراقبةُ - يا عباد الله -، المراقبةُ مِن العبدِ تعبُّدٌ للهِ باسمه - سبحانه - الرقيبِ الحفيظِ، العليمِ المحيطِ، الخبيرِ اللطيفِ، المُهيمِنِ باطِّلاعهِ على خفايا الأمور وخبايا الصدور.
فهو - عزَّ شأنُه - الشهيدُ المُطَّلِعُ على جميع الأشياء، السميعُ لجميع الأصوات جليِّها وخفيِّها، البصيرُ لجميعِ الموجودات دقيقِها وجليلِها، صغيرِها وكبيرِها، القريبُ مِن كل أحدٍ بعلمِه وخبرتِه ومراقبتِه ومشاهدتِه وإحاطتِه، فمَن عقَلَ هذه الأسماء الحسنى، وتعبَّدَ لله بمُقتضاها، حصَلَت له المراقبةُ الحقَّة التي تجعلُ قلبَه مُراعِيًا لملاحظة الحق - سبحانه - مع كلِّ خطرةٍ وخطوةٍ.
عباد الله:
إنَّ واجبَ العبدِ في هذه الحياة الدنيا أن يكونَ قلبه في مراعاةٍ دائمةٍ للرقيبِ - عزَّ شأنُه -، فلا يلتفِتُ إلا إليه، ولا يخافُ إلا منه، فهو دائم الحفظ لأوامره - جلَّ وعلا -، دائم الحفظِ لنواهيه، مُنصرف الهمةِ إلى ما يُرضيه ويُقرِّبه منه – سبحانه -، فمتى راقَبَ العبدُ ربَّه أوجبَ له ذلك الحياءَ من خالقه، والإجلالَ والتعظيمَ لبارئِه، والخشيةَ والمحبةَ والإنابةَ والخضوعَ والتذلُّلَ لمَن خلقَه وأوجدَه.
فصلاحُ الدارَين - يا عبادَ الله - وفلاحهما في مراقبةِ العبدِ لربه وتحرِّيه مرضاته، وملازمةِ عبوديتِه على السنَّةِ النبوية، مع لزومِ الإخلاص له - سبحانه -، إخلاصِ مَن يعلم أن الناس إن راقبوا ظاهره، فالله - جلَّ وعلا - يراقبُ ظاهرَه وباطنه، كما قال– سبحانه -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: 5]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: 235].
معاشر المسلمين:
مراقبةُ الله - جلَّ وعلا - توجِبُ على العبدِ مُحاسبةَ النفس؛ استجابةً لقوله - سبحانه -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18].
قال ابن القيم - رحمه الله -: "فينظرُ العبدُ ما قدَّم لليوم الآخر أمِنَ الصالحات التي تُنجِيه، أم مِن المُوبقات التي تُوبِقه ..." إلى أن قال: "والمقصودُ: أنَّ صلاحَ القلب بمحاسبةِ النفس، وفسادَه بإهمالِها والاسترسالِ معها". اهـ كلامُه.
معاشر المؤمنين:
إنَّ مراقبة الله حقًّا تحملُ العبدَ على الاجتهادِ في الطاعات، والتجرُّدِ عن كل ما يُعارِضُ أمرَ ربِّ الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: 90].
فالمؤمن - يا أيُّها الناس - يجبُ أن يكون في مراقبةٍ دائمةٍ لربِّه، في الطاعةِ: بالإخلاصِ والامتثالِ على الكمال، وفي بابِ النواهِي: بالانزجارِ والمداومةِ والمثوبةِ والإنابةِ إلى ربِّنا - جلَّ وعلا -، فما حُفِظَت حدودُ الله ومحارمُه، ووصلَ الواصلون إليه - سبحانه - بمثل خوفهِ ومراقبته، ورجائِه ومحبته، جعلنا اللهُ وإياكم من أهل الخوف والرجاء.
قال - سبحانه -: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46]، وقال - عزَّ شأنُه -: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: 40- 41].
قال ابن الجوزي - رحمه الله -: "الحقُّ - عزَّ وجل - أقربُ إلى عبده من حبل الوريد ..." إلى أن قال: "فقلوبُ الجُهَّال تستشعرُ البُعدَ، ولذلك تقعُ منهم المعاصي؛ إذ لو تحقَّقَت مراقبتهم للحاضرِ الناظرِ - سبحانه -، لكفُّوا الأكفَّ عن الخطايا".
قيلَ لبعض السلف: بمَن أستعينُ على غضِّ البصر؟ قال: "بعلمِك أنَّ نظرَ الناظرِ إليك أسبقُ مِن نظرِك إلى المنظورِ إليه".
وفي مِثل هذا المعنى يُذكِّرُنا نبيُّنا – صلى الله عليه وسلم – بهذا المعنى فيقول: «سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلِّه، يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه: الإمام العادل، وشابٌّ نشأ في طاعةِ الله، ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا عليه وتفرَّقَا عليه، ورجلٌ دعَتْه امرأةٌ ذات منصِبٍ وجمالٍ فقال إنِّي أخافُ الله، ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ، فأخفاها حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يمينُه، ورجلٌ ذكَرَ اللهَ خاليًا ففاضَت عيناه».
رقابة الله - جلَّ وعلا - تُنزِّهُ الأفرادَ عن مُقارفة الآثام والمحرمات، وتُنزِّهُ القلوبَ عن كل ما يُدنِّسُها ويُفسدها، وبذا يتحقَّق المجتمع الصالح الذي أراده الله - جلَّ وعلا - بقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].
فمراقبةُ الله - جلَّ وعلا - تُنشئُ مجتمعًا نقيًّا من الرذائل، خاليًا من الجرائم، يتحلَّى أبناؤه بكل فضيلة، ويعيشون عيشةً رضيَّةً، متعاونين على البرِّ والتقوى، مُعتصِمِين بحبل الله - جلَّ وعلا -، مُجتمِعين على كلمةِ الله، نابِذينَ كل تفرُّقٍ وتحزُّب، مُناوِئِين كلَّ منهجٍ غالٍ وفكرٍ متطرف، يعيشون على ضوء مبادئ دينهم، وما يحمِلُه من العدل والسماحة، واليسر والوسطية، والرفق واللين والمحبة، قال تعالى في وصفِ المؤمنين: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 45].
يعيشون تحت رقابةِ ربِّهم، في استقامةٍ وإصلاحٍ، آمنين مُستقِرِّين، يعبدون ربَّهم، يشكرون خالِقَهم، يُوحِّدون صفَّهم في محبةٍ إيمانيةٍ، ومودةٍ إسلامية، شعارهُم: قولُه - جلَّ وعلا -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10].
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحاسَدوا، ولا تناجَشوا، ولا تباغَضوا، ولا يبِع بعضُكم على بيعِ بعضٍ، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلمُ أخو المسلم لا يظلِمُه ولا يخذُلُه ولا يحقِرُه ..» الحديث.
فراقِبُوا الله - جلَّ وعلا - في أداء حقوقه - سبحانه -، وراقبوه في أداء حقوق عباده؛ تفلحوا وتفوزوا وتسعَدوا.
معاشرَ المسلمين:
ونحن نتكلَّمُ عن مراقبةِ الله - جلَّ وعلا -، فلا بُدَّ أن نُنوِّهَ لأمرِ ضروري، التنبيهُ عليه ضروري، وهو أنَّ الواجب والمُتحتِّم على الدعاة والعلماء أن يراقبوا الله - جلَّ وعلا - فيما يُصدِّرونه للناس، ويعلموا أن الفتوى خطيرةٌ، يجب الإخلاص فيها لله - جلَّ وعلا -، والصدقُ معه - سبحانه -، ومراقبتُه في السرِّ والعلن؛ فإنَّ الله - جلَّ وعلا - استأمَنَ العلماء على ذلك.
فعلى الجميع الحذر من الفتاوى الأحادية في قضايا الأمة ومُستجدَّاتها العامة، والتي لا يجوز فيها التعجُّل والتسرُّع، بل لا بُدَّ من التروِّي والانقطاع، مع لجوءٍ إلى الله - جلَّ وعلا - أن يُلهِم الصواب، ولا بُدَّ من مراعاة لمآلات الأمور، ومراعاة قواعد الشريعة ومقاصدِها العامة، والنظرِ الدقيق لقاعدةِ جلبِ المصالح وتكثيرِها، ودرء المفاسدِ وتقليلِها، مع الحرصِ التام على لُحمةِ الأمة، واجتماعِ الكلمة، ووحدةِ الصف، والبُعد عن كل ما يؤثِّرُ على ذلك ولو من طرفٍ خفي.
ولا بُدَّ في مثل هذه الفتاوى الرجوعُ إلى العلماء الراسخين مع ما هم عليه من التجارب الطويلة، والخبرةِ العميقة، فحرِيٌّ بمثل هذه الفتاوى أن تصِلَ إلى الرأي الأصلح الذي تصلُحُ به الأحوال، وتستقيمُ معه الأمور، وإلا فبدونِ مُراعاةٍ لتلك المبادئ تقعُ الأمةُ في فوضى فكريةٍ، تؤدِّي إلى عواقب وخيمة حذَّرَ منها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا فأفتَوا، فضلُّوا وأضلُّوا».
نسأل الله - جلَّ وعلا - السلامةَ من ذلك.
نسأل الله - جلَّ وعلا - أن يوفِّقنا جميعًا لما يحبُّه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمون:
اتَّقوا الله - جلَّ وعلا -، فهي وصيةُ الله للأولين والآخرين.
عباد الله:
أنتم في شهرٍ عظيم شهر الله المحرم، فأرُوا اللهَ من أنفسكم خيرًا.
عن أبي هريرة - رضي الله عليه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أفضلُ الصيامِ بعد رمضان شهرُ الله المحرم»؛ رواه مسلم.
ويُستحبُّ ويسنُّ صيامُ عاشوراء، وهو اليومُ العاشر من هذا الشهر.
فعن أبي قتادةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل عن صيامِ يومِ عاشوراء، فقال: «يُكفِّرُ السنةَ الماضية». وفي رواية: «أحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنةَ التي قبله»؛ رواه مسلم.
ثم إنه يُسنُّ للمسلم أن يجمع معه صيام يوم التاسع، كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «لئِن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التاسع»؛ رواه مسلم.
وأما سائرُ ما يُذكر من المستحبَّات في هذا اليوم، فذلك لم يرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قرَّر ذلك المُحقِّقون مِن أهلِ العلم.
ثم إنَّ الله - جلَّ وعلا - أمرَنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاةُ والسلامُ على النبيِّ الكريمِ.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشدين، وعن سائرِ الصحابة والآل أجمعين، وعن التابعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين.
اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم فرِّج همومَهم، واكشِف غمومَهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.
اللهم وفِّق الحجَّاجَ والمعتمرين، اللهم أوصِلهم إلى ديارِهم سالمِين غانمِين.
اللهم احفظ ووفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووليَّ عهده، اللهم أعِنهما على أمور الدين والدنيا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام.
عباد الله:
اذكُروا الله ذِكرًا كثيرًا، وسبِّحُوه بُكرةً وأصيلًا.
وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

حوضُ النبي
- صلى الله عليه وسلم - في الجنة
ألقى فضيلة الشيخ علي بن
عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حوضُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة"،
والتي حذَّرَ فيها من فتن الدنيا، ووجوب اغتنام الحياة فيها في طاعة الله تعالى
والإكثار من الصالحات، كما تحدَّث عن حوض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووجوب الإيمان به،
مُبيِّنًا فضلَه، وأسبابَ الشرب منه، وموانِع وُرودِه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله العزيز الوهاب، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: 3]، أحمدُ ربي وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ الكبير، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه السابِقين إلى كل فضلٍ وخير.
أما بعد:
فاتَّقوا الله بامتِثال ما أمَر، واجتِناب ما نهَى عنه وزجَر.
عباد الله:
اعملوا الأعمال الصالحات لإصلاح آخرتكم، ولا تُبطِلوا الأعمال فتخسَروا أنفسَكم، قال الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 105]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: 15].
وأصلِحوا دُنياكم بكسب الحلال، وإنفاقِه في أبوابِ الخير الواجِبة والمُستحبَّة والمُباحَة.
واجعَلوا هذه الدُّنيا زادَكم إلى دار النعيم، ولا تغُرنَّكم بمباهِجِها، ولا تفتنَنَّكم عن الآخرة.
فاعمَل - أيها المُسلم - لإصلاح دُنياك، واعمَل لإصلاح آخرتِك، وفي الحديث: «ليس خيرُكم مَن تركَ آخرتَه لدُنياه، ولا مَن تركَ دُنياه لآخرته».
وعن المُستورِد بن شدَّاد - رضي الله عنه - قال: كنَّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فتذاكَرنا الدنيا والآخرة، فقال بعضُهم: إنَّما الدنيا بلاغٌ للآخرة، وفيها العمل، وفيها الصلاة، وفيها الزكاة. وقالت طائفةٌ منهم: الآخرةُ فيها الجنة، وقالوا ما شاء الله. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما الدنيا في الآخرةِ إلا كما يمشِي أحدُكم إلى اليمِّ، فأدخَلَ أُصبعه فيه، فما خرجَ منه فهو الدنيا»؛ رواه الحاكم في "المُستدرك".
وروى الحاكمُ عن سعد بن طارق، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نِعمَت الدار الدنيا لمَن تزوَّد منها لآخرته، حتى يُرضِيَ ربَّه، وبِئسَت الدارُ لمَن صدَّته عن آخرته، وقصَّرَت به عن رِضا ربِّه».
وقال الحسنُ البصريُّ - رحمه الله -: "نِعمَت الدارُ كانت الدنيا للمُؤمن؛ وذلك أنه عملَ قليلًا، وأخذ زادَه منها إلى الجنة، وبِئسَت الدارُ كانت للكافر والمُنافِق؛ وذلك أنه ضيَّع ليالِيَه، وكان زادُه منها إلى النار"؛ رواه أحمد في "الزهد".
وكلٌّ يعلمُ يقينًا بأنه مُرتحِلٌ مِن هذه الدار، وتارِكٌ ما خوَّله الله في الدنيا وراءَ ظهره، لا يصحَبُه إلا عملُه، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ.
فإذا كان حالُ كل أحدٍ مُنتَهيًا إلى هذه الغاية، وقادِمًا على هذا المصير وجبَ عليه أن يَقدُم على ربِّه بأفضل ما يقدِرُ عليه مِن العمل الصالِح، فلا وسيلةَ بين العبد وربِّه إلا به، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ [سبأ: 37].
وليكُن همُّك - أيها المسلم - الفوزَ بالشُّرب مِن حَوضِ النبي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، سيِّد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام -، كيف تعملُ لهذه الغاية؟
فهو أولُ شراب أهل الجنة، فمَن وفَّقه الله ومَنَّ عليه بالشُّرب مِن هذا الحوض فلا خَوفٌ عليه بعد ذلك، ومَن كان مِمَّن يرِدُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحوضَ يسَّر الله عليه الأهوالَ قبل ذلك.
والإيمانُ بالحَوض إيمانٌ باليوم الآخر، ومَن لم يُؤمن بالحَوض فلا إيمانَ له؛ إذ أركانُ الإيمان لا يُفرَّقُ بينها، فمَن لم يُؤمن برُكنٍ مِن أركان الإيمان فقد كفرَ بها جميعًا.
والحوضُ كرامةٌ مِن الله تعالى لنبيِّه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، تشرَبُ منه أمَّته في أرض المحشَر، وموقِف الحساب يوم القيامة، في يومٍ كان مِقدارُ يومِه خمسين ألف سنة على الكفار، ويُقصِّرُه الله على المؤمن.
يغشَى الناسَ في هذا اليوم في موقِف الحساب مِن الكُرُبات والشدائِدِ ما لا يُطيقُون، ولولا أنَّ الله أعطَى أبدانَهم قوةَ التحمُّل والبقاء لماتُوا أجمعون.
ويُصيبُهم في موقِف الحساب الظمأُ الشديدُ الذي يحرِقُ الأكباد، ويُشعِلُ الأجوافَ عطَشًا شديدًا لم يظمَأوا قبلَه مثلَه قطُّ، ويُكرِمُ الله نبيَّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحَوض لتشربَ منه أمَّتُه، وهو - صلى الله عليه وسلم - قائمٌ بأصل الحوضِ ينظرُ إلى أمَّته، ويُسرُّ بذلك أعظم السرور، ويدعُو أمَّته للشُّربِ.
وسَعةُ الحوض وصفةُ مائِه تواتَرت بها الأحاديث النبوية، وجاء القرآنُ بذِكره في سورة الكوثر، ولكل نبيٍّ حوض.
عن سُمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الأنبياء يتباهَون أيُّهم أكثرُ أصحابًا مِن أمَّته، فأرجُو أن أكون يومئذٍ أكثرَهم كلِّهم وارِدَه، وإنَّ كل رجُلٍ منهم يومئذٍ قائمٌ على حَوضٍ ملآن، معه عصا يدعُو مَن عرفَ مِن أمَّته، ولكل أمةٍ سِيمَا يعرِفُهم بها نبيُّهم»؛ رواه الترمذي والطبراني.
وحَوضُ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - أكبرُها وأحلاها كشريعته.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ حَوضي أبعَدُ مِن أيْلَة إلى عدن، لهو أشدُّ بياضًا مِن اللبن، وأحلى مِن العسل، وأبرَدُ مِن الثلج، ولآنيَتُه أكثرُ مِن عدد النجوم»؛ رواه مسلم.
وفي روايةٍ لغير مُسلم: «أطيَبُ رِيحًا من المِسك».
وعن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيدِه؛ لآنيَتُه أكثر مِن عدد نجوم السماء وكواكبِها في الليلة المُظلِمة المُصحِيَة، آنِيةُ الجنة مَن شرِبَ منها لم يظمَأ آخرَ ما عليه، يشخُبُ فيه ميزابان مِن الجنة - أي: يصُبُّ فيه -»؛ رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وعن أبي أُمامة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَوضي مثلُ ما بين عدَن وعمَّان، وهو أوسعُ وأوسعُ، فيه مُثعِبَان مِن ذهبٍ وفضَّة، شرابُه أبيضُ مِن اللبن، وأحلى مذاقةً مِن العسل، وأطيبُ رِيحًا من المِسك، مَن شَرِب مِنه لم يظمَأ بعدها، ولم يسوَدَّ وجهُه أبدًا»؛ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان.
وعن زيد بن خالدٍ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل تدرُون ما الكوثر؟ هو نهرٌ أعطانِيه ربِّي في الجنة، عليه خيرٌ كثيرٌ، ترِدُ عليه أمَّتي يوم القيامة، آنيَتُه عددُ الكواكِب، يُختَلَجُ العبدُ منهم فأقولُ: يا ربِّ! إنه مِن أمَّتي! فيُقال: إنك لا تدري ما أحدَثَ بعدك»؛ رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
فالحَوضُ أرضٌ واسعةٌ في أرض الموقِف، يملؤُها الله ماءً مِن نهر الكوثر، يصُبُّ في هذا الحَوض ميزابان مِن ذهبٍ وفضَّةٍ مِن نهر الكوثر، فلا ينقصُ هذا الحَوض، ويشربُ منه كلُّ مؤمنٍ ومؤمنة على شدَّة ظمأٍ عظيم، فلا يظمَأُ أحدٌ بعد شُربه أبدًا.
والذين يَرِدُون على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحَوضَ هم المُتَّبِعون لسُنَّته - عليه الصلاة والسلام -، المُجانِبون للكبائر مِن الذنوب؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31].
ومع التمسُّك بسنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يدعُون إلى الله على بصيرةٍ؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108].
فيَدعُون إلى شريعةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجتنِبون البِدَع والمُحدثات في الدين، والمُنكَرات في الشرع، ويلتزِمون الإخلاصَ المُنافِيَ للرياء والسُّمعة، وأنواع الشرك.
ومِن أسبابِ الشُّرب مِن حَوضه - صلى الله عليه وسلم -: كثرةُ الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 1- 3].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعَنا بهدي سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ذي الجلال والإكرام، والمُلك الذي لا يُرام، والعزَّة التي لا تُضام، أحمدُ ربي وأشكرُه على كثيرِ الإنعام، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ القدُّوسُ السلام، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه عليه أفضلُ الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبِه الكرام.
أما بعد:
فاتَّقوا الله حقَّ التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى.
عباد الله:
ما أعظمَ فوز مَن تفضَّل الله عليه بوُرود حَوض نبيِّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فشَرِبَ منه فلا يظمَأُ أبدًا، وما أعظمَ خسارةَ مَن حُرِم مِن شُربه وطُرِد عنه، ولا يظلِمُ ربُّك أحدًا.
أيها المسلمون:
إنَّ مِن الموانِع مِن وُرود الحَوض: البِدع والمُحدثات في الدين، والصدَّ عن الإسلام بقولٍ أو فعلٍ، كما في الأحاديث المروية في سبب طرد أقوامٍ من الأمة، ففي هذه الأحاديث: «إنَّك لا تدري ما أحدثُوا بعدَك»، فيقول الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -: «سُحقًا لمَن غيَّر بعدي».
ومن الموانِع لوُرود الحَوض: كبائرُ الذنوب، فإنها خبائِث للقلوب، والرياءُ والسُّمعة مِن الموانِع، والمظالِم بين العباد مانِعٌ عظيم.
ومُناسبةُ الجزاء للأعمال ظاهرٌ لمَن تفكَّر فيه؛ فمَن اتَّبَعَ في الدنيا شريعةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمسَّك بهَديِه، وردَ حَوضَه كما وردَ شريعتَه، ومَن غيَر وابتدَع مُنِعَ لصَدِّه عن الحقِّ.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّمُوا على سيِّد الأولين والآخرين وإمام المرسلين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر أصحابِك نبيِّك أجمعين، وعن التابعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم أذِلَّ الكُفرَ والكافرين، والشِّركَ والمُشركين يا رب العالمين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين.
اللهم إنَّا نسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك مِن النَّار وما قرَّب إليها مِن قولٍ أو عمل.
اللهم أعِنَّا على ذِكرِك، وشُكرِك، وحُسن عبادتِك يا رب العالمين.
اللهم أحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم لا تكِلنا إلى أنفُسِنا طرفةَ عينٍ، ولا أقلَّ مِن ذلك، ولا تكِلنا إلى أحدٍ مِن خلقِك يا رب العالمين.
اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين، اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين.
اللهم إنَّا نسألُك أن تتولَّى أمرَ كل مُسلمٍ ومُسلمة، وأمرَ كل مُؤمن ومُؤمنة برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، اللهم أعِنَّا على ذِكرِك، وشُكرِك، وحُسن عبادتِك يا رب العالمين.
يا مُقلِّب القُلوب والأبصار ثبِّت قلوبَنا على طاعتِك.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8].
اللهم إنَّا نسألُك بجُودِك وكرمِك ومنِّك يا رب العالمين، وأسمائِك وصِفاتِك أن تجعلَنا مِمَّن يرِدُ على حوضِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ويُلقاه وأنت راضٍ عنه يا رب العالمين، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تحرِمنا مِن فضلِك يا رب العالمين، ولا تطرُدنا عن فضلِك وعن بابِك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا من إبليس وذريَّته وشياطينه وجنوده وأوليائِه يا رب العالمين، اللهم أعِذنا مِن شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعِذنا من شرِّ كل ذي شرٍّ يا رب العالمين، اللهم وأعِذ المُسلمين وذريَّاتهم من إبليس وذريَّته يا ذا الجلال والإكرام، إنَّك على كل شيء قدير.
اللهم إنَّا نسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرة، اللهم إنَّا نسألُك العفوَ والعافيةَ في دينِنا ودُنيانا وأهلِينا يا رب العالمين، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، وفرِّج كربَ المكرُوبين مِن المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين، وتولَّ أمرَ كل مُؤمنٍ ومُؤمنة، وأمرَ كل مُسلم ومُسلمة.
اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين يا أرحم الراحمين، برحمتِك يا أكرمَ الأكرمين.
اللهم احفَظ جُنودَنا، اللهم احفَظ جُنودَنا، واحفَظ بلادَنا مِن كل شرٍّ ومكرُوهٍ يا رب العالمين.
اللهم احفَظ الإسلامَ وأهلَه في كل مكان، اللهم احفَظ الإسلامَ وأهلَه في كل مكان، اللهم ارفَع عن كل مُسلمٍ كلَّ ضائِقةٍ وشدَّةٍ يا رب العالمين على وجهِ الأرضِ إنَّك على كل شيء قدير.
اللهم لا تُسلِّط مَن لا يُؤمنُ بالله واليوم الآخر على المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفِ المُسلمين شرَّ مَن لا يُؤمنُ بالله واليوم الآخر، وشرَّ مَن تسلَّط عليهم وعذَّبَهم وشرَّدَهم مِن ديارهم يا رب العالمين، إنَّك على كل شيء قدير، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق بتوفيقِك خادمَ الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، اللهم أعِنه على كل خيرٍ، اللهم وارزُقه الصحةَ والعافيةَ يا رب العالمين، اللهم ارزُقه الرأيَ السديدَ، والعملَ الرشيدَ، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، وأعِنه على كل خيرٍ يا رب العالمين، اللهم اجعَلهما مِن الهُداة المُهتَدين يا رب العالمين، وانفَع بهما الإسلامَ والمُسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكروا الله العظيمَ الجليلَ يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدْكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلم ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

ذكرُ الله
تعالى
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "ذكرُ الله تعالى"، والتي تحدَّث فيها عن ذِكرِ الله - جلَّ وعلا -، وعلاقته الوَطيدة بحياةِ قلبِ العبد، وبيَّن أنَّ ذِكرَ الله تعالى سببٌ في صحَّة البدَن وقوَّته، مُدلِّلًا على ذلك ببعضِ آياتٍ مِن القرآن الكريم، وأقوالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأفعالِه، وما ثبَتَ عن السَّلَف الصالِح.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد:
فإنَّ المُؤمنَ في سكَناته وتحرُّكاته، وحِلِّه وتَرحالِه، وتصرُّفاته وجميعِ أحوالِه لا غِنَى له عن خالقِه ومولاه؛ إذ هو عَونُه ومُعتمَدُه ومُبتغاه، والعبدُ الربَّانيُّ عابِدٌ مُتألِّهٌ، ومُخبِتٌ مُنكسِرٌ لله - جلَّ في عُلاه -.
لذا فكلما قوِيَت صِلةُ العبد بربِّه، وكان دائِمَ الطاعة لله هُدِيَ طريقَه، وأُلهِمَ رُشدَه، وقوِيَت عزيمتُه، وازدادَ قوةً إلى قوَّته، واشتدَّ صلابةً في الدين.
فهذا نبيُّ الله هُودٌ - عليه السلام - يقولُ لقومِه مُرشِدًا: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: 52].
قولُه: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ فإنَّهم كانُوا مِن أقوَى الناسِ، ولهذا قالُوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: 15]، فوعَدَهم إن آمنُوا زادَهم قوةً إلى قوَّتهم.
ويُستفادُ مِن الآية: أنَّ الاستِغفارَ مع الإقلاعِ عن الذنبِ سببٌ للخِصبِ والنَّماء، وكثرة الرِّزق، وزيادة العِزَّة والمنَعَة.
قال ابنُ كثيرٍ - رحمه الله -: "ومَن اتَّصَفَ بهذه الصِّفة - أي: الاستِغفار - يسَّر الله عليه رِزقَه، وسهَّل عليه أمرَه، وحفِظَ عليه شأنَه وقوَّتَه".
ولما سألَت فاطمةُ - رضي الله عنها - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خادمًا، وجَّهَها وزوجَها عليًّا بقولِه: «ألا أدُلُّكما على خيرٍ مما سألتُما؟ إذا أخذتُما مضاجِعَكما أو أويتُما إلى فِراشِكما، فسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمَدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرَا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما مِن خادمٍ»؛ رواه البخاري مِن حديثِ عليٍّ - رضي الله عنه -.
فأرشَدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابنتَه فاطمةَ - رضي الله عنها - إلى أنَّ ذِكرَ الله يُقوِّي الأبدانَ، ويحصُلُ لها بسبب هذا الذِّكر الذي علَّمَها قوَّةً، فتقدِرُ على الخِدمة أكثر مما يقدِرُ الخادِمُ.
قال ابنُ حجرٍ - رحمه الله -: "ويُستفادُ مِن قولِه: «ألا أدُلُّكما على خيرٍ مما سألتُما؟»: أنَّ الذي يُلازِمُ ذِكرَ الله يُعطَى قوَّةً أعظمَ مِن القوَّة التي يعملُها له الخادِمُ، أو تسهُلُ الأمورُ عليه؛ بحيث يكون تعاطِيه أمورَه أسهل مِن تعاطِي الخادِم لها".
معاشِر المُسلمين:
لقد فطِنَ أولياءُ الله وتيقَّنُوا أنَّ ذِكرَهم لله هو قُوتُهم، وأنَّ حاجةَ أرواحِهم للغِذاء أحوَجُ مِن حاجةِ أجسادِهم، بل إنَّ المادة التي تستمِدُّ مِنها أبدانُهم قُواها هي زادُ أرواحِهم؛ فقُلوبُهم مُعلَّقةٌ بالله، وألسِنتُهم تلهَجُ بذِكرِ الله دائِمًا.
جاء في "صحيح مسلم" مِن حديث جابرِ بن سمُرَة، "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلَّى الفجرَ جلَسَ في مُصلَّاه، حتى تطلُعَ الشمسُ حسَنًا".
قال أبو العباسِ القُرطبيُّ - رحمه الله -: "هذا الفِعلُ مِنه - صلى الله عليه وسلم - يدُلُّ على استِحبابِ موضِعِ صلاةِ الصُّبحِ للذِّكر والدُّعاء إلى طُلوع الشمسِ؛ لأنَّ ذلك الوقت وقتٌ لا يُصلَّى فيه، وهو بعد صلاةٍ مشهُودة، وأشغالُ اليوم بعدُ لم تأتِ، فيقعُ الذِّكرُ والدُّعاءُ على فراغِ قلبٍ، وحُضورِ فهمٍ، فيُرتجَى فيه قبُولُ الدُّعاء، وسماعُ الأذكار".
وعن الوليد بن مُسلم - رحمه الله - قال: "رأيتُ الأوزاعيَّ يثبُتُ في مُصلَّاه يذكُرُ اللهَ حتى تطلُعَ الشمسُ، ويُخبِرُنا عن السَّلَف أنَّ ذلك كان هَديَهم، فإذا طلَعَت الشمسُ قامَ بعضُهم إلى بعضٍ، فأفاضُوا في ذِكرِ الله والتفقُّه في دينِه".
وقال ابنُ القيِّم - رحمه الله - عن شيخِه ابن تيمية - رحمه الله -: "وحضَرتُه مرَّةً صلَّى الفجرَ، ثم جلَسَ يذكُرُ اللهَ تعالى إلى قريبٍ مِن انتِصافِ النَّهار، ثم التفَتَ إلَيَّ وقال: هذه غَدوَتِي، ولو لم أتغَدَّ الغداءَ سقَطَت قُوَّتِي".
تُرَى مَن اعتادَ هذا العملَ يبدأُ يومَه ذاكِرًا لله، مُنطَرِحًا بين يدَي مولاه، ذِلَّةً وخُضوعًا، ورغبةً ورجاءً .. كيف يكون سائِرَ يومه؟ وكيف يكون نشاطُه وحالُه؟ وقد عُلِمَ أنَّ الذِّكرَ يُقوِّي القلبَ والبدنَ.
وما بالُكم إذا كان الذِّكرُ مما يجمعُ فيه العبدُ بين الذِّكر القوليِّ والذِّكر البدنيِّ؛ كصلاةِ الليلِ تجمعُ الذِّكرَين، بل تجمعُ كثيرًا مِن الأذكار: القرآن الكريم، والأدعية، وتعظيم الله، كلُّ هذه الأمور - ولا شكَّ - تزيدُ العبدَ قوَّةً بدنيَّةً، وقوَّةً معنويَّةً.
وقد كان هَديُه - صلى الله عليه وسلم - الحِرصَ على قِيام الليل؛ فعن أم المُؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقومُ مِن الليل حتى تتفطَّرَ قدَماه، فقالت عائشةُ: لِمَ تصنَعُ هذا يا رسولَ الله، وقد غفرَ الله لك ما تقدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّر؟! قال: «أفلا أُحِبُّ أن أكون عبدًا شَكُورًا؟»؛ متفق عليه.
إنَّ هذه العبادة تُغذِّي الرُّوح، وتُقوِّي النَّفس، وتُربِّي الإرادة، فلا عجَبَ أن يصبِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ما كان يُواجِهُه مِن الشدائِد والصِّعابِ في سبيلِ الله، وما يلقَاهُ مِن الفتَن والأذَى، فيُدافِع كيدَ العدوِّ.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: 97، 98] أي: توكَّل على الله خالقِك، فإنَّه كافِيك وناصِرُك عليهم، فاشتغِل بذِكرِ الله، وتحميدِه، وتسبيحِه، وعبادتِه التي هي الصلاة؛ ولهذا قال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: 98].
فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حَزَبَه أمرٌ صلَّى، والصلاةُ مِن أكبَر العَون على الثباتِ في الأمر، كما قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: 45].
ومِن تسلِية الله لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -: أن ضرَبَ له العبدَ الصالِحَ والنبيَّ المُصطفى داود - عليه السلام - مثَلًا في قُوَّة العبادة، فقال - عزَّ مِن قائِل -: ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 17].
قال السعديُّ - رحمه الله -: "مِن الفوائِدِ والحِكَم في قصة داود: أنَّ الله تعالى يمدَحُ ويُحبُّ القُوَّةَ في طاعته: قُوَّة القلبِ والبدَن، فإنَّه يحصُلُ مِنها مِن آثار الطاعة وحُسنِها وكثرتِها ما لا يحصُلُ مع الوَهن وعدم القُوَّة، وإنَّ العبدَ ينبغي له تعاطِي أسبابِها، وعدم الرُّكُون إلى الكسَل والبَطالَة المُخِلَّة بالقُوَى، المُضعِفة للنَّفس".
ولم يقتصِر - صلى الله عليه وسلم - على بابٍ واحدٍ مِن أبوابِ تقوِية الصِّلة بربِّه، بل تنوَّعَت وسائِلُه في ذلك.
ففي "صحيح البخاري" عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوِصال في الصَّوم، فقال له رجُلٌ مِن المُسلمين: إنَّك تُواصِلُ يا رسولَ الله، قال: «وأيُّكُم مِثلِي؟ إنِّي أبِيتُ يُطعِمُني ربِّي ويَسقِينِ».
أي: يشغَلُني بالتفكُّر في عظمتِه، والتملِّي بمُشاهَدتِه، والتغذِّي بمعارِفِه، وقُرَّة العينِ بمحبَّته، والاستِغراقِ في مُناجاتِه، والإقبالِ عليه عن الطعامِ والشرابِ.
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "قد يكونُ هذا الغِذاء أعظمَ مِن غِذاء الأجساد، ومَن له أدنَى ذَوقٍ وتجرِبةٍ يعلَمُ استِغناءَ الجِسمِ بغِذاءِ القلبِ والرُّوح عن كثيرٍ مِن الغِذاءِ الجُسمانيِّ، ولاسيَّما الفَرِحُ المسرُورُ بمطلُوبِه الذي قرَّت عينُه بمحبُوبِه".
والذِّكرُ - عباد الله - عُمدةُ العبادات وأيسَرُها على المُؤمن، فلا غَرْوَ أن يُكثِرَ العبدُ مِنه؛ امتِثالًا لأمرِ الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41].
قال ابنُ عطيَّة - رحمه الله -: "وجعلَ تعالى ذلك دُون حدٍّ ولا تقديرٍ؛ لسهولتِه على العبدِ، ولعِظَم الأجرِ فيه".
أيها المُسلمون:
إنَّ للقلبِ غِذاءً يجبُ أن يتغذَّى به حتى يبقَى قويًّا، وغِذاءُ القلبِ هو الإيمانُ بالله تعالى، والعملُ الصالِحُ، وعلى قَدر ما يُحقِّقُ العبدُ مِن ذلك يكون في قلبِه مِن القوَّة والثباتِ على الحقِّ.
إنَّ الحياةَ الحقيقيَّة هي حياةُ القلبِ، وحياةُ القلبِ لا تتمُّ إلا بالعملِ بما يُرضِي اللهَ تعالى؛ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مثَلُ الذي يذكُرُ ربَّه والذي لا يذكُرُ ربَّه مثَلُ الحيِّ والميِّت»؛ رواه البخاري.
إنَّ القلبَ متى ما اتَّصلَ بالله وأنابَ إليه، حصَلَ له مِن الغذاءِ والنَّعيم ما لا يخطُرُ بالبال، ومتى غفَلَ العبدُ عن ربِّه، وأعرَضَ عن طاعتِه، فإنَّه سيموتُ قلبُه؛ ولذا فلا يجِدُ المرءُ راحةَ قلبِه، ولا صلاحَ بالِه، ولا انشِراحَ صَدرِه إلا في طاعةِ الله، فهذه العباداتُ والقُرُبات التي يقومُ بها العبدُ مِن شأنِها - بإذن الله - أن تُحقِّقَ الاطمِئنان، وتُورِثَ الصبرَ والثباتَ، وتُزيلَ الهُموم، وتُذهِبَ الاكتِئاب، وتمنَعَ الإحباطَ، وتُخلِّصَ مِن الضِّيقِ الذي يشعُرُ به العبدُ نتيجةَ مصائِبِ الدنيا.
أقولُ هذا القَول، وأستغفِرُ الله لي ولكم، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله مَن أقبلَ عليه تلقَّاه، ومَن اعتصَمَ به نجَّاه، ومَن لاذَ بحِماه وقاه، ومَن فوَّضَ أمرَه إليه هداه، أحمدُه - سبحانه -، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وفَّق مَن شاءَ مِن عبادِه لهُداه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه ومُصطفاه، أعظمُ النَّاسِ صِلةً بمولاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَن والاه.
أما بعد .. فيا عباد الله:
مِن أعظم ثِمار الإيمان: الصِّلةُ بالله، والافتِقارُ إليه، والإقبالُ عليه، والاستِئناسُ به، وتحقيقُ العبوديَّة له في السرَّاء والضرَّاء، وفي الشدَّة والرَّخاء.
وقُوَّةُ الصِّلة بالله تجعلُ المُؤمنَ طائِعًا لله، عامِلًا بأوامِرِه، مُستقيمًا على شرعِه، ومَن كان كذلك فجزاؤُه الحياةُ الطيبة التي وعدَها الله المُؤمنين، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
إنَّ التعلُّقَ بالله وحُسنَ الصِّلة به يُربِّي في صاحبِه العمل، ويجعلُه يُحاسِبُ نفسَه على الصَّغير والكبير، ويستشعِرُ مُراعاةَ الخالِقِ قبل مُحاسَبَة الخلق.
وصاحِبُ الصِّلة بالله مُقبِلٌ على فعلِ الخير، ساعٍ إليه، حرِيصٌ على ألا يفُوتَه شيءٌ مما ينفعُه، ويحزَنُ ويتحسَّرُ على ما فاتَه مِن زادٍ إيمانيٍّ عظيمٍ كان يُحصِّلُه وقتَ نشاطِه وقوَّتِه.
أيها الإخوة:
مَن حفِظَ جوارِحَه عن محارِمِ الله زادَه الله قوَّةً إلى قوَّته، ومتَّعَه بها، وهذا مطلَبُ كل مُؤمن؛ فمِن دُعائِه - صلى الله عليه وسلم -: «ومتِّعنا بأسماعِنا، وأبصارِنا، وقوَّتنا ما أحيَيتَنا، واجعَله الوارِثَ مِنَّا».
والتمتُّعُ بالسَّمع والبصَر إبقاؤُهما صحيحَين إلى الموت، فيكون معنى هذه الدُّعاء: اجعَلنا مُتمتِّعين ومُنتَفِعين بأسماعِنا وأبصارِنا وسائِر قُوانا مِن الحواسِّ الظاهِرة والباطِنة، وكلِّ أعضائِنا البدنيَّة بأن نستعمِلَها في طاعتِك مُدَّة حياتِنا وحتى نمُوت.
ومَن حفِظَ الله في صِباه وقوَّته، حفِظَه الله في حالِ كِبَرِه وضعفِ قوَّته، ومتَّعَه بمسعِه وبصرِه، وحواسِّه وأعضائِه، وحَولِه وقوَّتِه وعقلِه.
ألا وصلُّوا وسلِّمُوا - رحمكم الله - على النبيِّ المُصطفى، والرسولِ المُجتبَى، كما أمرَكم بذلك ربُّكم - جلَّ وعلا -، فقال تعالى قولًا كريمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى أزواجِه وذريَّته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارِك على مُحمدٍ وعلى أزواجِه وذريَّته، كما بارَكتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، وانصُر عبادَك المُوحِّدين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل هذا البلَدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، واجعَل ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقاك، واتَّبَع رِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّه وترضَاه مِن الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم، وخُذ بناصيتِه للبرِّ والتقوَى.
اللهم كُن لإخوانِنا المُستضعَفين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين على الثُّغور، وحُماة الحُدود، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا.
ربَّنا اجعَلنا لك شكَّارين، لك ذكَّارين، إليك مُخبِتِين مُنِيبِين أوَّاهِين.
اللهم احفَظنا بالإسلام قائِمين، واحفَظنا بالإسلام قاعِدين، واحفَظنا بالإسلام راقِدين، ولا تُشمِت بنا عدوًّا ولا حاسِدًا.
اللهم اكفِنا شرَّ الأشرار، وكيدَ الفُجَّار، وأذَى المُؤذِين، اللهم إنَّا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم.
اللهم اجعَلنا هُداةً مُهتَدين على صراطِك المُستقيم.
والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

كمالُ العبوديَّةِ لله تعالى
ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "كمالُ العبوديَّةِ لله تعالى"، والتي تحدَّث فيها عن عبوديَّة المُسلم لله؛ حيث أطالَ الشرحَ والبيانَ لآيتَي سُورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..﴾ الآية [الأنعام: 162، 163]، وبيَّن أنَّ هذا بمثابةِ الدُّستُور لجميعِ المُسلمين.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي كرَّمَ الإنسانَ وجعلَه في الأرضِ خليفة، أحمدُه - سبحانه - وأشكرُه على نعمةِ الإيمانِ والفضيلَة، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وعبوديَّتُه مقصِدُ الخليقَة، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه حذَّرَ مِن السِّباب والرَّذِيلَة، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه أهل القلوبِ السليمة.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله.
قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162، 163].
هذه الآيةُ الكريمةُ رسَمَت الهدفَ والوظيفةَ والغايةَ مِن الحياة، وهي: أنَّ مقصِد المُسلم وحياتَه ومماتَه لله ربِّ العالمين، لله مالِكِ يوم الدين الذي خلَقَنا ورزَقَنا ووهَبَنا الحياة.
تلاوةُ هذه الآية، والتذكيرُ بها، والتأمُّلُ فيها يُحيِي المفاهِيمَ العظيمة، ويُجدِّدُ المعانيَ النفيسَة التي يجِبُ ألا تغيبَ عن الأذهان، ولا تسقُطَ في دائرة الغفلَة والنِّسيان، وهي: أن تكون صلاةُ العبد ونُسُكُه وحياتُه ومماتُه لله، وأن يخضَعَ في كل شُؤونِه لمَن خلقَه ورزَقَه، وصرَّفَ أمرَه ودبَّرَه، وأن يتوجَّهَ العبدُ في جميعِ أمورِه إلى إرادةِ وجهِ الله، ولا يُريدُ شيئًا سِواه.
والذي يُريدُ مرضاةَ الله لا يتكلَّمُ إلا لربِّه، ولا يعملُ إلا لربِّه، ليلَه ونهارَه، صُبحَه ومساءَه، كلُّه لله وحدَه لا شريكَ له.
تُذكِّرُ الآيةُ بتحقيقِ أشرفِ مقامٍ - وهي العبوديَّة - في كل ما يأتِي المُسلمُ ويذَر، إيمانًا بالله، إخلاصًا له، حُبًّا لله، شوقًا له، خوفًا مِنه، رجاءً لفضلِه، أكلُ الحلال، تركُ الحرام، بِرُّ الوالدَين، صِلةُ الأرحام، إحسانٌ إلى الجِيران، حُسنُ خُلقٍ، غضُّ بصرٍ، حِجابٌ، ودعوةٌ إلى الله، وأمرٌ بالمعروف، ونهيٌ عن المُنكَر.
﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ أساسُ ما يتقرَّبُ به العبدُ لمولاه - جلَّ في عُلاه - أصولُ العبادات وأمهاتُها، وأجلُّها أداءُ الفرائضِ التي كتبَها الله وأوجبَها على عبادِه، ومَن رَامَ عظيمَ الثوابِ وجزيلَ الأجر عضَدَ أداء الفرائضِ بالنوافِلِ والسُّنَن، وبها ينالُ محبَّةَ الله فتسمُو روحُه، وتصفُو نفسُه.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القُدسيِّ: «وما يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إلَيَّ بالنوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإذا أحبَبتُه كنتُ سمعَه الذي يسمعُ بِهِ، وبصَرَه الذي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ التي يبطِشُ بِها، ورِجلَه التي يمشِي بِها، وإن سألَنِي لأُعطيِنَّهُ، ولئِن استَعاذَنِي لأُعِيذنَّهُ».
﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ النَّحرُ والذَّبحُ لله تعالى مِن أجلِّ العبادات وأشرَفها؛ ولذلك قرَنَه الله تعالى بالصلاةِ في قولِه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وهذه عبادةٌ لها غاياتٌ ومقاصِد، شُرِعَت في كل شريعةٍ لمحبَّة الله لها ولكثرة نفعِها.
الذَّبحُ لوجهِ الله مِن أصُول الإيمان، وهو قُربانٌ لا يجوزُ في الإسلام تقديمُه إلا لله ربِّ العالمين، وتأتي الذَّبيحةُ يوم القيامة بجُلودِها وشعرِها وأظلافِها وجميعِ ما فيها في ميزانِ العبد إذا كانت لله ولم تكُن لأيِّ شيءٍ سِواه، لا تُذبَحُ لوثَنٍ ولا لشجرٍ ولا لقبرٍ ولا لوليٍّ، بل تُذبَحُ لله - سبحانه وتعالى -؛ إخلاصًا له وتوحيدًا.
ومِن الشِّرك: تقديمُ القرابين، وذبحُ الذَّبائِح لغيرِ الله.
قال عليٌّ - رضي الله عنه -: حدَّثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعِ كلماتٍ: «لعَنَ الله مَن ذبَحَ لغير الله، لعَنَ الله مَن لعَنَ والدَيه، لعَنَ الله مَن آوَى مُحدِثًا، لعَنَ الله مَن غيَّرَ منارَ الأرض».
﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الحياةُ لله ربِّ العالمين هي الحياةُ على دينِه وشرعِه، وأمرِه ونهيِه، بلحظاتها وأشجانِها وأفراحِها، وليلِها ونهارِها، وبكلِّ ما فيها مِن قيامٍ وقعودٍ، وحركةٍ وسُكونٍ، ونومٍ واستِيقاظٍ، وبيعٍ وشِراءٍ، وطعامٍ وشرابٍ، وتعلُّمٍ وتعليمٍ، وعملٍ ووظيفةٍ، كلُّ ذلك وغيرُه لله ربِّ العالمين.
والخسارةُ كلُّ الخسارة أن يسهُو المُسلمُ عن هذه المعاني وينسَى ربَّه، فيغدُو تائهًا في سَيره، غافلًا عن هدفِه وغايتِه في الحياة، ويُشرِكَ مع معبُودِه الأوحَد، وربِّه الأكبَر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: 19].
للمُسلم معبُودٌ واحدٌ هو الله مالِكُ المُلك، الذي أرادَ مِن الإنسان أن يتحرَّرَ مِن كل معبُودٍ سِواه، وأن تكون حياتُه وتصرُّفاتُه، ومآلُه إليه - سبحانه - لا إلى سِواه، فيحيَا مِن أجلِ الله، وفي طاعةِ الله.
هذه الحياةُ إذا عِشناها لله وفقَ ما يُرضِيه، وأحبَبنا ما يُحبُّ، وأبغَضنا ما يُبغِض، وأحيَينا القلبَ بذِكرِ الله؛ فإنَّها تكون حياةً مُمتعةً سعيدة، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
وهذا حالُ المُسلم بشكلٍ دائمٍ، لا يكادُ يمُرُّ وقتٌ مِن الأوقات يكونُ فيه بعيدًا عن ربِّه وذِكره وعبادتِه، تكونُ الحياةُ لله ربِّ العالمين باستِثمار العُمر في البناء والتنمية، والعقل في إعمارِ الأرض والصناعة والزراعة، وإصلاح المُجتمع، وتحقيقِ الأمن والرَّخاء.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 126].
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالِك يوم الدين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له إلهُ الأولين والآخرين، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه وليُّ المُتَّقين، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه أجمعين.
أما بعد:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
هذا المُسلمُ الذي يجعلُ حياتَه لله كالغَيثِ أينما حلَّ نفَع، يُحيِي الأمل، ويُقوِّي الثقةَ بالله، يُشيعُ الرحمةَ في الحياة، ينشُرُ الخير، يُطعِمُ المِسكين، يقومُ على شُؤون الضُّعفاء والأيتام والمرضَى.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
ومَن كانت حياتُه لله لم ينتظِر مِن أحدٍ سِوَى الله جزاءً ولا شُكورًا، ماضٍ في عطائِه، لا يُوقِفُه مَن تنكَّبَ الطريقَ بجُحودٍ أو نُكران، ولِسانُ أحدِهم يقولُ: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: 9- 12].
ألا وصلُّوا - عباد الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصَّحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا أرحمَ الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر اللهم أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعملٍ، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعمل.
اللهم إنا نسألك مِن الخير كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا مِن كل شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك فواتِحَ الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخرَه، ونسألُك الدرجات العُلى مِن الجنَّة يا رب العالمين.
اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على مَن بغَى علينا.
اللهم اجعَلنا لك ذاكِرين، لك شاكِرين، لك مُخبِتين، لك أوَّاهِين مُنِيبِين، اللهم تقبَّل توبتَنا، واغسِل حَوبَتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، وسدِّد ألسِنَتَنا، واسلُل سَخِيمَةَ قُلوبِنا.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا.
اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أعلنَّا وما أسرَرنا، وما أنت أعلمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّمُ وأنتُ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن زوال نعمتِك، وتحوُّ عافيتِك، وفُجاءة نِقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن العجز والكسَل، والجُبن والبُخل، والهرَم وغلبَة الدَّين وقَهر الرِّجال.
اللهم إنا نسألُك حُسنَ الخِتام، والعفوَ عما سلَف وكان مِن الذنوبِ والعِصيان.
اللهم ابسُط علينا مِن بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورِزقِك.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار.
اللهم وفِّق إمامَنا لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك يا رب العالمين، ووفِّق ووليَّ عهدِه لكلِّ خيرٍ، وللبرِّ والتقوَى يا أراحم الراحمين، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين للعمل بكتابِك، وتحكيمِ شرعِك يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين
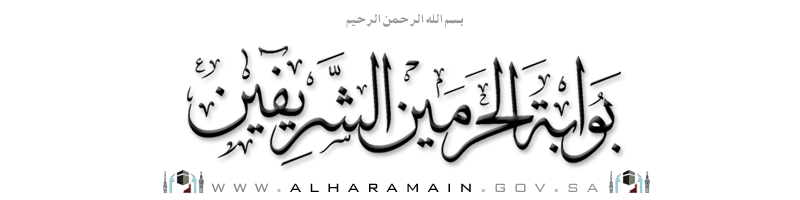
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "ادِّخارُ المال وحُسن تدبيره"، والتي تحدَّث فيها عن فوائِد الادِّخار وحُسن تدبيرِه، وأنَّه أمرٌ مشرُوعٌ جاء الإسلامُ بالحضِّ عليه، وأوردَ الأدلَّةَ على ذلك مِن آياتِ الله تعالى وأحاديث رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله المُحيِي الأموات، باعِث الرُّفات، ملأَ نورُه الأرضين والسماوات، يعلمُ ما مضَى والحاضِرَ وما هو آت، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له التحيَّات والصلوات والطيبات، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه دعا إلى الله بالهُدى والبيِّنات، وجمعَ الله برسالته الفُرقةَ والشَّتات، أُوتِي جوامِع الكلِم والعِظات، بلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، وعبَدَ ربَّه حتى مات، فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آل بيتِه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه للمُؤمنين أمهات، وعلى أصحابِه ذوي الديانة والمُروءات، وتابِعيهم ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ما تنفَّسَ إصباحٌ مِن بعد ظُلمات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد .. فيا أيها الناس:
اتَّقُوا ربَّكم حقَّ التقوَى، واستمسِكُوا مِن الإسلام بالعُروة الوُثقَى، واعلَمُوا أنَّ المرء بلا تقوَى كالجسَد بلا رُوح؛ فمَن رامَ الهدايةَ بلَّغَه الله مواطِن التقوَى، ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: 17].
عباد الله:
إنَّ بالناسِ ولَعًًا بالغًا بأرزاقِهم ومصادِرِ عيشِهم، ولَعًا يأخُذُ حيِّزًا كبيرًا من تفكيرِهم حين يُمسُون وحين يُصبِحُون، ولَعًا يُورِثُ المُسترسِلين معه ضَربًا مِن القلق والهلَع، والشُّحِّ والجشَع، يجعلُهم أمام الكسب والمعاشِ والرَّزق بين جادٍّ وهازِلٍ، ومُتوكِّلٍ ومُتواكِل، ونهِمٍ وقَنُوعٍ، ومُفرِطٍ ومُفرِّطٍ، وقاعِدٍ ومُكتَسِبٍ.
لا يستحضِرُون أنَّ النعمَ لا تدُوم، وأنَّ صُروفَ الحياة بين فتحٍ وإغلاقٍ، وسَعةٍ وضِيقٍ، وصفوٍ وكَدَرٍ، وحلوٍ ومُرٍّ، وأنَّ دوامَ الحال مِن المُحال، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: 54].
ناهِيكُم - بعد ذلكم كلِّه - عن غيابِ مفهوم الرِّزق والاستِرزاق، وأنَّ الله الرزَّاق ذا القوَّة المتين هو مَن أمَرَ بالسعي والاكتِساب، وبَذل الأسباب للتوازُن الاقتصاديِّ والمعيشيِّ، ومِنها سببُ الادِّخار والتوفير للمُستقبل.
نعم .. عباد الله! إنَّه الادِّخارُ بمفهومِه الجلِيِّ الذي هو الجُزءُ المُستبقَى مِن دَخل المرء بعد حسم إنفاقِه الاستهلاكيِّ الخاصِّ والعامِّ.
الادِّخارُ - عباد الله - مبدأٌ عظيمٌ، وسُلوكٌ اقتصاديٌّ بالِغُ الأهميةِ لاستِقرار الفرد والمُجتمع، معيشيًّا واقتصاديًّا؛ لأنَّ تغيُّرات الحياة لا مناصَ مِنها، فتلك هي سُنَّةُ الله، ولن تجِدَ لسُنَّة الله تبديلًا، لذا كان الحذرُ والحِيطة مِن الأسباب التي حضَّت عليها شريعتُنا الغرَّاء؛ لئلَّا يقعَ المرءُ في ضائِقةٍ تُلجِئُه إلى السُّؤال والاستِجداء المذمُومَين، أو ارتِكابِ كبائِر مُحرَّمةٍ، كالسَّرقة، والرِّبا، أو الالتِحاف بهمِّ الليل وذُلِّ النهار، الناتِجَين عن الدَّين الآسِر.
الادِّخارُ - عباد الله - يجمعُ عُنصرَين رئيسَين:
أحدهما: القناعةُ الفكريَّةُ به.
والآخر: السُّلوك الاستِهلاكيُّ للادِّخار.
والقناعةُ الفكريَّةُ - يا رعاكم الله - إنَّما تستقرُّ في الذِّهن مِن خلال فهم النُّصوص الشرعيَّة في أهمية الادِّخار، ومشروعيَّته، والحاجة إليه في الواقع الاقتصاديِّ، فإنَّ معيشة الإنسان مُرتهَنَةٌ بمدَى إحسانِه التوازُنَ الإنفاقيَّ له ولأهلِه.
وأما السُّلوكُ الاستِهلاكيُّ فإنَّه قُطبُ رحَى نجاحِ الادِّخار، متَى ما استحضَرَ المرءُ حُسنَ التفريقِ بين ضروريَّاته وحاجيَّاته وتحسيناتِه، مُخضِعًا ذلكم كلَّه لأحكام الدين الخمسة، ومدَى انطِباقِها على صُورة إنفاقِه وادِّخاره، والأحكامُ الخمسة هي: الواجِبُ، والمُحرَّم، والمُستحبُّ، والمكرُوه، والمُباح.
إن استَحضَرَ المرءُ ذلكم كلَّه، وأحسَنَ إنزالَه في واقعِ أمرِه، قامَت قِدرُ حياتِه الاقتصاديَّة على ثلاثِ أثافٍ، تكمُلُ في الاستِهلاك الشخصيّ، وحُسن التوزيع للغير، والادِّخار للمُستقبل، وقد جُمِعَت هذه كلُّها في قولِ الله - جلَّ شأنُه -: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].
ففي قولِه: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ مُتعلِّقٌ بجانبِ الاستِهلاك الشخصيِّ.
وفي قولِه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ مُتعلِّقٌ بجانبِ التوزيع للغير.
وفي قولِه: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ مُتعلِّقٌ بجانبِ الادِّخار للمُستقبل.
فما ظنُّكم - عباد الله - بمُجتمعٍ يعِي أفرادُه هذه المنظومةَ المُتكامِلة؟ أترَونَه يفتقِر؟! أترَونَه يضطرِب؟! أترَونَه يقعُ في كمَّاشة المسغَبة، أو شَرَك المترَبَة؟! كلا؛ فإنَّ مَن زرعَ الأسبابَ الشرعيَّة قطفَ ثمرةَ الاستقرار والتوازُن، ولم يكُ مُفرِّطًا قطُّ، ولا مُفرِطًا؛ لأنَّ الاستِهلاك بقَدر الحاجة، ودعمَ المُعوِزين، والادِّخار الاحتياطيَّ، ذلكم كلُّه هو مُثلَّث التوازُن الاقتصاديِّ للفرد والمُجتمع.
وقد جمعَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِه: «كُلُوا، وأطعِمُوا، وادِّخِرُوا»؛ رواه البخاري ومسلم.
إنَّ سُوء المُوازَنة وعدمَ إحكام التوزيع الماليِّ في الضرورات، والحاجيَّات، والتحسينات سببٌ مُباشرٌ بلا ريبٍ في تراكُم ديُون الفرد، الذي هو لبِنةٌ مِن لبِنات المُجتمع، لا يُطيقُ حملَها؛ لذا فإنَّ التنمية الماليَّة الصحيحة لا تعترِفُ بأيِّ نِتاجٍ اقتصاديٍّ في معزِلٍ عن حُسن توزيعه وحُسن ادِّخارِه، فكان المفهومُ الادِّخاريُّ أُسًّا لا بُدّض مِنه في تأمين الاحتِياط النقديِّ والمعيشيِّ؛ إذ به تكتمِلُ الحِيطة لما هو مُخبَّأٌ في قابِلِ المرء والمُجتمع على حدٍّ سواء.
وإنَّ مَن يستعمِلُ مفهومَ الادِّخار إنَّما يُعزِّزُ به احتِباسَ جُزءٍ مِن دخلِه، ليُخفِّفَ به مِن أعباءِ مُستقبلِه؛ خشيةَ نوازِل تطرُق بابَه، أو تحُلُّ قريبًا مِنه.
ولا شكَّ أنَّ في مِثل ذلكم حُسن تصرُّفٍ، وإتقانًا في إدارة الرِّزق، والتمكُّن مِن القِيام بما مِن شأنِه التميُّز في توجيهِ المُدَّخَرات الوِجهةَ التي تُوازِنُ له، فَرزَ ضروراته، وحاجيَّاته، وتحسيناته التي تُطِلُّ عليه بين أزمةٍ وأُخرى، ولن يستقيمَ أمرُ معاشِ امرئٍ ما لم يُوازِن بين إنفاقِه وتوزيعِه وادِّخارِه.
ومِن حكمةِ الله - جلَّ شأنُه - أن جعلَ مبدأَ التوزيع في الرِّزق جُزءًا مِن كُلٍّ؛ حيث قال: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [يس: 47] أي: بعضًا مما رزَقَكم الله، ولم يقُل: وأنفِقُوا ما رزَقَكم الله.
وفي هذا الأمر - عباد الله - يتجلَّى معنى الإنفاقِ والادِّخار، ومِن المعلُوم عقلًا وشرعًا وواقعًا أنَّ مَن أنفقَ بعضَ ما يكتسِب كان أبعدَ عن الافتِقار والمَترَبة.
فقد ذكرَ الفارُوقُ - رضي الله تعالى عنه -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يبيعُ نخلَ بنِي النَّضِير، ويحبِسُ لأهلِه قُوتَ سنَتِهم"؛ رواه البخاري ومسلم.
قال بعضُ السَّلف: "في الحديث: جوازُ ادِّخار قُوت سنةٍ، ولا يُقالُ هذا مِن طُول الأمل؛ لأنَّ الإعدادَ للحاجة مُستحسَنٌ شرعًا وعقلًا".
عباد الله:
إنَّ الادِّخار الذي شرَعَه الله لنا، وشرَعَه رسولُه - صلى الله عليه وسلم - علامةُ ضبطٍ وتوازُنٍ في الفرد والمُجتمع، وهو نَهجٌ شريفٌ بشرَف انتِسابِه إلى شريعة الإسلام، والإسلامُ دينُ يُسرٍ وسماحةٍ، وليس دينَ عُسرٍ وغضاضة.
هو شريعةُ الاقتِصاد العادِل الذي لا يُورِثُ ضررًا ولا ضِرارًا، ولا يذُمُّ الادِّخار أبدًا إلا حينما يتحوَّل إلى احتِكار، أو اكتِناز نتيجةَ جشَعٍ أو طمعٍ، وإضرارٍ بالآخرين، ومنعٍ لحقِّ الله وحقِّ العباد مِن مال الله الذي آتاهم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].
وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحتكِرُ إلا خاطِئٌ»؛ رواه مسلم.
إنَّه لم يأتِ البشرُ بشيءٍ يُنظِّمُ معاشَهم، ويضعُ لهم الحُلولَ مع الأزمات التي تحُلُّ بهم، إلا رأيتَ في شريعةِ الإسلام ما هو خيرٌ مِنها وأبقَى وأسلَمُ وأحكَمُ.
ولقد جمعَ الله في كتابِه العزيز هذه المُوازَنَة الفريدة في قصة يوسف - عليه السلام - مع رُؤيا البقرات السبع، التي عبَّرَها بقولِه: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [يوسف: 47- 49].
ففي قولِه: ﴿تَزْرَعُونَ﴾ رسمٌ لسياسةِ العمل والتكسُّب والجِدِّ بالأوجُه المشرُوعة، للدفع بموارِدِها المُكتسَبَة إلى السُّوق، لينتفِعَ بها كلٌّ بحسَبِه، دفعًا للبطالَة والكسَل والتواكُل؛ فإنَّ مَن جدَّ وجَد، ومَن زرَعَ حصَد.
وأما في الاستِهلاك ففي قولِ الله تعالى: ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ رسمٌ لسياسةِ الاستِهلاك الحاضِر الذي يلِي الإنتاج، وحاجة الاستِهلاك الآجِل الذي هو الادِّخار لمُستقبلٍ لا يُدرَى ما يعتَرِيه مِن قوارِع، ونوائِب، وغِيَر.
فما كلُّ ما يُنتِجُه المرءُ يستنزِفُه في حينِه، فتلك مُغامرةٌ وتهوُّرٌ يدُلَّان على قِصَرٍ في النَّظر، وبلادةٍ في الحِيطة والحذَر؛ لأنَّ الاحتِياطَ ضربٌ مِن العقلِ وبُعد النَّظَر لا غِنَى للفردِ ولا للمُجتمع عنه في اتِّقاء الأزمات، وفجأة الحوادِث التي تلِجُ دون أن تطرُقَ بابًا.
ألا إنَّ الادِّخارَ الذي شرَعَه الله للناسِ لكَفيلٌ - بعد عَونِ الله - بأن يكون مرفَأً لسفينةِ الرِّزق عن الغرق، أو التحطُّم أمام أمواجِ الديُون الهائِجة، المُلجِئة إلى استِنجاءِ الآخرين، ولاتَ حين مُنجِد!
|
لا تحسبَنَّ الرِّزقَ
يأتِي طَفرةً |
|
أو عُنوةً مِن دونِ
سعيٍ، كلَّا |
|
فاكسِبْ، وكُلْ،
وابذُلْ لغيرِكَ، وادَّخِرْ |
|
واحذَرْ تكُنْ بين
الخلائِقِ كلَّا |
أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين والمُسلمات من كل ذنبٍ وخَطيئةٍ، فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّ ربي كان غفورًا رحيمًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله على إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه، والصلاةُ والسلامُ على المُصطفى الداعِي إلى رِضوانِه.
وبعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، واعلَمُوا أنَّ الله ما شرَعَ لعبادِه أمرًا إلا كان خيرًا لهم في معاشِهم ومعادِهم.
وإنَّ في الادِّخار المشرُوع قَطعًا لداءِ الإسراف المُهلِك، وهو تهوُّرٌ محظُورٌ، وقطعًا لداء الجشَع المُزمِن، وهو اكتِنازٌ مذمُوم، وقطعًا لداء الاحتِكار المُزرِي، وهو إضرارٌ مرفُوض.
ثم إنَّ الادِّخار - عباد الله - لا يُنافِي التوكُّلَ والاعتِمادَ على الله؛ فإنَّ الذي أمرَ عبادَه بالتوكُّل عليه، هو الذي شرَعَ الادِّخار لهم، وإنَّ الذي قال لهم: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22]، هو الذي جعلَ لهم الأرضَ ذُلولًا، وأمرَهم أن يمشُوا في مناكبِها ويأكلُوا مِن رزقِه.
ومما لا ريبَ فيه أنَّ الفردَ والمُجتمعَ إذا استعمَلُوا الادِّخارَ على وجهِه الصحيح، وأصبحَ خُلُقًا عامًّا لهم، اجتمعَ لديهم فائِضٌ احتياطيٌّ استعانُوا به - بعد الله - على نوائِبِ الدَّهر، وأحسَنُوا تصريفَه فيما يعودُ عليهم جميعًا بالاستِغناء عن السُّؤال وتكفُّف الناسِ، وسدُّوا به ثغَرَات حياتهم الاقتصاديَّة المُتجدِّدة.
وقد قال الله - جلَّ شأنُه -: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9].
وهذه الآيةُ جاءَت فيمَن يُوصِي بوصيَّةٍ لا يُبقِي فيها الحظَّ الأوفرَ لأهلِه وولدِه.
وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقَّاصٍ لما عزَمَ أن يُوصِي بثُلُثَي مالِه: «إنَّك أن تذَرَ ورَثَتَك أغنياء خيرٌ مِن أن تذَرَهم عالَةً يتكفَّفُون الناسَ»؛ رواه البخاري ومسلم.
وقد قال كعبُ بن مالكٍ - رضي الله تعالى عنه - للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِن توبَتِي أن أنخَلِعَ مِن مالِي صدقةً إلى الله وإلى رسولِه"، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أمسِك عليك بعضَ مالِك، فهو خيرٌ لك»؛ رواه البخاري.
فتلكُم - عباد الله - هي نظرةُ الإسلام لمبدأ الادِّخار، وهي نظرةٌ ثريَّةٌ بالتوازُن والتكامُل، ملِيئةٌ بالسَّماحة والإرفاقِ والحِيطة، ولا عجَبَ في ذلكم؛ فتِلكُم هي صِبغةُ الله، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: 138]، وذلكُم هو حُكمُ الله، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50].
هذا وصلُّوا - رحِمَكم الله - على خيرِ البريَّة، وأزكَى البشريَّة: محمدِ بن عبد الله؛ فقد أمَرَكم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسِه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقُدسِه، وأيَّه بكم - أيها المُؤمنون -، فقال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ صاحِبِ الوَجهِ الأنوَر، والجَبِين الأزهَر، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ صحابةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وكرمِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الشركَ والمُشركين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِّك وعبادَكَ المُؤمنين.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين، ونفِّس كَربَ المكرُوبِين، واقضِ الدَّيْنَ عن المَدينِين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا، واجعَل ولايتَنا فيمن خافَك واتَّقَاك، واتَّبعَ رِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضاه مِن الأقوالِ والأعمالِ يا حيُّ يا قيوم، اللهم أصلِح له بِطانتَه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّقه وعضِيدَه وليَّ عهدِه لما تُحبُّه وترضاه، ولما فيه صلاحُ البلاد والعباد، إنَّك سميعٌ مُجيبُ الدعوات.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ العظيمَ الجليلَ يذكُركُم، واشكُرُوه على آلائِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

تزكيةُ
النفوس
ألقى فضيلة الشيخ عبد
الله بن عبد الرحمن البعيجان - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "تزكيةُ
النفوس"، والتي تحدَّث فيها عن النفسِ وصِفاتِها في القُرآن الكريم، ووجوبِ
تزكِيتِها وتطهيرِها، ومُعاهَدتها ومُحاسبَتها؛ فإنَّ ذلك هو الفلاحُ والفوزُ يوم
القِيامة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي خلقَ النفوسَ وسوَّاها، وألهَمَها فُجورَها وتقوَاها، وكتبَ الفلاحَ لمَن زكَّاها، والخيبةَ على مَن دسَّاها وأتبَعَها هواها، نعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا وسيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له حقًّا ويقينًا، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ خيرَ الحديثِ كلامُ الله، وخيرَ الهَديِ هَديُ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ بِدعة، وكلَّ بِدعةٍ ضلالة.
عباد الله:
أُوصِيكُم بتقوَى الله ومُحاسبَة أنفسِكم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18].
معاشِر المُسلمين:
إنَّ الله تعالى خلقَ الإنسانَ، وعلَّمَه البيان، ومنَحَه العقلَ واللِّسانَ، وهداه النَّجدَين، وبيَّن له السبيلَين: ﴿{إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: 3]، امتَحَنه بعداوة النفسِ والشيطان، وكتبَ له التوفيقَ أو الخُذلان، وجعلَ مصيرَه إما إلى الجنةِ وإما إلى النيران.
شرعَ مِن أجلِه الشرائِع، وأنزلَ الكُتُب، وبعثَ الرُّسُلَ مُبشِّرين ومُنذِرين، فمِن الناس مَن استجابَ وتزكَّى، ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: 18]، ومِنهم مَن أعرضَ وأبَى ونكَثَ، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الفتح: 10].
معاشِر المُسلمين:
اعلَمُوا أنَّ النفسَ عدُوَّةٌ وأمَّارةٌ بالسوء، قاطِعةٌ بين القلوبِ وبين الوُصولِ إلى الربِّ علَّام الغيُوب. النفسُ بطبيعتها طَمُوحةٌ إلى الشهوات والملذَّات، كسُولةٌ عن الطاعات وفِعلِ الخيرات، النفسُ مركَبُ الشيطان ومطِيَّتُه، ووسيلتُه وآلتُه، بها تكونُ طاعتُه، وهي حُجَّتُه وذريعتُه: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: 22].
النفسُ أمَّارةٌ بالسوء، ميَّالةٌ إلى الهوى، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41]، وقال: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: 23].
النفسُ وِعاءُ الخير والشر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، وقال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: 53].
عباد الله:
إنَّ الله قد ألهَمَ النفوسَ الخيرَ والشرَّ، كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: 7، 8]، فكما وهَبَ اللهُ الإنسانَ الحواسَّ الظاهرةَ، فقد وهَبَه النفسَ التي لها بصيرةٌ باطِنةٌ، كما قال تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: 14، 15].
وقد أشارَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الإحساسِ، فقال: «الإثمُ ما حاكَ في نفسِك، وكرِهتَ أن يطَّلِع عليه الناسُ».
عباد الله:
إنَّ النفسَ بحاجةٍ إلى الرِّعاية والمُراقبة، والتهذيبِ والتزكية والمُتابعَة؛ ولهذا قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحُصَين بن المُنذِر: «قُل: اللهم ألهِمني رُشدِي، وقِنِي شرَّ نفسِي». وفي خُطبةِ الحاجة: «ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفُسِنا».
معاشِر المُسلمين:
إنَّ سبيلَ التخلُّص مِن شُرور النفسِ هو تزكيتُها ورِعايتُها ومُعاهَدتُها، وقد أقسَمَ الله في كتابِه أحدَ عشرَ قسَمًا مُتتالِيةً على فلاحِ مَن زكَّاها، وخيبَةِ مَن دسَّاها، فقال - سبحانه -: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 1- 10].
وامتنَّ الله على المُؤمنين بأعظم النِّعَم فقال: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: 2].
وأخبَرَ الله تعالى أنَّ تزكِية النفسِ وسِيلةٌ للفلاح والفوز بالجنَّة، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14، 15]، وقال: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41].
عباد الله:
إنَّ تزكِية النفوسِ لا تتأتَّى إلا بمقامِ الإحسانِ: أن تعبُدَ اللهَ كأنَّك تراه، فإن لم تكُن تراهُ فإنَّهُ يراك. لا تتأتَّى إلا بمُخالفة الهوَى، ومُلازَمَة التقوَى. لا تتأتَّى إلا بمُخالفة النفسِ الأمَّارة بالسُّوء، وترِ ملذَّاتها وشهَوَاتها.
|
فمَن يُطعِمُ
النَّفسَ ما تشتَهِي |
|
كمَن يُطعِمُ
النَّارَ جَزْلَ الحَطَبْ |
فمَن وُفِّقَ لقَمعِها نالَ المُنَى، ونفسَه بنَى، ومَن أرخَى لها العِنانَ ألقَت به إلى سُبُل الهلاك والرَّدَى.
|
فمَن هجَرَ
اللذَّاتِ نالَ المُنَى ومَنْ |
|
أكَبَّ على
اللذَّاتِ عضَّ على اليَدِ |
|
ففِي قَمعِ
أهواءِ النُّفوسِ اعتِزازُها |
|
وفِي نَيلِها ما
تشتَهِي ذُلُّ سرمَدِ |
|
فلا تشتَغِلْ إلا
بما يُكسِبُ العُلَا |
|
ولا ترضَ
للنَّفسِ النَّفيسَةِ بالرَّدِي |
معاشِر المُسلمين:
الجِهادُ ذروةُ سَنامِ الإسلام، وفريضةٌ مِن أعظم فرائِضِه، وأعظمُ الجِهاد مُجاهَدةُ النَّفس. فألجِمُوها عن ملذَّاتِها، وافطِمُوها عن شَهَوَاتها، ففي قَمعِها عن رغبَتِها عِزُّها، وفي تمكينِها مما تشتَهِي ذُلُّها وهوانُها.
|
والنَّفسُ
كالطِّفلِ إن تُهمِلْهُ شبَّ على |
|
حُبِّ الرَّضاعِ
وإن تفطِمْهُ ينفَطِمِ |
|
فجاهِدِ النَّفسَ
والشيطانَ واعصِهِما |
|
وإن هُما
محَّضَاكَ النُّصحَ فاتَّهِمِ |
فعداوةُ النفسِ - عباد الله - مِثلُ عداوة الشيطان، وإنَّ الله قد حذَّرَكم طاعتَهما في القُرآن: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40، 41].
بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآيات والذِّكر الحكيم، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي خلقَ الإنسانَ وسوَّاه، وكرَّمَه وفضَّلَه واستخلَفَه واستأمَنَه واستَرعاه، ورفعَه ورزَقَه وخوَّلَه وأعطاه، والصلاةُ والسلامُ على مَن اصطفاه واختارَه وارتَضاه نبيِّنا مُحمدِ بن عبد الله، وعلى آلِهِ وصحبِه ومَن سارَ على دربِه واتَّبَع هُداه.
معاشِر المُسلمين:
النفسُ أمَّارةٌ بالسوء، وهي ظَلُومةٌ وجَهُولةٌ، تُصابُ بالعُجب والكِبرياء، والحسَد والرِّياء، والغضَبِ والحِرصِ والطَّمَع، والشُّحِّ والبُخلِ والخوفِ والجشَع، وغيرِ ذلك مِن الأمراضِ، فتزكِيتُها إفراغُها وتطهيرُها مِن تلك الأعراض، تزكِيةُ النفسِ بالتحلِّي بمكارِمِ الأخلاق، والسُّلوك الحسَن، والآداب الشرعيَّة؛ كالمحبَّة والإخلاص، والصبر والصدقِ والتواضُع، والخوف والرَّجاء، والكرَم والسَّخاء، والتوبة والاستِغفار، وتذكُّر الموت والفناء، والإعراضِ عن الدُّنيا، والإقبال على الله تعالى.
تزكِيةُ النفسِ بمُخالفَة الهوَى، وعدم تلبِية رغباتها، وفِطامِها عن شهواتها وملذَّاتها، والإنكار عليها ومُعاتبتها، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14، 15].
عباد الله:
اجتهِدُوا في تزكِية النفوس قبل فُجاءَة الفَجعَة، ونَدامَة الحسرَة، ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: 30].
اجتهِدُوا في تزكِية النفوس قبل ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: 56- 58].
اجتهِدُوا في تزكِية النفوس قبل أن يُختَمَ على الفمِ فلا ينطِق، وتقومُ الأشهادُ والخُصماءُ مِن الجوارِح، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: 65]، وقال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [فصلت: 19- 24].
اجتهِدُوا في تزكِية النفوس قبل يومٍ فيه ﴿يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 34- 37].
عباد الله:
الكيِّسُ مَن دانَ نفسَه وحاسبَها، وعمِلَ لما بعد المَوتِ، والعاجِزُ مَن أتبَعَ نفسَه هواها وتمنَّى على الله الأمانِيَّ.
فحاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبُوا، وزِنُوها قبل أن تُوزَنُوا؛ فإنَّه أهوَنُ في الحسابِ غدًا أن تُحاسِبُوا أنفسَكم اليوم، وتزيَّنُوا للعرضِ الأكبَرِ على الله ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: 18].
دخلَ عُمرُ بن الخطَّاب - رضي الله تعالى عنه - يومًا حائطًا، فخلَى بنفسِه يُحاسِبُها، وأنسُ بن مالكٍ - رضي الله عنه - يُراقِبُه مِن حيث لا يرَاه، فسمِعَه يقولُ: "عُمرُ! أميرُ المُؤمنين! بَخٍ بخٍ! والله بُنيّ الخطَّاب لتتقِيَنَّ اللهَ أو ليُعذِّبنَّك الله".
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، واعلَمُوا أنَّكم مُلاقُوه. اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم آمنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورِنا، اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين بتوفيقِك، وأيِّده بتأييدِك، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِهما للبِرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقهما لما فيه خيرٌ للإسلام والمُسلمين، ولما فيه صلاحُ البلاد والعباد يا ربَّ العالمين.
اللهم احفَظ حُدودَنا، وانصُر جُنودَنا يا قويُّ يا عزيز.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنَّك أنت التوَّابُ الرحيم.
عباد الله:
صلُّوا وسلِّمُوا على مَن أمَرَكم الله بالصلاةِ والسلامِ عليه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم برحمتِك يا أرحم الراحمين.
خطب الحرمين الشريفين

صِفاتُ
المُتَّقين
ألقى فضيلة الشيخ أسامة
بن عبد الله خياط - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "صِفاتُ المُتَّقين"،
والتي تحدَّث فيها عن الصِّفاتِ التي ينبغي أن يتحلَّى بها عِبادُ الله
المُتَّقُون، والتي جاءَ وصفُهم بها في مطلَع سُورة البقرة، مُبيِّنًا بعضَ
الفوائِد والأسرار في هذه الآيات الكريمة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله وليِّ المُتَّقين، أحمدُه - سبحانه - حمدًا كثيرًا طيبًا إلى يوم الدين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظيرَ ولا شبيهَ له في العالمين، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه سيِّدُ الأولين والآخرين، وقُدوةُ خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ الطيبين الطاهرين، وصحابتِه الغُرِّ الميامين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ مُخبِتِين أوَّاهِين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281].
عباد الله:
بين لهو الحياة ولغوِها، وفي هَجيرِ مطامِحِها ومطامِعِها، ولظَى الصِّراع على حِيازة متاعِها، والتمتُّع بزهرتِها، والاغتِرار بزُخرفها، تقومُ للدعاوَى العريضة سُوقٌ نافِقة، وترتفعُ للمازعِم المُبهرَجة راياتٌ خادِعةٌ كاذِبةٌ خاطِئةٌ، إنَّها - يا عباد الله - ضُروبٌ وألوانٌ مِن الدعاوَى والمزاعِم لا تقومُ على حُجَّة، ولا تستقيمُ على محجَّة، ولا ترجِعُ إلى دليل، ولا تستنِدُ إلى بُرهان.
ولئن تنوَّعَت صُورُها وكثُرَت، وتعدَّدَت صُنوفُها، فإنَّ مِن أشدِّها ررًا، وأوخَمها مرتَعًا، وأضلِّها سبيلًا، وأقبَحِها مآلًا تلك الدعاوَى القائِمة على ما نهَى الربُّ - تبارك وتعالى - عنه في مُحكَم التنزيل بقولِه - سبحانه -: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32].
أي: على هذه التزكِية للنَّفس، والنظر إليها بعين التعظيم والإعجاب، والإكثار مِن الثناء عليها، وغضِّ الطرف عن عيوبِها ومثالِبِها، والرفض القاطع لأي إقرارٍ فيها بالنقص أو الخلَل أو التقصير.
وإنَّ مِن أسوأ ذلك - يا عباد الله -: ما يكون مِن دعاوَى الهداية والفلاح، وسلامة المنهَج، وصوابِ المسلَك، وصحَّة الطريق، ذلك المُتمثِّل فيما يزعمُه بعضُ مَن كثُرَت دعاواه ومزاعِمُه، وقلَّت عليها براهينُه وحُجَجُه، بل انعدَمَت أو كادَت في أنَّه على هُدًى مِن ربِّه، وأنَّه مِن المُفلِحين الذين أدرَكُوا ما فيه رغِبُوا، وسلِمُوا مما مِنه رهِبُوا.
ولما كان هذا الفريقُ مِن عبادِ الله موجودًا في كل زمانٍ بدعاواه ومزاعِمِه، فقد تكلَّم ربُّنا - سبحانه - في مُحكَم كتابِه عن هذا بكلامِه المُرشِد الهادِي، والمُبيِّن الناصِح، والمُحذِّر الناهِي الذي يُسفِرُ عن وجهِ الحقِّ في هذا الأمر، ويدُلُّ على الصوابِ فيه، فينقَعُ الغُلَّة، ويشفِي العِلَّة، ويقطَعُ المعاذِيرَ المُلتوية، ويُبطِلُ المزاعِمَ الكاذِبة، ويهدِي إلى سواء السبيل.
فدلَّ - سبحانه - بما ذكَرَ في هذا المقام على أنَّ الذين يصِحُّ وصفُهم بأنَّهم على هُدًى مِن ربهم، أي: على نورٍ مِن ربِّهم وبُرهانٍ واستِقامةٍ، وسدادٍ بتسديدِ الله إياهم وتوفيقهم له، وأنَّ الذين يصِحُّ وصفُهم كذلك بأنَّهم المُفلِحُون، أي: الذين أدرَكُوا ما طلبُوا، وسلِمُوا مما مِنه هربُوا إنَّما هم على الحقيقةِ المُتَّقُون، الذين اتَّقَوا اللهَ - تبارك وتعالى - في ركوبِ ما نهاهم عن ركوبِه، واتَّقَوه فيما أمَرَهم به مِن فرائِضِه، فأطاعُوه بأدائِها.
وهو بيانٌ لواقِعِهم ذكَرَه الإمامُ ابن جريرٍ الطبريُّ - رحمه الله -، وأنَّ هؤلاء المُتَّقين قد خصَّهم ربُّهم - عزَّ وجل - بصِفاتٍ تُوضِّحُ حالَهم، وتُرشِدُ إلى جميلِ خِصالِهم، وتستنهِضُ الهِمَم إلى اللِّحاق بهم بانتِهاجِ نَهجِهم، وسُلوكِ سبيلِهم، فذكَرَ - سبحانه - صفاتِ القوم في صدرِ سُورة البقرة، فقال - عزَّ مِن قائل -: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ: ﴿الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 1- 4].
وإنَّها - يا عباد الله - لصِفاتٌ مُضِيئة، وعلاماتٌ جلِيَّة، وأحوالٌ رضِيَّة، يبلُغُ بها أصحابُها أشرفَ المنازِلِ في حياتهم الدنيا وفي الآخرة، وتصِلُ بهم إلى الغايةِ مِن رِضوانِ الله ومحبَّته، ونزولِ الجنَّة دارِ كرامتِه.
وأُولَى هذه الصِّفات: التصديقُ بالغيبِ قولًا واعتِقادًا وعملًا، فآمَنُوا بالله، وملائكته، وكتبِه، ورُسُله، واليوم الآخر وما فيه مِن بعثٍ وحشرٍ، وحسابٍ وثوابٍ وعقابٍ، وصراطٍ، وكُرسيٍّ، وعرشٍ، وجنَّةٍ، ونارٍ. وآمَنُوا بالحياةِ بعد الموت، وبكل ما غابَ عن الحِسِّ مما أخبَرَ به الله في كتابِه، وبيَّنَه رسولُه - عليه الصلاة والسلام - فيما ثبَتَ به النقلُ عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وثانِي صِفاتِهم: أنَّهم يُقيمُون الصلاةَ بأدائِها بحُدودِها وفرائِضِها الظاهرة مِنها، مِن تمامِ ركوعٍ وسجودٍ وقيامٍ للقادِرِ عليه، وتلاوةٍ وتسبيحٍ وتحميدٍ وصلاةٍ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وغيرِ ذلك مِن أركانٍ وواجِباتٍ وسُننٍ وآداب. والباطِنة، مِن خُشوعٍ فيها وإخبات، وحُضورِ قلبٍ، وتفهُّم معانِي ما يُتلَى فيها مِن آياتِ الله - عزَّ وجل -، وامتِثالٍ صادقٍ يظهرُ فيما يأتي المرءُ وما يذَر مِن أقوالٍ وأعمالٍ؛ لأنَّ الصلاةَ كما أخبَرَ ربُّنا - عزَّ اسمُه - ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].
ولذا فإنَّ مَن لم تنهَه صلاتُه عن الإثمِ فهو مِمَّن أخلَّ بها، ولم يُقِمها كما أمَرَ الله، ولذا قِيل: إنَّ المُصلِّين كثِيرُون، لكنَّ المُقيمِين لها قلِيلُون.
وثالِثُ صِفاتِهم: أنَّهم كما قالَ الإمامُ ابنُ جرير الطبريُّ - رحمه الله -: "أنَّهم لجميعِ اللازمِ لهم في أموالِهم مُؤدِّين، زكاةً كان ذلك، أو نفقَة مَن لزِمَتْه نفقَتُه مِن أهلٍ وعيالٍ وغيرِهم مِمَّن تجِبُ عليه نفقَتُه بالقرابَة والمِلكِ وغيرِ ذلك، بجميعِ معانِي النَّفقَات المحمُود عليها صاحِبُها مِن طيِّب ما رزَقَهم ربُّهم مِن أموالِهم وأملاكِهم، وذلك الحلالُ مِنه الذي لم يشُبْه حرامٌ". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
ومِن صِفاتِهم أيضًا: التصديقُ الجازِمُ الذي لا يتطرَّقُ إليه شكٌّ بما جاءَ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ربِّه - عزَّ وجل -، وبما جاء به المُرسِلُون مِن قبلِه، لا يُفرِّقُون بين أحدٍ مِنهم، ولا يجحَدُون ما جاؤُوهم به مِن عند ربِّهم.
ومِن صِفاتِهم: أنَّهم مُوقِنُون بما كان المُشرِكُون به جاحِدِين، مِن البعثِ والنُّشُور، والثوابِ والعِقابِ والحِسابِ، والميزانِ والصِّراط، والجنَّة والنَّار، وغيرِ ذلك مما أعدَّ الله لخلقِه يوم القِيامة، وهو الإيمانُ باليوم الآخر الذي يُورِثُ المُؤمنَ كمالَ مُراقبةٍ لله تعالى، وعظيمَ خشيةٍ تبعَثُ على امتِثال الأوامِرِ واجتِنابِ النَّواهِي، طاعةً له - سبحانه -؛ رجاءَ الظَّفَر بجميلِ موعُودِه لعبادِه الصالِحين، وخشيةً مِن أليمِ عذابِه للعاصِين المُكذِّبين بآياتِ الله - عزَّ وجل - ورُسُله.
فهؤلاء المُتَّقُون أصحابُ هذه الصِّفات الجليلة، والخِصال الجميلة هم المُستحِقُّون بأن يُوصَفُوا بأنَّهم على هُدًى مِن ربِّهم، أي: على نورٍ مِنه وبُرهانٍ واستِقامةٍ وسدادٍ بتسديدِ الله إياهم، وتوفيقِه لهم. والمُستحِقُّون أيضًا بأن يُوصَفُوا بأنَّهم المُفلِحُون، وهم المُدرِكُون ما طلَبُوا عند الله - تعالى ذِكرُه -، بأعمالِهم وإيمانِهم بالله وكُتُبِه ورُسُله مِن الفوز بالثوابِ، ومِن الخُلُود في الجِنان، والنَّجاة مما أعدَّ الله - تبارك وتعالى - لأعدائِه مِن العِقاب.
وفي هذه الآيات الكريمة - كما قال حَبرُ الأمة، وترجُمان القُرآن عبدُ الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "فيها تعرِيضٌ مِن الله - عزَّ وجل - بذمِّ الذين زعَمُوا أنَّهم بما جاءَت به رُسُلُ الله - عزَّ وجل - الذين كانُوا قبل مُحمدٍ - صلواتُ الله وسلامُه عليهم وعليه - مُصدِّقُون، وهم بمُحمدٍ - صلواتُ الله وسلامُه عليه - مُكذِّبُون، ولما جاء به مع التنزيلِ جاحِدُون، ويدَّعُون مع جُحودِهم ذلك أنَّهم مُهتَدُون". اهـ ما قالَه حَبرُ الأمة عبدُ الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما -، مما نقَلَه عنه الإمامُ ابنُ جريرٍ - رحمه الله -.
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، وحذارِ مِن الاغتِرار بدعاوَى مُدَّعِي الهداية والفلاح بغير بُرهانٍ أتاهم، وبغير حُجَّةٍ يعتَدُّون بها، أو نقلٍ صحيحٍ، أو عقلٍ سليمٍ، أو واقعٍ لهم رشيدٍ سديدٍ.
نفَعَني الله وإياكم بهَدي كتابه، وبسنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أقولُ قَولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولجميعِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، إنَّه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الهادِي لمَن استَهداه، الكافِي لمَن تولَّاه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ولا ربَّ غيرُه ولا معبُود سِواه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه، وخِيرتُه مِن خلقِه، وحبيبُه ومُصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه ومَن اقتَفَى أثَرَه واتَّبَعَ هُداه.
أما بعد .. فيا عباد الله:
إنَّ في قولِ ربِّنا - عزَّ اسمُه - في وصفِ هؤلاء المُتَّقين: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3] فوائِد وأسرارًا بيَّنها أهلُ العلم بالتفسير بيانًا حسنًا وافيًا، ومِمَّن بيَّن ذلك فأحسَنَ العلامةُ عبدُ الرحمن السعديُّ - رحمه الله -؛ حيث قال:
"إنَّ الربَّ - تبارك وتعالى - الدالَّة على التبعيض؛ ليُنبِّههم أنَّه لم يُرِد مِنهم إلا جُزءًا يسيرًا مِن أموالِهم غيرَ ضارٍّ لهم، ولا مُثقِلٍ عليهم، بل ينتَفِعُون هم بإنفاقِه، وينتفِعُ به إخوانُهم.
وفي هذه الآية الكريمة إشارةٌ إلى أنَّ هذه الأموال التي بين أيدِيكم ليست حاصِلةً بقوَّتكم ومِلكِكم، وإنَّما هي رِزقُ الله الذي خوَّلَكم، وأنعَمَ به عليكم، فكما أنعَمَ عليكم وفضَّلَكم على كثيرٍ مِن عبادِه، فاشكُرُوه بإخراجِ بعضِ ما أنعَمَ به عليكُم، وواسُوا إخوانَكم المُعدِمِين.
وأنَّ الله تعالى كثيرًا ما يجمعُ بين إقامةِ الصلاةِ وإيتاءِ الزَّكاة؛ لأنَّ الصلاةَ مُتضمِّنةٌ للإخلاصِ للمعبُود، والزكاةُ والنَّفقةُ مُتضمِّنةٌ للإحسانِ إلى عَبيدِه، فعُنوانُ سعادة العبدِ إخلاصُه للمعبُود، وسعيُه في نفعِ الخلق، كما أنَّ عُنوانَ شقاوَة العبد عدمُ هذَين الأمرَين مِنه، فلا إخلاصَ، ولا إحسانَ". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، وخُذُوا أنفسَكم بالتخلُّق بصِفاتِ المُتَّقين الذين هم المُهتَدون حقًّا بهدايةِ الله، المُدرِكُون ما طلَبُوا مِن الله، فازُوا برِضَى الله، ونجَوا مِن عذابِ الله.
وصلُّوا وسلِّمُوا على خيرِ خلقِ الله: مُحمدِ بن عبدِ الله؛ قد أُمِرتُم بذلك في كتابِ الله؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا خَيرَ مَن تجاوَزَ وعفَا.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، واحمِ حَوزةَ الدين، ودمِّر أعداءَ الدين، وسائِرَ الطُّغاة والمُفسِدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصلِح قادَتَهم، واجمَع كلمَتَهم على الحقِّ يا ربَّ العالمين.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسنَّةَ نبيِّك محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك المؤمنين المجاهدين الصادقين.
اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ، ووفِّقه لما تُحبُّ وترضَى يا سميعَ الدُّعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خَيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى ما فيه صلاحُ العِباد والبِلاد يا مَن إليه المرجِعُ يوم المعاد.
اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها.
اللهم أصلِح لنا دينَنَا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خيرٍ، والموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ.
اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أردتَّ بقومٍ فتنةً فاقبِضنا إليك غيرَ مفتُونين.
اللهم إنا نعوذُ بك من زوالِ نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم أحسِن عاقبَتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا ربَّ العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا ربَّ العالمين، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم.
اللهم اكتُب النصرَ والتأييدَ والحفظَ والرِّعايةَ لأبنائِنا وجنودِنا المُرابِطين على جبَهات القِتال، اللهم انصُر بهم دينَك، وأعلِ بهم كلمتَك، اللهم انصُر بهم دينَك، وأعلِ بهم كلمتَك، اللهم ارحَم موتاهم، واكتُب أجرَ الشهادة لقتلاهم، واشفِ جرحاهم، اللهم اشفِ جرحاهم يا ربَّ العالمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
اللهم اشفِ مرضانا، وارحَم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، واختِم بالباقِيات الصالِحات أعمالَنا.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
وصلَّى الله وسلَّم على عبدِه ورسولِه نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

من علامات توفيق الله لعبده
ألقى فضيلة الخطيب: الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "من علامات توفيق الله لعبده"، والتي تحدَّث فيها عن الحثِّ على اغتِنام الأوقاتِ والأعمارِ في طاعةِ الله تعالى، مُبيِّنًا أنَّ ذلك مِن أبرزِ علاماتِ توفيقِ الله - جلَّ وعلا - لعبدِه، كما ذكَرَ أنَّ مِن أسبابِ تذوُّق حلاوةِ الإيمانِ: حُسنُ الخُلُق.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله جعلَ لكلِّ شيءٍ قَدرًا، وأحاطَ بكلِّ شيءٍ خُبرً، وأسبَلَ على الخلائِقِ مِن فضلِه سِترًا، أحمدُه - سبحانه - على جَزيلِ نَعمائِه شُكرًا، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً أدَّخِرُها ليومِ العرضِ ذُخرًا، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أرسلَه للعالمين كافَّةً عُذرًا ونُذرًا، فقامَ بالدعوةِ إلى الله سِرًّا وجَهرًا، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى أصحابِه رضِيَ الله عنهم وأرضاهم، وأعظمَ لهم أجرًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا يَتْرَى.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى الله، فاتَّقُوا الله - رحِمَكم الله -؛ فتقوَى الله هي الوصيةُ الجامِعة، والموعِظةُ النافِعة، فاتَّقُوه، واعلَمُوا أنَّكم مُلاقُوه، واحذَرُوه واذكُرُوه، واشكُرُوا له واستغفِرُوه، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2، 3].
أيها المُسلمون:
اغتنِمُوا حياتَكم، واحفَظُوا أوقاتَكم؛ فالأيام محدُودة، والأنفاسُ معدُودة، وكلُّ دقَّةِ قلبٍ ينقُصُ بها العُمر، وكلُّ نفَسٍ يُدنِي مِن الأجَل، واعلَمُوا أنَّ هذا العُمر القصيرَ هو السبيلُ إلى حياةِ الخُلُود، فإما نعيمٌ مُقيم، وإما عذابٌ أليمٌ، عِياذًا بوجهِ الله الكريم.
وإذا وازَنَ العاقِلُ هذه الحياةَ القصيرةَ بالخُلُود المُنتظَر، علِمَ أنَّ كلَّ نفَسٍ مِن أنفاسِه في هذه الدنيا يعدِلُ أحقابًا وأحقابًا، وآلافًا مُؤلَّفةً مِن الأعوام والسِّنين، لا تنقَضِي ولا تتناهَى، في نعيمٍ لا ينفَد، وقُرَّةِ عينٍ لا تنقطِع. نسألُ اللهَ الكريمَ مِن فضلِه.
فالعاقِلُ لا يُضيِّعُ نفيسَ عُمرِه بغيرِ عملٍ صالحٍ، وإنَّه ليحزَن على ما يذهَبُ مِنه بغيرِ عِوَضٍ.
وإذا كان كذلك - عباد الله -، فاعتبِرُوا بقوارِعِ العِبَر، وتدبَّرُوا بصوادِقِ الخبَر، وتفكَّرُوا في حوادِثِ الأيام والغِيَر، ففيها المُعتبَر والمُزدَجَر، واحذَرُوا زخارِفَ الدنيا المُضِلَّة؛ فمَن تكثَّرَ بها لم يزدَدْ بها إلا قِلَّة.
أهلُ الدنيا ينظُرُون إلى الرِّئاسات، ويُحبُّون الجمعَ والثناءَ والمُكاثَرَات، ويقتُلُهم التحاسُدُ والتنافُسُ، والتهارُجُ والتهارُشُ. وأهلُ الآخرة لا ﴿يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، ويقولُون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
يا عبدَ الله! أيُّ نفسٍ لم تحمِلْ ظُلمًا! وأيُّ جارِحةٍ لم تقتَرِف إثمًا! فرقِّقُوا قلوبَكم - وفَّقني الله وإياكُم - بذِكرِ هادمِ اللذَّات، فلعلَّها أن تَلِين، وعِظُوها بفِتنةِ القبر، فهو حقُّ اليقين، وذكِّرُوها بيومِ الحسابِ، فهو علمُ اليقين وعينُ اليقين، يومِ خُضوع الرِّقاب، وتقطُّع الأسباب، وقَطِيعَة الأنسَاب، ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبأ: 40]، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88، 89]، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: 19].
وإنَّ ما تُوعَدُون لآت، وليس بين العبدِ وبين القِيامة إلا الممات.
واعلَمُوا - رحمَنِي الله وإياكُم - أنَّ مِن علاماتِ توفيقِ الله لعبدِه: تيسيرَ الطاعة، ومُوافقةَ السُّنَّة، وصُحبةَ أهل الصلاح، وبذلَ المعروف، وحفظَ الوقت، والاهتِمامَ بشُؤون المُسلمين.
فكُن - يا عبدَ الله - سليمَ الصدر، نقِيَّ القلبِ، حبَّ لأخيكَ ما تُحبُّ لنفسِك، واعلَم أنَّ سعادةَ غيرِك لا تأخُذ مِن سعادتِك، وغِناه لا ينقُصُ مِن رِزقِك، وصحَّتَه لا تسلُبُ عافِيتَك، ومَن رفَقَ بعبادِ الله رفَقَ الله به، ومَن رحِمَهم رحِمَه، ومَن نفَعَهم نفَعَه، ومَن ستَرَهم ستَرَه، ومَن أحسَنَ إليهم أحسَنَ الله إليه، فالله تعالى لعبدِه كما يكونُ العبدُ لخلقِه.
وتأمَّل قولَه - عزَّ شأنُه -: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77]. فجميلٌ أن يكون إحسانُك مِن جنسِ إحسانِ الله إليك؛ فإن كان رِزقًا فتصدَّق، وإن كان علمًا فعلِّم، وإن كان سعادةً فمَن حولِك أسعِد.
والتغافُلُ عن الزلَّات مِن أرقَى شِيَم الكِرام؛ فكلُّ الناسِ خطَّاؤون، ومَن تتبَّعَ الزلَّات تعِبَ وأتعَبَ، والعاقِلُ مَن ينصرِفُ عن ذلك كلِّه؛ لتصفُو له عِشرتُه، وتحلُو له مجالِسُه، ويسلَم له دينُه وعِرضُه، ومَن حسَبَ كلامَه مِن عمله، قلَّ كلامُه إلا فيما يعنِيه.
وأعظمُ ما يدَّخِرُه العبدُ: صِدقُ الحديثِ، وتركُ ما لا يعنِي، وسلامةُ القلبِ، والورَعُ في الخَلَوات، وحُسنُ الخُلُق مع الدِّيانة، وصِدقُ الإخاءِ مع الأمانة.
معاشِرَ الأحِبَّة:
ومِن دلائِلِ ذَوق حلاوة الإيمان، وتذوُّق طعم الطاعات: طُمأنينة القلبِ، وانشِراحُ الصدر، والإقبالُ على الخير، وحُبُّ الدين، والغَيرةُ على الحُرُمات، ومودَّةُ أهل الصلاحِ، والسعيُ في عِزِّ المُؤمنين.
وقد سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: ما خَيرُ ما أُعطِيَ الإنسان؟ فقال: «حُسنُ الخُلُق»؛ رواه البخاري في "الأدب المفرد" بإسنادٍ صحيحٍ.
وإنَّ مِن علاماتِ حُسن الخُلُق: قِلَّة الخِلاف، وتركَ تطلُّب العثَرَات، والتِماسَ الأعذار، واحتِمالَ الأذَى، وطلاقةَ الوجه، ولِينَ الكلام، والانشِغالَ بعيُوبِ النَّفس، والعلاقات تدُومُ بالتغاضِي، وتزدادُ بالتراضِي، وتمرَضُ بالتدقيق، وتموتُ بالتحقيق.
وليس عيبًا أن تُخطِئ، ولكن مِن العيبِ ألَّا تتعلَّم مِن أخطائِك؛ فإذا جهِلتَ فاسأَل، وإذا غضِبتَ فأمسِك، والكريمُ لا يمُنُّ، والمُخلِصُ لا يندَم، ومَن زرَعَ الجميلَ حصَدَ الجَزيلَ، وانتَقُوا الإخوانَ والأصحابَ والمجالِسَ، وخُذُوا بأحسَنِ الحديثِ إذا حدَّثتُم، وبأحسَنِ الاستِماعِ إذا حُدِّثتُم، وبأحسَنِ البُشر إذا لقِيتُم، وبأيسَرِ المَؤُونة إذا خُولِفتُم.
ودَعُوا مُحادثَةَ اللئيم، ومُنازعَةَ اللَّجُوج، ومُماراةَ السَّفِيه، واعلَمُوا أنَّ مُحادثةَ الرِّجال تُغذِّي الألباب.
وصنائِعُ المعروف تقِي مصارِعَ السُّوء، فالتَمِسُوها - رحمكم الله - في إطعامِ مِسكِين، وكسوَةِ عارٍ، وتأمِينِ خائِفٍ، ورفعِ مَظلَمةٍ، ومُساعَدةِ مريضٍ، وعَونِ مُحتاجٍ.
وبعدُ .. عباد الله:
إذا أقبَلَت الفتَن، فلا تخُوضُوا فيما لا يعنِيكُم، والزَمُوا الصَّمتَ، وتمسَّكُوا بالسنَّة، وما أشكَلَ عليكم فقِفُوا وقُولُوا: اللهُ أعلَم، وإن احتَجتُم فاسأَلُوا أهلَ العلمِ الثِّقات الأثبات، ولا تتجاوَزُوهم؛ فالمُتعجِّلُ يقولُ قبل أن يعلَم، ويُجيبُ قبل أن يفهَم.
يقولُ ابنُ مسعُودٍ - رضي الله عنه -: "لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما أخَذُوا عن أكابِرِهم وأُمنائِهم وعُلمائِهم، فإذا أخَذُوا عن صِغارِهم وشِرارِهم هلَكُوا".
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ [العاديات: 9- 11].
نفَعَني اللهُ وإياكم بهَديِ كتابِه، وبِسُنَّةِ نبيِّه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله المُتوحِّد في قُدرتِه، المُتفرِّد في أمرِه، لا يذِلُّ مَن والاه، ولا يعِزُّ مَن عاداه، أحمدُه حمدَ شاكرٍ لما أَولَاه، وأستغفِرُه استِغفارَ عبدٍ عمَّا جَناه، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً أرجُو بها نَيلَ رِضاه، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه ومُصطفاه ومُجتباه، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن وَالاه، ودعَا بدعوتِه واهتَدَى بهُداه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا لا حدَّ لمُنتهاه.
أما بعد .. أيها المُسلمون:
الزَّمانُ لا يثبُتُ على حالٍ، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]، فتارةً يُفرِحُ المُوالِي، وتارةً يُشمِتُ الأعادِي، وطَورًا في حالِ فقرٍ، وطَورًا في حالِ غِنًى، ويومًا في عِزٍّ، ويومًا في ذِلٍّ، ومَن طاوَعَ شهوَتَه فضَحَتْه، والسَّعيدُ في كل ذلك مَن لازَمَ أصلًا واحدًا في جميعِ الأحوالِ، ألا وهو: تقوَى الله.
فتقوَى الله إن استغنَى العبدُ زانَتْه، وإن افتَقَرَ فتَحَت له أبوابَ الصَّبر، وإن ابتُلِيَ حمَلَتْه، وإن عُوفِيَ تمَّت عليه النِّعمة، ولا يضُرُّه إن نزَلَ به الزَّمانُ أو صعَدَ؛ لأنَّ التقوَى أصلُ السلامة، وهي حارِسٌ لا ينام.
ألا فاتَّقُوا الله، ثم اتَّقُوا الله - رحمكم الله -؛ فتقوَاه - سبحانه - عُروةٌ ليس لها انفِصام، مَن تعلَّقَ بها كان له - بإذنِ الله - حُسنُ العاقِبَة، والحِفظُ مِن شُرور كلِّ نائِبةٍ.
أسعَدَنا الله وإياكُم بلُزومِ ما أمَرَ الله به، وجنَّبَنا وإياكُم أسبابَ سخَطِه وغضَبِه.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على الرحمةِ المُهداة، والنِّعمةِ المُسداة: نبيِّكُم مُحمدٍ رسولِ الله؛ فقد أمرَكم بذلك ربُّكم في مُحكَم تنزيلِه، فقال - وهو الصادِقُ في قِيلِه - قَولًا كريمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك: نبيِّنا مُحمدٍ الحبيبِ المُصطفى، والنبيِّ المُجتبَى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه أمهاتِ المُؤمنين، وارضَ اللهم عن الخلفاءِ الأربعةِ الراشدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الصحابةِ أجمعين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وإحسانِك وكرمِك ولُطفِك يا أكرَمَ الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمُشركين، واخذُل الطُّغاةَ، والملاحِدَة، وسائرَ أعداءِ المِلَّة والدين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمُورِنا، واجعَل اللهم ولايتَنَا فيمن خافَك واتَّقاك واتَّبَع رِضاكَ يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا وولِيَّ أمرِنا بتوفيقِك، وأعِزَّه بطاعتِك، وأَعلِ به كلمَتَك، واجعَله نُصرةً للإسلامِ والمسلمين، ووفِّقه ووليَّ عهدِه وإخوانَه وأعوانَه لِما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بنواصِيهم للبرِّ والتقوَى.
اللهم وفِّق وُلاةَ أمورِ المُسلمين للعملِ بكتابِك، وبسنَّةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمَع كلمتَهم على الحقِّ والهُدَى يا ربَّ العالمين.
اللهم أصلِح أحوال المُسلمين، اللهم أصلِح أحوال المُسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم، اللهم احقِن دماءَهم، واجمَع على الحقِّ والهُدى والسنَّة كلِمتَهم، وولِّ عليهم خيارَهم، واكفِهم أشرارَهم، وابسُط الأمنَ والعدلَ والرَخاءَ في ديارِهم، وأعِذهم مِن الشُّرور والفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على الحُدود، اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على الحُدود، اللهم سدِّد رأيَهم، وصوِّب رميَهم، واشدُد أزرَهم، وقوِّ عزائِمَهم، وثبِّت أقدامَهم، واربِط على قلوبِهم، وانصُرهم على مَن بغَى عليهم، اللهم أيِّدهم بتأيِيدِك، وانصُرهم بنصرِك، اللهم احفَظهم مِن بين أيدِيهم، ومِن خلفِهم، وعن أيمانِهم، وعن شمائِلِهم، ومِن فوقِهم، ونعوذُ بك اللهمَّ أن يُغتالُوا مِن تحتِهم، اللهم ارحَم شُهداءَهم، واشفِ جرحاهم، واحفَظهم في أهلِهم وذَرارِيهم، إنَّك سميعُ الدُّعاء.
اللهم اغفِر ذنوبَنا، اللهم اغفِر ذنوبَنا، واستُر عيوبَنا، ونفِّس كُروبَنا، وعافِ مُبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحَم موتانا.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ يذكُركُم، واشكُرُوه على نعمِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

الحقوق الزوجية وأسباب الطلاق
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الحقوق الزوجية وأسباب الطلاق"، والتي تحدَّث فيها عن الزواج وأنه عقدٌ وميثاقٌ غليظٌ، ورِباطٌ مِن أقوى الروابِط في الحياة، مُبيِّنًا أن فيه مصالِح ومنافِع تعودُ على الزوج والزوجة والأولاد والمُجتمع بأَسرِه، ثم ذكرَ أبرزَ أسباب دوام الزواج، وفي المُقابِل ذكرَ بعضَ أسباب وقوع الطلاق، وبيَّن بعضَ أهم حقوقِ الزوج على زوجتِه والزوجةِ على زوجِها، كما حثَّ المسلمين - لاسيَّما الشباب - على عدم التساهُل في الطلاق دون النظر إلى عواقِبِه الوخِيمَة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي خلقَ الأزواجَ كلَّها مما تُنبِتُ الأرضُ ومِن أنفُسِهم ومما لا يعلَمون، أمرَ - عزَّ وجلَّ - بالصلاح والإصلاح، ونهَى عن الفسادِ بقوله: ﴿وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: 142]، وشرعَ - تبارك وتعالى - التشريعَ للمصالِح والمنافِع، ودرءِ المفاسِد والمضارِّ في حقِّ المُكلَّفين، أحمدُ ربي وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغنيُّ عن العالمين، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه الصادقُ الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله في السرِّ والعلانية؛ فما فازَ أحدٌ في حياتِهِ وبعد مماتِهِ إلا بالتقوَى، وما خابَ أحدٌ وخسِرَ إلا باتِّباعِ الهوَى.
أيها الناس:
اذكرُوا مبدأَ خلقِكم، وكثرةَ رِجالِكم ونسائِكم مِن نفسٍ واحدةٍ، خلَقَ الله منها زوجَها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: 189].
ثم جرَت سنَّةُ الله تعالى وشريعتُه أن يقتَرِنَ الرجلُ بالمرأة بعقد النِّكاح الشرعيِّ، ليبنِيَا بيتَ الزوجيَّةِ؛ تلبيةً واستِجابةً لمطالِبِ الفِطرة والغريزَة البشريَّة، مِن طريقِ النِّكاح لا مِن طريقِ السِّفاح.
فطريقُ الزواجِ هو العفافُ، والبركةُ والنَّماءُ، والطُّهرُ، والرِّزقُ، وصحَّةُ القلوب، وامتِدادُ العُمر بالذريَّة الصالِحة. وطريقُ السِّفاح والزِّنا هو الخُبثُ، وأمراضُ القلوب، وفسادُ الرَّجُل والمرأة، وذُلُّ المعصِيَة، وآفاتُ الحياةِ، والذَّهابُ ببركَتِها، والخلَلُ في الأجيَال، والعذابُ في الآخرة.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رأَى ليلةَ الإسراءِ والمعراجِ مِنَ العجائِب: «ثم أتَى على قومٍ تُرضَخُ رُؤُوسُهم بالصَّخر، كلَّما رُضِخَت عادَت كما كانت، ولا يُفتَّرُ عنهم مِن ذلك شيءٌ، فقال: ما هؤلاء يا جِبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقَلُ رُؤوسُهم عن الصلاةِ المكتُوبة. ثم أتَى على قومٍ على أقبالِهم رِقاعٌ، وعلى أدبارِهم رِقاعٌ، يسرَحُون كما تسرَحُ الإبلُ والنَّعَم، ويأكلُون الضَّريعَ والزَّقُّومَ ورَدغَ جهنَّم وحِجارتَها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يُؤدُّون صدقاتِ أموالِهم، وما ظلمَهم الله شيئًا. ثم أتَى على قومٍ بين أيدِيهم لحمٌ نضِيجٌ في قِدرٍ، ولحمٌ آخرُ نَيِّئُ في قِدرٍ خبيثٍ، فجعلَوا يأكلُون من النيِّئ ويدَعُون النَّضيجَ الطيِّبَ. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هذا الرجلُ مِن أمَّتك تكونُ عنده المرأةُ الحلالُ الطيِّبُ، فيأتِي امرأةً خبيثةً فيَبِيتُ عندها حتى يُصبِح، والمرأةُ تقوم مِن عند زوجِها حلالاً طيبًا، فتأتي رجلًا خبيثًا فتبتُ معه حتى تُصبِح»؛ رواه ابن جريرٍ في "تفسيره".
والزوجيَّةُ بيتٌ يحتضِنُ الذريَّة، ويحنُو عليهم ويَرعاهم ويُعلِّمُهم، وأبُوَّةٌ وأُمومةٌ تُعِدُّ الأجيالَ للقيامِ بأعباءِ الحياة، ونفعِ المُجتمع ورُقِيِّه في كل شأنٍ، وتُوجِّهُ إلى كلِّ خُلُقٍ كريمٍ، وتمنَعُ من كلِّ خُلُقٍ ذَميمٍ، وتُربِّي على الصالِحات للدار الآخرة والحياةِ الأبديَّة.
ويقتَدِي الصغيرُ بما يرى، فيتأثَّرُ بما يُشاهِدُ ويسمَع؛ حيث لا قُدرةَ له على قراءةِ التاريخ، وأخذ العِبَر مِنه والقُدوة.
وعقدُ الزواج ميثاقٌ عظيمٌ، ورِباطٌ قويٌّ، وصِلةٌ شديدةٌ، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20، 21].
قال المُفسِّرون: "هو عَقدُ النِّكاح".
وهذا العقدُ اشتملَ على مصالِح ومنافِع للزَّوجَين، ومنافِع ومصالِح للأولاد، ومصالِح ومنافِع لأقرباءِ الزَّوجَين، ومنافِع ومصالِح للمُجتمع، ومنافِع ومصالِح للدُّنيا والآخرة، لا تُعدُّ هذه المنافِعُ ولا تُحصَى.
ونَقضُ هذا العقد، وإبطالُ هذا الميثاق، وقطعُ حبل الزوجيَّة بالطلاقِ يهدِمُ تلك المصالِحَ والمنافِعَ كلَّها، ويقعُ الزوجُ في فتنٍ عظيمةٍ تضرُّه في دينه ودُنياه وصحَّته، وتقعُ المرأةُ بالطلاقِ في الفتن بأشدَّ مما وقعَ فيه الزوجُ، ولا تَقدِرُ أن تُعيدَ حياتَها كما كانت، وتَعِيشُ في ندامةٍ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي قَلَّ فيه المُوافِقُ لحالِها.
ويتشرَّدُ الأولادُ، ويُواجِهون حياةً شديدةَ الوطأَة تختلفُ عما كانت عليه وهُم في ظلِّ اجتماع الأبوَين، ويفقِدون كلَّ سعادةٍ تبتَهِجُ بها حياتُهم، ويكونون مُعرَّضين للانحِرافِ بأنواعه المُختلفة، ومُعرَّضِين لأمراضٍ مُختلفة، ويتضرَّرُ المُجتمعُ بالآثار الضارَّة التي تكون بعد الطلاقِ، وتستَحكِمُ القطيعةُ للأرحام. ومهما أُحصِيَ من مفاسِد الطلاق فهي أكثرُ مِن ذلك.
ولتعلَم مفاسِدَ الطلاقِ، وكثرةَ أضراره الخاصَّة والعامَّة، تأمَّل في حديثِ جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ إبليسَ يضَعُ عرشَه على الماء، ثم يبعَثُ سراياه، فأدناهم منه منزِلةً أعظمُهم فتنةً، يجِيءُ أحدُهم فيقولُ: فعَلتُ كذا وكذا، فيقولُ له: ما صنَعتَ شيئًا، ثم يجِيءُ أحدُهم فيقولُ: ما ترَكتُه حتى فرَّقتُ بينَه وبينَ امرَأَتِه، فيُدنِيه منه ويقولُ: نعم، أنتَ أنتَ، فيلتزِمُه»؛ رواه مسلم.
وقد استخَفَّ بعضُ الناس بالطلاقِ، فاستسهَلَ أمرَه، ووقعَ في أمورٍ خطيرةٍ، وشُرورٍ كثيرةٍ، وأوقعَ غيرَه فيما وقَعَ فيه. وقد كثُر الطلاقُ في هذا الزمان لأسبابٍ واهيَةٍ، ولعللٍ واهِمةٍ، وأسبابُ الطلاق في هذا الزمان كثيرة، ومن أكبرِها: الجهلُ بأحكام الطلاق في الشريعة، وعدمُ التقيُّد بالقرآن والسنَّة.
وقد أحاطَت الشريعةُ الإسلاميَّةُ عقدَ الزواجِ بكل رعايةٍ وعنايةٍ، وحفِظَتْه بسِياجٍ مِن المُحافَظةِ عليه؛ لئلَّا يتصدَّع وينهَدِم، ويتزعزَعَ أمام عواصِفِ الأهواء؛ لأن سببَ الطلاق قد يكونُ مِن الزوج، وقد يكونُ مِن الزوجةِ، وقد يكونُ مِنهما، وقد يكونُ مِن بعضِ أقاربِهما، فعالَجَت الشريعةُ كلَّ حالةٍ قد تكونُ سببًا في الطلاقِ.
فأمرَ الله في كتابِه الزَّوجَ أن يُعظِّم عقدَ الزَّواج، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
قال المُفسِّرون: "للمرأة على الرجلِ مثلُ ما للرجلِ على المرأة في حُسن العِشْرة، ويفضُلُها في القوَامَة".
وعلى الرجلِ العِشرةُ بالمعروف والإحسان، وإذا كرِهَها صبَرَ عليها، لعلَّ الحالَ تتبدَّل إلى أحسَن منها، أو لعلَّه يُرزَقُ منها بأولادٍ صالِحِين، ويُؤجَرُ على صبرِه عليها، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].
وعلى الزوجِ والزوجةِ أن يُصلِحَا أمورَ الخلافِ في بدايَتِها بينَهما؛ لئلَّا تزدادَ خلافًا، وعلى الزَّوجَين أن يعرِفَ كلٌّ مِنهما صاحبَه، فيأتي كلٌّ مِنهما ما هو أرضَى لصاحِبِه، ويجتنِبُ كلٌّ منهما ما لا يُحبُّ الآخر. وهذا ميسورٌ لا يَخفَى.
ومِن أسبابِ بقاءِ الزوجيَّة: الإصلاحُ بين الزَّوجَين مِن أهل الخير المُصلِحين؛ حتى يتحقَّق لكلٍّ منهما حقُّه الواجِبُ له على صاحِبِه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35].
ومن أسباب دوامِ الزَّواج وسعادته: الصبرُ والتسامُح؛ فمرارةُ صَبرٍ قليلٍ يعقُبُه حلاوةُ دهرٍ طويلٍ، وما استُقبِلَت المكرُوهات بمثلِ الصَّبرِ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: 10].
والتسامُح والعفوُ تَزِينُ به الحياة، ويكسُوها البَهجَةُ والسُّرورُ والجمالُ، وتندَمِلُ به جِراحُ العِشْرة، والتسامُحُ والعفوُ أمرٌ ضروريٌّ للحياة، ولا سيَّما بين الزوجَين، وإذا كان في أمورٍ كماليَّة، أو في أمورٍ قابِلةٍ للتأخير، فالتسامُحُ هنا خيرٌ للزوجَين.
وفي هذا الزمان أُرهِقَ كثيرٌ من الأزواجِ بمطالِبِ الحياةِ وإنجازِها حتى وإن كانت كماليَّة، واستِقصاءُ كلِّ الحُقوق، وعدمُ التسامُح والعفوِ في بعضِها يُورِثُ النُّفرةَ والتباغُضَ بين الزوجَين.
والزواجُ رُوحُه التعاوُن والرحمةُ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: 14].
والعداوةُ هنا هي التثبيطُ عن الخير، أو عدمُ الإعانةِ عليه، أو هي المنعُ منه.
قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].
ومن أسبابِ دوامِ الزواج: تقويمُ الزوجِ ما اعوَجَّ من أخلاقِ المرأة، بما أباحَه الشرعُ وأذِنَ فيه، قال الله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34].
وعلى القُضاةِ الإصلاحُ بين الزوجَين فيما يُرفَعُ إليهم مِن القضايا؛ حتى يتمَّ الاتفاقُ، وينتَفِيَ الطلاقُ.
وحقُّ المرأة على الزوجِ: عِشرَتُها بالمعروف، وسكَنُها الذي يصلُحُ لمثلِها، والنفقةُ والكِسوةُ، وبَذلُ الخير، وكفُّ الأذَى والضَّرَرُ عنها.
وقد يكونُ السببُ في الطلاقِ مِن المرأةِ ببذاءَة لسانِها، وسُوءِ خُلُقها، وجَهلِها، فعليها أن تُقوِّم أخلاقَها، وتُطيعَ زوجَها، وتبذُلَ جُهدَها في تربيةِ أولادِها التربيةَ الصحيحةَ.
عن عبد الرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلَّت المرأةُ خَمسَها، وصامَت شَهرَها، وحفِظَت فَرْجَها، وأطاعَت زَوجَها، قيل لها: ادخُلي الجنةَ من أيِّ أبوابِ الجنةِ شِئتِ»؛ رواه أحمد، وهو حديثٌ حسنٌ.
وعلى المرأةِ أن تخدِمَ زوجَها بالمعروف، تأسِّيًا بالصحابيات - رضي الله عنهنَّ -، وما أحسَنَ أن تكون مُشارِكةً له في سُروره أو حُزنِه، وأن تكون عَونًا له على طاعةِ الله تعالى.
ومِن أسبابِ الطلاقِ: تدخُّل أقرِباء أحَدِ الزوجَين بينهما، أو أقرِباء كلٍّ منهما، فليتَّقُوا اللهَ وليقُولوا قولًا سديدًا، وفي الحديث: «لعَنَ الله مَن خبَّبَ امرأةً على زوجِها، أو زوجًا على زوجَتِه».
وعلى المرأة أن تقومَ بحقِّ أقرِباء الزوجِ، ولا سيَّما الوالدَين. وعلى الزوجِ أن يقومَ بحقِّ أقرِباء الزوجةِ، فكثيرًا ما يكونُ التقصيرُ في حقِّ أقرِبائِهما سبَبًا مِن أسبابِ الطلاق.
ومِن أسبابِ الطلاق: التتبُّعُ للمُسلسلات الفضائيَّة التي تهدِمُ العفافَ والأخلاقَ، أو المواقِع المُحرَّمة التي تنشُرُ الفساد.
ومِن أسباب الطلاقِ: خُروجُ الزوجةِ بغير إذنِ الزوجِ، ولا يحلُّ لها أن تخرُجَ إلا بإذنِه، وهو الذي يُقدِّرُ الأمُورَ.
وإذا تعذَّرَت أسبابُ بقاءِ الزوجيَّة، فقد أحلَّ الله الطلاقَ مع بُغضِه له، وفي الحديث: «أبغَضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ».
فيُطلِّقُ الزوجُ الطلاقَ الشرعيَّ بعد روِيَّةٍ وتأنٍّ، كما أمرَ الله تعالى في قولِه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 1].
قال المُفسِّرون: "يُطلِّقُها في طُهرٍ لم يُجامِعها فيه طلقةً واحدةً، فإن شَاءَ راجَعَها في العدَّة، وإلا ترَكَها حتى تنقضِيَ عِدَّتُها فتخرُجَ مِن عِصمتِه".
والطلاقُ بهذه الطريقةِ يفتَحُ بابَ الأملِ بالرَّجعة لبقاءِ الزواجِ، أو بعقدٍ جديدٍ مع المهرِ بعد العِدَّة.
فانظُر إلى تأكيد عقدِ الزواجِ وحِمايته في الشرعِ الحَنيف، وإلى الاستِهانةِ بالطلاقِ في هذا الزمانِ وما جرَّ مِن المآسِي، والصَّبرُ مِنهما واجِبٌ.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: 21].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، ونفعَنا بهديِ سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائر المسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، شرَعَ الأحكامَ بعلمِه وحكمتِه ورحمتِه فسُبحانَه من إلهٍ عظيم، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له العليمُ الحكيم، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه الكريمُ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه المُتمسِّكين بشَرعِه القَويم.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله حقَّ التقوَى، وتمسَّكُوا مِن الإسلام بالعُروة الوُثقَى.
عباد الله:
يقولُ الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
أيها المسلمون:
لقد صارَ الطلاقُ جارِيًا على ألسِنةِ بعضِ الشبابِ مِن دون مُراعاةٍ لحقوقِ ولدٍ، ولا لقريبٍ، ولا اعتبارٍ لأحدٍ، وقد يقَعُ بتَكرَاره في أزمِنةٍ مُتباعِدةٍ، أو تَكرَراه في مجلسٍ واحدٍ، ثم يتلمَّسُ الفتاوى، وقد يحتالُ، وقد تنسَدُّ عليه الطرُقُ، ويندمُ ندامةً لا تنفعُه، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2، 3].
ومَن اتَّقَى الله في طلاقِه على الوجهِ الشرعيِّ جعَلَ الله له مخرَجًا، ومَن عظَّم عقدَ الزوجيَّة ولم يستخِفَّ به بارَكَ الله له في زواجِه، ونالَ عاقبةً حسنةً.
وبعضُ أنواع الطلاقِ الخاصَّة والحالات يكونُ الطلاقُ فيها مُحرَّمًا إثمًا، كما قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي أيوبَ: «إنَّ طلاقَ أمِّ أيوبٍ لحُوب» يعني: إثمًا.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
اللهم وارضَ عن الصحابةِ أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديِّين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن جميع الصحابةِ أجمعين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافرين، والشِّركَ والمُشركين يا ربَّ العالمين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم فقِّهنا في دِينِك، اللهم فقِّهنا في الدِّينِ، اللهم فقِّهِ المُسلمين في الدِّين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباعَه، وأرِنا الباطلَ باطلًا وارزُقنا اجتِنابَه، ولا تجعَله مُلتبِسًا علينا فنضِلُّ، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تُعينَنا على ذِكرِك، اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتِك برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفِرَ لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلَمُ به منَّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم إنَّا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل.
اللهم إنَّا نعوذُ بك مِن شُرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالِنا.
اللهم أعِذنا وذريَّاتنا مِن إبليس وذريَّته وشياطينه وأوليائِهِ يا ربَّ العالمين، وخُطواتِه إنَّك على كل شيءٍ قدير، اللهم أعِذ المُسلمين من إبليس وذريَّته يا ربَّ العالمين، يا أرحَمَ الراحمين.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن سُوء القضاء، ومِن شماتةِ الأعداء، ومِن دَرَك الشَّقاء، ومِن جَهد البلاء.
اللهم إنَّا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل، ونسألُك حُسنَ الخاتمة يا أرحَمَ الراحمين، برحمتِك إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم اغفِر لأمواتِنا وأمواتِ المُسلمين، اللهم اغفِر لأمواتِنا وأمواتِ المُسلمين، اللهم اغفِر للمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، الأحياءِ مِنهم والأموات برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أغِثنا يا أراحم الراحمين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم لا تُزِغ قلوبَنا بعد إذ هدَيتَنا، وهَبْ لنا مِن لدُنكَ رحمةً إنَّك أنت الوهَّاب.
اللهم احفَظ بلادَنا من كلِّ شرٍّ ومكرُوه يا رب العالمين، ومِن شرِّ الأشرار، وكَيدِ الفُجَّار، اللهم احفَظ جنودَنا، اللهم احفَظ جنودَنا، اللهم احفَظهم في كل مكانٍ يا ربَّ العالمين، اللهم إنَّا نسألُك أن تحفظَهم في أنفسِهم وفيما يخافُون عليه، إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم وفِّق عبدَكَ خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك يا ربَّ العالمين، اللهم أعِنه على كل خيرٍ، اللهم وفِّقه للعمل الصالِح الرشيد، والرأي السديد يا ذا الجلال والإكرام، وانفَع به الإسلامَ والمُسلمين، اللهم وفِّق نائبَه وليَّ عهده لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك يا ربَّ العالمين، وأعِنه على كلِّ خيرٍ، ووفِّقه للعمل الصالِح الرشيد، والرأي السديد، اللهم وانفَع به يا ربَّ العالمين الإسلامَ والمُسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ارفَع عن المُسلمين الشَّدائِدَ والكُرُبات، اللهم ارفَع عنهم الشَّدائِدَ والكُرُبات، اللهم اكسُ عارِيَهم، اللهم وأمِّن خائِفَهم، اللهم وأعِذهم مِن ظُلم الظالِمِين يا ربَّ العالمين الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الذين آذَوهم في دينِهم، وتسلَّطُوا عليهم يا ربَّ العالمين، وظَلَمُوهم يا أرحم الراحمين، ارفَع عن المُسلمين يا ذا الجلال والإكرام ما أصابَهم مِن الشَّدائِد في كل مكانٍ ظُلِمُوا فيه، إنَّك على كل شيءٍ قدير.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا الله العظيمَ الجليلَ يذكُركُم، واشكُرُوه على نِعَمِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبرُ، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "معالمُ التجديد وضوابِطُه"، والتي تحدَّث فيها عن التجديد في الفقهِ الإسلاميِّ وضوابِطِه، مُبيِّنًا أنَّ شريعتَنا الغرَّاء ليست جامِدةً، بل تمتازُ بالمُرونة، فلا تُنافِي الأخذَ بالتجديد في وسائلِ وآليَّات العصر، ومُواكَبَة تِقاناتِه، مُستدِلًّا على ذلك ببعضِ النُّقُول عن أئمةِ المُسلمين.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونتوبُ إليه، نحمدُه - سبحانه - على نعمِه السوابِغ، وآياتِه البوالِغ.
|
الحمدُ لله حمدًا ليس
مُنحصِرَا |
|
على أيادِيهِ ما يخفَى
وما ظهَرَا |
|
ثم الصلاةُ وتسليمُ
المُهيمِنِ ما |
|
هَبَّ الصَّبَا فأدَرَّ
العارِضُ المطَرَا |
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصَّنا بشريعةٍ بلجَاء، أفعمَت العالمين بسُمُوِّها وسَناها، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه جلَّى معالِمَ رُقيِّ الحضارة وأقامَ صُواها، اللهم صلِّ عليه وعلى آله صفوةِ الخليقة سِيرةً وأزكاها، وصحبِه الكِرام البَرَة البالِغين مِن ثُريَّا الأمجاد عُلاها، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا لا يتناهَى.
أما بعد:
اتَّقُوا الله - عباد الله -؛ فإنَّ تقوَاه أفضلُ ذُخرٍ وأحسنُ زادٍ للمعاشِ والمعاد، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 52].
|
إذا أنتَ لم ترحَلْ
بزادٍ مِن التُّقَى |
|
ولاقَيتَ بعد المَوتِ
مَن قد تزوَّدَا |
|
نَدِمتَ على ألَّا تكون
كمِثلِهِ |
|
وأنَّك لم ترصُدْ كما
كان أرصَدَا |
معاشر المُسلمين:
ليس يخفَى على أُولِي النُّهَى والألباب ما شهِدَت به الحضاراتُ عريقةُ الأسباب، أنَّ شريعتَنا الإسلاميَّةَ الغرَّاء غيَّرَت بنُور عدلِها ورحمتِها مِن الدُّنيا قاتِمَ معالِمِها، وانتزَعَت دُون شحنائِها مُرهَفَ صوارِمِها، وغرَسَت في البريَّة رحَمَاتها المُبهِجةَ ومكارِمَها، فهي رَحْبةُ واسِعةُ الأرجاء، عبِقَةُ الأفنان، تمتازُ بالشُّمول والكمال، وتنتظِمُ مصالِحَ العباد في أمور المعاشِ والمعادِ؛ وذلك لأنَّ الأحكام الشرعيَّة لا تُؤخَذُ إلا عن الله تعالى وعن رسولِه - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا أصلٌ عظيمٌ مِن أصول هذا الدين القَوِيم، قال تعالى مُخاطِبًا نبيَّه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18].
أيها المُسلمون:
لقد زخِرَت شريعتُنا الغرَّاء بالأصول النافِعة، والمقاصِد الجامِعة في قضايا الدين والدنيا معًا، وحَوَت نُصوصًا ومقاصِدَ، وحِكَمًا وقواعِدَ ملأَت البسيطةَ عدلًا وحِكمةً، وتيسيرًا ورحمةً، واستوعَبَت قضايا الاجتِهاد والنوازِل، فأبانَت أحكامَها، وأوضَحَت حلالَها وحرامَها عبر ميزانٍ دقيقٍ، ومِعيارٍ وثيقٍ، وأصولٍ مُحكَمة سارَ عليها عُلماءُ الإسلام ومُجتهِدُو الأنام، مما كان له الأثرُ البالِغُ في تحقيقِ الخير للأفراد والمُجتمعات، وإصابة الحقِّ في الاجتِهادات والمُستجِدَّات.
فهي ليست شريعةً جامِدة، أو أحكامًا مُتحجِّرةً تالِدة، بل هي مرِنةٌ مُتجدِّدة، لا تُنافِي الأخذَ بالتجديد في وسائلِ وآليَّات العصر، والإفادة مِن تِقاناتِه، في مُواكَبةٍ للمُعطيات والمُكتسَبات، ومُواءَمةٍ بين الثوابِتِ والمُتغيِّرات، والأصالة والمُعاصِرة؛ إذ التجديدُ كلمةٌ أخَّاذة، ومُفردةٌ نفَّاذة، تحتاجُ إلى عقليَّةٍ فذَّة، وملَكةٍ رائِدةٍ في استِنباطِ الأحكامِ مِن النُّصوص، وتفريعِ المسائل، وإلحاق الجُزئيَّات بالكليَّات، وتخريج الفروع على أصولِها القطعيَّات، وإحكام التأصيل الفقهيِّ، والاعتِبار المقاصديِّ لبيان الحُكم الشرعيِّ.
أخرج أبو داود والحاكم بسندٍ صحيحٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يبعَثُ لهذه الأمةِ على رأسِ كل مائةِ سنةٍ مَن يُجدِّدُ لها دينَها».
معاشِر المُؤمنين:
إنَّ للتجديد في شريعتِنا السامِية معالِم لألاءَة، وضابِط وضَّاءة، مِن أهمها: ألَّا يُعارِضَ نصًّا مِن النصوص الشرعيَّة، ولا مقصِدًا مِن المقاصِد المرعيَّة؛ إذ لا بقاءَ لشريعةٍ دون حفظِ نُصوصِها، ومُراعاةِ مقاصِدِها، فالمقاصِدُ هي الغاياتُ التي وُضِعَت الشريعةُ لأجلِ تحقيقِها لمصلَحة العباد.
يقولُ الإمامُ الطاهرُ ابن عاشُورٍ - رحمه الله -: "إنَّ مقصِد الشريعة مِن التشريع حِفظُ نظام العالَم، وضبطُ تصرُّف الناسِ فيه عل وجهٍ يعصِمُ مِن التفاسُدِ والتهالُك".
ومِن ضوابِط التجديدِ المُهمَّة: أن يقوم عليه أهلُ الحلِّ والعقد والرأي والعلم؛ فإنَّ مُوافقة الشرع ومقاصِد الشريعة تحتاجُ إلى العُلماء الربَّانيِّين ذوِي العقليَّات الفَذَّة، والمَلَكات الاجتِهاديَّة الذين يُحكِمُون الأصولَ والقواعِد، ويَزِنُون الأمورَ بميزان الشرع الحَنيف، وأن يكون مجالُ التجديدِ في الفروع والجُزئيَّات، والوسائل والصِّياغات ونحوِها؛ لأنَّ مِن سِمات الشريعة الغرَّاء: المُرونة، والصلاحية لكل الأزمِنة والأمكِنة، ومُراعاةَ الظروف والمُتغيِّرات، والأحوال والعادات والبِيئات. وهذا يقتَضِي شرعًا وعقلًا أن تستوعِبَ الشريعةُ هذه الأمورَ كلَّها.
وأن يكون التجديدُ مُحقِّقًا لمصلَحةٍ شرعيَّةٍ مُعتبَرةٍ، أو دارِئًا لمفسَدةٍ مُحقَّقةٍ أو راجِحة؛ لأنَّ هذه الشريعة جاءَت بتحقيقِ مصالِح العباد في أمورِ المعاشِ والمعادِ.
ولذلك اجتهَدَ الصحابةُ - رضي الله عنهم - في نوازِل حصَلَت، ووضَعُوا لها أحكامًا مُعتبَرة مبنيَّةً على تحقيقِ المصالِح، كتضمين الصُّنَّاع، وتدوين الدواوين، وجمع المُصحَف ونحوِها؛ لأنَّها جاءَت مُتواكِبةً مع رُوح الشريعة ورِعايةِ مقاصِدِها، وبِناءً عليه لا يكون التجديدُ مبنيًّا على الرَّغَبات والأهواء، والمُشتهَيات والآراء.
ومِن ضوابِطِه: تصفِيةُ المفاهيم الصحيحة مِن ضدِّها مما يُخالِفُ فهمَ السَّلَف - رحمهم الله - في الاستِدلال والاستِنباط، وتمحيصُها وتحريرُها، وترجيحُ أقرَبِها إلى الكتابِ والسنَّة، وكذلك النظرُ إلى مقاصِد القِيَم مِن خلال المصالِح والمفاسِد بميزان الشرعِ لا بأهواءِ النُّفوس.
وفي ذلك يقولُ الإمامُ الشاطبيُّ - رحمه الله -: "إنَّ المصالِح التي تقومُ بها أحوالُ العبد لا يعرِفُها حقَّ معرفتِها إلا خالِقُها وواضِعُها، وليس للعبدِ بها علٌ إلا مِن بعضِ الوُجوه، والذي يخفَى عليه أكثرُ من الذي يبدُو له، وكَم مِن مُدبِّرٍ أمرًا لا يتمُّ له على كمالِه أصلًا، ولا يَجنِي مِنه ثمرةً أصلًا، فإذا كان كذلك فالرجوعُ إلى الوجهِ الذي وضَعَه الشارِعُ رُجوعٌ إلى وجهِ حُصول المصلَحة".
أمة الإسلام:
أما المسائِلُ الخلافيَّة فينبغي أن تتسِعَ لها الصدُور، ويتسامَحَ فيها القادِرُ والمقدُور، ولا يُبادَرُ فيها بالإنكار على المُخالِف، ومِن المُقرَّر في الشريعة: أنَّه لا إنكارَ في مسائل الخِلاف السائِغة، وأنَّ الفتوَى تتغيَّرُ بتغيُّر الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والظروف والأحوال والبيئات والأشخاص، وأنَّ حُكم الحاكِم يرفعُ الخلاف، وحُكمَه في الرعيَّة منُوطٌ بالمصلَحة.
أيها المُؤمنون:
وبعد الأخذ بهذه الإضاءات المُهمَّة، فإنَّه يجِبُ العملُ على استِلهام حضارةِ الإسلام المُشرِقة التي كانت أهمَّ روافِد التحضُّر البشريِّ، والإبداعِ الإنسانيِّ، والإهابة بقادَة الأمة وعُلمائِها ومُفكِّريها بالاتِّفاقِ على مبادِئ مُشترَكة لتجديدِ أمورِ الدينِ، مع الحِفاظِ على الثوابِتِ والمُسلَّمات، ووضعِ خارِطة طريقٍ لإنقاذِ الأمةِ مِن الفتَن، وعِلاجِ مُشكِلاتها، ووقفِ نَزِيف دماءِ أبنائِها، باستِئصالِ أسبابِ الصِّراع في بعضِ أرجائِها، كالحِزبيَّة المَقِيتة، والطائفيَّة البَغِيضة، وما خلَّفَت مِن فتنٍ واضطِراب، ونِزاعٍ واحتِراب.
فشريعةُ الإسلام شريعةُ هدايةٍ واستِقامةٍ، ووسطيَّةٍ واعتِدالٍ، ورحمةٍ وتسامُح، وأمنٍ واستِقرارٍ، ورخاءٍ وسلامٍ.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].
هذا وإنَّنا لنسألُ المَولَى - سبحانه - أن يحفظَ أمَّتَنا الإسلاميَّة مِن كيد المُتربِّصين الأعداء، والكائِدِين الألِدَّاء، إنَّ ربِّي سميعٌ مُجيبُ الدُّعاء.
أقولُ قولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم، فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّه هو التوابُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله أسبَغَ علينا نعمًا غامِرةً عِظامًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له تقدَّسَ إجلالًا وإعظامًا، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه المُجتبَى مِن العالمين رسالةً ومقامًا، اللهم صلِّ عليه وعلى آلِهِ البالِغين مِن محبَّته السَّنامَا، وصحبِهِ المُقتَفين لسُنَّته التِزامًا واعتِصامًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ ما تعاقَبَ النيِّران ودامَا.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واستمسِكُوا جميعًا بالعُروة الوُثقَى، واجتنِبُوا مُضِلَّات الفتَن تبلُغُوا مِن العِزِّ غايةَ المِكَن، وعليكُم بالجماعة؛ فإنَّ يدَ الله مع الجماعة، ومَن شذَّ شذَّ في النار.
أمة الإيمان:
وإنَّ مِن التحدُّث بنعَمِ الله تعالى وشُكر آلائِه: ما حبَانا به في هذه البلاد المُبارَكة - حرَسَها الله - مِن مُقوِّماتٍ شرعيَّةٍ وأخلاقيَّةٍ وحضاريَّةٍ، تجعلُها مثلًا يُحتَذَى، ونِبراسًا يُقتَدَى في الحِفاظ على المُثُل والأخلاق الفاضِلة، مما يُحتِّمُ علينا جميعًا الوقوفَ معها، والالتِفافَ حولَ وُلاةِ أمرِها وعُلمائِها، خاصَّةً ضدَّ الحملات المسعُورة الموتُورة، التي تستهدِفُ النَّيلَ مِن وحدتها ونهضَتها.
|
هنا
دعوةُ الإحسانِ في ثَوبِ حِكمةٍ |
|
هنا
الرِّفقُ والنَّهجُ الزكِيُّ الأطهَرُ |
|
فهذا
حصادُ المنهَجِ الحقِّ يانِعًا |
|
وإنَّ
طريقَ الحِلمِ والعِلمِ نَيِّرُ |
وإنَّ مسيرةَ التجديد في هذه البلاد المُبارَكة برِعايةٍ مِن وُلاةِ أمرِها الميامِين، وحِرصٍ واهتِمامٍ مِن الشابِّ الطَّمُوحِ المُحدَّثِ المُلهَم وليِّ عهدِ هذه البلاد المحرُوسة، ماضِيةٌ في رُؤيتِه التجديديَّة الصائِبة، ونظرتِه التحديثيَّة الثاقِبة، رغم التهديدات والضُّغوطات.
وإنَّ أيَّ مُحاولاتٍ للتهديدِ وإجهاضِ التجديد مُحاولاتٌ يائِسة، وستنعكِسُ سلبًا على الأمنِ والسلامِ والاستِقرارِ العالميِّ، وبلادُنا المُبارَكة ستظلُّ رائِدةً شامِخةً، وترديدُ الاتِّهاماتِ والشِّائِعات والحَمَلات الإعلاميَّة المُغرِضة لن يَثنِيَها عن التمسُّك بمبادِئِها وثوابتِها، مُعتمِدةً في ذلك على الله وحدَه، ثم على حِكمةِ قادَتِها وتلاحُم أبنائِها، فهي الكفِيلةُ - بإذن الله - لمُواجَهة المزاعِمِ الباطِلة، والمُحاولات الفاشِلة، والتأريخُ خيرُ شاهدٍ على ذلك.
والنَّيلُ مِنها استِفزازٌ لمشاعِرِ أكثر مِن مِليار مُسلمٍ هي قِبلتُهم، ومحلُّ مناسكِهم، ومهدُ رسالتِهم، ومهوَى أفئِدتِهم، وهنا تُقدَّرُ بإجلالٍ مشاعِرُ ومواقِفُ الإنصاف، والعقل والحِكمة التي تُؤثِرُ التروِّيَ ونُصرةَ الحقِّ، والاعتِماد على الحقائِقِ ونَبذِ القَفزِ على التكهُّنات، وبِناء المواقِفِ على مُجرَّد الشَّائِعات والافتِراءات، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: 43]، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8].
ألا وصلُّوا - رحِمَكم الله - على النبيِّ المُصطفَى، والرسولِ المُجتبَى، كما أمرَكم بذلك ربُّكم - جلَّ وعلا -، فقال تعالى قولًا كريمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى علَيَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
|
ثم
الصلاةُ بعدُ والسلامُ |
|
على
نبيٍّ دينُه الإسلامُ |
|
مُحمدٍ
خاتَمِ رُسْلِ ربِّهِ |
|
وآلِهِ
مِن بعدِهِ وصَحبِهِ |
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاءِ الأربعة المهديين، الذين قضَوا بالحقِّ وبِه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، ذوي الشَّرف الجلِيِّ والقَدرِ العلِيِّ، وارضَ اللهم عن الصحابةِ أجمعين، وعن الطاهرات أمهات المُؤمنين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معَهم برحمتِك يا أرحمَ الراحِمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلِك كلمةَ الحقِّ والدين يا رب العالمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتنا ووُلاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين، اللهم وفِّقه لِما تُحبُّ وتَرضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لكل خيرٍ، اللهم وفِّقه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد.
اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمور المُسلمين للعمل بكِتابِك، واتِّباع سُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -، اللهم اجعَلهم رحمةً على عبادِك المُؤمنين.
اللهم أنقِذِ المسجدَ الأقصَى، اللهم أنقِذِ المسجدَ الأقصَى، اللهم أنقِذِ المسجدَ الأقصَى مِن عُدوان المُعتَدين، ومِن الحاقِدين الغاشِمين يا رب العالمين.
يا حيُّ يا قيُّوم، يا ذا الجلال والإكرام نسألُك أن تحقِنَ دماءَ المُسلمين في كل مكان، وأن تُصلِحَ أحوالَهم، وأن تجمعَ كلمتَهم على الكتاب والسنَّة يا ذا العطاء والفضل والمِنَّة.
اللهم إنا نسألُك مِن الخير كلِّه عاجِلِه وآجلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه عاجِلِه وآجلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم اغفِر للمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، وألِّف بين قلوبِهم، وأصلِح ذاتَ بينهم، واهدِهم سُبُل السلام، وجنِّبهم الفواحِشَ والفتَن ما ظهرَ منها وما بطَن.
يا حيُّ يا قيُّوم برحمتِك نستغيث، فلا تكِلنا إلى أنفسِنا طرفةَ عينٍ، وأصلِح لنا شأنَنا كلَّه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم انصُر جُنودَنا، واحفَظ حُدودَنا، اللهم وفِّق رِجالَ أمنِنا، اللهم سدِّد رميَهم ورأيَهم يا ذا الجلال والإكرام، عافِ جَرحَاهم، واشفِ مرضاهم، ورُدَّهم سالِمين غانِمين منصُورين مُظفَّرين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم احفَظنا واحفَظ بلادَنا وبلادَ المُسلمين مِن شرِّ الأشرار، وكَيدِ الفُجَّار، وشرِّ طوارِقِ الليل والنَّهار، ورُدَّ عنَّا كيدَ الكائِدِين، وحِقدَ الحاقِدين، ومكرَ الماكِرين، وحسَدَ الحاسِدين، وعُدوانَ المُعتَدين.
حسبُنا الله ونِعمَ الوكيل، حسبُنا الله ونِعمَ الوكيل على مَن آذانا وآذَى المُسلمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
اللهم أنت اللهُ لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا.
اللهم إنَّا نستغفِرُك إنَّك كنتَ غفَّارًا، فأرسِلِ السماءَ علينا مِدرارًا، اللهم إنا خلقٌ مِن خلقِك، فلا تمنَع عنَّا بذنوبِنا فضلَك.
نستغفِرُ اللهَ، نستغفِرُ اللهَ، نستغفِرُ اللهَ الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ ونتُوبُ إليه.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنَّك أنت التواب الرحيم، واغفِر لنا ولوالِدِينا ووالِدِيهم وجميعِ المُسلمين والمُسلِمات الأحياء مِنهم والأموات، إنَّك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعَوات.
خطب الحرمين الشريفين

وقفاتٌ مع آية الكُرسيِّ
ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "وقفاتٌ مع آية الكُرسيِّ"، والتي تحدَّث فيها عن أعظمِ آيةٍ في كتابِ الله تعالى "آية الكُرسيِّ"، مُبيِّنًا فضلَها وما تتضمَّنُه مِن فوائِد وتنبيهاتٍ، وعِبَر وعِظاتٍ.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الحيِّ القيُّوم، أحمدُه - سبحانه - لا تأخُذه سِنةٌ ولا نَوم، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له العليُّ العظيم، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه دلَّنا على صِراطِ الله المُستقيم، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه السَّائِرين على النَّهج القَويم.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا المُنذِر! أتدرِي أيُّ آيةٍ مِن كتابِ الله معك أعظَم؟»، قال: قُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلَم، قال: «يا أبا المُنذِر! أتدرِي أيُّ آيةٍ مِن كتابِ الله معك أعظَم؟»، قال: قُلتُ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، قال: فضَرَبَ في صَدرِي وقال: «واللهِ ليَهنِكَ العلمُ أبا المُنذِر».
آيةُ الكُرسيِّ أعظمُ آيةٍ؛ لأنَّها جمَعَت أصولَ الأسماء والصِّفات، وبيَّنَت قُدرةَ الله العظيمة: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمانُ بِضعٌ وسبعُون أو بِضعٌ وسِتُّون شُعبَة، فأفضلُها قَولُ: لا إله إلا الله».
فهو - سبحانه - الحقُّ، قَولُه الحقُّ، ووعدُه الحقُّ، ودينُه حقٌّ، وكِتابُه حقٌّ، وما أخبَرَ عنه حقٌّ، وما أمَرَ به حقٌّ.
الحقُّ في ذاتِهِ وصِفاتِه كامِلُ الصِّفات والنُّعُوت، فهو الذي لم يزَل ولا يزالُ بالجلال والجمال والكمال موصُوفًا، ولم يزَل ولا يزالُ بالإحسان معرُوفًا.
﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾: فهو الحيُّ الذي لا يمُوت ولا يَبِيدُ، له الحياةُ الدائِمةُ، والبقاءُ الذي لا أولَ له يُحدُّ، ولا آخر له يُؤمَّد.
والقيُّوم مُتضمِّنٌ كمالَ غِناه، وكمالَ قُدرتِه؛ فإنَّه القائِمُ بنفسِه، وهو المُقيمُ لغيرِه، فلا قِيامَ لغيرِه إلا بإقامتِه، فانتظَمَ هذان الاسمَان صِفات الكمال، فكأنَّ المُستغيثَ بهما مُستغِيثٌ بكل اسمٍ مِن أسماء الربِّ تعالى، وبكل صِفةٍ مِن صِفاتِه.
كان - صلى الله عليه وسلم - كثيرَ الدعاءِ بهما، وإذا كرَبَه أمرٌ قال: «يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتِك أستَغيثُ».
وإذا تدبَّرَ المُسلمُ، وأدرَكَ أنَّ ربَّه هو الحيُّ القيُّوم اطمأنَّ قلبُه وسكَن، فقد كُفِيَ همَّ التدبير، ووُقِيَ الشُّرور والآثام.
﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ فهو - جلَّ في عُلاه - مُنزَّهٌ عن كل نقصٍ وعجزٍ وعيبٍ مما في عبادِه، يشهَدُ بذلك انتِظامُ الكَون، وسَيرُورة الحياة، ومعاشُ الخلائِق.
﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ وإلا اضطرَبَ هذا الكَون، وفسَدَ سيرُه، واختلَّ نِظامُه، ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: 40]، ولا البِحارُ تفِيضُ مياهُها والأنهار.
وعندما تهدَأُ العيُون، وتغارُ النُّجُوم، فإنَّ أُناسًا مِن المُؤمنين تتجافَى جُنوبُهم عن المضاجِع، يُناجُون مَن لا تأخُذُه سِنةٌ ولا نوم، فيستجِيبُ لهم.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ينزِلُ ربُّنا - جلَّ وعلا - كلَّ ليلةٍ إلى سماءِ الدُّنيا حين يبقَى ثُلُثُ الليل الآخر فيقول: مَن يدعُوني فأستجِيبَ له؟ مَن يسألأُني فأُعطِيَه؟».
﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كلُّ شيءٍ فيهما تحت مُلكِه وقُدرته وتقديرِه، وفضلِه وتفضيلِه، وحُكمِه وحِكمتِه، أفلاكٌ وعوالِمُ عظيمة هو الخالِقُ لها، ومالِكُها، وإلهُها، لا إله سِواه ولا ربَّ غيرُه.
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسعَدُ الناسِ بشَفاعَتي يوم القِيامة مَن قال: لا إله إلا الله خالِصًا مِن قلبِه أو نفسِه».
﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ فهو - سبحانه - السميعُ البصيرُ، العليمُ الخبيرُ، يرَى دَبيبَ النَّملة السوداء على الصَّخرة الصمَّاء، في الليلة الظَّلماء، ويرَى نِياطَ عُروقِها، ومجارِيَ القُوت في أعضائِها، قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59].
فلا يُحيطُ بعلمِه ملَكٌ مُقرَّب، ولا نبيٌّ مُرسَل، فكيف يُحيطُ به العرَّافُون والكَهَنة الذين يدَّعُون معرفةَ المُستقبل؟! قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65].
﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ما أعظمَ الله! الإلهَ الكبيرَ المُتعال، جلَّت قُدرتُه - سبحانه -، هو - سبحانه - الواسِعُ في علمِه، الواسِعُ في غِناه، الواسِعُ في فضلِه وإنعامِه وجُودِه، الواسِعُ في قوَّتِه وعظمتِه، الواسِعُ في قُدرتِه، الواسِعُ في حِكمتِه، وهو الواسِعُ في مغفرتِه ورحمتِه.
فالمُسلمُ يعبُدُ ربًّا عطاؤُه وسِعَ كلَّ شيءٍ، وفضلُه جاوَزَ كلَّ ما يتمنَّى.
أمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يسألَ الداعِي ربَّه ولا يستكثِرُ شيئًا عليه - سبحانه -، فقال: «إذا سألَ أحدُكم فليُكثِر؛ فإنَّما يسألُ ربَّه».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا سألتُمُ اللهَ فسَلُوه الفِردوسَ؛ فإنَّه أوسطُ الجنَّة، وأعلى الجنَّة، وفوقَه عرشُ الرحمن، ومِنه تفجَّرُ أنهارُ الجنَّة».
﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ كلُّ شيءٍ في الكَون في حِفظِ الله، فهو - سبحانه - الحافِظُ الحفيظُ، الذي يحفَظُ أعمالَ المُكلَّفين، وهو الحفيظُ لمَن يشاءُ مِن الشرِّ والأذَى والبلاء.
ومِنه الدُّعاء الذي علَّمَنا إياه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم احفَظني مِن بي يدَيَّ، ومِن خلفِي، وعن يمينِي، وعن شِمالِي، ومِن فَوقِي، وأعوذُ بعظمَتِك أن أُغتالَ مِن تحتِي».
الله - سبحانه - هو الذ يحفَظُ الإنسانَ إن هو حفِظَ حُدودَ الله، واجتَنَبَ محارِمَه، قال الله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: 34].
آيةُ الكُرسيِّ غنيمةٌ للمُسلمين، ونِعمةٌ مِن أعظم نِعَم الله تعالى عليهم؛ فهي مِن آكَدِ أذكارِ الصباح والمساء التي يتحقَّقُ بها حِفظُ الله.
وفيها قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قرأَ آيةَ الكُرسيِّ في دُبُر كل صلاةٍ، لم يحُل بينَه وبين دخُول الجنَّة إلا المَوت».
وإذا قرأتَها عند النوم، لن يزالَ عليك مِن الله حافِظ، ولا يقرَبُك شيطانٌ حتى تُصبِح.
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفَى، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له العليُّ الأعلى، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه المُصطفَى، ونبيُّه المُجتبَى، ورسولُه المُرتضَى، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه ومَن اقتَفَى.
أما بعد:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله.
حين يكثُر الكلامُ، ويمتلِئُ الفضاءُ بالقِيل والقال، فإنَّ الواجِبَ على المُسلم أن يَزِنَ ما يُبصِرُ وما يسمعُ وما يُقالُ بمِيزانِ الشرع والعقل، فإذا وجَدتَ الكلمةَ تُطفِئُ فتنةً، وتبعَثُ أملًا، وتحفَظُ أمنًا، وتُعزِّزُ اطمِئنانًا، وتَئِدُ بلبلةً، وتسُدُّ بابَ فتنةٍ، وتُغلِّبُ مصلَحةَ الوطن، وتُقوِّي لُحمةَ الأمة، وتحفَظُ لوُلاةِ الأمر حُقوقَهم، فتلك كلمةٌ طيبةٌ.
وإذا كانت الكلمةُ تُؤجِّجُ فتنةً، وتُخِلُّ بالأمن، وتُثيرُ بلبلةً، وتهُزُّ الثِّقةَ بوُلاة الأمر، وتخدِشُ مقامَ العُلماء، وتُصدِّعُ البِناء، وضدَّ مصالِح البناء، فتلك كلمةٌ خبيثةٌ، وأدُها في مهدِها أَولَى، وهَجرُها هو المسلَكُ الأسمَى.
والمملكةُ العربيةُ السعوديةُ قويَّةُ البُنيان، راسِخةٌ في الوجدان، النَّيلُ مِن شُموخِها ذُلٌّ، ومَن عاداها هُزِمَ وذَلَّ، والعملُ على حفظِ أمنِها وأمنِ الحرمَين وصدِّ السِّهام المُغرِضة، وتعزيزِ وحدتِها واجِبٌ شرعيٌّ، ومطلَبُ العُلماء، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 3، 4].
ألا وصلُّوا - عباد الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصَّحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا أرحمَ الراحِمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ الإسلام والمُسلمين بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعملٍ، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها مِن قولٍ وعملٍ.
اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا مِن كل شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك الهُدى والتُّقَى والعفافَ والغِنَى.
اللهم إنا نسألك فواتِحَ الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخرَه، ونسألُك الدرجات العُلى مِن الجنَّة يا رب العالمين.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن زوال نعمتِك، وتحوُّ عافيتِك، وفُجاءة نِقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم ابسُط علينا مِن بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورِزقِك.
اللهم أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلنا إلى أنفسِنا ولا إلى أحدٍ مِن خلقِك طرفةَ عين.
اللهم إنا نسألُك حُسنَ الخِتام، والعفوَ عما سلَفَ وكان.
اللهم اغفِر لنا ولوالِدِينا ولجميعِ المُسلمين، اللهم ارحَم موتانا، واشفِ مرضانا، وتولَّ أمرَنا يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك يا الله أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هدمٍ، ولا غرَقٍ.
اللهم تُحيِي به البلاد، وتُغيثُ به العباد، وتجعلُه بلاغًا للحاضِر والباد برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين ووليَّ عهدِه لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقهما لهُداك، واجعَل عملَهما في رِضاك يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

وجوب التفكُّر والتأمُّل في آياتِ الله
الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي
ألقى فضيلة الشيخ ماهر
المعيقلي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "وجوب التفكُّر والتأمُّل في
آياتِ الله"، والتي تحدَّث فيها عن التفكُّر والتأمُّل في الكَون الفَسِيح
وفي عظمة الله تعالى وقُدرتِه، وعلمِه وحِكمتِه، وأنَّ هذا مِن أعظم العِبادات
التي يتقرَّبُ بها العبدُ إلى ربِّه - جلَّ وعلا -، كما بيَّن أنَّ
هذا كان مِن هَديِ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، وهَديِ سَلَفنا الصالِح
مِن الصحابة والتابِعين - رضي الله عنهم أجمعين -.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي خلقَ كلَّ شيءٍ فقدَّرَه تقديرًا، وجعلَ اللَّيلَ والنَّهارَ خِلفةً لمَن أرادَ أن يذَّكَّرَ أو أرادَ شُكُورًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه الله بين يدَي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعِيًا إلى الله بإذنِه وسِراجًا مُنيرًا، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، واعلَمُوا أنَّ أحسنَ الحديث كلامُ الله، وخيرَ الهَدي هَديُ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ بِدعة، وكلَّ بِدعةٍ ضلالة، وعليكم بجماعة المُسلمين؛ فإنَّ يدَ الله على الجماعة، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].
أمةَ الإسلام:
إنَّ التفكُّر والتدبُّر مِن العبادات العظيمة، والأعمال القلبيَّة الجليلة التي يغفُل عنها كثيرٌ مِن الناس. فالنظرُ في آيات الله المسطُورة في كتابِه، والمنثُورة في كَونِه، والتفكُّر في أسمائِه وصِفاتِه، وجمالِه وجلالِه، وعلمِه وقُدرتِه، وقوَّته وحِكمته، وفي حِلمِه - جلَّ جلالُه - على عبادِه، كلُّ هذا مما يزيدُ في إيمانِ العبدِ ويقينِه؛ فلذا كان تدبُّرُ كلام الله مِن أعظم مقاصِدِ إنزالِه، ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29].
وأعظمُ الناس هدايةً، وأسلَمُهم عاقِبةً في الدنيا والآخرة مَن طلبَ الهُدى في كتابِ الله، ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 15، 16].
فالمُؤمنُ - يا عباد الله - إذا تلَا كلامَ الله تأمَّلَه وتدبَّرَه، وعرَضَ عليه عملَه، فيرَى أوامرَه فيتَّبِعها، ونواهِيَه فيجتنِبَها، ويُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّمُ حرامَه، ويعملُ بمُحكَمه، ويُؤمِنُ بمُتشابِهِه، وما خوَّفَه به مولاه مِن عقابِه خافَه، وما رغَّبَ فيه مولاه رغِبَ فيه ورَجاه.
فمَن كانت هذه صِفتُه رُجِيَ أن يكون تلاه حقَّ تلاوتِه، وكان له القرآن شاهِدًا وشفيعًا، وحِرزًا وأَنيسًا، ونفَعَ نفسَه، وعادَ عليها بكلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة.
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "فليس شيءٌ أنفَعَ للعبد في معاشِه ومعادِه، وأقربَ إلى نَجاتِه مِن تدبُّر القرآن وإطالَة التأمُّل فيه، وجَمع الفِكر على معانِي آياتِه، فلا تزالُ معانِيه تُنهِضُ العبدَ إلى ربِّه بالوَعد الجَميل، وتُحذِّرُه وتُخوِّفُه مِن العذابِ الوَبِيل، وتحُثُّه على التضمُّرُ والتخفُّفُ للقاءِ اليوم الثَّقيل، وتَهدِيه في ظُلَم الآراء والمذاهِب إلى سواءِ السبيل". اهـ كلامُه - رحمه الله تعالى -.
معاشرَ المؤمنين:
إذا كان القُرآن هو كِتابُ الله المسطُور، فإنَّ الكَون كتابُه المنظُور، فكلُّ شيءٍ فيه خاضِعٌ لأمر فاطِرِه، مُنقادٌ لتدبيرِه، شاهِدٌ بوحدانيَّته وعظمَته وجلالِه، ناطِقٌ بآياتِ علمِه وحِكمتِه، دائِمُ التسبيحِ بحمدِه، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].
وكلما كان الإنسانُ أكثرَ تفكُّرًا، كان أكثرَ علمًا وخشيةً لله تعالى، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27، 28].
فلذا كان الأنبياءُ والرُّسُل أكثرَ الناس تفكُّرًا وتأمُّلًا في خلقِ الله؛ فهذا إبراهيمُ الخليلُ - عليه السلام -، يقولُ تعالى عنه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75].
وأما نبيُّنا - صلواتُ ربِّي وسلامُه عليه -، فكانت الخَلوةُ والتأمُّلُ والتفكُّرُ آخرَ المراحلِ له قبل بِعثتِه.
فعن عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - قالت في حديثِ بدء الوحي: "ثُمَّ حُبِّبَ إليه الخلاءُ، وكان يخلُو بغار حِراء فيتحنَّثُ فيه - وهو التعبُّدُ - الليالِي ذواتِ العدَد قبل أن ينزِعَ إلى أهلِه ويتزوَّدُ لذلك، ثم يرجِعُ إلى خديجة فيتزوَّدُ لمثلِها"؛ رواه البخاري ومسلم.
وظلَّ - صلى الله عليه وسلم - دائِمَ التفكُّر في آياتِ الله وآلائِه، حتى لحِقَ بالرفيقِ الأعلى.
فقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها وأرضاها -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذاتَ ليلة: «يا عائشة! ذَرِيني أتعبَّدُ الليلةَ لربِّي»، قُلتُ: "واللهِ إنِّي لأُحِبُّ قُربَك، وأُحِبُّ ما سرَّك". قالت: "فقام فتطهَّرَ ثم قامَ يُصلِّي ويبكِي".
وقال في حديثِه لعائشة: «لقد نزَلَت عليَّ الليلةَ آيةٌ وَيلٌ لمَن قرأَها ولم يتفكَّر فيها: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190]»؛ رواه ابن حبان في "صحيحه".
وكذلك كان حالُ الصحابة والتابِعين - رضي الله عنهم وأرضاهم -؛ فهذا ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - يقول: "ركعتَان مُقتصِدَتان في تفكُّر خيرٌ مِن قِيامِ ليلةٍ والقلبُ ساهِي".
ولما سُئِلَت الصحابيَّةُ الجليلةُ أمُّ الدَّرداء - رضي الله عنها وأرضاها -: ما كان أفضلُ عبادةِ أبي الدَّرداء؟ قالت: "التفكُّر والاعتِبار".
وقال الحسنُ البصريُّ - رحمه الله -: "تفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ مِن قِيامِ ليلةٍ".
معاشرَ المؤمنين:
لقد أمَرَنا الله - عزَّ وجل - في مواضِعَ كثيرةٍ مِن كتابِه بالنظر إلى السماوات والأرض، نادِبًا إلى الاعتِبار بها، ومُثرِّبًا على الغافِلِين عنها، فقال في سُورة يُونس: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]، وفي سُورة الأعراف: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185].
فلنتفكَّر - يا عباد الله - في عظمة هذا الكَون واتِّساعه، في السماوات وأفلاكِها، والنُّجوم ومواقِعِها، والجِبال الشاهِقة، والبحار الغائِرة، والصحارِي المُنقطِعة، فمَن تدبَّرَ ذلك علِمَ صِغَرَ حجمِه، وهوانَه وضعفَه، وقِلَّةَ حيلتِه، وكُسِرَ كِبرياؤُه، وتواضَعَت نفسُه، وصدَقَ الله تعالى إذ يقول: ﴿{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: 37].
وكذلك إذا تفكَّر الإنسانُ في حالِه وأصلِ خِلقتِه، وأنَّه لم يكُن شيئًا مذكُورًا، ثم مرَّ بأطوارٍ مُختلِفة، حتى استوَى خلقُه، وشقَّ الله فيه سمعَه وبصَرَه، علِمَ مقدارَ ضعفِه وعجزِه، وأيقَنَ بفقره إلى ربِّه، وفضلِه تعالى ومِنَّتِه عليه، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 12- 14].
فيا أيها الإنسان! ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 6- 8].
وإنَّ مِن التفكُّر المحمُود - يا عباد الله - التأمُّلَ والتدبُّرَ في حالِ الدنيا، وسُرعة زوالِها، وعِظَم فِتنتها، وتقلُّب أحداثِها، وتداوُل أيامِها، وألَم المُزاحَمة عليها، وما في ذلك مِن الغُصَص والأنكاد؛ فطالِبُها لا ينفَكُّ مِن همٍّ قبل حُصولِها، وهمٍّ في حالِ الظَّفَر بها، وحُزنٍ وغمٍّ بعد فواتِها، فمَن تأمَّل ذلك لم يتعلَّق قلبُه بها، ونظرَ إلى الآخرة وإقبالِها ودوامِها، وما فيها مِن شرف الخيرات والمسرَّات، واجتهَدَ في رِضوانِ ربِّه، وعلِمَ أنَّ ما عِنده خيرٌ وأبقَى.
﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: 24].
بارَك الله لي ولكم في القرآنِ والسنَّة، ونفعَني وإيَّاكُم بما فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه؛ إنَّه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله حمدَ الشاكرين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له إلهُ الأولين والآخرين، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وصحبهِ أجمعين.
أما بعدُ .. معاشر المؤمنين:
إنَّ المقصُود بالتفكُّر في مخلُوقات الله تعالى: التفكُّرُ والتأمُّلُ الذي يقُودُ صاحِبَه إلى الطاعة والتسليم، والانقِياد لربِّ العالمين، حتى قال أبو سُليمان الدَّاراني - رحمه الله تعالى -: "إنِّي لأخرُجُ مِن منزلِي، فما يقَعُ بصَرِي على شيءٍ إلا رأيتُ لله عليَّ فيه نعمة، ولِي فيه عِبرَة".
ويتَّضِحُ ذلك جلِيًّا في هَديِه - صلى الله عليه وسلم -؛ ففي "صحيح مسلم" عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، أنَّه باتَ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ ليلةٍ، فقامَ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن آخر الليل، فخرَجَ فنظَرَ في السماء، ثم تلا هذه الآيةَ في آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190، 191]، ثم رجَعَ - صلى الله عليه وسلم - إلى البيتِ، فتسوَّك وتوضَّأ، ثم قامَ فصلَّى ثم اضطجَع، ثم قامَ فخرَجَ فنظَرَ إلى السماء فتلا هذه الآيةَ، ثم رجَعَ فتسوَّكَ فتوضَّأ، ثم قام فصلَّى.
فجمَعَ - صلى الله عليه وسلم - بين التفكُّر في مخلُوقات الله تعالى والقِيام إلى الصلاة، فجمَعَ بين التأمُّل والعمل.
قال الإمامُ النوويُّ - رحمه الله تعالى -: "فِيه: أنَّه يُستحبُّ قِراءتُها عند الاستِيقاظِ في اللَّيل، مع النَّظَر إلى السماء؛ لِما في ذلك مِن عظيمِ التدبُّر، وإذا تكرَّر نومُه واستِيقاظُه وخُروجُه استُحِبَّ تكريرُه قِراءةَ هذه الآيات، كما ذُكِرَ في الحديثِ، والله - سبحانه وتعالى - أعلَم".
ثم اعلَمُوا - معاشِر المُؤمنين - أنَّ الله أمرَكم بأمرٍ كريمٍ، ابتدَأ فيه بنفسِه، فقال - عزَّ مِن قائِلٍ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وجُودِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، واحمِ حَوزةَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنَّا نسألُك بفضلِك ومِنَّتِك وجُودِك وكرمِك أن تحفظَ بلادَ المُسلمين مِن كل سُوءٍ ومكروهٍ، اللهم احفَظ بلادَ الحرمَين، اللهم احفَظ بلادَ الحرمَين، اللهم احفَظها بحفظِك، واكلأها برعايتِك وعنايتِك، اللهم أدِم أمنَها ورخاءَها واستِقرارَها برحمتِك وفضلِك وجُودِك يا رب العالمين، اللهم مَن أرادَ بلادَ الحرمَين بسُوءٍ فاجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه، اللهم مَن أرادَ بلادَ الحرمَين بسُوءٍ فاجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا قويُّ يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق خادمَ الحرمَين لِما تُحبُّ وترضَى، واجزه عن الإسلام والمسلمين خيرَ الجزاء، اللهم واجمَع به كلمةَ المُسلمين يا رب العالمين، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما فيه خيرٌ للبلاد والعباد، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لما تُحبُّه وترضَاه برحمتِك يا جوادُ يا كريمُ.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابطين على حُدودِ بلادِنا، اللهم أيِّدهم بتأييدك، واحفَظهم بحفظِك، وثبِّت أقدامَهم، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ورُدَّهم إلينا سالِمين غانمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتِك يا ذا الجلال والإكرام.
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10]، ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
سُبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفُون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

فضلُ الأذكار
الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضلُ الأذكار"، والتي تحدَّث فيها عن عُموم الفتَن وكثرة المِحَن في ديار المُسلمين، وأنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ لتذكير المُسلمين بفضل الأذكار للخروج مِن الكُرُوب والخُطُوب، ثم دارَ حديثُه في الخُطبة على فضلِ وأهميَّةِ قولِ "لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله" في تفريجِ الهُمُوم، وتنفيسِ الكُرُوب.
الخطبة الأولى
الحمدُ للهِ وليِّ المُتقين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له إلهُ الخلق أجمعين، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه أفضلُ الخلق وسيِّدُ الأنبياء والمُرسَلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه وأصحابهِ أجمعين.
أما بعد .. فيا أيها المُسلمون:
أُوصِيكم ونفسي بما أوصانا الله به - جلَّ وعلا - بقولِه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: 28].
في مثلِ هذا الزمن الذي عمَّت فيه الفتَن وكثُرت المِحَن، الحاجةُ ماسَّةٌ إلى تذكيرِ المُسلمين بالمخارِجِ اليقينيَّة مِن كلِّ الكُرُوب والخُطُوب، الأصلُ العظيمُ للخُروجِ مِن مصاعِبِ هذه الحياة الفانِية، والخلاصِ مِن هُمومِها يكمُنُ في تحقيقِ التقوَى لله - جلَّ وعلا - سِرًّا وجَهرًا، والانكِسار له في السرَّاء والضرَّاء.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2، 3]، وقال - سبحانه -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].
وإنَّ مِن صُور هذا الانكِسار والتضرُّع والاستِسلام لله - جلَّ وعلا -: ما أرشدَ إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جُملةً مِن أصحابِه، وأوصَاهم بلُزومِه قَلبًا وقالَبًا، قَولًا وفِعلًا، سُلُوكًا وحالًا.
فقد أرشَدَ أبا مُوسى - رضي الله عنه - بقولِه: «قُل: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله؛ فإنها كنزٌ من كُنوز الجنة»؛ رواه الشيخان.
قال أبو ذرٍّ - رضي الله عنه -: "أوصَانِي حِبِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أُكثِرَ مِن قَولِ: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله".
إنَّه ذِكرٌ يتيقَّنُ به العبدُ أنه لا تحوُّلَ له ولا لغيرِهِ مِن حالٍ إلا حالٍ يُحبُّها، ولا قُوَّةَ له على شأنٍ مِن شُؤونِه، أو تحقيقِ غايةٍ مِن غاياتِه إلا بتقوَى الله - جلَّ وعلا - المَتِين العليِّ العظيم.
ذِكرٌ يُظهِرُ به العبدُ فقرَه وذِلَّه الحقيقيَّ، وأنَّه في ضرورةٍ وافتِقارٍ إلى خالِقِه العزيزِ القهَّار.
ذِكرٌ يخرُجُ مِن لسانِ عبدٍ قَلبُه مُوحِّدٌ لربِّه عظيمِ الشأنِ، وجوارِحُه خاضِعةٌ لطاعةِ الرحمن الذي مِنه يُستَمِدُّ النصرَ والظَّفَرَ، والفرَجَ والمخرَجَ، قال - جلَّ وعلا -: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].
ذِكرٌ لله - جلَّ وعلا -، ومُلازمةٌ لطاعتِه، والذي بذلك يتحقَّقُ معه الفلاحُ والنجاحُ، والخلاصُ والمخرَجُ، كما قال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45].
ذِكرٌ ينبَغي لكلِّ مُسلمٍ أن يلهَجَ بلِسانِ المقالِ والحالِ، أن يلهَجَ به كثيرًا؛ إذ هو سِرُّ التوحيدِ الذي يقتَضِي الانكِسارَ للخالقِ، والانقِطاعَ إليه، والبراءةَ مِن الحَول والقوةِ إلا به - جلَّ وعلا -.
فأنت - أيها العبدُ الضعيفُ - لا حولَ ولا قُوَّةَ لك إلا بخالِقِك وربِّك.
يا عباد الله:
اسمَعوا لهذه القصَّة العظيمةِ التي هي بُرهانٌ ساطِعٌ على أنَّ قُوَّةَ التوحيدِ للخالِقِ تنحَلُّ بها الكُروبُ مهما عظُمَت، وتندَكُّ معها الخُطوبُ مهما اشتَدَّت، إنها قصةٌ ذكرَها كثيرٌ مِن المُفسِّرين وغيرِهم، جاءَت مِن أوجُهٍ أقلُّ أحوالِها الحُسن، وهي:
أنَّ عَوفَ بن مالكٍ الأشجعيَّ أسَرَ المُشرِكُون ابنًا له يُسمَّى "سالِمًا"، فأتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: يا رسولَ الله! إنَّ العدوَّ أسرَ ابنِي، وشَكَا إليه الفاقَةَ - أي: الفقرَ -، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمسَى عند آلِ مُحمدٍ إلا مُدٌّ، فاتَّقِ الله واصبِر، وأكثِر مِن قولِ: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله».
وفي رِوايةٍ: "أنه أمَرَه وأمَرَ أمَّ الولَدِ بذلك".
ففعلَا ما أوصَى به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فبَينما هو - أي: عوف - في بيتِه، إذ جاءَه ابنُه وقد غفَلَ عنه العدوُّ، فأصابَ إبِلًا، وأتَى بها إلى أبِيهِ - وكان فقِيرًا -، فأتَى أبوه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «اصنَع بها ما أحبَبتَ، وما كُنتَ صانِعًا بإبِلِك»، فأنزلَ الله - جلَّ وعلا -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ الآيات [الطلاق: 2].
إنَّها قصَّةٌ ينبغي أن تكون أمامَ أعيُننا في كل حالٍ؛ ولهذا كان سَلَفُنا على تلك الحالِ العظيمةِ:
روَى ابنُ أبي الدنيا أنَّ أبا عُبَيدة حُصِرَ مِن العدُوِّ، فكتَبَ إليه عُمرُ - رضي الله عنه - يقول: "مهما يَنزِلُ بامرِئٍ شدَّةٌ سيجعَلُ الله له بعدَها فَرَجًا، وإنه لن يغلِبَ عُسرٌ يُسرَين، وإنَّه يقول - جلَّ وعلا -: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200]".
إنَّها أخبارٌ ينبغي ألَّا نسمَعها لمُجرَّد السماع المُجرَّد، وإنَّما نقومُ بما قامَ به سلَفُنا مِن قُوَّة التعلُّق بالله - جلَّ وعلا -، إنه التعلُّقُ باللهِ - سبحانه -، والتوكُّلُ عليه، ولَهجُ القلُوبِ والألسُنِ بذِكرِه - عزَّ شأنُه -، مما يجعلُ الكُروبَ مهما اشتَدَّت وعظُمَت مآلُها إلى فرَجٍ ومخرَجٍ.
قال الفُضَيلُ - رحمه الله -: "والله لو يئِستَ مِن الخلقِ حتى لا تُريدُ منهم شيئًا، لأعطاكَ مولَاك كلَّ ما تُريد".
إنَّها قُوَّةُ التوحيد في القلبِ التي تجعلُ مِن الصِّعاب أمرًا سهلًا ويسيرًا.
معاشِرَ المُسلمين:
إنَّ مِن أسبابِ تفريجِ الكُروبِ وإزالة الهُموم: أنَّ الإنسانَ متى استبطَأَ الفرَجَ، وأيِسَ مِنه - بحُكم بشريَّته - بعد كثرةِ دُعائِه وتضرُّعه، ولم يظهَر عليه أثرُ الإجابة، فعليه أن يرجِعَ إلى نفسِه، وأن يُفتِّشَ في حالِه، فيرجِعَ إلى نفسِه باللائِمَةِ، حينئذٍ إذا كان صادقًا ومُخلِصًا يُحدِثُ لربِّه توبةً صادِقةً، وأَوبَةً مُخلِصةً، وانكِسارًا لمولَاه - تبارك وتعالى -.
فيا أيها المُسلمون:
حافِظُوا على مثلِ هذا الذِّكرِ العظيمِ في كل وقتٍ وحينٍ؛ فخيراتُ الذِّكر مُتنوِّعة، وأفضالُه مُتعدِّدة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسُبحان الله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله إلا كُفِّرَت خطايَاه ولو كانت أكثرَ مِن زبَدِ البحر»؛ وهو حديثٌ حسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه الحاكم، ووافقَه الذهبيُّ، وهو في "مُسند الإمام أحمد".
وعن عُبادة بن الصامِتِ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تعارَّ مِن الليلِ - أي: استيقَظَ - فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قدير، الحمدُ لله، وسُبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفِر لي، أو دعَا استُجِيبَ له، فإن توضَّأَ وصلَّى قُبِلَت صلاتُه»؛ رواه البخاري.
معشَر المُسلمين:
إنَّ قولَ: "لا حولَ ولا قُوَّة إلا بالله" دُعاءٌ توحيديٌّ عظيمٌ، يتضمَّنُ السلامةَ والحفظَ مِن الربِّ العظيم لعبادِه.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قال - يعني: إذا خرجَ مِن بيتِه -: بِسم الله، توكَّلتُ على الله، لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله، يُقال له: كُفِيتَ ووُقِيتَ وهُدِيتَ، وتنحَّى عنه الشيطان».
ذلكم أنه ذِكرٌ لله - جلَّ وعلا - يقتَضِي الاستِسلامَ له - سبحانه -، وتفويضَ الأمورِ إليه، والاعتِرافَ بالانكِسار إليه - سبحانه -، وأنَّه لا رادَّ لأمرِه، وأنَّ العبدَ لا يملِكُ شيئًا مِن الأمر؛ فأزِمَّةُ الأمور بيَدِ الله - سبحانه -، وأمورُ الخلائِقِ معقُودةٌ بقضائِه وقَدَره، ولا رادَّ لقضائِه، ولا مُعقِّبَ لحُكمه.
فكُن - أيها المُسلم - في مثلِ هذه الحياةِ التي تعُثُّ بالفساد، كُن فيها - أيها المُسلم - مُطمئِنَّ القلبِ بإيمانِك بربِّك، مُرتاحَ البالِ بطاعةِ مولاك، مُستيقِنًا بالفرَجِ والمخرَج بمشيئةِ خالِقِك؛ فكُلُّ ما في الكَون خاضِعٌ لأمرِ الله - سبحانه -، جميعُ ما في هذا العالَم مهما عظُمَت قوَّتُها، وتناهَت شِدَّتُها فهي خاضِعةٌ لقُوَّةِ الله وأمرِه، وقضائِه وقدَرِه، فكلُّ قويٍّ ضعيفٌ في جَنبِ الله - جلَّ وعلا -.
فأشغِل نفسَك - أيها العبد - بسائِرِ الطاعات لله - جلَّ وعلا -، وأنواعِ الخيرات التي تُقرِّبُك إلى مولاك، والزَم ذِكرَ الله العظيم بأصنافِ الأذكار المُتنوِّعة في السرَّاء والضرَّاء، في الشدَّة والرَّخاء.
ففيما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن سرَّه أن يَستَجِيبَ اللهُ له عند الشدائِدِ والكُرَب، فليُكثِر الدعاءَ في الرَّخاء».
فما طابَت الدنيا إلا بذِكرِ الله - سبحانه -، ولا طابَت الآخرةُ إلا بعفوِه - جلَّ وعلا -.
والله المُستعان، وعليه التُّكلان، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، وسُبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا ورسولِنا مُحمدٍ، وعلى آله وأصحابِه أجمعين.
أيها المسلمون:
المُؤمنُ المُوحِّدُ الحافِظُ لحُدودِ الله - جلَّ وعلا -، المُلتَزِمُ بطاعتِه وطاعةِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، صادِقًا مُخلِصًا، فإنَّه مخصُوصٌ بمعيَّةِ الله الخاصَّة التي قال الله عنها: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128].
هذه الآية نُردِّدُها كثيرًا، ولنعلَم أنَّها لا تكون إلا مَن كان مُطيعًا لله - جلَّ وعلا - في السرَّاء والضرَّاء، في الشدَّة والرَّخاء.
إنَّها معيَّةٌ يعتمِدُ المُسلمُ عليها في تحمُّل الأثقال، وتكابُد الأحوال، بها ينالُ النَّصرَ والتأييدَ في جميعِ الأحوال. فمَن يكُن اللهُ معه فمعَه الفِئةُ التي لا تُغلَب، والحارِسُ الذي لا ينامُ، والهادِي الذي لا يضِلُّ.
رزَقَنا الله وإياكم معيَّتَه ونصرَه وتأييدَه وحِفظَه، إنَّه على كل شيءٍ قدير.
ثم إنَّ الله - جلَّ وعلا - أمرَنا بما تزكُو به أحوالُنا، وهو الإكثارُ مِن الصلاةِ والسلامِ على نبيِّنا.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبِيبِنا ونبيِّنا ورسولِنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابِعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم أصلِح أحوالَنا وأحوالَ المُسلمين، اللهم أصلِح أحوالَنا بتقوَاك، اللهم أصلِح أحوالَنا بسُنَّة نبيِّنا مُحمدٍ - عليه الصلاة والسلام -.
اللهم كُن للمُسلمين مُعينًا وحافِظًا، اللهم كُن للمُسلمين ناصِرًا ومُؤيِّدًا، اللهم فرِّج هُمومَهم، اللهم نفِّس كُرُباتهم، اللهم اكبِت أعداءَهم، اللهم اكبِت أعداءَهم.
اللهم مَن أرادَ المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، اللهم مَن أرادَ المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعَل كيدَه في نَحرِه، اللهم امكُر بمَن مكَرَ بالمُسلمين يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادمَ الحرمين الشريفَين لما تحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّق وليَّ عهدِه لِما تُحبُّه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفِر للمُؤمنين والمُؤمنات، والمُسلمين والمُسلمات.
اللهم زكِّ نفُوسَنا بتقواك، اللهم زكِّ قُلوبَنا بتوحيدِك، اللهم زكِّ قُلوبَنا بتوحيدِك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار.
اللهم احفَظ بلادَنا وبلادَ المُسلمين مِن كل سُوءٍ ومكرُوهٍ، اللهم احفَظ بلادَنا وبلادَ المُسلمين مِن كل سُوءٍ ومكرُوهٍ.
اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لِما فيه خِدمةُ رعاياهم لِما يُصلِحُ دينَهم ودُنياهم يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم يا غنيُّ يا حميد، يا غنيُّ يا حميد، يا غنيُّ يا حميد، أنت الغنيُّ الكريمُ، أنت الغنيُّ الكريمُ، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم اسقِنا سُقيا رحمةٍ، اللهم اسقِنا سُقيا رحمةٍ، اللهم اسقِنا سُقيا رحمةٍ، اللهم اسقِ قُلوبَنا بالتوحيدِ والإيمانِ، اللهم اسقِ أرضَنا بالماء النافِعِ يا ذا الجلال والإكرام.
عباد الله:
اذكُروا الله ذِكرًا كثيرًا، وسبِّحُوه بُكرةً وأصيلًا.
خطب الحرمين الشريفين

من أسباب انشِراح الصدر
الشيخ د. عبد المحسن بن محمد القاسم
ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "من أسباب انشِراح الصدر"، والتي تحدَّث فيها عن السَّبيل والطريقِ المُوصِلة لانشِراح الصدور، وطُمأنينة القلوب، مُبيِّنًا الأسبابَ الجالِبة لذلك.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقوا الله - عباد الله - حقَّ التقوَى؛ فبِها تُستجلَبُ النِّعَم، وتُستدفَعُ النِّقَم.
أيُّها المسلمون:
الدُّنيا دارُ بلاءٍ وامتِحانٍ، طُبِعَت على كَدَرٍ ونصَبٍ، يُكابِدُ الإنسانُ فيها المتاعِبَ والمشاقَّ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: 4].
وحياةُ المرء في الدنيا قصِيرةٌ وليس له مِن عُمره إلا ما طابَ، وراحةُ القلبِ وزوالُ الهمِّ والغمِّ مطلَبُ كلِّ إنسانٍ، وبذلك تحصُلُ الحياةُ الطيبةُ والعيشُ الهنِيُّ، والخلقُ كلُّهم ينشُدُون السعادةَ ويسعَون إلى تحصيلِها.
وأصلُ السعادة انشِراحُ الصدر، وطُمأنينةُ القلب، وإذا أرادَ الله بعبدٍ خيرًا شرَحَ صدرَه، وذلك مِن أعظم أسبابِ الهُدى وأجَلِّ النِّعَم.
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "شَرحُ الصدر كما أنَّه سببُ الهداية، فهو أصلُ كلِّ نعمةٍ، وأساسُ كلِّ خيرٍ".
ولعظيمِ قَدرِ هذه النِّعمة سألَ مُوسَى ربَّه أن يمُنَّ عليه بها أولَ ما أرسلَه إلى فرعون، فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه: 25].
وابتدأَ - سبحانه - تعدادَ نعمِه على نبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: 1].
وإذا عظُمَ الشيءُ تعدَّدَت أسبابُه، وكان تحصِيلُه أيسَر، وأتمُّ الأسبابِ وأكمَلُها ما دلَّ عليه الشرعُ وأرشَدَ إليه، ولا أعظمَ في تحقيقِ انشِراحِ الصدُور مِن العلمِ بالله وأسمائِه وصِفاتِه وتوحيدِه - سبحانه - بالعبادة، وعلى حسب كمالِ ذلك وقوَّتِه يكونُ انشِراحُ صدرِ صاحبِه وانفِساحُه.
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "قال بعضُ أهل العلم: فكَّرتُ فيما يسعَى فيه العُقلاء، فرأَيتُ سعيَهم كلَّه في مطلُوبٍ واحدٍ - وإن اختلَفَت طُرُقهم في تحصِيلِه -، رأيتُهم جميعًا إنَّما يسعَون في دفعِ الهمِّ والغمِّ عن نفوسِهم، ولكنَّ الطُّرُق كلُّها غيرُ مُوصِلةٍ إليه، بل ولعلَّ أكثَرَها إنَّما يُوصِلُ إلى ضدِّه، ولم أرَ في جميعِ هذه الطُّرُق طريقًا مُوصِلةً إلا الإقبالَ على الله، ومُعاملتَه وحدَه، وإيثارَ مرضاتِه على كلِّ شيء؛ فليسَ للعبدِ أنفَعُ مِن هذه الطريقِ ولا أوصَلَ مِنها إلى لذَّته وبهجَته وسعادتِه".
وأكمَلُ الخلقِ في كلِّ صِفةٍ يحصُلُ بها اتِّساعُ القلبِ: نبيُّنا مُحمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وأكمَلُ الخلق مُتابعةً له أكمَلُهم انشِراحًا ولذَّة ونعيمًا، ورأسُ الأسبابِ الجالِبة لانشِراح الصدرِ: الإيمانُ والعملُ الصالِحُ؛ فبِهما صلاحُ القلب والجوارِح، واستِقامة الباطِن والظاهِر، وبذلك الحياةُ الطيبةُ، والسعادةُ الدائِمة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97].
وأشرَحُ شيءٍ لصدر العبدِ محبَّتُه - سبحانه -، والإنابةُ إليه، والتنعُّمُ بعبادتِه.
قال شيخُ الإسلام - رحمه الله -: "إذا لم تجِد للعملِ حلاوةً في قلبِك، وانشِراحًا فاتَّهِمه؛ فإنَّ الربَّ تعالى شَكُور".
واختِيارُ الله للعبدِ خيرٌ مِن اختِيارِه لنفسِه، وهو - سبحانه - أرحَمُ بالخلقِ مِن أنفُسِهم، ومَن آمَنَ بالقَدَر خيرِه وشرِّه سكَنَ قلبُه، وانشَرَحَ صدرُه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11].
قال علقمةُ - رحمه الله -: "هو الرجُلُ تُصيبُه المُصيبةُ فيعلَمُ أنَّها مِن عندِ الله، فيرضَى ويُسلِّم".
والعبادُ يتقلَّبُون في حياتِهم بين السرَّاء والضرَّاء، ولا انفِكاكَ لأحدٍ عن ذلك بحالٍ، والسعادةُ في الإيمانِ بالقضاءِ، والشُّكر حالَ السرَّاء، والصبرِ على الضرَّاء.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «عجَبًا لأمرِ المُؤمن، إنَّ أمرَه كلَّه له خيرٌ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمُؤمن، إن أصابَتْه سرَّاءُ شكَرَ، فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضرَّاءُ صبَرَ، فكان خيرًا له»؛ رواه مسلم.
ومَن آمَنَ بلِقاءِ الله وثوابِه تعلَّقَت نفسُه بالفاضِلِ عن المفضُول، وتسلَّى بالموعُود عن المفقُود، وبهذا تصلُحُ له دُنياه وآخرتُه.
وحُسنُ الظنِّ بالله تعالى عبادةٌ تُورِثُ صاحبَها أمنًا وسعادةً، وللعبدِ مِن ربِّه ما ظنَّه فيه؛ إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرُّ.
قال تعالى في الحديث القُدسيِّ: «أنا عند ظنِّ عبدِي بِي»؛ متفق عليه.
والفألُ الحسنُ يشرَحُ الصدرَ، وهو مِن حُسن الظنِّ بالله.
ومقالِيدُ الأمور وأزِمَّتُها بيدِ الله وحدَه، يُقلِّبُ القلوبَ كيف يشاءُ فسادًا وصلاحًا، وضِيقًا وانشِراحًا، وسعادةً وشقاءً، والتوكُّلُ على مَن بيدِه ذلك، وتفويضُ الأمور إليه، والثِّقةُ به واجِبٌ شرعيٌّ، وهو جنَّةٌ لأهلِه حاضِرة.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3].
وأرزاقُ العبادِ بيدِ الله، ولن تموتَ نفسٌ حتى تستكمِلَ رِزقَها. فطِب نفسًا بما قسَمَ الله لك، ولا تحزَن على ما فاتَك مِنه.
ومَن لجأَ إلى الله أعانَه وكفاه، قال - سبحانه -: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: 173، 174].
ومَن طمِعَ في السعادة، وابتغَى انشِراحَ الصدر فليُكثِر قَرعَ بابِ الكريم؛ فإنَّ الله قريبٌ ممَّن دعاه، ولا يُخيِّبُ مَن رَجاه، فبالدُّعاء صلاحُ أمورِ الدنيا والآخرة.
ومِن دُعاء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم أصلِح لِي دِينِي الذي هو عِصمةُ أمرِي، وأصلِح لِي دُنيايَ التي فيها معاشِي، وأصلِح لِي آخرتِي التي إليها معادِي، واجعَل الحياةَ زيادةً لِي في كلِّ خير، واجعَل الموتَ راحةً لِي مِن كلِّ شرٍّ»؛ رواه مسلم.
وللذِّكرِ تأثِيرٌ عجيبٌ في انشِراحِ الصدُور، واطمِئنانِ القلوبِ، وزوالِ الهُموم والغُموم، قال - سبحانه -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
وكان - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عند الكَربِ: «لا إله إلا الله العظيمُ الحليم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُّ العرش الكريم»؛ رواه البخاري.
والقُرآنُ العظيمُ كلامُ الله فيه الهُدى والشِّفاء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 57].
وأَولَى الخلق بالسَّعادة مَن تلا القُرآنَ وعمِلَ بما فيه، قال - سبحانه -: ﴿طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: 1، 2].
وفي التسبيحِ والتحميدِ وكثرةِ السُّجُودِ ودوامِ الطاعةِ سعَةُ الصدر، وذَهابُ الهمِّ والضِّيق، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 97- 99].
وبلُزومِ التقوَى انفِراجُ الهُموم، وانكِشافُ الكُرُوب، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].
وبها تتيسَّرُ الأمور، قال - سبحانه -: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].
والصلاةُ نورٌ لصاحِبِها، وعَونٌ على انشِراحِ النَّفسِ وذَهابِ أحزانِها، قال - عزَّ وجل -: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45].
وكان مِن هَديِه - عليه الصلاة والسلام - إذا حزَبَه أمرٌ فزِعَ إلى الصلاةِ؛ رواه أبو داود.
وإذا استفتَحَ العبدُ يومَه بالصلاةِ، صلَحَ له سائِرُ نهارِه؛ فمَن صلَّى الفجرَ فهو في ذِمَّة الله، ومَن صلَّاها مع سُنَّتها كفَاه الله آخرَ يومِه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ اللهَ يقولُ: يا ابنَ آدم! لا تعجِز عن أربعِ ركعاتٍ مِن أولِ النَّهار، أكفِك آخِرَه»؛ رواه أحمد.
والعلمُ المورُوثُ عن الله ورسولِه المُقترِنُ بالعمل يشرَحُ الصدور، وأهلُه أشرَحُ الناس صدُورًا، وأوسَعُهم قلوبًا، وأطيَبُهم عيشًا، وأحسَنُهم أخلاقًا، وكلَّما اتَّسَعَ علمُ العبد ازدادَ انشِراحًا في صَدرِه، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 122].
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله - عن شيخِ الإسلام: "ما رأيتُ أحدًا أطيَبَ عيشًا مِنه قطُّ، مع كلِّ ما كان فيه مِن ضِيقِ العيش وخِلافِ الرَّفاهِية والنَّعيم بل ضِدُّها، وهو مع ذلك مِن أطيَبِ الناسِ عيشًا، وأشرَحِهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسَرِّهم نفسًا، تَلُوحُ نَضرةُ النَّعيم على وجهِه".
والإحسانُ إلى الخلق خيرٌ، ولا يأتِي إلا بخيرٍ، فلا ترَى الكريمَ المُحسِنَ إلا أشرَحَ الناسِ صدرًا، وأطيَبَهم نفسًا، وأنعَمَهم قلبًا.
وقد ضرَبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثَلًا في انشِراحِ صدرِ المُؤمن المُتصدِّق وانفِساحِ قلبِه، ومثَلًا لضِيقِ صدرِ البَخيلِ وانحِصارِ قلبِه، فقال: «مثَلُ البَخِيل والمُتصدِّقِ كمَثَل رجُلَين عليهما جُنَّتان مِن حديدٍ، قد اضطُرَّت أيدِيهما إلى ثُدَيِّهما وتراقِيهما، فجعلَ المُتصدِّقُ كلَّما تصدَّقَ بصدقةٍ انبسَطَت عنه، حتى تُغشِّيَ أنامِلَه وتعفُو أثَرَه، وجعلَ البخِيلَ كلَّما همَّ بصدقةٍ قلَصَت، وأخَذَت كلُّ حلقةٍ مكانَها»؛ رواه مسلم.
ومَن عاملَ الناسَ لأجلِ الله استراحَ، فلا يتطلَّعُ لمدحٍ، ولا ينحسِرُ مِن قدحٍ، حالُه كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9].
ويتأكَّدُ هذا في مُعاملة الأقرَبين ومَن قوِيَ الاتِّصالُ بهم. وقد ترَى مِن البشَر ما تكرَه، والعاقِلُ لا يبخَسُ محاسِنَهم لنقصٍ بدَرَ منهم، ولا يقطَعُ وصلَهم لتقصيرٍ أو قُصورٍ فيهم، وبذلك يعيشُ المرءُ هادِئَ البال، مُطمئنًّا على كلِّ حالٍ.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا يَفرَك مُؤمنٌ مُؤمنةً - أي: لا يُبغِضُها -، إن كرِهَ مِنها خُلُقًا رضِيَ مِنها آخر»؛ رواه مسلم.
وفي مُجالسَة الصالِحين وأهلِ العلمِ والدينِ أُنسٌ وسعادةٌ، وبها يكسَبُ المرءُ علمًا وحكمةً، وتزكُو نفسُه، وينبُلُ بين أقرانِه.
ومَن رجَعَ في أمورِه إلى أهلِ المَشُورة والعقل انشَرَحَ صدرُه، وزالَ عنه اللَّبسُ والتردُّد، قال - عزَّ وجل -: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وعداوةُ الشيطان للإنسان لا تنقطِع، وفي الاستِعاذة طردٌ لوساوسِه التي تُكدِّرُ صفوَ كثيرٍ مِن الخلق، والإسلامُ يسعَى لأسبابِ شَرحِ صدر المُسلم مِن حِينِ استِيقاظِه، والشيطانُ يسعَى لضِدِّ ذلك.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ الشَّيطانَ يعقِدُ على قافِيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نامَ ثلاثَ عُقَدٍ، يضرِبُ كلَّ عُقدةٍ: عليك ليلٌ طويلٌ فارقُد، فإن استيقَظَ فذكَرَ اللهَ انحلَّت عُقدةٌ، فإن توضَّأَ انحلَّت عُقدةٌ، فإن صلَّى انحلَّت عُقدةٌ، فأصبَحَ نشيطًا طيِّبَ النَّفس، وإلا أصبَحَ خبيثَ النَّفس كسلان»؛ متفق عليه.
وقوَّةُ المُؤمن مصدَرٌ عظيمٌ لانشِراحِ صدرِه، فلا ينساقُ مع الأوهام، ولا يستسلِمُ للأحزان، ولا يضعُفُ أمامَ المكارِهِ، بل ثابِتُ القلب، واثِقٌ بأنَّ مع العُسر يُسرًا.
وإذا استحضَرَ العبدُ فضلَ الله ونِعمتَه عليه، أوجَبَ ذلك له إحداثُ شُكرٍ تطمئنُّ به النَّفسُ، وينشرِحُ الصَّدرُ.
والقناعةُ رأسُ الغِنَى، ومِن أنفَع ما تُداوَى به النُّفوسُ ما أرشَدَ إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: «انظُرُوا إلى مَن هو أسفَلَ مِنكم، ولا تنظُرُوا إلى مَن هو فوقَكم؛ فهو أجدَرُ ألا تزدَرُوا نعمةَ الله عليكم»؛ متفق عليه.
ومَن جمعَ قلبَه على يومِه وساعتِه، اطمأنَّت نفسُه، فلا يحزَنُ على ما مضَى، ولا يغتَمُّ لِما يُستقبَل؛ فالماضِي لن يعُود، والمُستقبَلُ غيبٌ مكتُوبٌ.
ومِن دُعائِه - عليه الصلاة والسلام -: «اللهم إنِّي أعوذُ بك مِن الهمِّ والحزَن»؛ رواه البخاري.
وعدمُ الانتِفاع بفراغِ الوقتِ مصدرٌ للهمِّ والكَدَر، ومَن عمَرَ وقتَه بعملٍ صالحٍ، أو علمٍ نافعٍ زالَ عنه ذلك.
وجِماعُ السَّعادة في الاستِعانة بالله على ما ينفَع، والبُعد عن كل ما يُوهِنُ العبدَ ويُضعِفُ قلبَه وعملَه.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «احرِص على ما ينفعُك، واستَعِن بالله ولا تعجَز، وإن أصابَك شيءٌ فلا تقُل: لو أنِّي فعَلتُ كان كذا وكذا، ولكن قُل: قدَّرَ اللهُ وما شاءَ فعَل؛ فإنَّ لو تفتَحُ عملَ الشيطان»؛ رواه مسلم.
والذُّنوبُ بابٌ ترِدُ مِن المصائِبُ على العباد، وما يُجازَى به المُسيءُ مِن الهمِّ والغمِّ وضِيقِ الصدرِ وقسوة القلبِ عُقوبةٌ عاجِلةٌ قبل الآخرة، والمخرَجُ مِن ذلك بالبُعد عن المعاصِي والتوبةِ إلى الله؛ ليحُلَّ مكان الضِّيقِ انشِراحٌ، ومحلَّ الوحشَة أُنسٌ.
وتطهيرُ القلبِ مِن أمراضِه يشرَحُ الصدر ويُوسِّعُه، ومِن دُعاء المُؤمنين: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
وعلى هذا الوصفِ يكونُ أهلُ الجنَّة، قال - سبحانه -: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: 43].
وبعدُ .. أيها المُسلمون:
فالإسلامُ أصلُ كلِّ خيرٍ، ومصدرُ السَّعادة جميعِها، أهلُها في جنَّةٍ عالِيةٍ ونعيمٍ لا ينقطِع، قال - سبحانه -: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: 30].
ومَن عرَفَ شقاءَ الجاهليَّة وأهلَها، عرَفَ فضلَ نعمةِ الإسلام وأهله، ولم يسَعه إلا شُكرُ الله على ذلك، والتمسُّك بدينِه والاعتِزاز به، والثباتُ عليه، ودعوة الخلق إليه.
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 125].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفرُ الله لي ولكم ولجميعِ المُسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشكرُ على توفيقِهِ وامتِنانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له تعظِيمًا لشأنِه، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابِه، وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا.
أيُّها المسلمون:
أسبَغَ الله على المملكة الربية السعودية آلاء كثيرة، فأكرَمها بنعمةِ الإسلام ونشرِه، وعِمارة الحرمَين الشريفَين وخِدمتها وقاصِدِيهما، وطِباعة ونشر المُصحَف الكريمِ في الآفاق، وتحكيمِ شَرعِ الله في أرضِه، وجعلَها قِبلةَ المُسلمين وقلبَ العالم الإسلامي، مع ما أنعَمَ عليها مِن الأنِ واستِتبابِه، ورغَد العيش ونعيمِه، ووحدة شَعبِها وأُلفَته، كلُّ ذلك وغيرُه بفضلِ الله وحدَه، ثم بما وفَّق الله وُلاةَ أمرِها أن جعلُوا أُولَى مُهمَّاتهم مُنذ تأسيسِ هذه الدولة تحقيقَ توحيدِ الله واتِّباع نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، وخِدمة الإسلام والمُسلمين، ونشر العلم الشرعي النابِع من الكتاب والسنَّة، واقتِفاء سلَف هذه الأمة.
ومهما تلوَّنَت أصواتُ المُناوِئين فلن يزيدَ هذه البلادَ إلا تمسُّكًا بالإسلام واجتِماع كلمةِ أهلِها مع وُلاتِهم.
ويجِبُ على المُسلم الإعراضُ عن الأراجِيف وإشاعات المُغرِضِين، وعدم الإضغاء إليها، وأن يشغَلَ وقتَه بما ينفَع.
ثم اعلَموا أنَّ الله أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَمِ التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدين، الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بجُودِك وكرمِك يا أكرَم الأكرَمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم اصرِف عن هذه البلاد الفتَنَ والمِحَنَ والشُّرورَ، ومَن أرادَها فاجعَل كيدَه في نحرِه، وألقِ الرُّعبَ في قلبِه يا قويُّ يا عزيز.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِهما للبِرِّ والتقوَى، وانفَع بهما الإسلام والمُسلمين.
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعلنا مِن القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا.
اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ ولا هدمٍ ولا غرقٍ ولا بلاءٍ، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
اللهم انصُر جنودَنا، وأمِّن حُدودَنا يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ العظيمَ الجليلَ يذكُركم، واشكُرُوه على آلائِه ونِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعون.
خطب الحرمين الشريفين

المنهَجُ النبويُّ في تصحِيحِ المفاهِيم
الشيخ د. فيصل بن جميل غزاوي
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "المنهَجُ النبويُّ في تصحِيحِ المفاهِيم"، والتي تحدَّث فيها عن وجوبِ تصحيحِ التصوُّرات والمفاهِيمِ، وتخلِيصها من رواسِبِ الاعتِقادات الجاهليَّة؛ لأنَّ هذا هو الذي جاء به الشرعُ الحنيف، وذكَرَ العديدَ مِن الأمثِلة والنماذِج مِن سُنَّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والتي جاءَ فيها قولُه - عليه الصلاة والسلام - مُصحِّحًا لمفاهِيم مغلُوطة عند الصحابةِ - رضي الله عنهم -.
الخطبة الأولى
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله - حقَّ التقوَى، وتمسَّكُوا مِن الإسلام بالعُروة الوُثقَى، وراقِبُوه في السرِّ والنَّجوَى.
أيها المُسلمون:
مِن الأمور المُهمَّة التي جاء بها الشرعُ القويمُ: تصحيحَ التصوُّرات والمفاهِيم، وتخلِيصَها مِن رواسبِ الاعتِقادات الجاهليَّة البائِدة، والأباطِيل السائِدة، وتصويبَها لتُصبِحَ مُتوافِقةً مع الدين المُبِين، ومُلائِمةً لهَديِ المُؤمنين.
وعند النَّظر والتأمُّل في نُصوص الوحيَين، نجِدُهما حافِلَين بتناوُل هذه القضيَّة في مجالاتٍ شتَّى، وصُورٍ مُختلِفة.
فتعالَوا - عباد الله - نقِفُ مع جُملةٍ مِن الأمثِلةِ الشاهِدة لذلك، والدالَّة على تميُّز منهَجِ دينِ الإسلام في بيانِ حقائِقِ الأشياء:
ففي قولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13] بيانٌ لِما كان عليه الناسُ في الجاهِليَّة مِن التفاخُرِ بالأنسابِ ومآثِرِ الآباء والأجداد، فجاء الشرعُ بالمفهُوم الصحيحِ للكرامةِ؛ فالتفاضُلُ إنَّما يحصُلُ بالتقوَى: «لا فَضلَ لعربيٍّ على عجَمِيٍّ إلا بالتقوَى».
فكلَّما كان الإنسانُ مُحقِّقًا للتقوَى، كان ذلك كمالًا في حقِّه، وهو الكريمُ حقًّا.
وفي بياٍ نبويٍّ صريحٍ يُقرِّرُ - صلى الله عليه وسلم - هذه الحقيقةَ بقولِه: «الحَسَبُ المال، والكَرَمُ التقوَى».
أي: الشرَفُ بين الناسِ المال، والكرَمُ عند الله هو التقوَى، فانظُرُوا الفرقَ بين المفهُوم عند أهلِ الدنيا وحقيقتِه عند الله.
وأهلُ التقوَى والإيمان والصلاح هم أولياءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، سواءً كانُوا مِن ذِي رحِمِه أم لا.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أَولَى الناسِ بِي المُتَّقُون، مَن كانُوا، وحيثُ كانُوا».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ آل بنِي فُلانٍ ليسُوا لِي بأولياء، إنَّما ولِيِّي اللهُ وصالِحُ المُؤمنين».
والمعنى: إنَّما ولِيِّي مَن كان صالِحًا وإن بعُدَ نسَبُه مِنِّي، وليس ولِيِّي مَن كان غيرَ صالِحٍ وإن كان نسَبُه قريبًا مِنِّي.
عباد الله:
ويُبنَى على المفهوم الحقيقيِّ للكرامة مفهومٌ آخر؛ إذ يقولُ - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ الله لا ينظُرُ إلى صُوركم وأموالِكم، ولكن ينظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم». وفي لفظٍ آخر: «ولا إلى أجسامِكم».
فليس بين الله وبين خلقِه صِلَةٌ إلا بالتقوَى؛ فمَن كان لله أتقَى كان مِن الله أقرَب، وكان عند الله أكرَم.
وعليه فلا يصِحُّ أن يفتَخِرَ المرءُ بمالِه، ولا بمكانتِه، ولا بجمالِه، ولا بشيءٍ مِن أعراضِ الدنيا أبدًا، فمحلُّ الاعتِبار القلبُ والعملُ.
ومما يشهَدُ لهذا المعنَى كذلك: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّه ليأتِي الرجُلُ العظيمُ السَّمِينُ يوم القِيامة لا يزِنُ عند الله جَناحَ بعُوضة»، وقال: «اقرأُوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: 105]».
فالأساسُ الذي يُعوَّلُ عليه هو تقوَى الله، والاستِقامةُ على شرعِه.
وقد حرصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ترسيخِ مفهُوم التفاضُل بين الناسِ، وأنَّه ليس بصُورهم ولا بأجسادِهم، وأكَّد هذه الحقيقةَ الإيمانيَّة مِن خلال مشاهِد حيَّة ماثِلةٍ أمام أصحابِه الكرام:
فمِن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن مسعُودٍ - رضي الله عنه -، أنَّه كان يحتَزُّ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سِواكًا مِن الأراكِ، فكانت الرِّيحُ تكفَؤُه، وكان في سَاقَيه دِقَّة، فضحِكَ القومُ مِن دِقَّة ساقَيه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ما يُضحِكُكم؟»، قالُوا: مِن دِقَّة ساقَيْه، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسِي بيدِه؛ لهُما أثقَلُ في الميزانِ مِن أُحُد».
ومِنها: ما رواه سهلُ بن سعدٍ الساعديُّ - رضي الله عنه -، أنَّه قال: مرَّ رجُلٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لرجُلٍ عنده جالِسٌ: «ما رأيُك في هذا؟» فقال رجُلٌ مِن أشرافِ الناسِ، حرِيٌّ إن خطَبَ أن يُنكَح، وإن شفَعَ أن يُشفَّع. قال: فسكَتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم مرَّ رجُلٌ فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما رأيُك في هذا؟»، فقال: يا رسولَ الله! هذا رجُلٌ مِن فُقراء المُسلمين، هذا حرِيٌّ إن خطَبَ ألا يُنكَح، وإن شفَعَ ألا يُشفَّع، وإن قال ألا يُسمَع لقولِه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذا خَيرٌ مِن مِلءِ الأرض مثل هذا».
ويلحَقُ بهذا المعنى - عباد الله -: أن بسطَ الرِّزق وتضييقَه لا علاقةَ له بمحبَّة الله ولا ببُغضِه، وليس دليلًا على استِحقاق العبدِ لذلك، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 35، 36].
فأهلُ الاستِكبار على الله يقولُون: نحن أكثرُ أموالًا وأولادًا وما نحن في الآخرة بمُعذَّبِين؛ لأنَّ الله لو لم يكُن راضِيًا ما نحن عليه مِن المِلَّة والعملِ لم يُعطِنا الأموالَ والأولادَ، ولم يبسُط لنا في الرِّزق، ولم يُؤثِرنا بما آثَرَنا على غيرِنا إلا لفضلِنا.
وغابَت عنهم الحقيقةُ: أنَّ الله يبسُطُ الرِّزقَ لمَن يشاءُ مِن خلقِه، ويُضيِّقُ على مَن يشاء، لا لمحبَّةٍ فيما يبسُطُ له ذلك، ولا زُلفةٍ له استحقَّها مِنه، ولا لبُغضٍ مِنه لمَن ضيَّقَ عليه ذلك ولا مقت، ولكنَّه يفعلُ ذلك مِحنةً لعبادِه وابتِلاءً، وأكثرُ الناسِ لا يعلَمُون أنَّ الله يفعلُ ذلك اختِبارًا لعِبادِه.
فلو كان البسطُ دليلَ الإكرام والرِّضا لاختصَّ به المُطِيع، وكذا لو كان التضيِيقُ دليلَ الإهانة والسَّخَط لاختصَّ به العاصِي، بل قد يُعطِي اللهُ العبدَ مِن الدنيا استِدراجًا له وإملاءً.
فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذا رأيتَ اللهَ يُعطِي العبدَ مِن الدنيا على معاصِيه ما يُحبُّ، فإنَّما هو استِدراجٌ»، ثم تلا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44].
أيها المُسلمون:
ومِن أساليبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تعليمِ أصحابِه، وتربيتهم على الفضائِل، وتصحيحِ المفاهِيم لدَيهم: السُّؤال.
فعن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذَرٍّ! أتَرَى كثرةَ المال هو الغِنَى؟»، قُلتُ: نعم يا رسولَ الله، قال: «فتَرَى قِلَّةَ المال هو الفقرُ؟»، قُلتُ: نعم يا رسولَ الله، قال: «إنَّما الغِنَى غِنَى القلب، والفقرُ فقرُ القلب».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الغِنَى عن كثرةِ العَرَض، ولكنَّ الغِنَى غِنَى النفسِ».
العَرَض هو متاعُ الدنيا، وحقيقةُ الغِنَى غِنَى النَّفس، وهو مَن استغنَ بما أُوتِي، وقنِعَ به ورضِي، ولم يحرِص على الازدِياد، ولا ألَحَّ في الطلَب، فكأنَّه غنيٌّ.
ومما يتَّصِلُ بهذا المعنى: أنَّ الإفلاسَ الحقيقيَّ المُهلِك هو أن يلقَى العبدُ ربَّه يوم القِيامة مُفلِسًا مِن الحسنات، ليس عنده مِنها شيءٌ.
يُبيِّنُ لنا هذه الحقيقةَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ يقولُ لأصحابِه: «أتَدرُون مَن المُفلِسُ؟»، قالُوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ له ولا متاع، فقال: «إنَّ المُفلِسَ مِن أمَّتِي مَن يأتِي يوم القِيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي وقد شتَمَ هذا، وقذَفَ هذا، وأكَلَ مالَ هذا، وسفَكَ دمَ هذا، وضرَبَ هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناتِه، وهذا مِن حسناتِه، فإن فنِيَت حسناتُه قبل أن يُقضَى ما عليه أُخِذَ مِن خطاياهم فطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النَّار».
معاشِر المُسلمين:
لقد أرشدَت جُملةٌ مِن الآيات والأحاديث إلى حقيقةٍ جوهريَّةٍ تتعلَّقُ بالمالِ مِن حيث البقاء والفناء، قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96].
الشيءُ الذي يُقدِّمُه المرءُ ويُنفِقُه في سبيلِ الله تعالى وابتِغاءَ مرضاتِه هو الذي يبقَى، أما ما عداه؛ مِن مطعَمٍ، أو مشرَبٍ، أو ملبَسٍ، ونحو ذلك مِن شُؤون الدنيا فإنَّه يفنَى.
فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أيُّكُم مالُ وارِثِه أحبُّ إليه مِن مالِه؟»، قالُوا: يا رسولَ الله! ما مِنَّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإنَّ مالَه ما قدَّم، ومالَ وارِثِه ما أخَّر».
وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا أنَّه قال: «يقولُ ابنُ آدم: مالِي مالِي، وهل لك يا ابنَ آدم مِن مالِك إلا ما أكَلتَ فأفنَيتَ، أو لبِستَ فأبلَيتَ، أو تصدَّقتَ فأمضَيتَ؟».
أي: لك إلا لُقمةٌ تُؤكَل، أو ثِيابٌ تَبلَلا، أو صدقةٌ تبقَى.
إنَّ اعتِقادَ المُسلم بهذه الحقيقة، ويقينَه بأنَّ ما يُخرِجُه مِن مالِه في أوجُهِ البِرِّ وسدِّ حاجةِ الفقير ابتِغاءَ مرضاتِ الله هو المالُ الباقِي على وجهِ الحقيقة، فهذا سيدفَعُه - بلا شكٍّ - إلى البذل والعطاء والإنفاق، والبُعد عن البُخل والشُّحِّ والإمساك.
وعن عائشة - رضي الله عنها -، أنَّهم ذبَحُوا شاةً فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ما بقِيَ مِنها؟»، قالت: ما بقِيَ مِنها إلا كتِفُها، فقال - صلى الله عليه وسلم - مُصحِّحًا ومُوجِّهًا: «بقِيَ كلُّها غيرَ كتِفِها».
والمعنى: أنَّ ما تُصدِّقَ به فهو الباقِي، وما أُكِلَ فهو الفانِي.
فهنا يأتِي التصحيحُ النبويُّ للمفهُوم الخاطِئ السائِد الذي يعتبِرُ ما بقِيَ مِن المال هو الذي لم يتمَّ إنفاقُه، وبقِيَ في حَوظَة صاحبِه، في الوقتِ الذي يظنُّ فيه أنَّ المالَ الذي تُصدِّقَ به واستقرَّ في يدِ المُحتاج هو مالٌ ذاهِبٌ وفانٍ ومفقُودٌ.
وهذا الحديثُ جاء مُوافِقًا لمدلُول الآية السابِقة: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96]، ويُعدُّ أنموذجًا عمليًّا وتطبيقًا واقعيًّا لمعناه، بل قد جعلَ الله تعالى عدمَ الإنفاقِ في سبيلِه مِن التَّهلُكة، فقال - عزَّ وجل -: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
قال القُرطبيُّ - رحمه الله -: "المعنى: لا تُلقُوا بأيدِيكم بأن تترُكوا النَّفقةَ في سبيلِ الله، وتخافُوا العَيْلَة، فيقولُ الرَّجُلُ: ليس عندي ما أُنفِقُه".
ومِن المعاني التي ذكَرَها بعضُ العُلماء في معنى الآية: "لا تُمسِكُوا أموالَكم، فيَرِثها مِنكم غيرُكم، فتهلَكُوا بحِرمانِ منفَعة أموالِكم".
ومما يتبَعُ هذا المعنَى كذلك: تعقِيبُه - صلى الله عليه وسلم - عندما سألأَ أصحابَه: «ما تعُدُّون الرَّقُوبَ فيكُم؟»، قالُوا: الذي لا يُولَدُ له، قال: «ليس ذاك بالرَّقُوب، ولكنَّه الرَّجُلُ الذي لم يُقدِّم مِن ولَدِه شيئًا».
فالمفهُومُ الذي تناوَلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالتصحيحِ هنا هو معنَى الرَّقُوب؛ إذ كان السائِدُ بين الناسِ عُمومًا أنَّ الرَّقُوبَ فيهم مَن ابتُلِيَ بمَوت الذريَّة، فلا يكادُ يعيشُ له ولَدٌ، أو هي المرأةُ التي لا يبقَى لها ولَدٌ.
فعمَدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى تغيير ذلك التصوُّر، وأوقفَ أصحابَه على حقيقةِ الرَّقُوب، مُؤكِّدًا أنَّه ذلك الذي لم يكُن له نصيبٌ مِن الأجر الكبير، والثوابِ العظيم الذي يحظَى به الصابِرُ المُحتسِبُ الأجرَ في موتِ أحدِ أولادِه، وفُقدانِ فِلذَة كبِدِه.
إخوة الإسلام:
ومِن المفاهيم التي جاء الشارِعُ بتصحيحِها: مفهُومُ الشدَّة والقوَّة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الشَّديدُ بالصُّرَعة، إنَّما الشَّديدُ الذي يملِكُ نفسَه عند الغضَبِ».
يعنِي: ليس الإنسان الشديدُ هو الذي يصرَعُ الناسَ، وإنَّما الشديدُ حقيقةً والمفهوم الصحيح للقوَّة هو مَن يملِكُ نفسَه عند الغضَبِ؛ فقد يكون الإنسانُ قويًّا يغلِبُ الرِّجال، لكنَّه إذا غضِبَ خرَجَ عن طَورِه وفقَدَ سيطرتَه على نفسَه، وظلَمَ ووقَعَ في الأفعالِ المُحرَّمة.
عباد الله:
ومِن الخِصال التي شابَ مفهُومَها الخلَلُ عند بعضِ الناسِ: الحياءُ؛ فهو شُعبةٌ مِن شُعبِ الإيمان، ومحمُودٌ على كلِّ حالٍ، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحياءُ خيرٌ كلُّه».
بل زجَرَ - صلى الله عليه وسلم - مَن دعَا غيرَه إلى التخفُّفِ مِنه؛ إذ مرَّ على رجُلٍ وهو يُعاتِبُ أخاهُ في الحياء، يقولُ: إنَّك لتَستَحيِي، حتى كأنَّه يقولُ: قد أضَرَّ بِك، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْهُ؛ فإنَّ الحياءَ مِن الإيمانِ».
أي: اترُكه على هذا الخُلُق السَّنِيِّ.
وبيَّن - عليه الصلاة والسلام - كيف يُحقِّقُ العبادُ هذا الخُلُق وكيف يكتسِبُونَه عن طريقِ التزكِية والترقِّي في مراتبِ الإيمانِ والإحسانِ، فقال: «استَحيُوا مِن الله حقَّ الحيَاء»، قُلنا: يا رسولَ الله! إنَّا لنَستَحيِي والحمدُ لله، قال: «ليس ذاك، ولكنَّ الاستِحياءَ مِن الله حقَّ الحياءَ أن تحفَظَ الرأسَ وما وعَى، وتحفَظَ البطنَ وما حوَى، وتتذكَّرَ المَوتَ والبِلَى، ومَن أرادَ الآخرةَ ترَكَ زينةَ الدنيا، فمَن فعلَ ذلك فقد استَحيَى مِن الله حقَّ الحياء».
ويدخُلُ في حِفظِ الرأسِ وما وعَى: حِفظُ السَّمع والبصَر واللِّسان مِن المُحرَّمات، ويتضمَّنُ حِفظُ البَطن وما حوَى: حِفظَ القلبِ عن الإصرارِ على ما حرَّم الله، وحِفظَ البَطن مِن إدخالِ الحرامِ إليه مِن المآكلِ والمشارِبِ.
ونُنبِّهُ هنا - عباد الله - إلى مسألةٍ مُهمَّة، وهي: أنَّ كلَّ ما أدَّى إلى تركِ الحُقوقِ والتساهُلِ فيها فهو عَجزٌ ومهانةٌ؛ فتركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر، وتركُ السُّؤال عن مسائل العلمِ، والسُّكوت عن بيانِ الحقِّ هو مِن الضَّعف والخَوَر، وليس مِن الحياءِ وإن ادَّعاه الناسُ.
ولذلك قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: "نِعمَ النساء نِساءُ الأنصار، لم يمنَعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدينِ".
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ الله لي ولكم، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ذي الجلال والإكرام، شرَعَ الشرائِعَ وأحكَمَ الأحكام، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له الملِكُ القُدُّوسُ السلام، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه سيِّدُ الأنام، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وصحبِه البرَرة الكرام ما تعاقَبَت الشُّهور والأيام، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فتزدادُ أهمية الدعوة إلى تصحيحِ المفاهِيم والتصوُّرات الخاطِئة في هذا العصر؛ حيث طغَت فيه المفاهِيمُ الماديَّة على المعنويَّة، وقُدِّمَت فيه الاعتِباراتُ الدنيويَّة على الأُخرويَّة، واقتضَت الحاجةُ إلى تضافُر الجُهُود في سبيلِ عِلاجِ ما رسَخَ في أذهانِ كثيرٍ مِن الناسِ، وتشبَّعَت به نفوسُهم مِن عوائِد باطِلة، ومورُوثاتٍ بالِية، وتوعيتهم لما يجِبُ أن يكونُوا عليه مِن اعتِقاداتٍ صحيحةٍ، وأفكارٍ سديدةٍ، ومسالِك رشيدةٍ.
فتُصبِحَ مُنطلَقاتُهم ومعايِيرُهم وأحكامُهم وفقَ ميزانِ الشرع، مُتجرِّدةً عن الأهواء والنَّزعات الجاهليَّة.
عباد الله:
ومِن دلائِلِ نبُوءتِه - صلى الله عليه وسلم -: إخبارُه عما سيكونُ في آخر الزمان مِن تغيُّر المفاهِيم، واختِلال المبادِئ.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «سيأتِي على الناسِ سنَواتٌ خدَّاعات، يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، وينطِقُ فيها الرُّويبِضة»، قالُوا: مَن الرُّويبِضةُ يا رسولَ الله؟ قال: «التافِهُ يتكلَّمُ في أمرِ العامَّة».
ومِن الأمثِلة التي تدُلُّ على أنَّ الشارِعَ الحكيمَ ينقُلُ الناسَ مِن معنًى معهُودٍ مُتعارَفٍ عليه إلى معنًى آخر ينبغي أن يكون محلَّ الاهتِمام، ويُؤخَذَ بعينِ الاعتِبار: ما يُرشَدُ إليه قولُه تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].
أي: ليس العَى الذي يُعتدُّ به عمَى العين والبصَر، وإنَّما العمَى حقَّ العمَى عمَى القلبِ والبصِيرة، وإن كانت القوَّةُ الباصِرةُ سليمةً فإنَّها لا تنفُذُ إلى العِبَر، ولا تدرِي ما الخبَر.
ومِن أمثِلة المفاهِيم المُصحَّحة: ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا عدوَى ولا طِيَرة، ويُعجِبُني الفأل»، قالُوا: وما الفألُ؟ قال: «كلِمةٌ طيِّبةٌ».
قولُه: «لا عدوَى» على الوجهِ الذي يعتقِدُه أهلُ الجاهليَّة مِن إضافة الفعلِ إلى غيرِ الله تعالى، وأنَّه هذه الأمور تُعدِي بطَبعِها، وتنتقِلُ بذاتِها، فجاء الشرعُ بإبطالِ هذا المُعتقَد، وبيَّن أنَّ العدوَى إذا انتقَلَت كان ذلك بقَدَر الله لا بتأثِيرِ المرَضِ ذاتِه.
والتطيُّرُ هو التشاؤُمُ بمرئيٍّ أو مسمُوعٍ أو معلُومٍ، وهو مذمُومٌ كلُّه لا يخرُجُ مِن ذلك شيءٌ، والمُؤمنُ شأنُه أن يتفاءَل لا أن يتشاءَم، تأسِّيًا بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. والتفاؤُلُ حُسنُ ظنٍّ بالله - عزَّ وجل -.
ومِن الأمثِلة أيضًا: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «أسوَأُ الناسِ سرِقةً الذي يسرِقُ مِن صلاتِه، لا يُتمُّ رُكوعَها ولا سجُودَها ولا خُشوعَها».
فبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيه حقيقةَ السرِقة، بأن يُصلِّي العبدُ ولكنَّه لا يطمئِنُّ في صلاتِه، فيُخِلَّ بالرُّكُوع والسُّجُود، ويفقِدَ الخُشوعَ الذي هو رُوحُ الصلاة.
ومِن الأمثِلة كذلك: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «أعجَزُ الناسِ مَن عجَزَ عن الدُّعاء».
فإنَّه لا يترُكُ دُعاءَ الله ومسألتَه إلَّا أعجَزُ الناس؛ إذ لا مشقَّةَ فيه ولا كُلفَة، وهو عبادةٌ محبُوبةٌ لله تعالى.
إنَّ هذا التقريرَ النبويَّ الجامِعَ هو عكسُ ما يعتقِدُه بعضُ الجُهَّال المُتسكبِرِين أنَّ الدُّعاء هو سِلاحُ الضُّعفاء، أو حِيلةُ العاجِزِ والمهزُوم، أو أنَّه سلبِيَّةٌ وضعفٌ يلجَأُ إليها الكُسالَى الذين لا يبذُلُون وُسعَهم لبلوغِ أمانِيهم.
إنَّ شأنَ الدُّعاء عظيمٌ؛ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «ليس شيءٌ أكرَمَ على اللهِ مِن الدُّعاء».
وصحَّ عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَن لم يسأَل الله يغضَب عليه».
قال الطِّيبيُّ - رحمه الله -: "وذلك لأنَّ الله يُحبُّ أن يُسألَ مِن فضلِه".
فمَن لم يسأَل الله يُبغِضه، والمبغُوضُ مغضُوبٌ عليه لا محالة.
أيها الإخوة:
وللبُخل معانٍ أُخرى حرِيٌّ أن يُلتَفَت إليها؛ منها: ما تضمَّنَه قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «وأبخَلُ النَّاسِ مَن بخِلَ بالسلامِ»؛ لأنَّه بخِلَ بأسهَلِ الأقوال، وما لا ضرَرَ عليه فيه أصلًا.
ومِن أعظم معانِي البُخل: ما أشارَ إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: «البَخِيلُ الذي مَن ذُكِرتُ عنده فلم يُصَلِّ علَيَّ».
فالبَخيلُ الكامِلُ في بُخلِه مَن إذا ذُكِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في مكانٍ هو فيه، فلم يُبادِر فيُصلِّي عليه - صلى الله عليه وسلم -. فهذا هو البَخيلُ على الحقيقةِ، وهل تجِدُ أحدًا أبخَلَ مِن هذا؟
فلا تبخَلُوا - عباد الله - على أنفسِكم، وبادِرُوا بالصلاةِ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كلَّما ذُكِرَ - صلى الله عليه وسلم -، بل أكثِرُوا مِن الصلاةِ عليه؛ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أَولَى الناسِ بِي يوم القِيامة أكثَرُهم علَيَّ صلاةً».
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: «أكثِرُوا الصلاةَ علَيَّ يوم الجُمعة وليلَةَ الجُمعة؛ فمَن صلَّى علَيَّ صلاةً صلَّى الله عليه عشرًا».
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالَمين، إنَّك حميدٌ مجيد.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك الصالِحين.
اللهم انصُر المُسلمين في كل مكانٍ، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، واجعَل ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقاك، وعمِلَ برِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصيتِه للبرِّ والتقوَى.
اللهم انصُر إخوانَنا المُستضعَفين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين في الثُّغور، وحُماة الحُدود، واربِط على قلوبِهم، وثبِّت أقدامَهم، واخذُل عدوَّهم، واهزِمهم شرَّ هزيمةٍ.
اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباعَه، وأرِنا الباطِلَ باطلًا وارزُقنا اجتِنابَه، ولا تجعَله مُلتبِسًا علينا، واهدِنا لما اختُلِفَ فيه مِن الحقِّ بإذنِك، إنَّك تهدِي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم.
خطب الحرمين الشريفين

أهمية
الكلمة وخطورتها
ألقى فضيلة الشيخ سعود
الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "أهمية الكلمة وخطورتها"،
والتي تحدَّث فيها عن اللِّسان ومدَى تأثيرِه إيجابًا وسلبًا، مُبيِّنًا أنَّ
الكلمةَ تبنِي وتهدِم، وتُقيمُ الدنيا وتُقعِدُها، مُحذِّرًا مِن إطلاقِ العِنان
للِّسان يتكلَّمُ به بما يشاء وقتما يشاء، وذلك مِن خلال تعدادِه لأحوالِ الناسِ
مع اللِّسان.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الأول ليس قبلَه شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقَه شيء، والباطِن ليس دُونه شيء، أحمدُه - جلَّ في عُلاه - وأشكُرُه، وأتوبُ إليه مِن جميعِ الذنوبِ وأستغفِرُه، لا مانِع لما أعطَى، ولا مُعطِيَ لما منَع، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ مِنه الجَدُّ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه، وخليلُه وخيرتُه مِن خلقِه، بلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصَحَ الأمة، وترَكَنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارِها، لا يزيغُ عنها إلا شقيٌّ هالِك، فصلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آل بيتِه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه أمهات المُؤمنين، وعلى أصحابِه الغُرِّ الميامِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله في المنشَط والمكرَه، والغضب والرِّضا، والغيب والشهادة، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 52].
أيها الناس:
لقد أكرَمَ الله الإنسانَ بنعمٍ عظيمة، وآلاءٍ عميمة، وفضَّلَه على كثيرٍ مِمن خلقَ تفضيلًا، ووهَبَه على سبيلِ الامتِنان بيانًا يمتازُ به عن غيرِه، ويُبِينُ به مُرادَه، ويُحقِّقُ غايتَه، ﴿الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 1- 4].
وما كان لمثلِ هذا البيانِ أن ينبَثِقَ من فُؤاد الإنسان، لولا أن جعلَ الله له لسانًا يُحرِّكُ به الحروف، وشفتَين يُتقِنُ بهما مخارِجَها، ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ [البلد: 8، 9].
إنَّه اللِّسانُ - عباد لله -، جسمٌ لحميٌّ بين فكَّي الإنسان، يُظهِرُ للملأ ما قد زوَّرَه في نفسِه مِن كلامٍ، ويُطلِعُهم على حجم ما يملِكُه مِن عقلٍ بقَدر ما يملِكُه مِن بيان؛ فإنَّ اللِّسان رِشاءُ القلب، وبريدُه الناطِق، وبه يختارُ المرءُ مصيرَه إما إلى هلاكٍ، وإما إلى نجاةٍ.
كيف لا، والمُصطفى - صلى الله عليه وسلم - هو مَن قال: «وهل يكُبُّ الناسَ في النَّار على وُجوهِهم - أو على مناخِرِهم - إلا حصائِدُ ألسِنَتهم؟!»؛ رواه أحمد والترمذي.
اللِّسانُ - عباد الله - سلاحٌ ذُو حدَّين؛ مَن أحسنَ استِعمالَه نالَ به ما يُحمَد، ومَن أساءَ استِعمالَه عادَ عليه بالحسرَة والوَبال.
وإنَّ كثيرًا مِن النِّزاعات والحُروب لم تكُن لتطفُو إلا بسببِ اللِّسان وعثَرَاتِه. فإذا كانت النِّيران تُذكَى بالعِيدان، فإنَّ الحروبَ مبدؤُها كلام، وما وقعَ خلافُ ولا تباغُضٌ ولا تدابُرٌ إلا وللِّسَان مِنه نصِيبٌ بمُجافاتِه ما هو أحسَن، وبَينُونَته عن القول السديد، ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ [الإسراء: 53].
ولا عجَبَ - عباد الله -؛ فإنَّ نَزغَ الشيطان لن يجِد محلًّا له بين الناسِ إلا إذا فقَدَ اللِّسانُ حُسنَه، وقدَّم ما يشِينُ على ما يَزِينُ، وإنَّ تحقُّق التقوَى بأفئِدَتهم وصلاحِ أعمالِهم لا يتمُّ إلا إذا حكَمَ ألسِنتَهم القولُ السديدُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: 70، 71].
إنَّ دينَ المرء وعقلَه يُوجِبان عليه استِشعارَ عِظَم شأنِ لِسانِه وما له مِن تبِعَاتٍ وما عليه مِنها؛ فإنَّ عثرَةَ اللِّسان أشدُّ خطرًا على صاحِبِه مِن عثرَةٍ برِجلِه، وإنَّ مكمَنَ خُطورتِه يبدُو في استِصغار حجمِه أمام بقيَّة أعضاءِ جسَدِه.
فكَم مِن أرواحٍ أُزهِقَت بسببِه .. وكَم مِن أعراضٍ قُذِفَت مِن خلالِه .. وكَم مِن حقٍّ قُلِبَ باطلًا، وباطِلٍ قُلِبَ حقًّا، كلُّ ذلكم بسببِ إعمالِ اللِّسان فيما لا يجوزُ، أو إحجامِه عما ينبغي، في حين أنَّ أخطارَه وأضرارَه أسرعُ في المُضِيِّ مِن نفعِه؛ لأن بعضَ الأفهام تعبَثُ بالأسماع، فلا تعرِفُ لإحسانِ الظنِّ طريقًا، ولا للمحمَلِ الحسَنِ سبيلًا؛ فإنَّ الكلِمة إذا خرَجَت مِن لِسان المرء لم تعُد مُلكًا له، بل تُصبِحُ كالكرة تتقاذَفُها مضارِبُ اللاعِبِين بها، كلٌّ يُفسِّرُها بما يخدِمُ غاياتِه ومآرِبَه.
والواقعُ - عباد الله - أنَّ الناسَ مع ألسِنتهم ثلاثةُ أصنافٍ: حكيمٌ، ونَزِقٌ، وجاهِلٌ.
فالحكيمُ يقُودُ عقلُه لِسانَه، فله عقلٌ حاضِر، ودينٌ زاجِر، يعرِفُ مواضِع الإكرام باللِّسان، ومواضِع الإهانة به، يعلَمُ الكلامَ الذي به يندَم، والذي به يفرَح، وهو على ردِّ ما لم يقُل أقدَرُ مِنه على ردِّ ما قال. فمِثلُه يعلَمُ أنَّه إذا تكلَّم بالكلِمَةِ ملَكَتْه، وإن لم يتكلَّم بها ملَكَها، وربما صارَ حكيمًا بالنُّطقِ تارةً، وبالصمتِ تاراتٍ أخرى، مع إدراكِه بأن يقولَ الناسُ: ليتَه تكلَّم، خيرٌ مِن أن يقولُوا: ليتَه سكَت.
وأما النَّزِقُ فإنما يقُودُه طَيشٌ ثائِر، وصَلَفٌ عاثِر، وضِيقُ عطَن مُستحكِم، فلا معنَى للأناة عنده، وليس لديه حدودٌ ولا خطوطٌ حمراءُ في الألفاظ، فهو يغرِفُ منها ما يشاء، ويُطلِقُ حبلَها على الغارِبِ بلا زِمامٍ ولا خِطامٍ، دون استِحضارٍ لدلالاتِها وما تكونُ به مآلاتُها؛ حيث تختلِطُ عنده ألفاظُ السِّباب، وألفاظُ المَدِيح، وألفاظُ الأُلفة، وألفاظُ النُّفرَة؛ إذ لا مِعيارَ لها عنده يحكُمُها، وإنما يُدبِّرُها غضَبُه، ويُوجِّهُها نَزَقُه، ويُهيِّجُها ضِيقُ عطَنِه، فلا يُفيقُ إلا وقد طارَت بكلامِه الرُّكبان، ولاتَ حين ندَمٍ واعتِذارٍ. هو وأمثالُه يصدُقُ فيهم ما جاء في الحديثِ الحسَنِ مرفوعًا: «ولا تكلَّم بكَلامٍ تعتَذِرُ مِنه غدًا»؛ رواه أحمد وابن ماجه.
وأما الجاهِلُ - يا رعاكم الله - فذلكم مَن يقُودُ لِسانُه عقلَه، فيكونُ به عدوَّ نفسِه قبل أن يستعدِيَ الناسَ عليه، وقد قِيل:
|
لا يبلُغُ الأعداءُ مِن
جاهِلٍ |
|
ما يبلُغُ الجاهِلُ مِن
نفسِهِ |
لأنَّ الجهلَ - عباد الله - أُسُّ كل بلِيَّةٍ؛ فمَن جهِلَ عِظَم شأنِ اللِّسان جهِلَ ما سيتلفَّظُ به، فلم يدرِ ما خيرُه وما شرُّه.
والجهلُ - عباد الله - داءٌ يُزرِي بعقلِ صاحِبِه، فكيف بلِسانِه؟! ومِثلُ ذلكم لا يعلَمُ متى ينطِقُ، ومتى يسكُت؛ لأنَّ فاقِدَ الشيءِ لا يُعطِيه، وتلك معرَّةٌ نعوذُ بالله مِن غوائِلِها.
كيف لا، وقد وعَظَ الله نوحًا - عليه السلام - بقولِه: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: 46].
ثم إنَّ كثرةَ الكلام ليس هو علامةَ العلم؛ فقد يكونُ الصمتُ علمًا تارةً، كما يكونُ الكلامُ علمًا تارات.
وقد كان صمتُ بعضِ عُلماء السَّلَف مُزاحِمًا كلامَهم، وربما كان للصَّمت صوتٌ معنويٌّ أبلَغُ مِن صَوت الكلامِ الحِسِّي؛ إذ ليس شرطًا أن يكون الصَّمتُ جهلًا بالشيء، بل إنَّه يعني بداهَةً أنَّه ليس ثمَّة ما يستحِقُّ الكلام.
ومما لا شكَّ فيه أنَّ مَن أحسَنَ صمتَه أحسَنَ كلامَه، فيُصبِحُ صَمتُه حكمةً، ومنطِقُه حكمةً، تتعلَّمُ مِن صَمتِه كما تتعلَّمُ مِن كلامِه، هذا وأمثالُه لآلِئٌ يقِلُّ وجودُها في بِيئاتٍ مليئةٍ بالثَّرثَرةِ والصُّراخ.
وإن كان ثمَّة إشارةٌ بهذه المُناسَبة - عباد الله - ففي أمرَين:
أحدهما: أنَّ إطلاقَ المرء لِسانَه في كل شيءٍ تكلُّفٌ ممقُوت، ولَبُوسٌ مكرُوه؛ فمِن أقبَح ما ينطِقُ به اللِّسان ما خرَجَ مِنه على سبيلِ التعالِي، والتكلُّف، والغُرور، ووحشِيِّ الألفاظ؛ فإنَّ أصحابَ مِثل ذلكم اللِّسان هم مِن أبغَضِ الناسِ إلى الحبيبِ المُصطفى والرسُولِ المُجتبَى، حين قال - صلواتُ الله وسلامُه عليه -: «وإنَّ أبغَضَكم وأبعَدَكم مِنِّي يوم القِيامة الثَّرثَارُون والمُتشدِّقُون والمُتفَيهِقُون»؛ رواه الترمذي.
والثَّرثارُ - عباد الله - هو كثيرُ الكلامِ.
والمُتشدِّقُ هو المُتطاوِلُ على الناسِ بكلامِه تفاصُحًا وتعظيمًا لنفسِه.
والمُتفيهِقُ هو المُتوسِّعُ في كلامِه غُرورًا، وكِبرًا، وإظهارًا لفضلِه على غيرِه.
والأمرُ الآخرُ - عباد الله - أنَّ نُزولَ صاحِبِ اللّسان ميدانًا غيرَ ميدانِه، وخوضَه فنًّا غيرَ فنِّه عورةٌ مكشُوفة، ومحلٌّ لتندُّرِ الناسِ به؛ فإنَّ مِن المُسلَّمات بداهةً احتِرام التخصُّص، فلا يَهيمُ المرءُ في كل وادٍ، بل ينبغي له ألا يقولَ إلا ما يُحسِنُه، فإنَّ أقوامًا تحَّثُوا فيما لا يُحسِنُون، فأوقَعَهم حديثُهم فيما لا يرجُون. فلِسانُ الفقيهِ ليس كلِسان الطَّبيبِ، ولِسانُ السياسيِّ ليس كلِسان الواعِظِ.
ولقد أحسَنَ الحافِظُ ابنُ حجر - رحمه الله - حين قال: "ومَن تكلَّمَ فيه غير فنِّه أتَى بالعجَائِبِ".
ثم اعلَمُوا - يا رعاكم الله - أنَّ خطرَ الكلِمة لا يكمُنُ في مبناها، وإنما يكمُنُ الخطرُ كلُّ الخطر في معناها؛ فلكم أن ترَوا كم في كلمةِ (أُفٍّ) مِن عُقوقٍ بالوالِدَين بالِغ، وهي كلِمةٌ صغيرةٌ لا تحمِلُ إلا حرفَين اثنَين، ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].
بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآيات والذِّكر الحكيم، قد قُلتُ ما قُلتُ؛ إن صوابًا فمِن الله، وإن خطأً فمِن نفسِي والشيطان، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين والمُسلمات مِن كل ذنبٍ وخَطيئةٍ، فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّ ربي كان غفورًا رحيمًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا لا ينفَد، والصلاةُ والسلامُ على أفضل المُصطفَين محمد، وعلى آله وصحبِه ومَن تعبَّد.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - معاشِر المُسلمين -، وراقِبُوه فيما تنطِقُون به وما تسكُتُون عنه؛ فإنَّ اللِّسانَ العَفِيفَ يهدِي صاحِبَه إلى الجنَّة، كما أنَّ اللِّسانَ البَذِيء يهدِي صاحِبَه إلى النار. اللِّسانُ الصالِحُ ضِياءٌ ونُورٌ، واللِّسانُ الفاسِدُ قتَرٌ وظُلُماتٌ.
وحسبُكم في ذلكم دُعاءُ المُصطفى - صلواتُ الله وسلامُه عليه -: «اللهم اجعَل في قلبِي نُورًا، وفي لِسانِي نُورًا، واجعَل في سمعي نُورًا، واجعَل في بصَرِي نُورًا ..»؛ رواه البخاري ومسلم.
ثم اعلَمُوا - يا رعاكم الله - أنَّ البلاء مُوكَّلٌ بالمنطِق، فلينظُر المرءُ ما ينطِقُ به لِسانُه؛ فإنَّ تغليبَ الفأل في الكلام، والنأْيَ به عن مراتِعِ التجهُّم والتشاؤُم مِن هَديِ سيِّد المُرسَلين - صلواتُ الله وسلامُه عليه -، فإنَّه - صلواتُ الله وسلامُه عليه - دخلَ مرَّةً على أعرابيٍّ يعُودُه، فقال: «لا بأس، طهورٌ إن شاء الله»، قال: قُلتَ: طَهور! بل هي حُمًّى تفُور - أو تثُور - على شيخٍ كبير، تُزِيرُه القبُور، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فنَعم إذًا»؛ رواه البخاري.
وفي بعضِ الروايات أنَّ الرجُلَ ماتَ اليومَ الذي يَلِيه.
وبمِثلِ هذا جاء خبرُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيمَن ابتدَرَه لِسانُه بالنَّظر إلى واقعِ الناسِ نظرةَ تشاؤُمٍ ويأسٍ وانغِلاقٍ لا انفِتاحَ معه؛ حيث قال - صلواتُ الله وسلامُه عليه -: «مَن قال: هلَكَ الناسُ، فهو أهلَكُهم»؛ رواه مسلم.
ثم إنَّ لِسانَ المُسلم ينبغي أن يكون كالمِرآة لمُجتمعه وبنِي مِلَّته، فلا يسمَعون مِنه إلا نُصحًا هادِفًا، أو خبرًا صادِقًا، أو ذِكرًا نافِعًا، بعيدًا عن تتبُّع العَورات، والفُجور في الخُصومات، والانتِقائيَّة المَقِيتة التي تُظهِرُ التضادَّ والتضارُبَ، والكَيلَ بمِكيالَين، بل ينبغي له ألا يُطلِقَ لِسانَه مِن زاوِيةٍ ضيِّقةٍ، فلا يسكُت فيما ينبغي الحديثُ عنه مِن نفعٍ وبِرٍّ، ولا يُطلِقُ لِسانَه فيما ينبغي سَترُه أو السُّكُوتُ عنه؛ ليكونَ خُلُقُه الخِطابيُّ واقعيًّا لا خياليًّا، ومنطقيًّا لا افتراضيًّا، وفاضلًا غيرَ مُنافٍ للأخلاق، ونافعًا غيرَ مُضادٍّ للمصلَحة العامَّة.
وإذا ما تنازَعَت الألسُن، وتشاحَّت الأفهام، ومارَت ظُنُون الناسِ، فغارَ بعضُها على بعضٍ، فإنَّ السلامةَ لا يعدِلُها شيءٌ. فلو كانت السلامةُ في مثلِ هذه الصُّورة عشرة أجزاء، فإنَّ تِسعةً مِنها في السُّكُوت.
فعن عُقبة بن عامرٍ - رضي الله تعالى عنه - قال: قُلتُ: يا رسولَ الله! ما النَّجاة؟ قال: «أمسِك عليكَ لِسانَك، وليَسَعْكَ بيتُك، وابْكِ على خطِيئَتِك»؛ رواه الترمذي.
هذا وصلُّوا - رحِمَكم الله - على خيرِ البريَّة، وأزكَى البشريَّة: محمدِ بن عبد الله صاحبِ الحوض والشَّفاعة؛ فقد أمَرَكم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسِه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقُدسِه، وأيَّه بكم - أيها المُؤمنون -، فقال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ صاحِبِ الوَجهِ الأنوَر، والجَبِين الأزهَر، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ صحابةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وكرمِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الشركَ والمُشركين، اللهم انصُر دينَكَ وكتابَكَ وسُنَّةَ نبيِّك وعبادَكَ المُؤمنين.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين، ونفِّس كَربَ المكرُوبِين، واقضِ الدَّيْنَ عن المَدينِين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمورِنا، واجعَل ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقَاك، واتَّبعَ رِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضاه مِن الأقوالِ والأعمالِ يا حيُّ يا قيوم، اللهم أصلِح له بِطانتَه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد.
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، اللهم أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، اللهم لا تحرِمنا خيرَ ما عندك بشرِّ ما عندنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعَلنا مِن القانِطين، واجعَل ما أنزلتَ لنا بلاغًا لنا ومتاعًا إلى حين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
اذكُرُوا اللهَ العظيمَ يذكُركُم، واشكُرُوه على آلائِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

فضل
التواصِي بالمرحَمة
ألقى فضيلة الشيخ
صلاح البدير - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "فضل التواصِي بالمرحَمة"،
والتي تحدَّث فيها عن التراحُم بين المُسلمين، وأنَّه فضيلةٌ عظيمةٌ، وقُربةٌ
جليلةٌ، مُبيِّنًا أنَّ رحمةَ الخلق مِن أبرز الصِّفات التي وصَفَ بها ربُّنا -
سبحانه - نبيَّه مُحمدًا -
صلى الله عليه وسلم - في كِتابِه
العظيم، ووصَفَ بها أصحابَه الكِرام - رضي الله عنهم -.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله ذي الآلاء والنَّعماء، أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا، ووسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وحِلمًا، وقهَرَ كلَّ مخلُوقٍ عزَّةً وحُكمًا، ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110]، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له يرحَمُ مِن عبادِه الرُّحماء، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه خاتمُ الأنبِياء، وسيِّدُ الأصفِياء، نبيُّ الرحمة، الداعِي إلى سبيلِ ربِّه بالحِكمة، وخيرُ نبيٍّ بُعِثَ إلى خيرِ أُمَّة، صلَّى الله عليه وعلى آلِه الطيبين، وأصحابِه الغُرَّة الميامِين، وسلَّم تسليمًا.
أما بعدُ .. فيا أيها المُسلمُون:
اتَّقوا الله؛ فإنَّ الأمسَ مثَل، واليوم عمَل، وغدًا أمَل، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20].
أيها المُسلمُون:
المُبارَكُون الميامِين يتعطَّفُون بالصِّلة والبِرِّ والإحسان، ويتفضَّلُون بالعفو والمُسامَحة، ويتواصَون بالمرحَمة، والتواصِي بالمرحَمة فضيلةٌ عظيمةٌ، وقُربةٌ جليلةٌ، قال ربُّنا - جلَّ في عُلاه -: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 17، 18].
ومعنى ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي: أوصَى بعضُهم بعضًا برحمةِ النَّاسِ، والعطفِ على الخلقِ، وحثَّ بعضُهم بعضًا على الرِّفقِ ولِينِ الجانبِ، ورحمةِ الفقيرِ والمِسكين، والصَّغير واليَتِيم، والمرضَى والمكلُومين، والشَّفقَة على الجاهِلين، والشَّفقَة على أهلِ المعاصِي بالنَّصِيحة والموعِظة، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المُنكَر. وفي ذلك قِوامُ النَّاس، ولو لم يتراحَمُوا هلَكُوا.
ووصَفَ الله - سبحانه - المُحبِّين له بخمسةِ أوصافٍ: أحدِها: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 54] والمُرادُ: لِينُ الجانبِ وخفضُ الجَناح، والرأفةُ والعطفُ والرحمةُ للمُؤمنين، كما قال تعالى لرسولِه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 215].
ووصَفَ أصحابَه بمثلِ ذلك في قولِه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29] رُحَماءُ رُفَقاءُ أرِقَّاءُ بينهم، والمُؤمنُ يكون رحيمًا بَرًّا، ضَحُوكًا بَشُوشًا في وجهِ أخِيهِ المُؤمن.
وقال تعالى في صِفةِ نبيِّنا وسيِّدِنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].
|
فآمِنُوا بنيٍّ لا أبَا لكُمُ |
|
ذِي خاتَمٍ صاغَهُ الرحمنُ مختُومٍ |
|
رَأْفٍ رحيمٍ بأهلِ البِرِّ يرحَمُهُمْ |
|
مُقرَّبٍ عند ذِي الكُرسِيِّ مرحُومِ |
|
ما زالَ بالمعرُوفِ فِينَا آمِرَا |
|
يَهدِي الأنامَ بنُورِه المُتشعشِعِ |
|
صلَّى الله اللهُ جلَّ جلالُهُ |
|
ما لاحَ نُورٌ في البُرُوقِ اللُّمَّعِ |
جاء بالتوبةِ وجاء بالتراحُم، وقال: «أنا نبيُّ التوبةِ ونبيُّ المرحَمة». وقال: «الرَّاحِمُون يرحَمُهم الرحمن، ارحَمُوا مَن فِي الأرضِ يرحَمكم مَن في السَّماء». «لا يرحَمُ اللهُ مَن لا يرحَم الناسَ». «مَن لا يرحَم صغِيرَنا، ويعرِف حقَّ كبيرِنا فليس مِنَّا». «لا تُنزَعُ الرَّحمةُ إلا مِن شقِيٍّ».
وعن أُسامة بن زيدٍ - رضي الله عنهما - قال: أرسَلَت ابنةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إليه: إنَّ ابنًا لِي قُبِضَ، فأْتِنا، فرُفِعَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الصبِيُّ ونفسُه تتقَعقَع، ففاضَت عينَاه - صلى الله عليه وسلم -، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله! ما هذا؟ فقال: «هذِهِ رَحمةٌ جعلَها اللهُ في قُلوبِ عبادِه، وإنَّما يرحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحماءُ»؛ أخرجه البخاري.
ونالَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن قومِه ما نالَه؛ مِن التكذيبِ والإيذاءِ البَليغ.
قالت عائشةُ - رضي الله عنها -: هل أتَى يومٌ كان أشدَّ مِن يومِ أُحُدٍ؟ قال: «لقد لقِيتُ مِن قومِكِ ما لقِيتُ، وكان أشدَّ ما لقِيتُ مِنهم يوم العَقَبة؛ إذ عرَضتُ نفسِي على ابنِ عبدِ يالِيلَ بن عبدِ كُلالٍ، فلم يُجِبنِي إلى ما أردتُ، فانطلَقتُ وأنا مهمُومٌ على وجهِي، فلم أستَفِق إلا وأنا بقَرنِ الثَّعالِب، فرَفعتُ رأسِي فإذا أنا بسَحابةٍ قد أظَلَّتنِي، فنَظَرتُ فإذا فيها جِبريلُ فنادَانِي فقال: إنَّ الله قد سمِعَ قَولَ قومِك لك، وما ردُوا عليك، وقد بعَثَ إليك ملَكَ الجِبال لتأمُرَه بما شِئتَ فِيهم، فنادَانِي ملَكُ الجِبال فسلَّم علَيَّ، ثم قال: يا مُحمد! إنَّ الله قد سمِعَ قَولَ قومِك لك، وأنا ملَكُ الجِبال، وقد بعَثَني ربُّك إليك لتأمُرَني بأمرِك، فما شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبِقَ عليهم الأخشبَين».
فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بل أرجُو أن يُخرِجَ اللهُ مِن أصلابِهم مَن يعبُدُ اللهَ وحدَه لا يُشرِكُ به شيئًا»؛ متفق عليه.
قال ابنُ حجرٍ - رحمه الله تعالى -: "وفي هذا الحديثِ بيانُ شفَقَةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على قومِه، ومزيد صَبرِه وحِلمِه، وهو مُوافِقٌ لقولِه تعالى: ﴿{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، وقولِه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]".
فهذا خُلُقُ نبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وهذه صِفتُه، وهذه دعوتُه، وتلك رحمتُه وشَفَقَتُه، وتلك أخلاقُ المُؤمنين. فطُوبَى للرُّحماء.
أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ فاستغفِرُوه، إنَّه كان للأوابِين غفُورًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الكريم الحليم، أحمدُه كما ينبغي لجلالِه العظيم ووجهِه الكريم، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له ولا عديدَ ولا نَديدَ له ولا قَسِيم، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنَا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه أزكَى صلاةٍ وتسليم، وأعلى تشريفٍ وتكريم.
أما بعدُ .. فيا أيها المسلمون:
اتَّقُوا الله وراقِبُوه، وأطيعُوه ولا تَعصُوه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أُخَيَّ أُخَيَّ! كُن رحيمًا لنفسِك ولغيرِك، ولا تستبِدَّ بخيرِك، وارحَم الجاهِلَ بعلمِك، والمُحتاجَ بجاهِك، والفقيرَ بمالِك، والكبيرَ باحتِرامِك، والصَّغيرَ برأفَتِك، والعُصاةَ بدعوتِك، والبهائِمَ بعَطفِك. فأقرَبُ النَّاسِ مِن رحمةِ الله أرحَمهم بخَلقِه.
فمَن كثُرَت مِنه الشَّفَقةُ على خلقِه، والرحمةُ على عبادِه رحِمَه الله برحمتِه، وأدخَلَه دارَ كرامتِه، ووقاهُ عذابَ قبرِه، وهَولَ موقِفِه، وأظَلَّه بظِلِّه.
|
أُخَيَّ عندِي مِنَ الأيامِ تجرِبةٌ |
|
فيما أظُنُّ وعِلمٌ بارِعٌ شافِي |
|
لا تَمشِ في النَّاسِ إلا رحمةً لَهُمُ |
|
ولا تُعامِلْهُمُ إلا بإنصَافِ |
|
واقطَعْ قُوَى كلِّ حِقدٍ أنت مُضمِرُهُ |
|
إن زلَّ ذُو زلَّةٍ أو إن هفَا هافِي |
|
وارغَب بنَفسِك عما لا صَلاحَ لَهُ |
|
وأَوسِعِ النَّاسَ مِن بِرٍّ وإلطَافِ |
|
ولا تُكشِّف مُسِيئًا عن إساءَتِهِ |
|
وصِلْ حِبالَ أخِيكَ القاطِعِ الجَافِي |
|
فتستحِقَّ مِن الدُّنيا سلامَتَها |
|
وتستقِلَّ بعِرضٍ وافِرٍ وافِي |
|
ما أحسَنَ الشُّغلَ في تدبِيرِ مَنفَعَةٍ |
|
أهلُ الفراغِ ذَوُو خَوضٍ وإرجَافِ |
وصلُّوا وسلِّمُوا على أحمدَ الهادِي شفيعِ الورَى طُرًّا؛ فمَن صلَّى عليه صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا.
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن الآلِ والأصحابِ، وعنَّا معهم يا كريمُ يا وهَّاب.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدين، واجعَل بلادَ المُسلمين آمنةً مُطمئنَّةً مُستقِرَّةً يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمَين الشريفَين لما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما فيه عِزُّ الإسلام وصلاحُ المُسلمين يا رب العالمين.
اللهم انصُر جُنودَنا المُرابِطِين على ثُغورِنا وحُدودِنا يا رب العالمين، اللهم احفَظ رِجالَ أمنِنا، واجزِهم خيرَ الجزاءِ وأوفاه يا رب العالمين.
اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا، وارحَم موتانا، وانصُرنا على مَن عادانا.
اللهم اجعَل دُعاءَنا مسمُوعًا، ونداءَنا مرفوعًا يا كريمُ يا عظيمُ يا رحيمُ.
خطب الحرمين الشريفين

التحذير من آفات اللِّسان
ألقى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "التحذير من آفات اللِّسان"، والتي تحدَّث فيها عن اللِّسان هذه القِطعة الصَّغيرة الحَجم والجِرْم، العظيمةُ الطاعة والجُرْم، مُحذِّرًا مِن الوقوعِ في أعراضِ المُسلمين ونشر الإشاعات والأكاذِيبِ عنهم، ومُبيِّنًا ما توعَّدَ اللهُ به مَن أشاعَ عن المُسلمين الشائِعات والافتِراءات.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي خلقَ الإنسانَ وفضَّلَه، ومنَحَه العقلَ آلةَ الإدراك ومناطَ التكليف وأدَّبَه، ووهَبَه اللِّسانَ أداةَ التعبير والبيان وعلَّمَه، فسُبحان مَن سوَّاه وعدَّلَه، وتبارَك اللهُ أحسَنُ الخالِقِين، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه بالهُدى ودينِ الحقّ شاهدًا ومُبشِّرًا ونذيرًا، فجاء بالحقِّ وصدَّقَ، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ خيرَ الحديثِ كلامُ الله، وخيرَ الهَديِ هَديُ مُحمدِ بن عبدِ الله، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ فِي النَّار.
عباد الله:
أُوصِيكُم ونفسِي بتقوَى الله؛ فهي وصيَّةُ الله للأولين والآخرين: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131].
معاشِر المُسلمين:
إنَّ جِراحَ الجوارِحِ غائِرة، وفي النُّفوس لها آثارٌ قائِمةٌ بالِغة.
|
جِراحاتُ
السِّنانِ لها الْتِئامُ |
|
ولا يَلتَامُ ما
جَرَحَ اللِّسَانُ |
اللِّسانُ أداةُ التعبير والبيان، وتُرجمانُ الجَنان. صغيرٌ حجمُه وجِرمُه، عظيمٌ طاعتُه وجُرمُه، به يُستبانُ الكُفرُ والإيمانُ، وهما غايةُ الطاعة والعِصيان، له في الخَير مجالٌ رَحْب، وله في الشرِّ ذَيلٌ سَحْب. بِه تُشاعُ الاتهامات، وتُقذَفُ المُحصَناتُ الغافِلاتُ المُؤمنات، وتقومُ الفِتَن والصِّراعات، وتُكشَفُ مُخبَّآتُ الخُدُور، وتُستباحُ الحُرَمُ والدُّور، وتُزرَعُ الفتنةُ والضَّغينةُ والحسَراتُ في الصُّدُور.
بِهِ السَّبُّ والغَمزُ، والنَّميمةُ واللَّمزُ، والإشاعةُ واللَّعن، والغِيبةُ والقَذفُ والفُحشُ والبَذاءةُ والطَّعن، مِن الحركة لا يَتعَب، ومِن الكلام لا يَنضَب.
لكن كلَّ ذلك محفُوظٌ مُسجَّل، وسيُحاسَبُ عليه في يوم الوَعيد، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18].
أخذَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلِسانِه وقال: «يا مُعاذ! كُفَّ عليك هذا»، فقال مُعاذٌ: وإنَّا لمُؤاخَذُون بما نتكلَّمُ به يا رسولَ الله؟ فقال: «ثَكِلَتْك أمُّكَ يا مُعاذ! وهل يكُبُّ الناسَ في النارِ على وجوهِهم - أو على مناخِرِهم - إلا حصائِدُ ألسِنَتهم».
وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه -، أنَّه سمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ينزِلُ بها في النارِ أبعَدَ ما بين المشرِقِ والمغرِبِ».
وعن أنَسٍ - رضي الله عنه - قال: استُشهِدَ غُلامٌ مِنَّا يوم أُحُد، فوُجِدَ على بطنِه صَخرةٌ مربُوطةٌ مِن الجُوع، فمَسَحَت أمُّهُ التُّرابَ عن وجهِهِ وقالت: هنِيئًا لك يا بُنَيَّ الجنَّة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما يُدرِيكِ! لعلَّه كان يتكلَّمُ فيما لا يَعنِيهِ».
وصعِدَ ابنُ مسعُودٍ - رضي الله عنه - يومًا الصَّفا، فأخَذَ بلِسانِه، فقال: "يا لِسان! قُل خَيرًا تَغنَم، واسكُتْ عن الشرِّ تَسلَم، مِن قبل أن تَندَم"، ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أكثَرُ خطايَا ابنِ آدم مِن لِسانِه».
عباد الله:
بحسب امرِئٍ مِن الشرِّ أن يَحقِرَ أخاه المُسلم، كلُّ المُسلمِ على المُسلمِ حرامٌ؛ دَمُه ومَالُه وعِرْضُه.
إنَّ ذِكرَ المُسلم لأخِيهِ بما يَكرَهُ في حُضورِه سبٌّ وشَتمٌ، وفي غَيبَته سواءٌ كان في بَدَنِه أو دِينِه أو دُنياه، أو في خَلقِه أو خُلُقِه، أو مالِه أو وَلَدِه أو زَوجِه، أو ثَوبِه أو حركتِه، سواءٌ بلفظٍ أو إشارةٍ، أو رمزٍ أو كِتابةٍ أو حِكايةٍ، كلُّ ذلك غِيبةٌ إن كان فيه، فإن لم يكُن فيه فغِيبةٌ وظُلمٌ وكذِبٌ وبُهتانٌ.
عباد الله:
الرِّبا اثنان وسبعُون بابًا، وأدنَى الرِّبا مِثلُ إتيان الرَّجُل أمَّه، ودِرهمُ رِبا أشدُّ مِن ستٍّ وثلاثين زَنْيَة، وإنَّ أربَى الرِّبا استِطالةُ الرَّجُل في عِرضِ أخِيهِ المُسلم بغير حقٍّ.
معاشِر المُسلمين:
إنَّ مِن أعظم آفات اللِّسان وغوائِلِه، ومصائِدِه وحبائِلِه: نشرُ الإشاعات المُزيَّفة، وإذاعةُ الأراجِيف المُختلَقَة، ونَسجُ الأكاذِيب المُفتَعَلة، ونَزعُ الثِّقة بين المُسلمين، حتى يسُوءَ الظنُّ بينهم، ويتكدَّرَ صَفوُ الأُخُوَّة فتتفكَّكُ وِحدتُهم، ويتخلخَلُ تماسُكُهم، ويتزَعزَعُ أمنُهم.
فكَم أقلَقَت الإشاعةُ مِن أبرِياء! وكَم حطَّمَت مِن عُظماء! وكَم هدَمَت مِن وشائِج! وكَم تسبَّبَت في جرائِم! وكَم فكَّكَت مِن علاقاتٍ وصداقاتٍ! وكَم دمَّرَت مِن مُجتمعات! وكَم هدَمَت مِن أُسَر، وفرَّقَت بين أحِبَّةٍ! وكَم أهدَرَت مِن أموالٍ، وضيَّعَت مِن أوقات! وكَم أحزَنَت مِن قلُوبٍ، وأولَعَت مِن أفئِدَة، وأورَثَت مِن حسرَةٍ! وكَم أخَّرَت في سَير أقوامٍ.
وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
وعن عبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما - قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن قالَ فِي مُؤمنٍ ما لَيسَ فِيه، أسكَنَه الله رَدْغَةَ الخَبَال، وهي عُصارةُ أهلِ النَّار».
وعن سَهلِ بن مُعاذٍ، عن أَبِيه - رضي الله عنهما -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن رمَى مُسلِمًا بشيءٍ يُريدُ شَيْنَه، حَبَسَه الله على جِسرِ جهنَّم حتى يخرُجَ مما قال».
معاشِر المُسلمين:
إنَّ الله قد حرَّم أعراضَ المُسلمين، كما حرَّم دماءَهم وأموالَهم، بل وشرَعَ الدِّفاعَ عن العِرضِ بالنَّفسِ والمالِ، وإنَّ تدنيسَ أعراضِ المُسلمين بصِناعةِ الإشاعةِ ونَشرِها في الآفاقِ، وتَروِيجِها بالشُّكُوك والظُّنُون والاختِلاق، والكذِبِ والافتِراء، والزُّور والبُهتان والاستِهزاء، وبَثِّ السُّمُوم والفِتنة عبر وسائِل الاتِّصال ومواقِع التواصُل، كلُّ ذلك مِن انتِهاك العِرضِ المَصُون، ومِن الجرائِم المُوبِقَة، والفتَن المُضلِّلَة. فعلى كلِّ مُسلمٍ الحذَرُ مِن ذلك.
فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - يرفَعُه قال: «مَن أشاعَ على امرِئٍ مُسلمٍ كلِمةَ باطِلٍ ليُشِينَه بها في الدُّنيا؛ كان حقًّا على الله أن يُذِيبَهُ بها مِن النَّار حتى يأتِيَ بنَفاذِها»؛ رواه الطبراني.
ألا وإنَّ مَن أشاعَ إشاعةً فهو كبادِيها، وعليه وِزرُها ووِزرُ مَن نقَلَها عنه إلى مُنتهاها.
فعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سمِعَ»؛ رواه مسلم.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15].
الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي صانَ بدِينِه الدماءَ والأعراضَ والأموالَ، وتوعَّدَ المُعتَدِي عليها بالأفعال والأقوال، وجعلَ المُؤمنين إخوَة، وزرَعَ بينهم مودَّةً ورحمة.
معاشِر المُسلمين:
إنَّ الاستِطالةَ على الحُرُمات، وتتبُّع العَورات مِن أعزم المصائِبِ والابتِلاءات، ومِن أشدِّ الفِتَن وأكبَر المُنكَرات، ومِن نتائِجِه ضَعفُ الإيمانِ في النُّفوس.
فعن أبي بَرْزَة الأسلميِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشَرَ مَن آمَنَ بلِسانِهِ ولم يدخُلِ الإيمانُ قَلبَه! لا تغتابُوا المُسلمين، ولا تتَّبِعُوا عَوراتِهم؛ فإنَّه مَن يتَّبِع عَوراتِهم يتَّبِعُ اللهُ عَورَتَه، ومَن يتَّبِع اللهُ عَورَتَه يفضَحْه في بَيتِه»؛ رواه أحمد.
فصُونُوا أعراضَكم، واحفَظُوا ألسِنَتكم.
عباد الله:
إنَّ للمُسلم حُرمةً عظيمةً، قد حماها الشَّرعُ وصانَها، وتوعَّدَ مَن تعدَّى عليها، فلا ينبغي للمُسلم أن يتطاوَلَ عليها، ولا أن يسعَى في هَتْكِها.
نظرَ عبدُ الله بن عُمر - رضي الله عنهما - يومًا إلى الكعبةِ فقال: "ما أعظمَكِ وأعظَمَ حُرمَتَكِ! ولَلمُؤمنُ أعظَمُ عند اللهِ حُرمَةً مِنكِ".
وعن أبي بَكْرةَ - رضي الله عنه - قال: خطَبَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحر فقال: «أتَدرُونَ أيُّ يومٍ هذا؟»، قُلنا: اللهُ ورسولُه أعلَم، فسَكَت حتى ظنَّنا أنَّه سيُسمِّيه بغَير اسمِه، قال: «ألَيسَ يومَ النَّحر؟»، قُلنا: بَلَى، قال: «أيُّ شَهرٍ هذا؟»، قُلنا: اللهُ ورسولُه أعلَم، فسَكَت حتى ظنَّنا أنَّه سيُسمِّيه بغَير اسمِه، قال: «ألَيسَ ذو الحَجَّة؟»، قُلنا: بَلَى، قال: «أيُّ بلدٍ هذا؟»، قُلنا: اللهُ ورسولُه أعلم، فسَكَت حتى ظنَّنا أنَّه سيُسمِّيه بغَير اسمِه، قال: «ألَيسَت بالبَلدَة الحرام؟»، قُلنا: بَلَى، قال: «فإنَّ دِماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكُم حرامٌ كحُرمةِ يَومِكم، في شَهرِكم هذا، في بلَدِكم هذا إلأى يوم تَلقَونَ ربَّكم، ألا هل بلَّغتَ؟»، قالُوا: نعم، قال: «اللهم اشهَد، فليُبلِّغِ الشاهِدُ الغائِبَ؛ فرُبَّ مُبلَّغٍ أوعَى مِن سامِعٍ، فلا ترجِعُوا بعدِي كفَّارًا يضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ»؛ رواه البخاري.
عباد الله:
إنَّ اجتِنابَ المُحرَّمات والمحظُورات مُقدَّمٌ على فعلِ الطاعاتِ والحسنات والأعمال الصالِحات، وإنَّ المُفلِسَ هو الذي يكِدُّ ويعملُ ويجمَعُ، ولكنَّهُ سفِيهٌ يُبذِّرُ ما جمَع.
فعن أبي هُريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتَدرُون مَن المُفلِسُ؟»، قالُوا: المُفلِسُ فِينا مَن لا دِرهَمَ له ولا متاع، فقال: «إنَّ المُفلِسَ مِن أمَّتِي يأتِي يوم القِيامة بصَلاةٍ وصِيامٍ وزكاةٍ، ويأتِي وقد شتَمَ هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفَكَ دمَ هذا، وضرَبَ هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناتِه، وهذا مِن حسناتِه، فإن فَنِيَت حسناتُه قبل أن يُقضَى ما علَيه، أُخِذَ مِن خطاياهم فطُرِحَت عليه ثم طُرِحَ في النَّار».
معاشِر المُسلمين:
إنَّ المملكة العربيةَ السعوديةَ بلادَ الحرمَين الشريفَين، مهبِطُ الوحي وقِبلةُ المُسلمين، ومهوَى أفئِدتِهم، اختارَه الله مُنطلَقًا لدِينِه، ومِنبرًا للدعوةِ إليه، ومأوًى للمُوحِّدين. فانتشَرَ مِنها شُعاعُ الإسلام، وأرسَت مبادِئَ الوسطيَّة والسلام، والعلمَ والإيمان، وضمَّت ضمَّةَ الأُم - وبكلِّ حَنانٍ - كلَّ مَن وفَدَ إليها مِن المُسلمين.
فجزَى الله وُلاةَ أمرِها خيرَ الجزاء.
ألا وإنَّ الإرجافَ والإشاعات والبلابِل التي يُضرِمُها الحاسِدُون، ويُشيعُها الحاقِدُون على هذه البِلاد المُبارَكة إنَّما هي فِتَنٌ وحَربٌ ضَرُوسٌ، يشُنُّها أعداءُ دِينِنا المُتربِّصِين بأمَّتِنا.
فنضرَعُ إلى الله، ونَدرَأُ به في نُحورِهم.
اللهم احفَظ هذه البلادَ بحفظِك، واكلَأها برِعايتِك، اللهم اجعَلها آمنةً مُطمئنَّةً، وسائرَ بلادِ المُسلمين يا ربَّ العالمين.
اللهم مَن أرادَ بها سُوءًا فأشغِله في نفسِه، ورُدَّ كيدَه في نَحرِه يا قويُّ يا عزيز.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين بتوفيقِك، وأيِّده بتأييدِك، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما تُحبُّ وترضَى يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين، وانصُر عبادَك المُوحِّدين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكان يا ربَّ العالمين.
اللهم لك الحمدُ ربَّنا على ما أنزَلتَ مِن خيرٍ عَمِيم، اللهم فاجعَله قُوَّةً لنا وبلاغًا إلى حِين.
عباد الله:
صلُّوا وسلِّمُوا على مَن أمَرَكم الله بالصلاةِ والسلامِ عليه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم برحمتِك يا أرحم الراحمين.
خطب الحرمين الشريفين

الرحمةُ والتراحُم في الكتاب والسنَّة
ألقى فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الرحمةُ والتراحُم في الكتاب والسنَّة"، والتي تحدَّث فيها عن الرحمةِ، وأنَّها صِفةٌ مِن صفاتِ الربِّ - سبحانه وتعالى -، مُبيِّنًا آثار رحمةِ الله تعالى على خلقِه كما ورَدَ في كتابِ الله تعالى، ثم عرَّجَ على ذِكرِ بعضِ النماذِج المُضِيئةِ مِن رحمةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمُختَلَف فِئات المُجتمَع: الأطفال، والنساء، والمرضَى، والخَدَم، والضُّعفاء، وحتى البهائِم والحيوانات، كما ذكَرَ أنَّ رحمةَ العِبادِ ببعضِهم سببٌ في رحمةِ الله تعالى لهم يوم القِيامَة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله وسِعَ كلَّ شيءٍ برحمتِه، وعمَّ كلَّ حيٍّ بفضلِه ومِنَّتِه وكرمِه، وخضَعَت الخلائِقُ لكِبريائِه وعظمَتِه، يُسبِّحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ مِن خِيفَتِه، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له في ربوبيَّته وألوهيَّته وأسمائِه وصِفاتِه، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه، وخيرتُه مِن خلقِه، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وأصحابِه، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ .. معاشِر المُؤمنين:
فأُوصِيكم ونفسي بتقوَى الله - عزَّ وجل -؛ فإنَّها وصيَّةُ الله لأولين والآخرين: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131].
أمةَ الإسلام:
الرحمةُ صِفةٌ مِن صِفات ربِّنا الكريم، كتبَها - سبحانه - على نفسِه، فوسِعَ بها كلَّ شيء، وعمَّ بها كلَّ حيٍّ، فهو الرحمنُ الرحيم، وأرحمُ الراحمين، يداهُ مبسُوطتان آناء الليل وأطراف النهار، يُوالِي على عبادِه بنعمِه، وعطاؤُه أحبُّ إليه مِن منعِه، ورحمتُه - جلَّ جلالُه - غلَبَت غضَبَه.
وفي "الصحيحين": قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لما قضَى اللهُ الخلقَ، كتَبَ عنده فوقَ عرشِهِ: إنَّ رحمَتِي سبَقَت غضَبِي».
وآثارُ رحمتِه - جلَّ جلالُه، وتقدَّسَت أسماؤُه - ظاهرةٌ في خلقِه، بيِّنةٌ في آياتِه، ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: 73]، ومِن رحمتِه - سبحانه - ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الروم: 46]، ويُنزِّلُ الغيثَ، ويُحيِي الأرضَ بعد موتِها، ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: 28].
ومِن آثار رحمتِه - تبارك وتعالى - ما نشَرَه من رحمةٍ بين الخلائِق؛ فما هذه الرحمةُ التي يتراحَمُون بها إلا شيءٌ يسيرٌ مِن رحمةِ أرحم الراحمين.
ففي "الصحيحين": أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلَ الله الرحمةَ مائةَ جُزءٍ، فأمسَكَ عنده تسعةً تسعين جُزءًا، وأنزلَ في الأرض جُزءًا واحدًا، فمِن ذلك الجُزء يتراحَمُ الخلقُ، حتى ترفَعَ الفرَسُ حافِرَها عن ولدِها خشيةَ أن تُصيبَه».
والله - تبارك وتعالى - أرحَمُ بعبادِه مِن الوالِدةِ بولدِها.
ففي مشهَدٍ عجيبٍ يصِفُه لنا الفارُوقُ - رضي الله عنه - بقولِه: لما قدِمَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بسَبْيٍ، فإذا امرأةٌ مِن السَّبْيِ تبتَغِي، إذا وجَدَت صبِيًّا في السَّبْيِ، أخَذَتْه فألصَقَتْه ببطنِها وأرضَعَتْه، فقال لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتَرَونَ هذه المرأةَ طارِحةً ولَدَها في النَّار؟»، قُلنا: لا والله، وهي تقدِرُ على ألا تطرحَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لله أرحَمُ بعبادِهِ مِن هذه بولَدِها»؛ رواه البخاري ومسلم.
ومِن رحمتِه - سبحانه - بعبادِه المُؤمنين: أنَّه ينزِلُ كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا نُزولًا يلِيقُ بجلالِه؛ إكرامًا بالسائِلِين، ورحمةً بالمُستغفِرين التائِبِين.
ففي الحديث المُتفق على صحَّته: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ينزِلُ ربُّنا - تبارك وتعالى - كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ الليل الآخر يقولُ: مَن يدعُوني فأستجِيبَ له؟ مَن يسأَلُني فأُعطِيَه؟ مَن يستغفِرُني فأغفِرَ له؟».
وتتجلَّى رحمتُه - جلَّ جلالُه - بفَتحِ يدِه للمُسرِفين، وبَسطِ يَدِه للتائِبِين: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].
ومِن رحمتِه - سبحانه -: أن جعَلَ حمَلَة العرشِ ومَن حولَه يُسبِّحُون بحمدِ ربِّهم، ويستغفِرُون ويشفَعُون للذين آمنوا ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر: 7- 9].
والجنَّةُ - يا عباد الله - رحمةُ الله - تبارك وتعالى - يُدخِلُها مَن يشاءُ مِن عبادِه برحمتِه، ولا يبلُغُها أحدٌ بعملِه؛ فلو أتَى العبدُ بكلِّ ما يقدِرُ عليه مِن الطاعات ظاهرًا وباطنًا، لم يعبُد اللهَ حقَّ عبادتِه، ولم يُؤدِّ شُكرَ نعمِه.
ففي "الصحيحين": قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يُدخِلَ أحدًا مِنكم عملُه الجنَّة»، قالُوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أنا، إلأا أن يتغمَّدَني الله مِنه بفضلٍ ورحمةٍ».
ومَن نظرَ في سيرة سيِّد ولدِ آدم - صلى الله عليه وسلم - يجِدُ الرحمةَ في أكمل صُورها، وأعظم معانِيها قد حفَلَت بها سِيرتُه، وامتلأَت بها شريعتُه؛ فكان - صلى الله عليه وسلم - يعطِفُ على الصِّغار، ويرِقُّ لهم، ويُقبِّلُهم، ويُلاعِبُهم، ويقولُ: «مَن لا يرحَمُ لا يُرحَمُ».
وفي "صحيح البخاري": لما دخَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنِه إبراهيم وهو في سكَرَات الموت، جعَلَت عَينَا رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تذرِفَان، فقال له عبدُ الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: وأنتَ يا رسولَ الله! - يعني: تبكِي -، فقال: «يا ابنَ عوفٍ! إنَّها رحمةٌ»، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ العَينَ تدمَعُ، والقلبَ يحزَنُ، ولا نقُولُ إلا ما يُرضِي ربَّنا، وإنَّا بفِراقِك يا إبراهيمُ لمحزُونُون».
فما عرَفَت البشريَّةُ أحدًا أرحَمَ بالصِّغار مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى قال عنه خادِمُه أنسٌ: "ما رأيتُ أحدًا كان أرحَمَ بالعِيالِ مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -".
وأما النِّساء؛ فكانت الرحمةُ بهنَّ مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أعظَم، والرِّفقُ بهنَّ أكثَر، والوصِيَّةُ في حقِّهنَّ آكَد، فحثَّ - صلى الله عليه وسلم - على الرحمةِ بالبَناتِ، والإحسانِ إليهنَّ.
ففي "صحيح البخاري": قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن يَلِي مِن هذه البَناتِ شيئًا فأحسَنَ إليهنَّ، كُنَّ له سِترًا مِن النَّار».
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله - فيما ولَّاكم الله عليه.
ففي "سنن الترمذي" بسندٍ صحيحٍ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خَيرُكُم خَيرُكُم لأهلِهِ، وأنا خَيرُكُم لأهلِي».
وكان - صلى الله عليه وسلم - يرحَمُ الضُّعفاءَ والخَدَمَ، ويهتمُّ بأمرِهم؛ خشيةَ وقوعِ الظُّلم عليهم، والاستِيلاءِ على حُقوقِهم.
وجعلَ - عليه الصلاة والسلام - العطفَ والرحمةَ بالمساكين والضُّعفاء مِن أسبابِ الرِّزقِ والنَّصرِ على الأعداء.
ففي "سنن أبي داود" بسندٍ صحيحٍ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ابغُونِي ضُعفاءَكم» أي: اطلُبُوا رِضائِي في ضُعفائِكم، «فإنَّما تُرزَقُون وتُنصَرُون بضُعفائِكم».
وفي يوم فَتحِ مكَّة، لما مكَّن الله لرسولِه - صلى الله عليه وسلم -، ما كان مِنه إلا أن أعلَنَ عفوَه عن أعدائِه الذين أخرَجُوه مِن أرضِهِ، وائتَمَرُوا على قتلِه، ولم يدَّخِرُوا وُسعًا في إلحاقِ الأذَى بِهِ وبأصحابِهِ، فقابَلَ - صلى الله عليه وسلم - الإساءةَ بالإحسانِ، والأذِيَّةَ بحُسن المُعاملَة.
ولما بلَغَه قولُ سعدٍ - رضي الله عنه وأرضاه -: "اليوم يومُ المَلحَمَة!"، أي: يوم الحَربِ والقَتلِ، أعلَنَ - صلى الله عليه وسلم - رحمتَه صريحةً واضِحةً، فقال: «اليوم يومُ المَرحَمَة».
فرَحِمَ - صلى الله عليه وسلم - الصَّغيرَ والكبيرَ، والقريبَ والبعيدَ، والعدوَّ والصَّديقَ، بل شمَلَت رحمتُهُ الحيوانَ والجماد، وما مِن سبيلٍ يُوصِلُ إلى رحمةِ الله إلا جلَّاه لأمَّته، وحثَّهم على سُلُوكِه، وما مِن طريقٍ يُبعِدُ عن رحمةِ الله إلا زجَرَ عنه، وحذَّرَ أمَّتَه مِنه.
فكانت حياتُه - صلى الله عليه وسلم - كلُّها رحمة، إي وربِّي الذي لا إله إلا هو؛ فهو - بأبي وأُمِّي - عليه الصلاة والسلام - رحمةٌ، وشريعتُه رحمةٌ، وسِيرتُه رحمةٌ، وسُنَّتُه رحمةٌ، وصدَقَ الله إذ يقُولُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
بارَك الله لي ولكم في القرآنِ والسنَّة، ونفعَني وإيَّاكُم بِمَا فِيهما مِن الآياتِ والحِكمة، أقولُ ما تسمَعُون، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم، فاستغفِروه؛ إنَّه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله المُبدِئ المُعِيد، الفعَّال لما يُريد، الرحيم بعِبادِه المُؤمنين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ الحقُّ المُبين، وأشهدُ أن مُحمدًا عبدُه ورسولُه إمامُ المُتَّقين، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِه وصحبهِ أجمعين.
أما بعدُ .. معاشِرَ المؤمنين:
إنَّ دينَ الإسلام دينُ سماحةٍ ورحمةٍ، وسلامٍ للبشريَّة، دعَا إلى التراحُم، وجعلَه مِن دلائِلِ كمالِ الإيمانِ.
ففي "السنن الكُبرى" للنسائيِّ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسِي بيَدِه؛ لا تدخُلُوا الجنَّةَ حتى تراحَمُوا»، قالُوا: يا رسولَ الله! كلُّنا رحيمٌ، قال: «إنَّه ليس برَحمةِ أحدِكم خاصَّته، ولكن رحمةُ العامَّة».
نعم .. يا عباد الله:
إنَّها الرحمةُ العامَّة التي تسَعُ الخلقَ كلَّهم، وهي مِن أعظم أسبابِ رحمةِ الله تعالى، كما أنَّ عدَمَها - أجارَنا الله وإيَّاكُم - سببٌ للحِرمانِ مِن رحمةِ الله.
ففي "الصحيحين": يقولُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن لا يَرحَم النَّاسَ لا يَرحَمُه الله - عزَّ وجل -».
وإنَّ أَولَى النَّاسِ بالرَّحمةِ، وأحقَّهم وأَولاهم بها: الوالِدان؛ فبالإحسانِ إليهما تكون السعادة، وببِرِّهما تُستجلَبُ الرحمة، وخاصَّةً عند كِبَرهما؛ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23، 24].
ومِن العلاقات البشريَّة والروابِط الاجتِماعيَّة التي لا تستقِيمُ إلا بخُلُق الرحمةِ: العِلاقةَ الزَّوجيَّة؛ فهي مبنِيَّةٌ على المودَّة والرَّحمة، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وقد تضعُفُ المودَّةُ بين الزَّوجَين، فيشُدُّ وَثاقَها خُلُق الرحمة؛ فترحَمُ المرأةُ زوجَها، ويرحَمُ الرجُلُ امرأتَهُ، ويمتَدُّ أثَرُ هذه الرحمةِ للبَنِين والبَناتِ، فتنشَأُ داخِلَ هذه الأُسَر المرحُومة نُفوسٌ مُطمئنَّةٌ، وطِباعٌ سليمةٌ مُستقيمةٌ.
وإذا كان للقريبِ نصِيبٌ وحقٌّ مِن الرحمةِ، فالغرِيبُ كذلك له حظٌّ ونصِيبٌ، خاصَّةً كِبار السنِّ، والضُّعفاء، وذوُو الحاجات.
فتخلَّقُوا - معاشِر المُؤمنين - بخُلُق الرحمة، وارحَمُوا مَن ولَّاكُم الله عليهم، وتراحَمُوا فيما بينَكم؛ تفُوزُوا برحمةِ أرحم الراحمين.
ففي "سنن الترمذي" بسندٍ صحيحٍ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّاحِمُون يرحَمُهم الرَّحمن، ارحَمُوا مَن في الأرضِ يرحَمكم مَن في السَّماء».
ثم اعلَمُوا - معاشِر المُؤمنين - أنَّ رحمةَ الله - تبارك وتعالى - تُستجلَبُ بطاعتِه وطاعةِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، والاستِقامةِ على أمرِه، وكلما كان نصِيبُ العبدِ مِن الطاعةِ أتمَّ، كان حظُّه مِن رحمةِ الله أوفَر، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].
معاشِرَ المُؤمنين:
إنَّ الله أمرَكم بأمرٍ كريمٍ، ابتدَأ فيه بنفسِه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الراشِدِين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائِرِ الصحابةِ والتابِعِين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعَفوِك وكَرمِك وجُودِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين، واحمِ حَوزةَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، رخاءً سخاءً، وسائرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتِك نستَغِيثُ، أصلِح لنا شأنَنا كلَّه، ولا تكِلنا إلى أنفُسِنا طرفَةَ عينٍ.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوبِين، واقضِ الدَّينَ عن المَدِينين، واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتِك يا أرحَم الراحمين.
اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ، اللهم أصلِح أحوالَ المُسلمين في كل مكانٍ.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفِّق إمامَنا بتوفيقِك، وأيِّده بتأيِيدِك، واجزِه خَيرَ الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا ربَّ العالمين، اللهم وفِّقه وولِيَّ عهدِه لِما تُحبُّه وترضاه، اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لما تُحبُّ وترضَى برحمتِك يا ربَّ العالمين.
اللهم مَن أرادَنا وبلادَنا وأمنَنا ورِجالَ أمنِنا بسُوءٍ فاجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا قويُّ يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنَّا ندرَأُ بك في نُحورِهم، ونعُوذُ بك مِن شُرورِهم.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابطين على حُدودِ بلادِنا، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم رُدَّهم إلى أهلِيهم سالِمين مُنتَصِرين، وبالأُجُور غانِمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
خطب الحرمين الشريفين

اقرأوا التاريخ .. إذ فيه العِبَر
ألقى فضيلة الخطيب: الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "اقرأوا التاريخ .. إذ فيه العِبَر"، والتي تحدَّث فيها عن التعاطِي مع الشائِعات والأخبار المُلفَّقة، مُحذِّرًا من كلِّ ما مِن شأنِه تقويض أمنِ بلادِ الإسلام، والفُرقة بين المُسلمين، وزَعزَعةِ الثوابِتِ.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله تفرَّد بكلِّ كمال، بيَدِه الخير ومِنه الخيرُ وله الحمدُ على كلِّ حالٍ وفي كلِّ حال، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه تفضَّلَ بجَزيلِ النَّوال في جميعِ الأحوال، جوادٌ كريمٌ يبدأُ بالإحسان قبل السُّؤال، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له تنزَّهَ عن الأشبَاه والأندَاد والأمثَال، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه الصادِقُ الأمين، شريفُ الخِصال، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آلِهِ وأصحابِه خيرِ صحبٍ وآل، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ وسارَ على الحقِّ والهُدى واجتنَبَ سُبُل الضَّلال، وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم المآل.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم - أيها الناس - ونفسِي بتقوَى الله، فاتَّقُوا الله - رحِمَكم الله -، وتزوَّدُوا مِن ممرِّكم لمقرِّكم، واحذَرُوا التوانِيَ والغفلة، وأحسِنُوا العملَ في هذه الدار، واجتَهِدُوا فيما بقِيَ مِن الأعمار.
طهِّرُوا بفَيضِ الدَّمع أدرَانَ القلوب، وأيقِظُوها بتجافِي الجُنُوب. جعَلَني الله وإياكم ممَّن تنفَعه المواعِظُ الزاجِرة، وجمعَ لي ولكم خيرَي الدنيا والآخرة؛ فمتاعُ الدنيا قليلٌ، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: 77].
أيها المُسلمون:
التعاطِي مع الأحداث وأخذُ العِبَر يكونُ بصِدقِ التعلُّقِ بالله، ثم بالعقل الحَصِيف، والهُدوء الحَذِر، والحِكمةُ ضالَّةُ المُؤمن، وليس التذمُّر مُصلِحًا للأُمم، والنَّقدُ وحدَه لا يُقدِّمُ مشرُوعًا، ورُدودُ الأفعال المُجرَّدة لا تبنِي رُؤيةً راشِدة.
وفي بعضِ اللَّحظات والمحطَّات قد يحتاجُ المرءُ إلى التأكيد على الثوابِتِ، والتركيزِ على الأُسس أمام سَيل الإعلام الجارِفِ بأدواتِه ومواقِعِه، وما يحفَلُ به مِن تلبيسٍ في الطَّرح، وانحِرافٍ في التَّحليل، وتعسُّفٍ في التفسير، وعبَثٍ بالكلِمات والمُصطلَحات، ناهِيكم بالتضليلِ والتزيِيف، وخَلطِ الأوراقِ؛ كلُّ ذلك لإيجادِ مزيدٍ مِن التوتُّر والبَلبَلة، عن طريقِ مُعرِّفاتٍ مجاهِيل في مصالِح ضيِّقة، أو نوائِحَ مُستأجَرة.
معاشِرَ الأحِبَّة:
حين يتداعَى المُرجِفُون، ويتطاوَلُ المُتربِّصُون، فإنَّ الذَّبَّ عن الدين، ولُزومَ الجماعة، والاجتِماعَ على القِيادة يكونُ لِزامًا مُتحتِّمًا مِن أجل صدِّ الشائِعات، وإبقاءِ اللُّحمَة، والحِفاظِ على الوِحدة.
والعاقلُ المُتأمِّل يرَى مِن حوله سُفُنًا تُخرَق، وأخرى تغرَق. فالحَذَرَ الحَذَرَ مِن مُفسِدٍ أو حاقِدٍ، أو طامِعٍ أو حاسِدٍ، أو جاهلٍ ليتعدَّى على السفينة فيخرِقَها ثم يُغرِقَها. وقد يكون ذلك مِن خلال حديثٍ مكذُوب، أو استِدلالٍ مُحرَّف، أو تعليقٍ مُرِيبٍ، أو تفسيرٍ مُتعسِّفٍ.
معاشِر المُسلمين:
وإن شئتُم نموذجًا لهذه السَّفينة المُستهدَفة، فتأمَّلُوا ما يُحاوِلُ فيه بعضُ المُتربِّصين، وذوِي الأغراض والأهواء، والمُتطرِّفين مِن النَّيل مِن حِصن الدين، وقِبلةِ المُسلمين بلادِ الحرمَين الشريفَين، مأرِزِ الإيمان، ورافِعةِ لِواءِ الشَّرع، وتحكيمِ الكتابِ والسنَّة، غايتُها في رايتِها "لا إله إلا الله، مُحمدٌ رسولُ الله"، توحيدُ الله شِعارُها، والحُكمُ بما أنزل الله دُستُورُها، والبَيعةُ على كتابِ الله وسُنَّة رسولِه مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَهجُها، والدينُ والحُكمُ فيها أخَوَان، مما ينتَظِمُ سياسة الدين والدُّنيا.
العقيدةُ، والوحدةُ الوطنيَّة، ولُزومُ الجماعة، والحِفاظُ على البَيعَة، وحِمايةُ المُقدَّسات هي الأعلى والأغلى في أهدافِ الدولة وخُططها وبرامِجِها.
دولةٌ عربيةٌ إسلاميَّةٌ، حافِظةٌ - بعَون الله وتوفيقِه - أمنَ الحرمَين الشريفَين، وراعِيتُهما، وخادمتُهما، مُحافِظةٌ على المُقدَّساتِ والشَّعائِر والمشاعِر. معقِلُ التوحيد والسنَّة، ودارُ المُسلمين. وطنٌ يسكُنُ التارِيخ، ويسكُنُه التارِيخ.
إنَّها دولةٌ كبيرةٌ - ولله الحمدُ والمِنَّة - بدينِها وأهلِها وقيادتِها وتأريخِها، مُؤثِّرةٌ في ميزانِها وموقعِها واقتِصادِها وسياستِها وقوَّتها وقرارِها، وستبقَى - بإذن الله - لها أدوارُها وعلاقاتُها الواسِعة الرَّزِينة الرَّصِينة، ونفوذُها النَّفَّاذ.
العُقلاءُ يُدرِكُون أنَّ هذه البِلادَ لو تأثَّر موقِعُها فسَوفَ تتوسَّعُ دائِرةُ القلقِ والفشل والتمزُّق في المنطِقة وخارِج المنطِقة.
إنَّ المُتربِّصين، وذوِي الأهواء، والقُوَى المُتطرِّفة يستَهدِفُون هذه البِلاد بسُمعتها وتأثيرِها وقوَّتها ووحدتِها، وثِقَلها الدينيِّ والسياسيِّ والاقتِصاديِّ والعسكريِّ.
وانظُر فيمَن يُحاوِلُ التطاوُلَ على بِلادِ الحرمَين الشريفَين، لا تكادُ تراهُ إلا مُتَّهمًا في مقصِدِه، أو إمَّعةً يَسِيرُ خلفَ كلِّ ناعِقٍ، ناهِيكُم بأنَّ كثيرًا مما يُطرَح ما هو إلا تنفِيسٌ على غاياتٍ مدخُولَة.
وقد قال الإمامُ الشافعيُّ - رحمه الله -: "تتبَّع سِهامَ المُخالِفين حتى تُرشِدَك إلى الحقِّ".
وإنَّ مما هو معرُوفٌ - ولله الحمدُ - أنَّ هذا الاستِهدافَ لم يكُن وَلِيدَ السَّاعة، بل هو قديمٌ يتجدَّدُ أو يتلوَّنُ حسبَ الظُّروف والمُستجِدَّات والأغراض، وفي كلِّ ذلك تخرُجُ هذه الدولةُ المُبارَكة مرفوعةَ الرأس، مُنتصِرةً لصِدقِها مع ربِّها، ومع شعبِها، ومع المُسلمين، وصِدقِ علاقاتِها، ووضُوحِ مَنهَجها، وجلاءِ تعامُلِها.
بل كثيرٌ ما انقَلَبَت القضايا المُثارَة ضدَّ أصحابِها، بل إنَّها تُفسِدُ عليهم أهدافَهم، وتخرُجُ هذه البِلادُ مُنتصِرةً، قد زادَت قُوَّةً إلى قُوَّتها، وعِزًّا إلى عِزِّها.
ومِن القواعِدِ المشهُورة: الأزمات تشُدُّ مِن قوَّة الدولة المُستقِرَّة، وتُؤكِّدُ مكانتَها ورُسُوخَها، وتعاظُمَ دَورِها، ومِن المعلُوم أنَّ هذه البِلاد المُبارَكة مِن أكثر الدول استِقرارًا. فلله الحمدُ والمنَّة.
معاشِر الأحِبَّة:
الحَذَرَ ثم الحَذَرَ مِن الإفراطِ في التعمِيم، ثم التوظيفِ والتسيِيس، والاستِهدافِ والهُجُوم، والخَلط في القضايا، بل التلبِيس في الطَّرح والتحليل والتفسير. فاستِقرارُ الحُكم يغِيظُ المُتربِّصين، والالتِفافُ حولَ القِيادة يَكِيدُ الشَّانِئين، في تصيُّدٍ مَقِيت، وتلفِيقاتٍ آثِمة.
ثم الحَذَر مِن إضاعَة المكاسِب، وإزالَة النِّعمة نعمةِ علُوِّ الدين، واجتِماعِ الكلِمة، ورَغَد العَيش، وبَسطِ الأمن، والالتِفافِ حول وُلاةِ الأمر، والنُّصحِ الصَّادِقِ، والسَّعيِ في الإصلاحِ، والوقوفِ في وجهِ كلِّ مُتربِّصٍ، والتحدُّثِ بنِعَم الله في إبداءِ المحاسِنِ، والخوفِ مِن التنكُّر للنِّعَم بالتبرُّم وتَعدادِ النَّقائِصِ.
وبعدُ .. رحِمَكم الله:
فاستَيقِنُوا ثم استَيقِنُوا أنَّ منعَ الفِتَن أسهَلُ مِن دَفعِها، ومَن لم يعتَبِر جعلَ نفسَه عِبرةً لمَن يعتبِر، ومَن لم يقرَأ التارِيخَ ينسَاهُ التاريخ.
حفِظَ الله بلادَ الحرمَين الشريفَين، وحفِظَ عليها إيمانَها وأمنَها، وزادَ مِن لُحمَتها وتماسُكِها، وكبَتَ عدوَّها، ونصَرَها على كلِّ مَن أرادَ بها سُوءًا، ونعوذُ بالله مِن التقلُّبات السياسيَّة، والحُروبِ الأهليَّة، والتحزُّبات والطَّائِفيَّة، والتوجُّهات العُنصريَّة، والمسالِك التصريفيَّة، وحفِظَ بلادَ المُسلمين أجمعين، وجمعَ كلمتَهم على الحقِّ والهُدى والسنَّة، إنه سميعٌ مُجيب.
أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: 55، 56].
نفَعَني اللهُ وإياكم بالقرآن العظيم، وبهَديِ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وأقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله على إنعامِه الموفُور، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا مُتوالِيًا على مرِّ الدُّهور، وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً تُؤنِسُ في وحشَة القُبُور، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه جاء بالحقِّ والهُدى والنُّور، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آلِهِ وأصحابِه ذَوِي القَدر العلِيِّ والفضلِ المشهُور، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم النُّشُور.
أما بعد .. معاشِر المُسلمين:
الكمالُ عزيز، والخطأُ والقُصورُ مِن شأنِ البشَر، والذين لا يُخطِؤُون هم الذين لا يعمَلُون، ومسارُ الدولة والأمة يتطلَّبُ العقلَ والحِكمةَ والأناة والسَّير بخُطًى ثابتةٍ غير مُتوقِّفة، في حكمةٍ ووعيٍ وتمييزٍ بين الثابِتِ والمُتغيِّر، في قُوَّةٍ راشِدة، وتنميةٍ مُخطَّطة، وحَزمٍ وعَزمٍ، يُحيطُ بذلك كلِّه رحمةٌ ورِفقٌ وإحسانٌ. والنَّقصُ يُعالَج، والمُعوَجُّ يُقوَّم تحت مِظلَّة الوِلاية الشرعيَّة.
ألا فاتَّقُوا اللهَ - رحِمَكم الله -، واعلَمُوا أنَّ المُبالَغَةَ في مُلاحقة التغريدات، والإكثارَ في تتبُّع أخبارِ القائِمين على بُؤَر التوتُّر، يُوقِعُ في ضلالٍ وحَيرةٍ وإرباكٍ، عاقِبتُه التشتُّت والانشِقاق والتصدُّعات، وهَدمُ المُكتَسَبات، وحاصِلُه فوضَى فِكريَّة، وتعليقاتٌ يائِسة، ومُداخلاتٌ بائِسة، يختلِطُ فيها الحابِلُ بالنَّابِل، ونتيجتُها الفُرقة، وعاقِبتُها نُفوسٌ سَوداء، وأحقادٌ مُتبادَلة مِن غير مُسوِّغٍ ولا معقُوليَّة.
والسلامةُ في ذلك الأخذُ بالقاعِدةِ السُّليمانيَّة، قاعِدة سُليمان بن دواد - عليهما وعلى نبيِّنا أفضلُ الصلاة والسلام -، في قولِه - عزَّ شأنُه - حِكايةً عنه: ﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: 27]، مع أنَّ الهُدهُد قد قال على سَبِيل الجَزمِ: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: 22].
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا على الرحمةِ المُهداة، والنِّعمةِ المُسداة: نبيِّكُم مُحمدٍ رسولِ الله؛ فقد أمرَكم بذلك ربُّكم، فقال عزَّ قائِلًا عليمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك: نبيِّنا مُحمدٍ الحبيبِ المُصطفى، والنبيِّ المُجتبَى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجِه أمهاتِ المُؤمنين، وارضَ اللهم عن الخلفاءِ الأربعةِ الراشدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الصحابةِ أجمعين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وجُودِك وإحسانِك يا أكرَمَ الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذلَّ الشركَ والمُشركين، واخذُل الطُّغاةَ، والملاحِدَة، وسائرَ أعداءِ المِلَّة والدين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتَنا وولاةَ أمُورِنا، واجعَل اللهم ولايتَنَا فيمَن خافَك واتَّقاك واتَّبَع رِضاكَ يا رب العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا وولِيَّ أمرِنا بتوفيقِك، وأعِزَّه بطاعتِك، وأَعلِ به كلمَتَك، واجعَله نُصرةً للإسلامِ والمسلمين، ووفِّقه ووليَّ عهدِه وإخوانَه وأعوانَه لِما تُحبُّ وترضَى، وخُذ بنواصِيهم للبرِّ والتقوَى.
اللهم وفِّق وُلاةَ أمورِ المُسلمين للعَملِ بكتابِك، وبسُنَّةِ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، واجعَلهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمَع كلمتَهم على الحقِّ والهُدَى يا ربَّ العالمين.
اللهم أصلِح أحوال المُسلمين، اللهم أصلِح أحوال المُسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم، واجمَع على الحقِّ والهُدى والسنَّة كلِمتَهم، وولِّ عليهم خيارَهم، واكفِهم أشرارَهم، وابسُط الأمنَ والعدلَ والرَخاءَ في ديارِهم، اللهم وأعِذهم مِن الشُّرور والفتَن ما ظهَرَ مِنها وما بطَن.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ دينَنا وديارَنا وأمَّتَنا وأمنَنا ووُلاةَ أمرِنا وعُلماءَ وأهلَ الفضل والاحتِسابِ منَّا ورِجالَ أمنِنا ووحدتَنا واجتِماعَ كلمتِنا، اللهم مَن أرادَنا بسُوءٍ اللهم فأشغِله بنفسِه، واجعَل كيدَه في نَحرِه، واجعَل تدبيرَه تدميرًا عليه يا ربَّ العالمين.
اللهم انصُر جنودَنا المُرابِطين على حُدودنا، اللهم سدِّد رأيَهم، وصوِّب رميَهم، واشدُد أزرَهم، وقوِّ عزائِمَهم، وثبِّت أقدامَهم، واربِط على قلوبِهم، وانصُرهم على مَن بغَى عليهم، اللهم أيِّدهم بتأيِيدِك، وانصُرهم بنَصرِك، اللهم ارحَم شُهداءَهم، واشفِ جرحاهم، واحفَظهم في أهلِهم وذُرِّيَّاتهم إنَّك سميعُ الدُّعاء.
ربَّنا اغفِر لنا ذنُوبَنا، واستُر عيوبَنا، ونفِّس كُروبَنا، وعَافِ مُبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحَم موتانا.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ يذكُركُم، واشكُرُوه على نعمِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

الدِّينُ النَّصِيحة
ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الدِّينُ النَّصِيحة"، والتي تحدَّث فيها عن النَّصِيحة وأنَّها مِن أعظمِ أمورِ الدين، مِن خلال تسليطِ الضَّوء على حديثِ: «الدِّين النَّصِيحة»، مُبيِّنًا ما تضمَّنه الحديثُ الشريفُ مِن الفوائِد والأحكام.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله ذي العِزِّ والكرَم، بارِئ النَّسَم، واسِعِ الفضلِ والنِّعَم، أحمدُ ربي وأشكرُه على آلائِه التي نعلَم والتي لا نعلَم، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعزُّ الأكرَم، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه الذي آتاه الله جوامِعَ الكلِم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِه الذين هُدُوا إلى الصراطِ الأقوَم.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - جلَّ وعلا - بالتقرُّبِ إليه بالأعمالِ الصالِحات، ومُجانبَة المُحرَّمات؛ فما فازَ إلا المُتَّقُون، وما خابَ وخسِرَ إلا المُتَّبِعُون للأهواءِ والمُفرِّطُون.
أيها المُسلِمون:
حاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبُوا، وأيقِظُوا القلوبَ مِن غفلَتها، وكُفُّوا النُّفوسَ عن مُحرَّمات لذائِذِها، وبادِرُوا بالتوبةِ قبلَ حُلُول الأجل، وانقِطاع الأمل، وتعذُّر العمل. فأنتم ترَون سُرعةَ انقِضاء الأعوام، وتصرُّم الأيام، وما بعد الحياة إلا الممات، وما بعد الموت إلا دارُ النَّعيم أو دارُ العذابِ الأليم.
وكما تعملُون للدُّنيا الفانِية، فاعمَلُوا للآخرة الباقِية، قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: 16، 17].
أيها المُسلمون:
أقبِلُوا على كتابِ ربِّكم؛ ففيه عِزُّكم وسعادتُكم، وصلاحُ أحوالِكم، وفيه فوزُكم بعد موتِكم، وبه عِصمتُكم ونجاتُكم مِن الفِتَن التي تتكاثَر كلما قرُبَت القِيامة، وتَشتَبِهُ في أول وُرودِها، وتَستَبِينُ في آخر أمُورِها، فلا ينجُو مِنها إلا مَن اعتصَمَ بالقُرآن والسنَّة ولُزوم الجماعة.
فتدبَّرُوا كتابَ الله - عزَّ وجل -، واعمَلُوا به، واحفَظُوا مِن سُنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقومُ به الدين، وتصِحُّ به العقيدة، وتكمُلُ به العِبادة، لاسيَّما الأحاديثُ الجامعةُ لأحكام الإسلام، المُشتمِلة على الفضائِل، واعرِفُوا معانِيها للتمسُّك بها والعمل.
فهذا منهَجُ السَّلَف الصالِح الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100].
وأُورِدُ في هذا المقام حديثًا مِن جوامِعِ الكَلِم يجبُ العملُ به على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ في كل الأحوال، ويلزَمُ التمسُّك به مِن الرِّجال والنساء ما دامَت الأرواحُ في الأجساد، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «الدِّينُ النَّصِيحةُ، الدِّينُ النَّصِيحةُ، الدِّينُ النَّصِيحةُ»، قُلنا: لمَن يا رسولَ الله؟ قال: «لله ولكِتابِهِ ولرسولِهِ ولأئمةِ المُسلمين وعامَّتِهم»؛ رواه مسلم مِن حديثِ تميمٍ الدَّاري - رضي الله عنه -.
وقد رواه غيرُ مُسلم كثيرٌ مِن المُحدِّثين، وهو حديثٌ ذُو شأنٍ عظيمٍ.
قال الإمامُ أبو داود: "الفقهُ يدُورُ على خمسَةِ أحاديث: «الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ»، وحديث: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»، وحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات»، وحديث: «الدِّينُ النَّصِيحةُ»، وحديث: «ما نَهَيتُكُم عنه فاجتَنِبُوه، وما أمرتُكُم به فأْتُوا مِنه ما استَطعتُم»".
وقال الحافظُ أبو نُعيمٍ: "هذا حديثٌ له شأنٌ، ذكَرَ مُسلمُ بن أسلَم الطُّوسيُّ أنَّ حديثَ: «الدِّينُ النَّصِيحةُ» أحدُ أرباعِ الدِّين".
ومِن الأدلَّة على أنَّ هذا الحديثَ واجِبٌ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ في كلِّ حالٍ دائمًا: أنَّ الله تعالى أسقَطَ بعضَ العِبادات عن بعضِ المُكلَّفين للعُذر، ولبعضِ الأسبابِ، ولم يُسقِطِ النُّصحَ بأيِّ عُذرٍ، وبأيِّ حالٍ، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 91].
فبيَّن الله أنَّه لا عُذرَ لمُسلمٍ بالتخلِّي عن النَّصِيحة طَرفةَ عينٍ.
ولم يسأَل الصحابةُ عن معنَى النَّصيحة؛ لعِلمِهم بما تدلُّ عليه مِن معانِي الدين الواسِعة، بالمُطابقَة والتضمُّن والالتِزام، فهي تشمَلُ مراتِبَ الإسلام والإيمان والإحسان، وإنَّما سألُوا: لمَن تكونُ، ومَن هم المُستحِقُّون لها؟
وأصلُ معنَى النُّصح: تخلِيصُ الشَّيء مِن الشَّوائِبِ والأخلاطِ والدواخِلِ والمُكدِّرات. يُقال: نصَحَ العسلَ إذا خلَّصَه ونقَّاه مِن الشَّمع.
ومعنَى النَّصيحة لله تعالى: محبَّتُه والتذلُّل والخُضُوعُ له - سبحانه -، والاستِسلامُ والانقِيادُ لشَرعِه طلبًا لرِضوانِه وثوابِه، وخوفًا مِن غضَبِه وعِقابِه، قال - سبحانه -: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة: 15، 16]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].
وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أحِبُّوا اللهَ مِن كلِّ قُلوبِكم؛ لما يَغذُوكم بِه مِن النِّعَم».
وأعظمُ النَّصِيحة لله - عزَّ وجل -: عِبادتُه - سبحانه - وحدَه لا شريكَ له، بإخلاصٍ وسُنَّةٍ ومُتابعَةٍ لهَديِ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وتخصِيصُ الربِّ بأنواعِ العِباداتِ كلِّها بالدُّعاء، والاستِعانة، والاستِغاثة، والتوكُّل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 20].
والربُّ - جلَّ وعلا - يُعبَدُ لِما له مِن صِفاتِ الكمال والجلال، ولتقدُّسِه وتنزُّهِه عن صِفاتِ النَّقصِ، ولِما له على خلقِه مِن النِّعَم، ولافتِقارِ العِبادِ إلى رحمتِه. فالعِبادةُ سببٌ لخَيراتِه، وسببٌ لدَفعِ الشُّرورِ عن الإنسانِ في حياتِه، وبعد مماتِه.
والنَّصِيحةُ لله - تبارك وتعالى - أيضًا بإثباتِ ما أثبَتَه الله لنفسِه في كتابِه، وأثبَتَه له رسولُه - صلى الله عليه وسلم - مِن الأسماء والصِّفاتِ، على ما كان عليه السَّلَفُ الصالِحُ - رضي الله عنهم -.
وعن أبي أُمامةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «قال اللهُ تعالى: أحَبُّ ما تعبَّدَني به عَبدِي النُّصحُ لِي»؛ رواه أحمد والطبرانيُّ في "الكبير".
ومعنَى النَّصِيحة لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: محبَّتُه وتوقيرُه، وتعظيمُ سُنَّته، وفِعلُ أوامِرِه، واجتِنابُ نواهِيه، وعِبادةُ الله بشَرعِه، ومُتابعَةُ هَديِه، وتصدِيقُ أخبارِه، ونشرُ حديثِهِ، والدعوةُ إلى دينِه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54].
ومعنَى النَّصِيحة لكِتابِ الله - تبارك وتعالى -: تعظيمُ القُرآن الكريم ومحبَّتُه، والاجتِهادُ في تعلُّمه وتعليمِه، والتفقُّهِ في أحكامِه، وتلاوتُه تلاوةً صحيحةً، وفِعلُ أوامِرِه، وتركُ نواهِيه، ومُداومةُ تلاوتِه، وحِفظُ حُروفِه وحُدودِه، ومعرِفةُ تفسِيرِه ومعانِيه، وما يُرادُ مِنه، وتدبُّرُه، والتخلُّقُ به، والردُّ على المُنحَرِفين في فَهمِ القُرآن والسنَّة، ودَحضُ أباطِيلهم، والتحذير مِنهم، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: 9].
ومعنَى النَّصِيحة لأئمَّة المُسلمين: محبَّةُ الخير لهم، ومحبَّةُ عدلِهم، والفرحُ بتوفيقِهم، وعدمُ غِشِّهم، وعدمُ خِيانتِهم، وألا يخرُج عليهم، وألا يُظاهِرَ عليهم، ومُعاونتُهم على الحقِّ، وطاعتُهم في غير معصِيةٍ، والدُّعاءُ لهم بالتوفيقِ وإصابةِ الحقِّ في أقضِيَتهم.
عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ اللهَ يرضَى لكم ثلاثًا: يرضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تُشرِكُوا بِه شيئًا، وأن تعتَصِمُوا بحَبلِ الله جميعًا ولا تفرَّقُوا، وأن تُناصِحُوا مَن ولَّاهُ اللهُ أمرَكم»؛ رواه مسلم.
وقال ابنُ مسعُودٍ - رضي الله عنه -: "إنَّما تكرَهُون في الجماعة خيرٌ مما تُحبُّون في الفُرقَة".
والنَّصِيحةُ جِماعُها سلامةُ الصَّدر.
وعن جُبَير بن مُطعِم، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في خُطبتِه بالخَيف: «ثلاثٌ لا يغِلُّ عليهنَّ قلبُ مُسلم: إخلاصُ العمل لله، ومُناصَحةُ وُلاةِ الأمر، ولُزومُ جماعةِ المُسلمين»؛ رواه أحمد والحاكم.
وعن معقِل بن يَسار، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما مِن عبدٍ يَستَرعِيه اللهُ رعِيَّةً، ثم لم يُحِطها بنُصحِه إلا لم يدخُلِ الجنَّة»؛ رواه البخاري ومسلم وأحمد.
ومعنَى النَّصِيحة لعامَّة المُسلمين: إرشادُهم إلى مصالِحِهم، وتعليمُهم أمور دينِهم، وسَترُ عوراتهم، وسدُّ حاجاتِهم، وعدمُ الغِشِّ والخِيانةِ لهم، ومُجانبَةُ الحسَدِ لهم، والتحمُّل لهم.
والنُّصحُ صِفةُ الأنبِياء والمُرسَلين - عليه الصلاة والتسليم -، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، وقال عن نُوحٍ - عليه السلام -: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: 62]، وقال عن هُودٍ - عليه السلام -: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: 68]، وقال عن صالِحٍ - عليه السلام -: ﴿{لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: 79].
والنُّصحُ مِن صِفاتِ المُؤمنين، قال الله تعالى عن مُؤمنِ يس: ﴿يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ..﴾ [يس: 20]، ثم قال: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26، 27].
قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: "نصَحَ قومَه في حياتِه وبعد مماتِه".
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، وقال - عزَّ وجل -: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَني وإياكم بما فيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، ونفعَنا بهديِ سيِّد المرسلين وقوله القويم، أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم وللمُسلمين، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله علَّام الغُيُوب، مُقلِّب القُلُوب، كاشِفِ النَّوازِلِ والكُرُوب، أحمدُ ربِّي وأشكُرُه على نِعمِه كلِّها المُتقدِّمة والمُتأخِّرة، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له غفَّارُ الذُّنُوب، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُصطفَى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه الأتقِياء الشُّرفاء.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله تعالى في السرِّ والعلانِية؛ فبالتقوَى تنالُون أعلى الدَّرجات، وتفوزُون بالخَيرات في الحياةِ وبعد المَمات.
عباد الله:
تدبَّرُوا قولَ الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].
ففي هذه الآية تعاوُنٌ وتناصُرٌ، وتناصُحٌ وتكافُلٌ، وأُخُوَّةُ رحمةٍ ومودَّة.
وعن جريرِ بن عبدِ الله قال: "بايَعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على إقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاة، والنُّصحِ لكلِّ مُسلمٍ"؛ رواه البخاري ومسلم.
وقال أبو بكر المُزَنيُّ: "ما فاقَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بصَومٍ ولا صلاةٍ، ولكن بشَيءٍ وقَرَ في قلبِه".
قال ابنُ عُليَّة: "الذي كان في قلبِه: الحُبُّ في الله - عزَّ وجل -، والنَّصِيحةُ في خَلقِه".
وعن حَكيمِ بن أبي يَزيد، عن أبِيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استَنصَحَ أحدُكُم أخاه فلينصَح له»؛ رواه أحمد والطبرانيُّ في "الكبير".
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين، وإمام المُرسَلين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابةِ أجمعين، اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديِّين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانُوا يعدِلُون: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الصحابةِ أجمعين برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم وارضَ عن التابِعين وتابِعِي التابِعين الذين اتَّبَعُوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشِّركَ والمُشركين، والكفرَ والكافرين يا ربَّ العالمين، اللهم دمِّر أعداءَك أعداءَ الدين إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم فقِّهنا في دِينِك، اللهم فقِّهنا في الدِّينِ، اللهم فقِّهِ المُسلمين في الدِّين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفِرَ لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلَمُ به منَّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم إنَّا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن عذابِ النَّار وعذابِ القَبر يا ربَّ العالمين.
اللهم أحسِن عاقِبتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا مِن خِزيِ الدُّنيا وعذابِ الآخرة.
اللهم إنا نعوذُ بك أن نظلِمَ أو نُظلَم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم تولَّ أمرَ كلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنة، وأمرَ كلِّ مُسلمٍ ومُسلمة برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم ألِّف بين قُلوبِ المُسلمين، اللهم ألِّف بين قُلوبِ المُسلمين، وأصلِح ذاتَ بينهم، واهدِهم سُبُل السلام، وأخرِجهم مِن الظُّلُمات إلى النُّور، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا ربَّ العالمين.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تُوفِّقَهم، وأن تُؤلِّفَ بين قُلوبِهم على الحقِّ يا ربَّ العالمين.
اللهم فقِّهنا في الدِّين، اللهم فقِّهنا في الدِّين، اللهم فقِّهنا والمُسلمين في دينِك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنَّا نسألُك رِضاكَ والجنةَ، ونعوذُ بك اللهم مِن سَخَطِك ومِن النار.
اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين، اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم ادفَع عنَّا الغلا والوبا والرِّبا والزِّنا، والزلازِلَ والمِحَن، وسُوءَ الفِتَن ما ظهرَ منها وما بطَن.
اللهم أعِذنا والمُسلمين مِن الخبائِث، اللهم أعِذنا والمُسلمين مِن الخبائِث.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا مِن إبليس وذريَّته وشياطينه وأوليائِهِ يا ربَّ العالمين، إنَّك على كل شيءٍ قدير، اللهم إنا نسألُك أن تُعِيذَ المُسلمين وذريَّاتهم مِن الشَّيطان الرجيم برحمتِك يا أرحَمَ الراحمين.
اللهم إنا نسألُك أن تقضِيَ الدَّينَ عن المَدِينين مِن المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافِيةَ في الدُّنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم احفَظ بلادَنا مِن كلِّ شرٍّ ومكرُوهٍ إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير.
اللهم واحفَظ جنودَنا، اللهم واحفَظ جنودَنا يا ذا الجلال والإكرام في أموالِهم، وفي أنفسِهم، وفي دمائِهم، وفي أهلِيهم إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم وفِّق خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحبُّ وترضَى، اللهم استَعمِله في طاعاتِك يا ربَّ العالمين، اللهم وفِّقه لما تُحبُّ وترضَى، اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام أن تُوفِّقَه للرأي السديد، والعمل الرشيد، اللهم وفِّق وليَّ عهده لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم خُذ بناصِيتِه للبرِّ والتقوَى، ومِن العمل ما ترضَى، وانصُر بهما الإسلامَ والمُسلمين يا ربَّ العالمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا الله العظيمَ الجليلَ، واشكُرُوه على نِعَمِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبرُ، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

الأدب مع
الله عز وجل ورسولِه صلى الله
عليه وسلم
ألقى فضيلة الشيخ عبد
الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الأدب مع الله -عز وجل- ورسولِه صلى الله عليه وسلم "، والتي تحدَّث فيها عن الأدَبِ الواجِبِ مع الله - سبحانه وتعالى -، مُبيِّنًا بعضَ
النماذِج المُشرِقَة من أدَبِ الأنبِياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الله ، كما بيَّن أهميةَ
الأدَبِ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكيف يكونُ ذلك مِن عُمُوم المُسلمين.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله خيرُ ما افتُتِحَ به القولُ واختُتِم، وابتُدِئ به الخِطابُ وتُمِّم، أحمدُه - سبحانه - حمدًا يستنزِلُ الرَّحمات، تَترَى كالعَذبِ الفُرات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منَّ على هذه الأمة ببِعثةِ خَيرِ البرايا، وجعلَ التمسُّكَ بسُنَّته عِصمةً مِن الفِتَن والبلايا، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وحبيبَنا وقُدوتَنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه كريمُ الخِصال شريفُ السَّجايا، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أفضلُ الصَّلوات، وأزكَى التسليمات، وأشرفُ التَّحايا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد .. فيا عباد الله:
اتَّقُوا الله حقَّ تُقاتِه؛ فتقوَاه - سبحانه - هي العِزُّ المُنتضَى، والهَديُ السَّنِيُّ المُرتضَى، وبِها يتحقَّقُ الفوزُ والرِّضا، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
|
تقوَى القُلوبِ هي
السَّبِيلُ إلى العُلا |
|
وهِيَ الصِّراطُ
المُستقيمُ قَبُولَا |
|
فلْنَتَّقِ اللهَ الذي
هو ربُّنَا |
|
فلَهُ الثَّناءُ
مُرتَّلًا وجَمِيلَا |
معاشر المُسلمين:
على حِينِ فترةٍ مِن الرُّسُل هبَّت النَّسائِمُ النَّدِيَّة للرِّسالة الإسلاميَّة بتشريعاتِها السَّنِيَّة الربَّانيَّة، فاعتَنَقَتها فِطَرُ أُمم الأرض السَّوِيَّة، دون تأبٍّ أو الْتِياثِ طوِيَّة، إلى أن خلَفَت خُلُوفٌ انبَجَسَت عنهُم قضيَّةٌ وأيُّ قضيَّة! طاشَت لها النُّهَى وطارَت، وأفَلَت شُهُبُ الدُّجَى وغارَت، وفي عصرِنا الرَّاهِن لاقَت رَواجَها، ومجَّت مِلحَها وأُجاجَها، فألهَبَت مِن غَيرَةِ المُسلمِ ضِرامَها؛ لأنَّها قضيَّةٌ تتعلَّقُ بالمحبَّةِ الخالِصة ذاتِ الظِّلال الوارِفة.
تلكُم - يا رعاكُم الله - هي قضيَّةُ "حُسن الأدَب"، لاسيَّما مع الذَّات الإلهِيَّة العلِيَّة، والتأدُّب الشَّريفِ العَفِيفِ مع الجَنابِ النبويِّ المُحمديِّ المُطفوِيِّ المُنِيف، سَلِيل أكرَمِ نَبعَة، وقَرِيع أشرَفِ بُقعَة.
|
واعلَم بأنَّ بُلُوغَ
الأَرَبِ |
|
فِي الدِّينِ والعِلمِ
وحُسنِ الأدَبِ |
ولئِن كان هذا العصرُ هو العصرَ الذي بلَغَت فيه البشريَّةُ ذُرَى الرُّقِيِّ الفِكريِّ، والحضاريِّ، والثَّقافيِّ، والمادِّيِّ، والتِّقانِيِّ؛ فإنَّه أيضًا هو أشدُّ العُصور حاجةً وعَوَزًا إلى الرُّواء الرُّوحيِّ، المُزكَّى بالفضائِل الأدبيَّة، والمكارِمِ الأخلاقِيَّة التي نرشُفُ مِنها حلاوةَ اليَقين، وبَردَ الاطمِئنان؛ لنَنتَشِلَ البشريَّةَ المُعنَّاة مِن مباوِئِ الضَّلالا، وأعاصِير الفسادِ والانحِلال.
معاشِر المُؤمنين:
وإنَّ أسمَى درجَات الأدَب: الأدَبُ مع الذَّات العلِيَّة، تلكُم الإشراقاتُ السَّنِيَّة مِن أسلُوب الخِطابِ ومُناجاةِ الأنبِياء الكِرام - عليهم الصلاة وأزكَى السلام -؛ فبِها تُدرِكُ أرواحُنا مثُوبةَ المنَّان.
فهذا خليلُ الرحمن إبراهيمُ - عليه السلام - يُؤصِّلُ الأدبَ في القُلوب والحَنايَا، ويُقيمُ بواهِرَه في الأفئِدةِ والطَّوايا، فيقولُ اللهُ عنه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]، فنسَبَ المرضَ لنفسِه، ونسَبَ الشِّفاءَ لربِّ العالَمين؛ حِفظًا للأدَبِ مع الله - سبحانه -.
ونبيُّ الله أيوب - عليه السلام - يُناجِي ربَّه مُناجاةً بَلْجَاء سامِقة، غدَت كالتَّاجِ في مِفرَق، فقال: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، فأشارَ بـ ﴿مَسَّنِيَ﴾ ولم يُصرِّح بـ "أصابَنِي"، ولم يسأَل ربَّه الشِّفاءَ مُباشرةً.
ولم ينسِب الشرَّ إليه - سبحانه -، بل نسَبَ الشَّرَّ إلى الشَّيطان، فأفصَحَ عن رُوحٍ زكِيَّةٍ، وهِمَّةٍ علِيَّة، ونفسٍ بالمكرُمات رضِيَّة، حين قال: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: 41].
وأما الصورةُ المُشرِقة والصفحةُ المُتألأِّقة، المُتمثِّلةُ في كَلِيم الرَّحمن مُوسى - عليه السلام -، فتلكُم أنوارٌ في الظُّلَم، ومجدٌ مُرتسَم؛ حيث قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: 24].
قال الإمامُ الطبريُّ - رحمه الله -: "وذُكِرَ أنَّ نبيَّ الله مُوسَى - عليه السلام - قالَ هذا القَولَ وهو بجَهدٍ جَهِيد، وما معَه دِرهَمٌ ولا دِينارٌ، وإنَّما عنَى بِه شَبعَةً مِن طعامٍ".
|
وهو
العزيزُ فلَن يُرامَ جَنابُهُ |
|
أنَّى
يُرامُ جَنابُ ذِي السُّلطَانِ |
وها هو كلِمةُ الله عِيسَى - عليه السلام -، يرفَعُ رايةَ الأدَبِ الأنِيق، والخُلُق السَّامِي الرَّقِيق، في قَولِه لربِّ العالَمين: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [المائدة: 116]، ولم يقُل: "لم أقُلْه"، وفرقٌ بين الجوابَين في حقيقةِ الأدَبِ مع الله مبنَاه ومعنَاه.
وإن تعجَبْ مِن هذا الأدَبِ المَلِيح، فلْتُرْخِ العِنانَ لشَأْوٍ مُعجَبٍ رَجِيح، كبدر التَّمامِ، وعلى طرَف الثُّمام، يأسِرُ لُبَّ السَّامِع؛ لأنَّه السِّحرُ الحلالُ، مِن كلامِ سيِّد المُرسَلين - بأبي هو وأمِّي - صلى الله عليه وسلم -، الذي كان يُناجِي ربَّه قائِلًا: «الوخَيرُ كلُّه بيَدَيك، والشَّرُّ لَيسَ إلَيكَ»؛ رواه مسلم.
وروَى البخاريُّ في "صحيحه" مِن حديثِ الإسراء والمِعراج المعرُوف، عندما فُرِضَت الصلاةُ، فلمَّا أخبَرَ مُوسَى بذلك، قال: «ارجِع إلى ربِّك واسأَله التَّخفِيفَ لأمَّتِك»، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «سأَلتُ ربِّي حتَّى استَحيَيتُ مِنه، ولكن أرضَى وأُسلِّم».
الله أكبر .. ما أروعَ هذا الأدَبَ النُّورانيَّ الحَصِيف، المُضمَّخَ بالخُلُق النبويِّ الشَّرِيف، وجَوهَرِه مِن الحياءِ المُنِيف.
|
النَّاسُ
بَحرٌ دُونَ بَحرِك مالِحُ |
|
والعَذْبُ
أنتَ أيَستَوِي البَحرَانِ؟! |
|
وعلَوتَ
مِن رُتَبِ الكَمالِ أجَلَّها |
|
وسمَوتَ
عن دَركِ الثَّنَا بلِسَانِي |
إنَّها النُّفوسُ التي جُبِلَت على الأدَبِ الدَّفُوق، والقَولِ الرَّقِيق الشَّفُوق، أدَبٌ يُبلِّغُ مِن الأمجاد قاصِيَتها، ومِن المحامِدِ ناصِيتَها.
يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "إنَّ الأدَبَ مع الله تعالى هو القِيامُ بدِينِه، والتأدُّبُ بآدابِه ظاهرًا وباطنًا، ولا يستَقِيمُ لأحدٍ قطّ الأدَبُ مع الله إلا بثلاثةِ أشياء: معرِفتِه بأسمائِه وصِفاتِه، ومعرِفتِه بدِينِه وشَرعِه، وما يُحبُّ وما يَكرَه، ونفسٍ مُستعِدَّة قابِلةٍ ليِّنة، مُتهيِّئة لقَبُول الحقِّ عِلمًا وعملًا وحالًا".
عباد الله:
الأدَبُ مع الله يَستوجِبُ تحقيقَ التوحِيدِ، وإخلاصَ العِبادةِ له - سبحانه -، والمُسارَعَة إلى مرضاتِه، وتمامَ الخُضُوع له، وحُسنَ التوكُّلِ عليه، والحياءَ مِنه، والوقوفَ عند حُدودِه، والتأمُّلَ في آياتِه الكونيَّة ومخلُوقاتِه، وبديعِ خلقِه ومصنُوعاتِه.
|
تأمَّل
سُطُورَ الكائِناتِ فإنَّها |
|
مِن
المَلِكِ الأعلَى إلَيكَ رسَائِلُ |
|
تُشِيرُ
بإِثبَاتِ الصِّفاتِ لرَبِّهَا |
|
فصَامِتُها
يَهدِي ومَن هو قَائِلُ |
أيها المُؤمنون:
وإنَّ مِن تمامِ الأدَبِ مع الله - سبحانه -: الأدَبَ مع نبيِّه الكَرِيم - صلى الله عليه وسلم -.
يقولُ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2].
قال قتَادةُ - رحمه الله -: "كانُوا يَجهَرُون له بِالكلامِ، ويرفَعُون أصواتَهم، فوعَظَهم الله ونهاهُم عن ذلِك".
وقال الضحَّاكُ - رحمه الله -: "نهاهُم الله أن يُنادُوه كما يُنادِي بعضُهم بعضًا، وأمرَهم أن يُشرِّفُوه ويُعظِّمُوه، ويَدْعُوه إذا دعَوه باسمِ النُّبُوَّة".
فإذا كان الأدَبُ مع المُصطفَى - عليه الصلاة والسلام -: عدمَ رفعِ الأصوَاتِ فوقَ صَوتِه؛ لأنَّه سببٌ لحُبُوط الأعمال، فما الظنُّ برَفعِ الآراء ونتائِجِ الأفكارِ على سُنَّتِه وهَديِه، وما جاءَ به - عليه الصلاة والسلام -؟!
وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، وهذا باقٍ إلى يومِ القِيامةِ لم يُنسَخ؛ فالتقدُّمُ بين يدَي سُنَّته بعد وفاتِه كالتقدُّمِ بين يدَيه في حياتِه، ولا فَرقَ بينَهما، كما قرَّرَه أهلُ العلمِ - رحمهم الله -.
قال الإمامُ ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "رأسُ الأدَبِ مع الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - كمالُ التسلِيمِ له، والانقِيادِ لأمرِه، وتلقِّي خبَرِه بالقَبُول التصدِيقِ، وألا يُتقدَّمَ بين يدَيه بأمرٍ ولا نهيٍ ولا إذنٍ ولا تصرُّفٍ حتى يأمُرَ هو وينهَى ويأذَن، فالتأدُّبُ معه واجِبٌ، وبعد وفاتِه وجَبَ التأدُّبُ مع سُنَّته وهَديِه، وما صحَّ عنه - عليه الصلاة والسلام -".
وإنَّ مِن المُؤسِفِ حقًّا أنَّ بعضَ أهلِ الإسلامِ لم يقدُرُوا رسولَهم - عليه الصلاة والسلام -، حتى وهُم يتوجَّهُون إليه بالحُبِّ والتعظيمِ؛ ذلك أنَّه حُبٌّ سلبيٌّ لا صدَى له في واقعِ الحَيَاة، ولا أثَرَ له في السُّلُوك والامتِثال.
ومِن عجَبٍ أنَّ أقوامًا أُفعِمَت جيُوبُهم بالنَّشَب، ولكن أُفرِغَت جُنُوبُهم دُون معالِي الرُّتَب، وجلِيلِ الأرَب، وروائِعِ الأدَبِ، حينَها وَيلٌ يومئذٍ لحُسنِ الأدَب مِن شِدَّة العَطَب.
وفي هذا العصرِ والأوانِ استقَى أقوامٌ كثيرًا مِن المَزَالِّ مِن مشارِبِ أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ، فتكائَدُوا قَبُول الأحاديثِ النبويَّة التي يرُدُّها بزَعمِه الواقِعُ المحسُوس، أو يمُجُّها هوَى عقلِهم المنكُوس، أو تتعارَضُ والطبَّ الحديثَ المدرُوس، وتتمانَعُ وكرامةَ النُّفُوس؛ لأنَّها - بزَعمِهم المنحُوس - تُجمِّدُ تحرُّرَ العقل الوقَّاد وإشراقَه، وتُصفِّدُ الفِكرَ المُبدِعَ دُون انطِلاقِه.
فهل مِن الأدَبِ مع الله والأدَبِ مع رسولِه - صلى الله عليه وسلم - الوُقوعُ في ضُروبِ الإشراكِ بالله، ومُمارسَةُ البِدَع والمُحدثات؟! حقًّا .. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91].
فلا بُدَّ أن تُربَّى الأجيالُ والأُسَر والمُجتمعات على تعظيمِ الهَديِ النبويِّ قَولًا واعتِقادًا، وعمَلًا وانقِيادًا، علميًّا وخُلُقيًّا واجتِماعيًّا؛ لأنَّه مِلاكُ الحِفاظِ على الهُويَّة الإسلاميَّة، والحِصنُ المَكِين دُون تسلُّل ذوِي الأفكارِ الإرهابيَّة أو الانحِلاليَّة شَطرَ دِيارِ الإسلام الأبِيَّة، وبذلك تعِزُّ الأمَّةُ وترقَى، وتبلُغُ مِن المجدِ أسمَى مرقَى.
والله - عزَّ وجل - يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: 57].
بارَكَ الله لِي ولكُم الوحيَين، ونفَعَني وإيَّاكُم بهَديِ سيِّد الثَّقَلَين، أقُولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه، إنَّه كان للأوَّابِين غفُورًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله لم يزَل بِعبادِه خبيرًا لطيفًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له بوَّأَ المُحبِّين مقامًا سنِيًّا شريفًا، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وحبيبَنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آلِهِ الطيبين الطاهِرين، وصحابتِهِ البالِغِين مِن المعالِي مجدًا مُنيفًا، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واتَّبِعُوا هَديَ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -؛ تسعَدُوا في دُنياكُم وأُخراكُم.
أمة الإيمان:
الأدَبُ هو اجتِماعُ خِصالِ الخَير في العبدِ، وهذه القضِيَّةُ قد حسَمَها الإسلام، وجلَّاها أيَّما تجلِيةٍ أسطِينُه الأفذاذُ الأعلامُ، فأيُّ نائِبةٍ تلك التي تُصيبُ الأمَّةَ حين يُفتقَدُ الأدَبُ بين أبنائِها.
قال الإمامُ عبدُ الله بنُ المُبارَك - رحمه الله -: "نحن إلى قَليلٍ مِن الأدَبِ أحوَجُ مِنَّا إلى كثيرٍ مِن العلمِ" .
وقد روَى أبو داود بسَنَدٍ حسنٍ عن أبي مُوسَى الأشعريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ مِن إجلالِ الله: إكرامَ ذِي الشَّيبَة المُسلمِ، وحامِلِ القُرآن غيرِ الغالِي فيه، وإكرامُ ذِي السُّلطانِ المُقسِط».
فتمامُ الأدَبِ: إجلالُ ذِي الشَّيبَة واحتِرامُه، لاسيَّما الوالِدان الكرِيمَان، ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]، وحُسنُ الأدَبِ بين الزَّوجَين، والأقارِبِ، والجِيران، والزُّملاء، وتوقِيرُ أهلِ العلم وتعظيمُهم، وحِفظُ مقاماتِهم، وصِيانةُ أعراضِهم، والذَّبُّ عنهم، وحُسنُ الظنِّ بهم، ولُزومُ أدَبِ الخِلافِ فيما بينَهم.
وإجلالُ وُلاة الأمر بالسَّمع لهم والطاعة بالمعرُوف، في العُسر واليُسر، والمنشَط والمكرَه، والالتِفافِ حولَهم، وجمعِ القُلُوب عليهم، وعدمِ مُنازَعَتهم أو الخُرُوج عليهم.
ولكلٍّ أدَبُه الذي يلِيقُ به، حتى مع غيرِ المُسلمين، ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 53]، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83].
قال ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "أدَبُ المرءِ عُنوانُ سعادتِه وفلاحِه، وقِلَّةُ أدَبِه عُنوانُ شقاوَتِه وبَوَارِه، فما استُجلِبَ خيرُ الدُّنيا والآخرةِ بمِثلِ الأدَبِ، ولا استُجلِبَ حِرمانُها بمِثلِ قِلَّةِ الأدَبِ".
وإنَّك لواجِدٌ مِن ذلك في وسائل التواصُلِ الاجتماعيِّ العَجَب العُجاب؛ مِن الطَّعن في دينِ النَّاسِ وأعراضِهم وعُقُولهم وأموالِهم ونُفوسِهم، فيتلقَّفُها الدَّهماء، وتلُوكُها الرُّويبِضةُ، في نشرٍ للشَّائِعات، وتروِيجٍ للافتِراءات، والله - عزَّ وجل - يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
فتمسَّكُوا - رحِمَكم الله - بآدابِ وأخلاقِ نبيِّكم الكريم، واتَّبِعُوا هَديَه القَوِيم، وأكثِرُوا واستَكثِرُوا مِن الصَّلاةِ والسَّلامِ عليه؛ فذلِكَ مِن قِمَّة الأدَبِ معه.
|
فلقَد
بلَغَ العُلا بجَلالِهِ |
|
سطَعَ
الدُّجَى بجَمالِهِ |
|
شَرُفَت
جَمِيعُ خِصالِهِ |
|
صلُّوا
علَيهِ وآلِهِ |
كما أمرَكم الله - جلَّ في عُلاه -، فقال تعالى قولًا كريمًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
|
وأفضَلُ
الصلاةِ والتسلِيمِ |
|
على النبيِّ
المُصطفَى الكَرِيمِ |
|
وآلِهِ
وصَحبِهِ الأبرَارِ |
|
الصَّفوَةِ
الأكابِرِ الأخيَارِ |
صلاةً لا يمَلُّ السَّامِعُ هَمسَها ونِداءَها، ولا تسأَمُ الألسُنُ إعادتَها وإبداءَها.
اللهم صلِّ وسلِّم على النبيِّ المُختار، وارضَ اللهم عن صَحبِه الكرامِ الأبرار: أبي بكرٍ أنِيسِه في الغَار، وعُمر الفارُوق فاتِحِ الأمصَار، وعُثمان ذِي الفضَائِلِ الغِزَار، وعليٍّ ذِي الشَّجاعَة والاعتِبار، وسائِرِ العشَرَة المُبشَّرِين بدارِ القَرار، وعنَّا معَهم بمَنِّك وجُودِك وكَرَمِك يا عزيزُ يا غفَّار.
اللهم شفِّع فينَا نبيَّنا وقُدوتَنَا مُحمدًا - صلى الله عليه وسلم - يوم القِيامَة، واجعَل حُبَّه في سُوَيداءِ قُلوبِنا، ومقامَه ونُصرتَه في حياتِنا كلِّها مُستدَامة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشِّركَ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَ الدِّين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا وسائِرَ بلادِ المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِح أئمَّتنا ووُلاةَ أمورِنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين، اللهم وفِّقه لِما تُحبُّه وتَرضَاه مِن الأقوال والأفعال والآراء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه صلاحُ البلاد والعباد، اللهم ارزُقهم البِطانةَ الصَّالِحةَ التي تدُلُّهم على الخَير وتُعينُهم علَيهِ.
اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمر المُسلمين، واجعَلهم لشَرعِك مُحكِّمين، ولأوليائِك ناصِرِين يا أرحمَ الرَّاحمين.
اللهم أنقِذِ مُقدَّسات المُسلمين مِن عُدوان المُعتَدين، اللهم حرِّرِ المسجدَ الأقصَى مِن بَراثِنِ المُعتَدين الغاصِبِين المُحتلِّين يا قويُّ يا عزيز.
اللهم كُن لإخوانِنا في فِلسطِين، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كُن لهم في بِلاد الشَّام، اللهم ارفَع الظُّلمَ عنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلِح أحوالَ إخوانِنا في العِراقِ، وفي اليَمَن، وفي أراكان، وفي كلِّ مكانٍ يا ذا الجلال والإكرام.
ربَّنا تقبَّل منَّا إنَّك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنَّك أنت التواب الرحيم، واغفِر لنا ولوالِدِينا وجميعِ المُسلمين والمُسلِمات الأحياء مِنهم والميتين، برحمتِك يا أرحَمَ الراحِمين.
اللهم انصُر جُنودَنا، اللهم انصُر جُنودَنا ورِجالَ أمنِنا، اللهم انصُرهم في الثُّغُور والحُدُود، اللهم سدِّد رميَهم ورأيَهم، اللهم اجعَلهم مُنتَصِرين ظافِرِين غانِمين سالِمين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ارحَم ضعفَنا، واجبُر كسرَنا، وتولَّ أمرَنا، اللهم اشفِ مرضانا، وعافِ مُبتلانا يا ذا الجلال والإكرام، يا قويُّ يا عزيز.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ العظيمَ الجليلَ يذكُركُم، واشكُرُوه على نِعمِه يَزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبر، واللهُ يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

حقوق المُسلم على أخِيه
ألقى
فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حقوق
المُسلم على أخِيه"، والتي تحدَّث فيها عن عناية الإسلام بالعلاقات
الاجتماعيَّة، وترتيبِ الأجر عليها؛ للتآلَف القُلُوب، وتتوثَّق الرَّوابِط،
وذكَرَ مِن ذلك بعضَ حُقوقِ المُسلمِ على أخِيه المُسلم، وهي ستُّ حُقوقٍ ورَدَت
في حديثٍ نبويٍّ شريفٍ، مُبيِّنًا عِظَمَ هذه الحُقُوق، وما رُتِّبَ عليها مِن
الأجر الجَزيل.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله على نِعمةِ التوفيقِ للطَّاعة وأداءِ الحُقُوق، أحمدُه - سبحانه - وأشكُرُه حفِظَ عبادَه الصَّالِحين مِن الزَّلَل والفُسُوق، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له نصَرَ أهلَ الحقِّ وجعلَ الباطِلَ إلى زُهُوق، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه دعَا إلى مكارِمِ الأخلاقِ، وحذَّرَ مِن العُقُوق، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه ما أقبَلَ فجرٌ وتزيَّنَت شمسٌ للشُّرُوق.
أما بعدُ:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله؛ فهي زادٌ لمَن أرادَ الزَّاد، وهي النَّجاةُ لمَن يرُومُ النَّجاة، وهي سُلَّمُ الرُّقِيِّ إلى الدَّرجات العُلَى.
في ظلِّ الشَّواغِلِ وسَيلِ الماديَّةِ الجارِفِ، يغفُلُ المُسلمُ عن بعضِ الحُقوقِ وبِناءِ العلاقاتِ الاجتِماعيَّة، وقد نسَى أو يتناسَى، على أملِ العَودةِ والتصحِيحِ لمسار حياتِه وعلاقاتِه، فتمُرُّ السُّنُون، وتتوالَى أيامُ العُمر، فتزيدُ الفَجوَة، وتعظُمُ الجَفوَة، وتغشَى الحياةَ مشاعِرُ جافَّة، وعواطِفُ قاسِية.
اعتنَى الإسلامُ بالعلاقات الاجتماعيَّة، ورتَّبَ علَيها أجرًا يُحفِّزُ على المُبادَرَة؛ لتتآلَفَ القُلُوب، وتتوثَّقَ الرَّوابِط، وتُلبَّى الحاجات، ويتطبَّعَ أفرادُ المُجتمع بمكارِمِ الأخلاقِ ومحاسِنِ الأفعال، ويثقُلُ المِيزان، وتُرفَعُ الدَّرَجات.
وإذا أُدِّيَت الحُقُوق، وقوِيَت العلاقات، اشتدَّ ساعِدُ المُجتمع، وقوِيَ عُودُه، وتمسَّكَ بُنيانُه.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «حقُّ المُسلمِ على المُسلمِ سِتٌّ»، قِيل: ما هُنَّ يا رسولَ الله؟ قال: «إذا لقِيتَه فسَلِّم علَيهِ، وإذا دعَاك فأَجِبْه، وإذا استَنصَحَك فانصَح له، وإذا عطَسَ فحَمِدَ اللهَ فسَمِّتْه، وإذا مرِضَ فعُدْهُ، وإذا ماتَ فاتَّبِعه».
حديثٌ عظيمٌ يفتَحُ آفاقَ التقارُبِ والتوادُد، ويبُثُّ في الحياةِ الرُّوحَ، قال الله تعالى: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: 63].
أولُ حُقوق المُسلمِ على المُسلمِ: كلِمةُ المحبَّة والوِئام، تحيَّةُ أهل الجنَّة السَّلام.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخُلُون الجنَّةَ حتَّى تُؤمِنُوا، ولا تُؤمِنُوا حتَّى تحابُّوا، أوَلا أدُلُّكم على شيءٍ إذا فعَلتُمُوه تحابَبتُم؟ أفشُوا السَّلامَ بينَكم».
السَّلامُ مِفتاحُ المحبَّة للقُلُوب، ومِفتاحُ الاستِئذانِ على كلِّ بابٍ، يُغذِّي الحياةَ بالبركة والنَّماء والزِّيادة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: 61].
السَّلامُ رِسالةُ أمان، وعلامةُ أهلِ الإيمان، مَن عرَفَ معناه وقَدرَه، وعرَفَ حقيقتَه وفضلَه طهُرَت نفسُه، وتهذَّبَ سُلُوكُه، وسمَا مُجتمعُه دِينًا ودُنيا، قال الله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 16].
ومِن حُقوقِ المُسلم على أخِيهِ المُسلم: إجابةُ عدوتِه، وحُضُور وليمَتِه، وتطيِيبُ خاطِرِه، ومُشارَكتُه فرحَته، وتبادُلُ الدَّعوات يُحقِّقُ الأُلفةَ والاجتِناع، والتزاوُرَ والالتِقاءَ، وفي ظلِّ ذلك تذُوبُ المُشكِلات، ويتجاوَزُ العُقلاءُ العِتاب، فتقوَى الأوصِر، وتذُوبُ الفواصِل.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى طعامٍ فليُجِب، فإن شاءَ طعِمَ، وإن شاءَ ترَكَ».
وقَدرُ الولِيمَةِ لا يُقاسُ بحَجمِ الإنفاقِ وشِدَّة التكلُّف، وإنَّما بتحقيقِ مقصُودِ التآخِي والتواصُلِ بين المُسلمين. وأما الإسرافُ في الولائِمِ فعملٌ غيرُ محمُود، تأبَاه الشَّرِيعةُ، وينزِعُ البركةَ، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
الحقُّ الثالِثُ مِن حُقوق المُسلم: إسداؤُه النُّصح لأخِيه برِفقٍ ولُطفٍ؛ فالنُّصحُ رِسالةُ حبٍّ مِن المُسلم لأخِيه؛ لأنَّه يُحبُّه، فهو يرجُو له كلَّ خيرٍ، ويخشَى عليه مِن كلِّ شرٍّ.
وللناصِحِ منزِلةٌ علِيَّةٌ في الدِّين، ومرتَبةٌ سنِيَّةٌ يوم يقُومُ النَّاسُ لربِّ العالَمين، وحين يبذُلُ الناصِحُ النُّصحَ، فإنَّ الصادِقَ ينشرِحُ للنَّصِيحة صَدرُه، ويُنصِتُ لها قلبُه، وتسمُو نفسُه بقَبُولِها، ولا يرُدُّها بسببِ ظنٍّ سيِّئٍ بالنَّاصِح، أو تفسيرٍ مغلُوط.
وقد كانأميرُ المُؤمنين عُمرُ - رضي الله عنه - يقولُ: "رحِمَ اللهُ امرأً أهدَى إلينا عيُوبَنا".
وشتَّان ما بين ناصِحٍ مُحِبٍّ ومُوجِّهٍ مُشفِقٍ ينصَحُ ويستُر، وآخر يتدثَّرُ بالنَّصِيحة، ويجعلُها غِطاءً لطوِيَّةٍ غيرِ سوِيَّة، فيُلاحِقُ قُصورَ إخوانِه تشهِيرًا، وعيُوبَ رُفقائِه نَشرًا، فينتَقِصُ هذا، ويتَّهِمُ ذاك، ويفرِي عِرضَ أولئك.
والحقُّ الرابِعُ: تشمِيتُ العاطِس، والدُّعاءُ له بالرَّحمة، وكلٌّ يُسرُّ بالدُّعاء، ويتمنَّى الزِّيادةَ مِن الرَّحمة.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَعوةُ المُسلمِ لأخِيهِ بظَهرِ الغَيبِ مُستجابةٌ، عِند رأسِهِ ملَكٌ مُوكَّلٌ كلَّما دَعَا لأخِيه بخَيرٍ قال المَلَكُ المُوكَّلُ به: آمين، ولك بمِثل».
العُطاسُ نِعمةٌ ربَّانيَّةٌ للعبدِ، تستحِقُّ الشُّكرَ والحمدَ، وفي تشميتِ العاطِسِ والدُّعاءِ له وذِكرِ الله إغاظةٌ للشَّيطان ودَحرٌ.
وأُمِرَ العاطِسُ أن يدعُو لسامِعِه ومُشمِّتِه بالمغفِرة والهِداية وإصلاحِ البال، التي تعنِي: صلاحَ شأنِه كلِّه.
ومِن حُقوقِ المُسلم على أخِيه المُسلم: عِيادتُه في مرضِه؛ ذلك أنَّ المريضَ يُكابِدُ ويُعانِي، وقد يطُولُ به المرَضُ أسابِيعَ وشهُورًا، فلا يغمُضُ له جَفنٌ، ولا يهدَأُ له بالٌ، يتضوَّرُ ألَمًا، ويتقلَّبُ وجَعًا، يتطلَّعُ إلى دَعوةٍ يكتُبُ الله بِها شِفاءَه، ويرفَعُ بها درجتَه، وزِيارةٍ تُخفِّفُ آلامَه، وكلِمةٍ تُؤنِسُه في أحزانِه، ولَمسَةٍ حانِيةٍ تُشعِرُه بقُربِ إخوانِه.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن عادَ مريضًا لم يحضُره أجَلُه، فقال عندَه سبعَ مرَّاتٍ: أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العَرشِ العظيم أن يَشفِيَك، إلا عافاه الله».
وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يقُولُ يوم القِيامة: يا ابنَ آدم! مرِضتُ فلم تعُدْني! قال: يا ربِّ! كيف أعُودُك وأنت ربُّ العالَمين؟! قال: أما علِمتَ أنَّ عبدِي فُلانًا مرِضَ فلم تعُدْه، أما علِمتَ أنَّك لو عُدتَه لوجَدتَني عِندَه؟!».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن عادَ مريضًا لم يزَلْ في خُرفةِ الجنَّة». قِيل: يا رسولَ الله! وما خُرفةُ الجنَّة؟ قال: «جَناهَا».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن عادَ مريضًا أو زارَ أخًا له في الله؛ نادَاه مُنادٍ: أن طِبتَ وطابَ مَمشاكَ، وتبوَّأتَ مِن الجنَّةِ منزِلًا».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن عادَ مريضًا لم يزَل يخُوضُ في الرَّحمةِ حتى يجلِس، فإذا جلَسَ اغتمَسَ فِيها».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما مِن امرِئٍ مُسلمٍ يعُودُ مُسلِمًا، إلا ابتعَثَ الله سبعِين ألفِ ملَكٍ يُصلُّون علَيه في أيِّ ساعاتِ النَّهار كان حتَّى يُمسِي، وأيِّ ساعاتِ اللَّيل حتَّى يُصبِح».
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكُم بما فِيه مِن الآياتِ والذِّكرِ الحكيم، أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكم ولسائِرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله حمدًا لا مُنتهَى لأمَدِه ولا حدَّ له، أحمدُ ربِّي وأشكُرُه والفضلُ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الكرامةُ والرِّفعةُ والشَّفاعةُ له، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبِه ومَن سارَ على نَهجِهم واقتَفَى أثَرَهم، فإنَّ العُقبَى له.
أما بعد:
فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله.
حين تتأمَّلُ الحُقوقَ وتنوُّعَها وشُمُولَها ومقاصِدَها، تعلَمُ يقينًا أنَّ حقَّ المُسلم على أخِيه المُسلم يستمرُّ حتى عند وفاتِه، ويمتَدُّ بعد مماتِه، باتِّباعِ جنازَتِه والدُّعاءِ له، وفي ذلك تكرِيمٌ له، وإعلاءٌ لشَأنِه، ورفعٌ لقَامَتِه، كما يُصوِّرُ واقِعَ الوفاءِ بين المُؤمنين، وهذا مُقتضَى عَقدِ الأُخُوَّة بينهم.
فما أعظمَ الإسلام دينًا، وأشملَه منهَجًا، وأنفَسَه نعمةً ومغنَمًا. دينٌ رقَّى ذَوقَ العبد وجمالَه، وزكَّى فعلَ العبدِ ومقالَه، وهذَّبَ سِرَّ المُسلم وجِهارَه، إذا ماتَ المُسلمُ يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُدعَى له، ويُشيَّعُ إلى قبره، ويُدفَن بتُرابِه، وتُتعاهَدُ القُبُور ألا يصِلَ إليها شيءٌ مِن الامتِهان.
قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اتَّبَعَ جنازةَ مُسلمٍ إيمانًا واحتِسابًا، وكان معَها حتَّى يُصلَّى عليها ويفرغ مِن دفنِها؛ فإنَّه يرجِعُ مِن الأجر بقِيراطَين، كلُّ قِيراطٍ مِثلُ أُحُد».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن غسَّلَ ميِّتًا فسَتَرَه؛ ستَرَه الله مِن الذُّنُوب، ومَن كفَّنَه؛ كسَاه الله مِن السُّندُس».
وقال: «إذا صلَّيتُم على الميِّتِ، فأخلِصُوا له الدُّعاءَ».
وعن يَزيد بن ثابِتٍ - رضي الله عنه - قال: خرَجنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا ورَدَ البَقِيعَ، فإذا هو بقَبرٍ جديدٍ، فسألَ عنه، فقَالُوا: فُلانة، قال: فعرَفَها وقال: «ألا آذَنتُمُوني بِها؟!»، قالُوا: كُنتَ قائِلًا صائِمًا، فكَرِهنا أن نُؤذِيَك، قال: «فلا تفعَلُوا، لا أعرِفنَّ ما ماتَ مِنكم ميِّتٌ ما كُنتُ بينَ أظهُرِكم إلا آذَنتُموني به؛ فإنَّ صَلاتِي علَيه له رحمة» ثم أتَى القبرَ، فصَفَفنا خلفَه، فكبَّرَ علَيهِ أربعًا.
هذا المُجتمعُ - عباد الله - الذي يُؤدِّي الحُقوقَ طاعةً لله، واقتِداءً بسُنَّة رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، يشتدُّ بِناؤُه، ويعِزُّ رِجالُه، ولن يجِد مُتربِّصٌ منفَذًا يبُثُّ مِنه سُمُومَه، أو ينخَرَ في بُنيانِه، أو يُقطِّعُ وشائِجِ الحُبِّ بين أفرادِه، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
ألا وصلُّوا - عبادَ الله - على رسولِ الهُدى؛ فقد أمرَكم الله بذلك في كتابِه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن الخُلفاء الأربعة الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن الآلِ والصَّحبِ الكرامِ، وعنَّا معهم بكرمِك وإحسانِك يا أرحمَ الراحِمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين، ودمِّر اللهم أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل اللهم هذا البلدَ آمِنًا مُطمئنًّا، وسائِرَ بلاد المُسلمين.
اللهم مَن أرادَنا وأرادَ بِلادَنا وأرادَ الإسلامَ والمُسلمين بسُوءٍ فأشغِله بنفسِه، واجعَل تدبيرَه تدميرَه يا سميعَ الدُّعاء.
اللهم إنا نسألُك رِضوانَك والجنةَ، ونعوذُ بك مِن سَخَطِك ومِن النار.
اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا مِن كل شرٍّ يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك مِن الخيرِ كلِّه، عاجِلِه وآجلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه، عاجِلِه وآجلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم إنا نسألك الهُدى والتُّقَى والعفافَ والغِنَى.
اللهم إنا نسألك فواتِحَ الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخرَه، ونسألُك الدرجات العُلى مِن الجنَّة يا رب العالمين.
اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على مَن بغَى علينا، اللهم اجعَلنا لك ذاكِرين، لك شاكِرين، لك مُخبِتِين، لك أوَّاهِين مُنِيبِين، اللهم تقبَّل توبتَنا، واغسِل حَوبَتَنا، وثبِّت حُجَّتَنا، وسدِّد ألسِنَتنا، واسلُل سَخِيمةَ قُلوبِنا.
اللهم إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا.
اللهم اغفِر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسرَرنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلَمُ به مِنَّا، أنت المُقدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن زوال نعمتِك، وتحوُّ عافيتِك، وفُجاءة نِقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم إنَّا نعوذُ بك مِن العَجز والكسَل، والجُبن والبُخل، والهرَم، وغلَبَة الدَّين، وقَهر الرِّجال.
اللهم ارحَم موتانا، واشفِ مرضانا، وتولَّ أمرَنا يا ربَّ العالمين.
اللهم وفِّق إمامَنا خادمَ الحرمَين الشريفَين لِما تُحبُّ وترضَى يا ربَّ العالمين، ووفِّق وليَّ عهدِه لكلِّ خيرٍ يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبَّل منَّا إنَّك أنت السَّميعُ العليم، واغفِر لنا إنَّك أنت الغفورُ الرحيم.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُروا اللهَ يذكُركم، واشكُرُوه على نِعمِه يزِدكم، ولذِكرُ الله أكبر، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
خطب الحرمين الشريفين

خُلُق سلامةِ الصَّدر
ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "خُلُق سلامةِ الصَّدر"، والتي تحدَّث فيها عن خُلُق عظيمٍ مِن أخلاقِ الإسلام، ألا وهو: سلامةُ الصَّدر، مُبيِّنًا أهميتَه في حياةِ الفرد والأمَّة، وآثارَه الجليلَة في الدنيا والآخرة.
الخطبة الأولى
الحمدُ للهِ الحليم العظيم، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له ربُّ العرش العظيم، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه المبعُوث بكلِّ خُلُق كريم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه وأصحابهِ، والتابِعين المُقتَدين المُتمسِّكين لهم بالدين القَويم.
أيها المُسلمون:
أُوصِيكم ونفسي بتقوَى الله - جلَّ وعلا -، وطاعتِه في الشدَّة والرَّخاء، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71].
أيها المُسلمون:
في زمنٍ ظهر فيه حبُّ الدنيا بمُختلَف الصُّور والأشكال، يحتاجُ المُسلمُ إلى التذكيرِ بما يبعَثُه على محبَّة الآخرين، وبَذل الخَير والمعرُف لهم، وكفِّ الشرِّ والأذَى عنهم، إنَّه خُلُق "سلامة الصَّدر"، الذي يعيشُ به المُسلمُ سعيدًا مرضيًّا، مسرُورًا مُطمئنًّا.
إنَّ سلامةَ الصَّدر مِن أنبَل الخِصال وأشرَفِ الخِلال التي يُدرِكُ بها المُسلمُ عظيمَ الأجر، وحُسنَ المآب، يقولُ ربُّنا - جلَّ وعلا -: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88، 89].
ومِن علامات سلامةِ القلبِ بعد الإيمان والتقوَى، والتوحيد واليَقِين: أن يكون القلبُ نقيًّا مِن الغِلِّ والحسَد والحِقد على المُسلمين. يعيشُ المُسلمُ مع إخوانِه بصفاءِ قلبٍ، وطِيبِ نفسٍ، وحُسن سَريرةٍ، لا يحمِلُ لهم ضغِينةً ولا كراهيةً، ولا يُضمِرُ لهم حِقدًا ولا غِشًّا، ولا خِداعًا ولا مكرًا، بل يعيشُ بنفسٍ تَفِيضُ بالخَيرات والإحسان، والخُلُق الجَميل، والصَّفاء والنَّقاء.
فهو مِن نفسِه في راحةٍ، والنَّاسُ مِنه في سَلامةٍ، لا يعرِفُ النَّاسُ مِنه بلاءً ولا شرًّا، ولا يُقاسُون مِنه عناءً ولا شَقاءً.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُؤمِنُ أحدُكم حتَّى يُحبَّ لأخِيه ما يُحبُّ لنفسِه»؛ متفق عليه.
إخوة الإسلام:
مِن النَّعيم المُعجَّل في هذه الحياة، بل هو جنَّةُ الدُّنيا، وبِه تكونُ لذَّةُ العيش، وذلك أن يحرِصَ المُسلمُ على تحصيلِ نِعمةِ سلامةِ الصَّدر على كلِّ مَن عاشَ معه أو خالَطَه، بل على كلِّ أحدٍ مِن المُسلمين، قال تعالى في وصفِ أهلِ الجنَّة: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43].
قال ابنُ عطيَّة - رحمه الله - عند هذه الآية: "وذلك أنَّ صاحِبَ الغِلِّ مُعذَّبٌ بِهِ، ولا عذابَ في الجنَّة".
وفي أبرَزِ دعوات أهلِ الإيمان ما وصَفَهم به ربُّهم - جلَّ وعلا -: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
إخوة الإسلام:
مِن أفضلِ الأعمال: سلامةُ الصَّدر مِن أنواع الشَّحناءِ كلِّها، ومِن البَغضاءِ بجميعِ صُورِها.
قِيل لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ النَّاسِ أفضَلُ؟ قال: «كلُّ مخمُومُ القلبِ صَدُوقُ اللِّسانِ»، قالُوا: صَدُوقُ اللِّسان نعرِلإُه، فما مخمُومُ القلبِ؟ قال: «هو النقِيُّ التقِيُّ لا إثمَ علَيه ولا بغي، ولا غِلَّ ولا حسَد»؛ رواه ابن ماجه، وصحَّح إسنادَه المُنذريُّ وغيرُه مِن المُحدِّثين.
وقد أدركَ سلَفُ الأمة - رضي الله عنهم - هذه الحقيقةَ، فعمِلُوا بها ودعَوا إليها.
فهذا زيدُ بن أسلَم يدخُلُ على أبِي دُجانةَ - رضي الله عنهما - وهو مرِيضٌ، وكان وجهُه يتهلَّل، فقال له: مالك يتهلَّلُ وجهُك؟ قال: "ما مِن عملِ شيءٍ أوثَقُ عِندِي مِن اثنتَين؛ أما أحدِهما: فكنتُ لا أتكلَّمُ بما لا يَعنِيني، وأما الأُخرى: فكان قَلبِي للمُسلمين سَلِيمًا".
ويقولُ الفُضَيلُ بن عِياضٍ - رحمه الله -: "ما أدرَكَ عِندنا مَن أدرَكَ بكثرةِ نوافِلِ الصلاةِ والصِّيام، وإنَّما أدرَكَ عِندنا بسَخاءِ الأنفُسِ، وسلامةِ الصُّدُور، والنُّصح للأمة".
إخوة الإسلام:
مِن الأسبابِ المُعِينة على سَلامةِ الصَّدر: الإخلاصُ لله - جلَّ وعلا -، والصِّدقُ معه، والرِّضاءُ بالقَدَر وبما كتَبَه الله - جلَّ وعلا - للعبدِ في هذه الحياة، ولُزُوم طاعةِ الله - جلَّ وعلا -، والإكثارُ مِن تلاوةِ كتابِه - سبحانه -، مع بَذلِ الإنسان الاجتِهادَ في مُجاهَدة النَّفسِ مِن الأدواءِ الخبيثة؛ كالغِشِّ والغِلِّ والحسَد، مع تذكُّرٍ دائِمٍ لما تعُودُ به تلك الأخلاقُ الخبيثةُ على الإنسانِ بالشرِّ الوَبِيل في العاجِلِ والآجِلِ.
ثم يجتهِدُ العبدُ بالدُّعاء الخالِصِ الصَّادِقِ أن يرزُقَه الله - جلَّ وعلا - قلبًا سليمًا، ولِسانًا صادقًا، مع عملٍ صادِقٍ ببذلِ كلِّ ما يجلِبُ المحبَّةَ والمودَّة، ويدفَعُ البُغضَ والكراهيةَ، مِن بَذلٍ للسلام، وتَركِ الإنسان ما لا يَعنِيه مِن أمور الخلق، والحِرصِ على بَذل العطيَّة والهديَّة، فهي جالِبةٌ للمودَّة، دافِعةٌ للكراهِية.
وكذا يحرِصُ المُسلمُ على الدُّعاء للمُسلمين جميعًا، والعفوِ عند الإساءَة، وبَذلِ الإحسان بشتَّى صُوره ومُختلَف أشكالِه القوليَّة والفعليَّة، مما يترتَّبُ عليه إدخالُ السُّرور على قُلوبِ المُسلمين؛ فالمُسلمُ شأنُه الفرَحُ بما يُفرِحُ المُسلمين، والمُشاركةُ الفاعِلةُ بما يُواسِيهم عِند أحزانِهم وهُمُومِهم.
فكُن - أيها العبدُ - على مُجاهدةٍ شديدةٍ للشَّيطان، فهو حرِيصٌ على إيغارِ الصُّدُور، وإفسادِ القُلُوب، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء: 53].
وفيما رواه مُسلمٌ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الشَّيطانَ أيِسَ أن يعبُدَه المُصلُّون في جَزيرَةِ العربِ، ولكن في التَّحرِيشِ بينَهم».
وإنَّ مما يسلَمُ به المُسلم: البُعدَ عن المُجادلَة والمِراءِ والمُخاصَمة حول المسائِلِ والوقائِعِ والأحداثِ، مما لا جَدوَى فيه، فهذا مما يُثيرُ الحِقدَ والكراهِيةَ، ويُذكِي الشَّحناء، ويُوجِدُ النُّفرةَ بين المُسلمين، وإنَّما تُحمدُ المُجادلَةُ لإحقاقِ حقٍّ مِن عالمٍ ناصِحٍ مُخلِصٍ، صادِقٍ مُتوسِّمٍ بجميعِ شُروطِ وصِفاتِ وعناصِر المُجادلَة والمُناظَرة، وفقَ أدبٍ جمٍّ، وخُلُقٍ أشَم، قال الله - جلَّ وعلا -: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83].
أقولُ هذا القَول، وأستغفِرُ اللهَ لِي ولكُم ولسائرِ المُسلمين مِن كل ذنبٍ، فاستغفِرُوه إنَّ هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله كما ينبغي لجلالِ وجهِه وعظيمِ سُلطانِه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظيمًا لشأنِه، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه الدَّاعِي إلى رِضوانِه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابِه.
أيها المسلمون:
إنَّ سلامةَ الصَّدر بابٌ عظيمٌ إلى النَّعيم المُقِيم.
قال أحدُ السَّلَف: "أصلُ الدِّين الورَع، وأفضلُ العِبادة مُكابَدةُ اللَّيل، وأقصَرُ طريقِ الجنَّة سلامةُ الصَّدر".
فالزَمُوا سلامةَ الصَّدر، وصفاءَ القلبِ، ونقاءَ السَّريرة.
ولذا حرِصَ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم - على تحقيقِ ما يُؤصِّلُ هذا الأصلَ، ويدرأُ عنه كلَّ العوارِضِ والأدواءِ؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحاسَدُوا، ولا تباغَضُوا، ولا تدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ الله إخوانًا، لا يحِلُّ لمُسلمٍ أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ»؛ رواه مسلم.
فكُونُوا - عباد الله - إخوانًا مُتحابِّين، على التقوَى مُتوادِّين، وعلى الطاعة والبِرِّ مُتواصِين.
ثم إنَّ الله - جلَّ وعلا - أمرَنا بأمرٍ عظيمٍ، ألا وهو الإكثارَ مِن الصلاةِ على النبيِّ الكريم.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبِيبِنا ونبيِّنا وقُرَّةِ عُيُونِنا نبيِّنا مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ما تعاقَبَ اللَّيلُ والنَّهار، ورضِيَ الله عن الخُلفاء الراشِدين، وعن الصحابة والآل أجمعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، اللهم وانصُر عبادَك المُوحِّدين.
اللهم مَن أرادَ المُسلمين بسُوءٍ فأشغِله في نفسِه، واجعَل تدمِيرَه في تدبِيرِه يا ربَّ العالمين.
اللهم اغفِر للمُؤمنين والمُؤمنات، والمُسلمين والمُسلمات، الأحياء مِنهم والأموات.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النَّار.
اللهم ارُزقنا سلامةَ القلبِ، اللهم ارُزقنا سلامةَ القلبِ، والصِّدقَ في الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعَلنا إخوةً مُتحابِّين على البِرِّ والتقوَى يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق خادمَ الحرمين لِما تحبُّه وترضَاه، اللهم وفِّقه ونائِبَه لِما تُحبُّه وترضاه، اللهم وفِّقهما لما فِيه خِدمةُ الإسلام والمُسلمين. اللهم وفِّق جميعَ وُلاة أمورِ المُسلمين لِما تُحبُّه وترضاه يا ربَّ العالمين، اللهم اجعَلهم رحمةً على رعاياهم، اللهم اجعَلهم رحمةً على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اكشِف همَّنا وهمَّ كلِّ مُسلمٍ يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم فرِّج هُمومَ المُسلمين، اللهم فرِّج هُمومَ المُسلمين، اللهم اكشِف كربَهم، اللهم اكشِف كربَهم في كلِّ مكانٍ، اللهم اكشِف كربَهم في كلِّ مكانٍ، اللهم أغنِ فقيرَهم، اللهم واشفِ مريضَهم، اللهم واهدِ ضالَّهم، اللهم ثبِّت مُطيعَهم يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم يا غنيُّ يا حميد، يا قابِضُ يا باسِطُ يا ماجِد، اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا، اللهم اسقِنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم ديارَنا وديارَ المُسلمين، اللهم ديارَنا وديارَ المُسلمين، اللهم ديارَنا وديارَ المُسلمين، اللهم بارِك لنا فيما نزلَ مِن رحمتِك، اللهم بارِك لنا فيما أنزَلتَ مِن رحمتِك، اللهم اجعَله مُبارَكًا نافعًا للمُسلمين يا حيُّ يا قيُّوم، اللهم أنزِل لهم فيه البركة، اللهم أنزِل لهم فيه البركة، اللهم أنزِل لهم فيه البركة يا حيُّ يا قيُّوم.
عباد الله:
اذكُرُوا اللهَ ذِكرًا كثيرًا، وسبِّحُوه بُكرةً وأصيلًا.
خطب الحرمين الشريفين

حُسنُ إسلام العبدِ
ألقى فضيلة الشيخ أسامة
بن عبد الله خياط - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حُسنُ إسلام العبدِ"،
والتي تحدَّث فيها عن خصلةٍ مِن جميلِ الخِصال، وفضيلةٍ مِن أعظم الفضائِل، وهي
تركُ الإنسان ما لا يَعنِيه مِن الأمور، كما صحَّ ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد بيَّن في
خُطبتِه أنَّ ذلك مِن كمال رجاحة عقلِ العبدِ، وقوَّةِ إيمانِه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله الذي أكملَ لنا الدِّين، وأتمَّ علينا النِّعمة، وأكرمَنا ببِعثة سيِّد المُرسَلين - صلى الله عليه وسلم -، أحمدُه - سبحانه - والحمدُ حقٌّ واجِبٌ له في كلِّ حِين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملِك الحقُّ المُبين، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه صاحِبُ النَّهج الراشِد والخُلُق القَويم، المبعُوث رحمةً للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ الطيبين الطاهرين، وصحابتِه الغُرِّ الميامين، والتابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله - عباد الله -؛ فتقوَى الله خيرُ زادٍ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهَاد، واذكُروا أنَّه - سبحانه - خلَقَكم لعبادتِه وحدَه دُون سِواه، فأخلِصُوا له الدِّين، وأحسِنُوا العمل؛ فالسَّعيدُ مَن أخلَصَ دينَه لله، وتابَعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتاه أمرُ الله.
أبها المُسلمون:
إنَّ حِرصَ المرءِ على سلامةِ دينِه، وحُسن إسلامِه، وصحَّة إيمانِه دليلٌ ظاهرٌ، وآيةٌ بيِّنة، وبُرهانٌ شاهِد على رَجاحَة عقلِه، واستِقامةِ نَهجِه، وكمالِ توفيقِه. فدينُ المُسلم - يا عباد الله - هو دليلُه وقائِدُه إلى كل سعادةٍ في حياتِه الدنيا، وإلى كل فوزٍ ورِفعةٍ في الآخرة؛ لما جاء فيه من البيِّنات والهدى الذي يستَعصِمُ به من الضلال، وينأَى به عن سُبُل الشقاء، ومسالك الخسران.
ولقد أرشد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم، وهو الحريصُ على كلِّ خيرٍ لأمَّته، الرؤوف الرحيم بها - أرشَدَ إلى أدبٍ جامعٍ، وخصلةٍ شريفة، وخُلُقٍ كريم يحسُنُ به إسلام المرء، ويبلُغُ به الغايةَ مِن رضوان الله، وذلك في قولِه - صلواتُ الله وسلامُه عليه -: «مِن حُسنِ إسلامِ المَرء تَركُهُ ما لا يَعنِيه»؛ أخرجه الإمام مالِكٌ في "الموطأ"، والترمذي في "جامعه"، وابن ماجه في "سُننه"، وابن حبَّان في "صحيحه"، وعبدُ الرزاق في "مُصنَّفه".
وهو وإن كان مُرسَلًا إلا أنَّ له طُرقًا وشواهِد يرتَقِي بها إلى درجة الحسَن لغيرِه، بل صحَّحه جمعٌ مِن أئمة أهل العلم بالحديث، مِنهم: الإمامُ ابن حبَّان، والعلامةُ أحمد محمد شاكر، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمهم الله -، على تفصيلٍ يُعرفُ مِن مظانِّه في كُتُبهم.
وهذا الحديثُ كما قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: "مِن الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقُلْهُ أحدٌ قبلَه - صلى الله عليه وسلم -".
وهذا دليلٌ على أنَّ ابنَ عبد البرِّ - رحمه الله - مِن القائِلِين بتصحيحِ الحديثِ، أو على الأقلِّ بقوَّته وثُبُوتِه، فقال - رحمه الله -: "إنَّ هذا الحديث مِن الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقُلْهُ أحدٌ قبلَه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مَن حسُن إسلامُه ترَكَ ما لا يَعنِيه مِن الأقوال والأعمال؛ إذ الإسلام يقتَضِي فعل الواجبات، وترك المحرمات، وإذا حسُنَ الإسلام استلزَمَ ذلك ترك ما لا يَعنِي مِن المُحرَّمات، والمُشتَبهات، والمكرُوهات، وفُضُول المُباحات، وهي القَدرُ الزائِدُ على الحاجةِ".
فإنَّ هذا كلَّه لا يَعنِي المسلم إذا كمُل إسلامه، وبلَغَ درجةَ الإحسان الذي أوضَحَ رسولُ الهدى - صلى الله عليه وسلم - حقيقتَه في حديثِ سُؤال جبريل - عليه السلام - عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال - عليه الصلاة والسلام - في رِوايتِه للحديثِ عن جبريل - عليه السلام - قال: «أَن تَعبُدَ اللهَ كأنَّك تَرَاه، فإن لم تكُن تَرَاه فإنَّه يَرَاك»؛ أخرجه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حديث أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ومَن عبَدَ اللهَ على استِحضار قُربِه مِن ربِّه، أو قُربِ ربِّه مِنه فقد حسُنَ إسلامُه، ولزِمَ لذلك أن يترُك كلَّ ما لا يَعنِيه في الإسلام، واشتغَلَ بما يَعنِيه مِن صحَّة اعتِقاد، وكمال إيمان، وصلاحِ عمل، وطلَبِ ما هو مِن ضروراتِ معاشِه لا قِيامَ لحياتِه بدُونِه مِن ألوانِ المُباحات.
وعلى العكسِ مِن ذلك: مَن أضاعَ نفائِسَ الأوقات فيما لم تُخلَق له، باشتِغالِه بما لا يَعنِيه، وما لا يحتاجُ إلَيه مِن قولٍ وعملٍ، فانصَرَفَ عما ينفعُه، ويرتفِعُ بمقامِه، ويبلُغُ به صحيحَ الغاياتِ، وشريفَ المقاصِد، وكريمَ المنازِل، فخسِرَ هُنالِك خُسرانًا مُبينًا.
ذلك أنَّ ما لا يحتاجُ إليه الإنسانُ مِن قولٍ وعملٍ، بل يفعلُه عبَثًا، فهذا كما قال شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا علَيه لا لَهُ، وفي "الصحيحين": عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليصمُت».
يعنِي: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ المُؤمِنَ بأحدِ أمرَين: قولِ الخَير، أو الصُّمات؛ ولهذا كان قَولُ الخير خيرًا مِن السُّكُوت عنه، والسُّكُوتُ عن الشرِّ خيرًا مِن قولِه.
فالمُؤمنُ مأمُورٌ إما بقولِ الخَير أو الصُّمات، فإذا عدَلَ عمَّا أُمِرَ بِهِ مِن الصُّمات إلى فُضُولِ القَول الذي ليسَ بخَيرٍ كان هذا علَيه؛ فإنَّه يكونُ مكرُوهًا، والمكرُوهُ يُنقِصُه.
ولهذا قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِن حُسنِ إسلامِ المَرءِ تَركُه ما لا يَعنِيه».
فإذا خاضَ فيما لا يَعنِيه نقَصَ إسلامُهُ، فكان هذا علَيه؛ إذ ليس مِن شَرطِ ما هو علَيه - أي: مِن النَّقصِ في حُسن إسلامِهِ - لَيسَ مِن شرطِه أن يكون مُستحِقًّا لعذابِ جهنَّم وغضَبِ الله، بل نقَصَ قدرُه ودرجتُه علَيه". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
ألا وإنَّ مِن اشتِغالِ المَرءِ بما لا يَعنِيه: تعلُّمَ ما لا يُهِمُّ مِن الأمور، وتركَ الأهمِّ مِنها مما فِيه صلاحُ قلبِه، وتزكِيةُ نفسِه، ونفعُ إخوانِه، ورفعُ شأنِ وطنِه ورُقِيِّ أمَّتِه.
ومِنه أيضًا: عدمُ حِفظِ اللِّسان عن لَغوِ الكلام، وعن تتبُّع ما لا يُهِمُّ ولا ينفَع تتبُّعُه مِن أخبارِ الناسِ وأحوالِهم، وأموالِهم، ومِقدار إنفاقِهم وادِّخارِهم، وإحصاءِ ذلك علَيهم، والتنقِيبِ عن أقوالِهم وأعمالِهم داخِلَ دُورِهم وبين أهلِيهم وأولادِهم بغَيرِ غرَضٍ شرعيٍّ سِوَى الكَشفِ عما لا يَعنِيه مِن خاصِّ شُؤونِهم، وخفِيِّ أمورِهم.
ومِن ذلك أيضًا: تكلُّمُ المرء فيما لا يُحسِنُه ولا يُتقِنُه مما لم يُعرَف له اختِصاصٌ فِيه، ولا سابِقُ إلمامٍ وخِبرةٍ بِه، وما ذلك إلا لطلَبِ التسلِّي وإزجاءِ الوقتِ وإضاعتِه في تصدُّر المجالِس، وصَرفِ الأنظار إليه، وقد يخرُجُ به ذلك إلى الخَوضِ فيما لا يجوزُ الخَوضُ فِيه مِن أحاديث الفواحِشِ والشَّهوات، ووصفِ العَورَات، وقَذفِ المُحصَنات المُؤمنات الغافِلات، ونشر قَالَة السُّوء، وبَثِّ الشَّائِعات والأكاذِيب والأخبار المُفتَرَيات.
وقد يجتمِعُ إلى ذلك ولَعٌ بما يُسمَّى بـ "التحليلات والتوقُّعات" المبنيَّة في غالبِها على الظنُون والأوهام والمُجازفات، وعلى الجُرأة على الباطلِ، بتصويرِه في صُورة الحقِّ، وكلُّ ذلك مما لا يصحُّ توقُّعه، ولا الخوضُ فيه، ولا الاستِنادُ إليه، ولا الاغتِرارُ به، ولا العملُ بمُقتضاه.
ألا وإمما يُعينُ المرءَ على تركِ ما لا يَعنِيه: تذكُّرَ أنَّ الواجِبات أكثرُ مِن الأوقات، وأنَّ العُمر قصير.
كما أخبَرَ بذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديثِ الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننهما"، والحاكم في "مستدركه" بإسنادٍ صحيحٍ، عن أبي هُريرة وأنسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أعمارُ أمَّتِي ما بين الستِّين إلى السَّبعِين، وأقلُّهم مَن يجوزُ ذلك».
فمِثلُ هذا العُمر الذي لا يكادُ يتَّسِع لما يلزَمُ ويجِبُ، أفيتَّسِعُ للفُضول وما لا يَعنِي؟!
والمرءُ أيضًا مسؤُولٌ عن عُمره فيما أفناه، كما جاء في الحديثِ الذي أخرجه الترمذي في "جامعه" بإسنادٍ صحيحٍ، عن أبي بَرزَة الأسلَمِيِّ - رضي الله عنه -، أنَّه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزُولُ عبدٍ يوم القِيامة حتى يُسأَلَ عن عُمره فيما أفناه، وعن علمِه ما فعلَ فيه، وعن مالِه مِن أين اكتسَبَه وفِيمَ أنفقَه، وعن جِسمِه فِيمَ أبلاه».
وما يلفِظُ الإنسانُ مِن قولٍ إلا وهو مُسطَّرٌ في صحائِفِه، مجزِيٌّ بِه؛ ليعلَمَ أنَّ للكلِمة مسؤوليَّةً وتَبِعَة، كما قال - عزَّ مِن قائِل -: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 16- 18].
وظاهرُ الآية كما قال الإمامُ الحافظُ ابنُ كثير - رحمه الله -: "أنَّ الملَكَ يكتُبُ كلَّ شيءٍ مِن الكلام ويُؤيِّدُه، عُموم قولِه - سبحانه -: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾، فهو شامِلٌ لكلِّ قولٍ".
وقد أخرجَ مالِكٌ في "الموطَّأ"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" بإسنادٍ صحيحٍ، عن علقمَة اللَّيثِيِّ، عن بِلال بن الحارِثِ - رضي الله عنه -، أنَّه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ مِن رِضوانِ الله تعالى ما يظنُّ أن تبلُغَ ما بلغَت، يكتُبُ الله له بِها رِضوانَه إلى يومِ يَلقَاه، وإنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ مِن سَخَطِ الله تعالى ما يظنُّ أن تبلُغَ ما بلغَت، يكتُبُ الله عليه بِها سَخطَه إلى يوم يَلقَاه».
فكان علقَمةُ اللَّيثِيُّ - رحمه الله - يقول: "كَم مِن كلامٍ قد منَعنِي مِنه حديثُ بلالِ بن الحارِثِ" أي: هذا الحديث وما فِيه مِن وعيدٍ.
أما التصدُّرُ وصَرفُ الأنظارُ إليه، فهو مقصُودٌ ذميمٌ، وخصلةٌ مرذُولةٌ، لا يَجتَنِي مَن بُلِيَ بِها سِوَى المقتِ مِن الله - عزَّ وجل - ومِن الذين آمنوا.
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -، واعمَلُوا على الاقتِداءِ بالصَّفوةِ مِن عبادِ الرَّحمن في تَركِ ما لا يَعنِي مِن الأقوالِ والأعمالِ، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18].
نفَعَني الله وإياكم بهَدي كتابه، وبسنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أقولُ قَولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّة المُسلمين مِن كل ذنبٍ، إنَّه كان غفَّارًا.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله أحصَى كلَّ شيءٍ عددًا، أحمدُه - سبحانه - لم يكُن له شريكٌ في المُلك ولم يتَّخِذ صاحِبةً ولا ولَدًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ سيِّدنا ونبيَّنا مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه، نبيُّ الرحمة والهُدى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه الأئمة الأعلام النُّجبَا.
أما بعد .. فيا عباد الله:
نُقِلَ عن الحسَن البصريِّ - رحمه الله - قولُه: "مِن علامةِ إعراضِ الله عن العبدِ: أن يجعلَ شُغلَه فيما لا يَعنِيه". اهـ.
فعلى العاقِلِ الذي يرجُو اللهَ والدارَ الآخرة إذًا أن يكون مُقبِلًا على شأنِه، حافظًا للسانِه، بصِيرًا بزمانِه، وأن يعُدَّ كلامَه مِن عملِه، فإنَّ مَن عدَّ كلامَه مِن عملِه قلَّ كلامُه إلا فيما يَعنِيه؛ ذلك أنَّ أكثرَ ما يُقصَد بتَركِ ما لا يَعنِي - كما قال الحافظُ ابنُ رجبٍ - رحمه الله -: "أكثرُ ما يُقصَدُ بتَركِ ما لا يَعنِي: حِفظُ اللِّسان عن لَغوِ الكلام، وحسبُه ضررًا - اللِّسان - أن يشغَلَ صاحبَه عن ألوانٍ كثيرةٍ مِن الخير الذي يسمُو به مقامُه، ويعلُو به قَدرُه، وتشرُفُ به منزلتُه، وتطِيبُ به حياتُه، وتحسُنُ به عاقِبتُه".
ألا فاتَّقُوا الله - عباد الله -، واحرِصُوا على ما ينفعُكم في دُنياكُم وأُخراكم، وعلى اجتِنابِ ما لا يَعنِيكم مِن الأقوال والأعمال.
واذكُروا على الدَّوام أنَّ الله تعالى قد أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على سيِّد الأولين والآخرين، ورحمةِ الله للعالمين، فقال - سبحانه - في الكِتابِ المُبين: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
وارضَ اللهم عن خُلفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، وعن أزواجِه أمَّهات المُؤمنين، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا أكرمَ الأكرَمِين.
اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، واحمِ حَوزةَ الدين، ودمِّر أعداءَ الدين، وسائِرَ الطُّغاة والمُفسِدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفَهم، وأصلِح قادَتَهم، واجمَع كلمَتَهم على الحقِّ يا ربَّ العالمين.
اللهم انصُر دينَك وكتابَك، وسنَّةَ نبيِّك مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وعبادَك المؤمنين المجاهدين الصادقين.
اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، وأيِّد بالحقِّ إمامَنا ووليَّ أمرِنا خادمَ الحرمَين الشريفَين، وهيِّئ له البِطانةَ الصالِحةَ، ووفِّقه لما تُحبُّ وترضَى يا سميعَ الدُّعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خَيرُ الإسلام والمُسلمين، وإلى ما فيه صلاحُ العِباد والبِلاد يا مَن إليه المرجِعُ يوم المعاد.
اللهم أحسِن عاقبَتَنا في الأمور كلِّها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا ربَّ العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا ربَّ العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شِئتَ يا ربَّ العالمين، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِ أعدائِك وأعدائِنا، ونعوذُ بك مِن شُرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك مِن شُرورهم.
اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أردتَّ بقومٍ فتنةً فاقبِضنا إليك غيرَ مفتُونين.
اللهم أصلِح لنا دينَنَا الذي هو عِصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعَل الحياةَ زيادةً لنا في كل خيرٍ، والموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ.
اللهم إنا نعوذُ بك مِن زوالِ نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميعِ سخَطِك.
اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، وارحَم موتانا، وارحَم موتانا، وارحَم اللهم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا، واختِم بالباقِيات الصالِحات أعمالَنا.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
وصلِّ اللهم وسلِّم على نبيِّنا مُحمدٍ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
خطب الحرمين الشريفين

التحذيرُ
من ملَل النِّعمة وازدِرائِها
ألقى فضيلة الشيخ فيصل بن
جميل غزاوي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "التحذيرُ من ملَل النِّعمة
وازدِرائِها"، والتي تحدَّث فيها عن نِعمِ الله تعالى الكثيرة على عِبادِه،
ووُجوبِ شُكرِها، مُحذِّرًا مِن كُفرها وجُحودِها وازدِرائِها، مُبيِّنًا عاقبة
ذلك في الدنيا قبل الآخرة، كما بيَّن كيفيَّة عِلاجِ هذا الملَل أو الفُتُور الذي
يُصيبُ العَبدَ بين الحِين والآخر، وأنَّ لا ينبغي أن يكون سببًا في تأخُّرِه عن
فعلِ العِبادة أو العمل الصالِح أو تركِه بالكليَّة.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله خالق الكَون، وبارِي البريَّات، ومُقسِّم الأرزاق والأقوات، ومانِح العطايا والهِبات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له يُعطِي مَن يشاءُ بفضلِه، ويمنَعُ مَن يشاء بحِكمتِه، لا مانِعَ لِما أعطَى، ولا مُعطِي لِما منَع، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ مِنه الجَدُّ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه رضِيَ بما أعطاه الله، وقنِعَ بما كتَبَ له، وكان شاكرًا في السرَّاء، صابِرًا في الضرَّاء، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه أجمعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ - عباد الله -؛ فبتقوَاه تُعصَمُون مِن الضلالة، وتُحفَظُون مِن الغِواية، وتنالُون عِزَّ الدنيا وسعادةَ الآخرة.
أيها المُسلمون:
إنَّ معايِشَ العِباد وأرزاقَهم الدنيويَّة، وأُعطياتهم في الحياة بيَدِ الله وحدَه، وهو الذي يُقسِّمُها بين عِبادِه، قال تعالى: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: 26].
قال البغويُّ - رحمه الله -: "أي: يُوسِّعُ على مَن يشاءُ، ويُضيِّقُ على مَن يشاءُ، وله الحِكمةُ والعدلُ التامُّ".
ومِن حكمتِه - سبحانه -: أن فاوَتَ بين الناسِ في أرزاقِهم، واختلَفَ عطاؤُه مِن عبدٍ إلى آخر، فيُعطِي هذا ما يمنَعُه غيرَه، والعكس، وقد لا يُدرِكُ المرءُ النِّعمَ التي أنعمَها الله عليه، فلا يرَاها شيئًا، وقد يُؤدِّي به ذلك إلى المَلَل ولسآمة والضَّجَر، فيُريدُ أن يتحوَّل عنها إلى غَيرِها.
ولنا في الماضِين عِبرةٌ وعِظة؛ فبنُو إسرائيل الذين طلَبُوا مِن نبيِّ الله مُوسَى - عليه السلام - أن يكون لهم طعامٌ بدلًا مِن المَنِّ والسَّلوَى الذي لم يعُودُوا يصبِرُوا علَيه، بل ملُّوا، فاستبدَلُوا بذلك ما هو أدنَى؛ مِن البُقُول والقِثَّاء والفُوم والعَدَس والبصَل، فتحوَّلُوا عن خيرِ الأطعِمة وأشرَفِها إلى ما طلَبُوا مِن الأدنَى.
وقومُ سبَأ الذين أدامَ الله علَيهم النِّعَم، وصرَفَ عنهم مِن النِّقَم، وقد رزَقَهم الله الجنَّتَين العظيمتَين وما فيها مِن الثِّمار، وجعلَ بلدَهم طيبةً لحُسن هوائِها، وقِلَّة وخَمِها، وحُصُول الرِّزقِ الرَّغَد فيها. بدلًا مِن أن يشكُرُوا اللهَ، بطِرُوا النِّعمةَ وملُّوها، حتى طلَبُوا أن تتباعَدَ أسفارُهم بين تلك القُرَى التي كان السَّيرُ فيها مُتيسِّرًا، فملُّوا حتى الأمنَ والأمانَ الذي كانُوا فيه.
فعاقَبَهم الله، فأرسَلَ عليهم سَيلَ العَرِم الذي خرَّبَ السدَّ، وأتلَفَ جنَّاتهم، فتبدَّلَت تلك الجنَّات ذاتُ الحدائِق المُعجِبة، والأشجارِ المُثمِرة، وصارَ بدلَها أشجارٌ لا نفعَ فيها.
معاشِر المُسلمين:
إنَّ المَلَل مِن نعمةِ الله آفةٌ عظيمةٌ، قد يخسَرُ العبدُ بسبَبِها ما هو فِيه، ويُصبِحُ في حالٍ يتمنَّى لو أن قد رضِيَ بما كان عليه.
يقولُ ابنُ القيِّم - رحمه الله - مُتحدِّثًا عن هذه الآفَة: "مِن الآفات الخفِيَّة العامَّة: أن يكون العبدُ في نعمةٍ أنعمَ الله بها علَيه، واختارَها له، فيمَلَّها ويطلُبَ الانتِقالَ مِنها إلى ما يزعُمُ لجهلِه أنَّه خيرٌ له مِنها، وربُّه برحمتِه لا يُخرِجُه مِن تلك النِّعمة، ويعذُرُه بجَهلِه وسُوءِ اختِيارِه لنفسِه، حتى إذا ضاقَ ذَرعًا بتِلك النِّعمة وسخِطَها وتبرَّمَ بها، واستحكَمَ ملَلُه لها، سلَبَه الله إيَّاها، فإذا انتقَلَ إلى ما طلَبَه، ورأَى التفاوُتَ بين ما كان فيه وما صارَ إلَيه، اشتدَّ قلَقُه وندَمُه، وطلَبَ العودةَ إلى ما كان فيه.
فإذا أرادَ الله بعَبدِه خيرًا ورُشدًا، أشهَدَه أنَّ ما هو فيه نِعمةٌ علَيه، ورضَّاه به، وأوزَعَه شُكرَه علَيه".
نعم .. عباد الله، إنَّ مِن النَّاس مَن لا يشعُرُ بقَدرِ النِّعمة التي هو فيها، فما أكثرَ ما يشكُو، وما أكثرَ ما يتضجَّرُ.
عن عبد الله بن أبِي نُوحٍ قال: قال لِي رجُلٌ على بعضِ السَّواحِل: كم عامَلتَه - تبارك اسمُه - بما يكرَه، فعامَلَك بما تُحبُّ؟ قُلتُ: ما أُحصِي ذلك كثرةً، قال: فهل قصَدتَ إلَيه في كَربِك فخَذَلَك؟ قُلتُ: لا والله، ولكنَّه أحسَنَ إلَيَّ فأعانَنِي، قال: فهل سألتَه شيئًا قطُّ فأعطاك؟ قُلتُ: وهل منَعَنِي شيئًا سألتُه؟ ما سألتُه قطُّ إلا أعطانِي، ولا استَغثتُ به إلا أغاثَني، قال: أرأَيتَ لو أنَّ بعضَ بنِي آدم فعلَ بك هذه الخِلال، ما كان جزاؤُه عِندَك؟ قُلتُ: ما كُنتُ أقدِرُ له على مُكافأةٍ ولا جزاءٍ، قال: فربُّك أحقُّ وأحرَى أن تُدنِيَ نفسَك له في أداءِ شُكرِ نعمتِه علَيك، وهو المُحسِنُ قديمًا وحديثًا إلَيك، واللهِ لشُكرُه أيسَرُ مِن مُكافأةِ عِبادِه، إنَّه - تبارك وتعالى - رضِيَ بالحمدِ مِن العِبادِ شُكرًا.
فالواجِبُ علَينا - عباد الله -: أن نحمَدَ اللهَ دائمًا على كلِّ حالٍ؛ تحدُّثًا بنِعمةِ الله، وإظهارًا لشُكرِه.
فقد روَى الطبرانيُّ عن عبدِ الله بن عَمروٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لرجُلٍ: «كيف أصبَحتَ يا فُلان؟»، قال: أحمَدُ اللهَ إلَيكَ يا رسُولَ الله، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذا الذِي أرَدتُ مِنكَ» أي: إظهارُ الحَمد والشُّكر والثَّناء.
ولما سُئِلَ ابنُ المُغِيرة - رضي الله عنه -: كيف أصبَحتَ يا أبا مُحمد؟ قال: "أصبَحنا مُغرَقِين في النِّعَم، عاجِزِين عن الشُّكرِ، يتحبَّبُ إلَينا ربُّنا وهو عنَّا غنيٌّ، ونتمَقَّتُ إلَيه ونحن إليه مُحتاجُون".
وهذا عَمرُو بن العاصِ - رضي الله عنه - يقولُ: "لا أمَلُّ ثَوبِي ما وسِعَني، ولا أمَلُّ زوجَتِي ما أحسَنَت عِشرَتِي، ولا أمَلُّ دابَّتِي ما حمَلَتني، إنَّ المَلالَ مِن سيِّئ الأخلاقِ".
وصدَقَ - رضي الله عنه -، فالمَلالُ مِن سيِّئ الأخلاقِ، وأقبَحِ الخِصال؛ إذ يجعلُ العبدَ يتنكَّرُ لنعمةِ الله علَيه ويتسخَّطُ، ولا يرضَى بما قسَمَ الله له مِن الرِّزق، وما أسوَأَ أن يكون المرءُ في نِعمةٍ مِن الله وفضلٍ، فإذا بِه يمَلُّ النِّعمةَ ويبطُرُها.
يقولُ ابنُ القيِّم - رحمه الله -: "وليس على العبدِ أضَرُّ مِن مَلَله لنِعَم الله، فإنَّه لا يراها نعمةً، ولا يشكُرُه علَيها، ولا يفرَحُ بها، بل يسخَطُها ويشكُوها، ويعُدُّها مُصيبةً، هذا وهي مِن أعظَمِ نِعَم الله علَيه، فأكثَرُ الناسِ أعداءُ نِعَم الله علَيهم، ولا يشعُرُون بفَتحِ الله علَيهم نِعَمه، وهم مُجتهِدُون في دَفعِها وردِّها جَهلًا وظُلمًا، فكَم سعَت إلى أحدِهم مِن نعمةٍ .. وهو ساعٍ في ردِّها بجُهدِه، وكَم وصَلَت إلَيه .. وهو ساعٍ في دَفعِها وزَوالِها بظُلمِه وجَهلِه".
قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: 53].
فيا أيها المُسلمون:
ما بالُ أقوامٍ يمَلُّون النِّعمةَ التي هم فيها، ويستصغِرُونها، ويتطلَّعُون إلى مَن فُضِّلُوا علَيهم في الدنيا، وقد يُؤدِّي بهم الحالُ إلى حسَدِ غيرِهم، حتى يقُولَ أحدُهم: لماذا كان فُلان أفضَلَ مِنِّي؟ ولِمَ أكُونُ أقَلَّ مِن غَيرِي؟ وإذا ظفِرَ بنِعمةٍ واستمتَعَ بها زمنًا، قال مُستقِلًّا لها مُزدرِيًا: ما عندنا شيءٌ غيرُ هذا؟!
قد ملَّ ما هو فيه مِن النِّعمة، فلا يشكُرُ مولاه، ولا يقنَعُ بما آتاه.
أين هؤلاء مِن النَّظرةِ الحقيقيَّةِ لمتاعِ الدنيا؟ فقد روَى مُسلمٌ في "صحيحِه" عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظُرُوا إلى مَن هو أسفَلَ مِنكُم، ولا تنظُرُوا إلى مَن هو فوقَكم؛ فهو أجدَرُ ألا تزدَرُوا نِعمةَ الله علَيكُم».
أي: أدَرُ أن يشكُرَ المرءُ نعمةَ الله علَيه، إذا هو قنِعَ بما أُعطِي، ولم يمُدَّ عينَيه لما مُتِّعَ به الآخَرُون.
|
فالعَبدُ حُرٌّ إن قَنِعْ |
|
والحُرُّ عَبدٌ إن طَمِعْ |
وإن تعجَب - عبد الله -، فعجَبٌ حالُ مَن يُريدُ أن يحظَى بشيءٍ لم يُكتَب له، أو أن يُغدَقَ علَيه مِن النِّعَم، ليكون في مُستوًى معيشِيٍّ رَفِيعٍ، فيُصبِح في رفاهِيةٍ ورغَدٍ مِن الرِّزق، وبُحبُوحةٍ مِن العَيش. وما درَى هذا المِسكِينُ أنَّ القناعَةَ لا يعدِلُها شيءٌ؛ فهناك مَن أصابَ مِن هذه الدنيا حظًّا وافِرًا، لكنَّه محرُومٌ، لا يشعُرُ بالقناعَةِ والرِّضا أبدًا، بل يطلُبُ المَزِيدَ، وهناك مَن بُسِطَ له في الرِّزقِ، وأُوتِيَ مِن أصنافِ النِّعَم، فبغَى في الأرضِ ولم يشكُر نِعمةَ الله علَيه، فكانت وَبالًا علَيه.
أيها الإخوة:
إنَّ واقِعنا اليوم يشهَدُ صُورًا شتَّى مِن إصابةِ كثيرٍ مِن الناسِ بالمَلَل، والشُّعور بالضِّيق والضَّجَر، وهذا ينشَأ عن ضعفِ صِلةِ العبدِ بربِّه وطاعتِه له، وإعراضِه عن منهَجِه.
فمِن تلك الصُّور الواقعيَّة: سآمةُ بعضِ الناسِ مِن حياتِه عِند الكِبَر، كحالِ الشاعرِ الجاهليِّ القائِلِ:
|
سَئِمتُ تكالِيفَ الحياةِ ومَن يَعِشْ |
|
ثَمانِينَ حَولًا لا أبَا لَكَ يسأَمِ |
وقد يحمِلُه ذلك على أن يدعُو على نفسِه بالموتِ، وغابَ عنه تحذيرُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقولِه: «لا يتمنَّيَنَّ أحدُكُم الموتَ لضُرٍّ نزلَ به، فإن كان لا بُدَّ مُتمنِّيًا للمَوتِ فليَقُل: اللهم أحيِنِي ما كانتِ الحَياةُ خَيرًا لِي، وتوفَّنِي إذا كانتِ الوفاةُ خَيرًا لِي»؛ رواه البخاري ومسلم.
ومِن الناسِ مَن يعيشُ مع والِدَيه أو أحدِهما حياةً سعيدةً طيبةً، بارًّا بهما، مُحسِنًا إليهما، فإذا كَبِرَا عافَى الحياةَ معهما، وملَّ صُحبتَهما، وتنكَّرَ لهما، وصارَ يُعادِيهما ويُؤذِيهما، ويتضجَّرُ مِنهما، ويُسمِعُهما مِن عِباراتِ التأنِيبِ ما يُؤلِمُهما، ويجرَحُ مشاعِرَهما، وينسَى فضائِلَهما. وأيُّ عُقوقٍ أعظَمُ مِن ذلك؟!
ألم يعلَم هذا الجاحِدُ حقَّهما أنَّ اللهَ نهاه أن يُسِيءَ إلَيهما؟ قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23].
فنُهِيَ الولَدُ عن أن يظهَرَ مِنه ما يدُلُّ على التضجُّر مِن أبَوَيه أو الاستِثقالِ لهما.
ومِن الناسِ مَن يبدأُ بتعلُّم القرآن أو الدُّرُوس الشرعيَّة النافِعة، ثم سُرعان ما يُصِيبُه الملَل ويستطِيلُ الطريقَ، فلا يثبُت، بل يستعجِلُ ويترُكُ ما هو فِيه، وينتقِلُ إلى علمٍ آخر دُون تدرُّجٍ، ومِن غير منهجيَّةٍ في الطلَبِ، ولا صبرَ ولا مُصابَرة.
ومِنهم مَن يكونُ له دورٌ عظيمٌ في تعليمِ الناسِ وفي دعوَتِهم، ونُصحِهم وتوجِيهِهم وإرشادِهم، فإذا طالَ علَيهِ الأمَد، وشعَرَ ألا فائِدةَ مِن التَّكرار والاستِمرار، أو وجَدَ في طريقِ دعوَتِه مَن عانَدَ واستَكبَرَ، وامتنَعَ عن قَبُول الحقِّ، فيقطَعُ رجاءَه في انتِفاعِهم، وييأَسُ مِن حالِهم، فيمَلُّ ويترُكُ مُواصَلةَ العمل دُون أن يستشعِرَ مكانةَ وشَرَفَ ما كان يقُومُ بِه.
ومِنهم مَن يقومُ بعملٍ خيرِيٍّ يُداوِمُ على فعلِ بِرٍّ وقُربَى؛ كقضاءِ حوائِج المسلمين، وإعالَة فُقراء مُحتاجِين، أو تفريجِ كُرُبات المُعسِرين، أو كفالَةِ أيتام، أو السَّيِ في الإصلاحِ بين الأنام، ثم لا يلبَثُ أن يترُكَ ذلك مِن غيرِ عُذرٍ مانِعٍ قاهِرٍ، ولا سبَبٍ وَجِيهٍ ظاهِرٍ، بل ملَلُه وفُتُورُه وسآمَتُه أدَّت إلى أن ينقطِعَ عن الخَيرِ الذي كان فِيه، ويُحرَم مِن الأجر الذي كان ينالُه ويَجنِيه.
أقولُ قَولِي هذا، وأستغفِرُ الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائِرِ المُسلمين، فاستغفِرُوه إنَّه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله الملِكُ الحقُّ المُبين، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه خاتمُ النبِيِّين، حثَّنا على الجِدِّ والعمل، ونهانا عن السآمَة والملَل، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.
أما بعد .. فيا عباد الله:
علينا أن نثبُتَ في طريقِ سَيرِنا إلى ربِّنا، ونحذَرَ أن تنحَرِفَ بنا الوِجهةَ عن طريقِ نجاتِنا، ونحذَرَ كذلك أن نمَلَّ النِّعمةَ والطاعةَ، وذلك يتأتَّى بأمُورٍ هي مِن وسائِلِ العِلاجِ لدَفعِ هذه الآفَةِ العظِيمةِ وإزالَتِها مِن النَّفسِ، مِنها:
تقوِيةُ الصِّلةِ بالله، ومُلازمةُ العبد دُعاءَ ربِّه، حتى يثبُتَ ويُواصِلَ العملَ؛ فقد كان أكثرُ دُعاءِ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «يا مُقلِّبَ القُلُوب! ثبِّت قَلبِي على دينِك».
وأوصَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُعاذَ بن جبَلٍ - رضي الله عنه - فقال: «أُوصِيكَ يا مُعاذ لا تدَعَنَّ في دُبُر كلِّ صلاةٍ تقُول: اللهم أعِنِّي على ذِكرِك وشُكرِك وحُسنِ عِبادتِك»؛ رواه أبو داود.
ومِنها: الصِّدقُ مع الله، وأخذُ الأمور بجِدٍّ وحَزمٍ، حتى يسمُو المرءُ عن مُستنقَعِ الكسَلِ والملَلِ، وهذا الذي دعَا علِيَّ بن أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - أن يُواظِبَ على الذِّكرِ الذي علَّمَه له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولفاطمة إذا أخَذَا مضجِعهما، حتى إنَّه لم يترُكه ليلةَ صِفِّين ليلةَ الحربِ والشِّدَّة.
ومما يُعينُ على البُعد عن الملَل والفُتُور: قِصَرُ الأمل وتذكُّرُ الآخرة، وهذا مِن أعزم المُوقِظات للهِمَّة، ومِن أكبَر البواعِثِ على الإقبالِ على الله، فيُدرِكُ المرءُ أنَّ الدنيا مزرعةٌ للآخرة، وفُرصةٌ لكَسبِ الأعمالِ الصالِحة.
كما أنَّه لا بُدَّ للمرءِ مِن دافعٍ قويٍّ يُنشِّطُه ويدفَعُه إلى عِبادةِ ربِّه، فعند إصابة أحدِنا بالملَل وهو يُداوِمُ على صالِحِ العمل، علَيه أن يستشعِرَ قِيمةَ ما يقُومُ به، وما له مِن الأجرِ علَيه.
فقد كان مسلَمةُ بن عبد الملك - رحمه الله - إذا أكثَرَ علَيه أصحابُ الحوائجِ، وخشِيَ الضَّجَر، أمرَ أن يحضُر نُدماؤُه مِن أهل الأدَب، فتذاكَرُوا مكارِمَ الأخلاق في الناسِ، وجَميلَ طرائِقِهم ومُروءَاتِهم، فيطرَبَ ويَهِيج، ثم يقول: ائذَنوا لأصحابِ الحوائِجِ، فلا يدخُلُ علَيه أحدٌ إلا قضَى حاجتَه.
وهكذا لو أقبَلَ المرءُ على العِبادة بنفسٍ مُنشَرِحة، واستِشعارٍ لقَدرِها، لوجَدَ لذَّةَ الطاعة وحلاوةَ الإيمان، ولعلَت همَّتُه، وقوِيَت عزيمتُه، فلم ينفَكَّ عن العمل، ولم يغتَرَّ بطُول الأمل، ولم يطرَأ علَيه الملَل.
عن عَون بن عبدِ الله بن عُتبةَ قال: أتَينا أمَّ الدَّرداء، فتحدَّثنَا عِندها، فقُلنا: أملَلناكِ يا أمَّ الدَّرداء، فقالَت: ما أملَلتُمُونِي، لقد طلَبتُ العِبادةَ في كلِّ شيءٍ، فما وجَدتُ شيئًا أشفَى لنفسِي مِن مُذاكَرةِ العلمِ. أو قالت: مِن مُذاكَرة الفِقهِ.
كما أنَّ على العبدِ ألا ييأَسَ مِن حالِه، ويحذَرَ أن يمَلَّ مِن تكرارِ التوبةِ كلما أخطأَ.
قِيل للحَسَن - رحمه الله -: ألا يستَحِيي أحدُنا مِن ربِّه، يستغفِرُ مِن ذنوبِه ثم يعُود، يستغفِرُ ثم يعُود؟ فقال: "ودَّ الشَّيطانُ لو ظفِرَ مِنكم بهذه، فلا تملُّوا مِن الاستِغفار".
عباد الله:
إنَّ الأَولَى بالملَل والكلَل والفُتُور هو صاحِبُ المعصِية والمُجاهِر بفِسقِه؛ فجديرٌ به أن يسأَمَ مِن ارتِكابِ المُحرَّمات، ويتوقَّفَ عن اجتِراحِ المُوبِقات، ويحذَرَ مِن سُوءِ الخاتمةِ والمُهلِكات، ويُقبِلَ على مَن يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِّئات.
أيها المُسلمون:
اجعَلُوا نُصبَ أعيُنِكم وأنتُم في طريقِ سَيرِكم إلى ربِّكم هَديَ قُدوتِنا - صلى الله عليه وسلم -، فمع أنَّ الله قد غفَرَ له ما تقدَّمَ وما تأخَّرَ مِن ذنبِه، إلا أنَّه لم ينقطِع عن العِبادة؛ بل كان دائِمَ الصِّلة بربِّه، مُقبِلًا علَيه، مُجتهِدًا في طاعتِه، لا يكَلُّ ولا يمَلُّ، ولا يسأَمُ ولا يفتُر.
هذا وصلُّوا وسلِّمُوا - رحِمَكم الله - على النبيِّ المُصطفى، والرسُولِ المُجتبَى؛ امتِثالًا لأمرِ الله - جلَّ وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد، وبارِك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيد.
اللهم وارضَ عن الخُلفاء الأربعَة، أصحابِ السنَّة المُتَّبَعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائرِ الصَّحب والتابِعين، ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا أكرمَ الأكرَمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفرَ والكافِرين، وانصُر عبادَك المُوحِّدين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، واجعَل هذا البلدَ آمنًا مُطمئنًّا، وسائرَ بلاد المُسلمين.
اللهم آمِنَّا في الأوطانِ والدُّور، وأصلِح الأئمةَ ووُلاةَ الأمور، واجعَل ولايتَنا فيمَن خافَك واتَّقاك، واتَّبَع برِضاك يا رب العالمين.
اللهم وفِّق وليَّ أمرِنا لِما تُحبُّه وترضَاه مِن الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم.
اللهم كُن لإخوانَنا المُستضعَفين والمُجاهِدين في سبيلِك، والمُرابِطين في الثُّغور، وحُماة الحُدود، اللهم كُن لهم مُعينًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظَهيرًا.
اللهم إنَّا نسألُك الثباتَ في الأمر، والعزيمةَ على الرُّشد، ونسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، ونسألُك قلبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، ونسألُك مِن خَيرِ ما تعلَم، ونعُوذُ بك مِن شرِّ ما تعلَم، ونستغفِرُك لما تعلَم.
وقُومُوا إلى صلاتِكم يرحَمكم الله.
خطب الحرمين الشريفين

أعداءُ
الإنسان في الدنيا
ألقى فضيلة الشيخ علي بن
عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "أعداءُ الإنسان في
الدنيا"، والتي تحدَّث فيها عن وعد الله تعالى للعبدِ إذا أطاعَ واتَّبعَ
الهُدى، ووعِيدِه إذا عصَى واستكبَرَ وغوَى، ثم بيَّن صوارِفَ العبدِ عن طريقِه
إلى الله تعالى، وأعدائِه فِيه.
الخطبة الأولى
الحمدُ لله، الحمدُ لله بيَدِه الخَيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قَدير، قائِمٌ على كلِّ نفسٍ بما كسَبَت، يُوفِّي كلًّا بما عمِل، ولا يظلِمُ مِثقالَ ذرَّة ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]، أحمدُ ربي وأشكرُه على فضلِه الكبير، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليمُ الخبير، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، والسِّراجُ المُنير، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ المبعُوثِ بالكتابِ المُنير، وعلى آله وصحابتِه الذين أعزَّ الله بهم الدِّين، وأذلَّ بهم الشِّركَ الحقير.
أما بعد:
فاتَّقُوا اللهَ بالمُسارَعَةِ إلى الخيرات، ومُجانَبَةِ المُحرَّمات؛ تفُوزوا بأعلَى الدرجات، وتنجُوا من المُهلِكات.
أيها المُسلمون:
إنَّ الله وعَدَكم وعدَ الحقِّ ولا خُلفَ لوعدِه، ولا مُعقِّبَ لحُكمه، وعَدَ عبادَه الطائِعِين بالحياة الطيبةِ في دُنياهم، ووعَدَهم بأحسن العاقِبَة في أُخراهم؛ يُحِلُّ عليهم رِضوانَه، ويُمتِّعهم بالنعيم المُقيم في جناتِ الخُلد مع النبيِّين والصالِحين الذين اتَّبَعُوا الصراطَ المُستقيم.
قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 96]، وقال عزَّ وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: 65، 66].
أي: لو أنَّهم آمنُوا بالقرآن وعمِلُوا به، مع إيمانهم بكتابِهم من غير تحريفٍ له؛ لأحيَاهم الله حياةً طيبةً في الدنيا، وأدخلَهم الله جنَّاتِ النعيم في الأُخرى.
وقال سبحانه في ترغيب نوحٍ عليه السلام لقومِه: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10- 12].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تعالى قال: من عادَى لي ولِيًّا فقد آذَنتُه بالحربِ، وما تقرَّبَ إلَيَّ عبدِي بشيءٍ أحبَّ إلَيَّ مما افترضتُه عليه، ولا يزالُ عبدِي يتقرَّبُ إلَيَّ بالنوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإذا أحبَبتُه كنتُ سَمعَه الذي يسمَعُ به، وبصَرَه الذي يُبصِرُ به، ويَدَه التي يَبطِشُ بها، ورِجلَه التي يمشِي بها، ولئِن سألَني لأُعطينَّه، ولئِن استعاذَني لأُعيذنَّه، وما تردَّدتُ عن شيءٍ أنا فاعِلُه تردُّدِي عن نَفسِ المُؤمن يكرَهُ الموتَ، وأكرَهُ مساءَتَه»؛ رواه البخاري.
والحديث يدُلُّ على أنَّ الله تعالى بلُطفِه وكرمِه ورحمتِه وقُدرته يتولَّى أمورَ عِباده الطائِعِين، ويُدبِّرُهم بأحسَن تدبيرِه في حياتهم وبعد مماتهم.
ووَعدُ ربِّنا حقٌّ لا يتخلَّفُ مِنه شيءٌ، قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 9]، وقال عزَّ وجل: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 194].
ووعَدَهم الحقَّ في آخرتهم بقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 72].
والمُؤمنون يُشاهِدُون ما وعَدَهم ربُّهم في حياتهم الدُّنيا، ويتتابَعُ عليهم ثوابُ الله، وتتَّصِلُ بهم وتترادَفُ عليهم آلاءُ الله، كما قال عزَّ وجل: ﴿فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 148].
وسيَجِدُون في الآخرة الأجرَ الموعُودَ، والنَّعيمَ الممدُودَ، قال سبحانه: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ [القصص: 61].
وكما وعَدَ الله المُؤمنين الطائِعِين، توعَّد الكفَّارَ الجاحِدِين، والعُصاةَ المُتمرِّدين، وما أنذَرَهم به مِن العذابِ واقِعٌ بهم، قال عزَّ وجل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: 12]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: 23].
وحياتُهم في الدنيا أشقَى حياةٍ، قال عزَّ وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]، ولو أُعطُوا الدنيا.
وقال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55].
وقد ابتُلِيَ الإنسانُ بما يصرِفُه عما ينفَعُه، ويُوقِعُه فيما يضُرُّه، ابتِلاءً وفتنةً تُثبِّطُ عن الطاعات، وتُزيِّنُ المعاصِي؛ ليعلَمَ الله من يُجاهِدُ نفسَه، ويُخالِفُ هواه، ممن يُعطِي نفسَه هواها، ويتَّبِعُ شيطانَه، فيُفاضِلُ بين المُهتَدين بالدرجات، ويُعاقِبُ أهلَ الأهواء الغاوِيَة بالدرَكَات.
قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: 31]، وقال عزَّ وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
فالنفسُ مِن أعدَى الأعداء للإنسان، ولا يدخُلُ الشيطانُ إلا مِن بابِها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53]، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: 23]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
والنفسُ بما تتَّصِفُ به مِن الجهلِ والظُّلمِ تُبعِدُ صاحبَها عن التصديقِ بوعدِ الله، وتُثبِّطُه عن الاستِقامة، وتنحرِفُ بالإنسان عن الاعتِدال.
قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى: "فمَن عرَفَ حقيقةَ نفسِه وما طُبِعَت عليه، عَلِمَ أنها منبَعُ كل شرٍّ، ومأوَى كل سُوءٍ، وأن كل خَيرٍ فيها ففَضلٌ من الله مَنَّ به عليها لم يكُن منها، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 21]". اهـ.
ولا تَسلَمُ النفسُ من الجهلِ إلا بالعلمِ النافعِ الذي جاءت به الشريعةُ، ولا تسلَمُ من الظُّلم إلا بالعمل الصالح، ولا بُدَّ للمُسلمِ أن يرغَبَ إلى الله تعالى دائِمًا ويدعُوه لصلاحِ نفسِه.
عن زيدِ بن أرقَم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «اللهم آتِ نفسِي تقوَاها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهم إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفَع، ومن قلبٍ لا يخشَع، ومن نفسٍ لا تشبَع، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها»؛ رواه مسلم.
وروى الترمذيُّ من حديث عِمران بن حُصَين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمَ حُصَينًا كلمَتَين يدعُو بهما: «اللهم ألهِمنِي رُشدِي، وأعِذنِي مِن شرِّ نفسِي».
فإذا لم تَتزَكَّ النفس وتتطهَّر بالعلم الشرعيِّ والعملِ الصالحِ، استَولَى عليها الجهلُ والظُّلمُ، واتَّحَدَت مع الهوَى، فكذَّب صاحبُها بوَعد الله، واتَّبَع الشهوات، فتردَّى في درَكَات الخُسرانِ والعذابِ والهَوَانِ، وخسِرَ الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 50].
وإذا زُكِّيَت النفسُ وطُهِّرَت بالعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، تحوَّلَت إلى نفسٍ مُصدِّقةٍ بوَعد الله، مُطمئنَّةٍ مُنيبةٍ إلى ربِّها، تُبشَّرُ بالكرامةِ عند الموتِ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 27- 30].
وقاطِعُ سُبُل الخير، والداعِي إلى كل معصِيةٍ وشرٍّ عدوُّ الإنسانِ الشيطانُ الرجيمُ، الرِّجسُ النَّجِسُ - نعوذُ بالله منه -، جعلَه الله تعالى فتنةً للمُكلَّفين؛ مَن أطاعَه كان بأخبَثِ المنازِل، ومَن عصَاه كان بأفضلِ المنازِل، لذَّتُهُ وسُرورُهُ ونعيمُهُ في الغِوايَةِ والإفسادِ، يدعُو الإنسانَ إلى التكذيبِ بالوَعدِ والوعيدِ، ويُزيِّنُ له المُحرَّمات، ويصُدُّه عن الفرائِضِ والمُستحبَّات، ويَعِدُه الأمانِيَ الباطِلَة، ويغُرُّه بالوسوسةِ الخبيثةِ.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، وقال سبحانه عن إبليس أنه يخطُبُ أتباعَه في النار: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: 22].
وللشَّيطانِ مع ابنِ آدم سبعةُ أحوالٍ:
فهو يَدعُوه إلى الكُفرِ - والعياذُ بالله -، فإن استجابَ الإنسانُ، فقد بلغَ منه الشيطانُ الغايةَ، وضمَّه لحِزبِه، وإن لم يستجِب للكُفر، دَعاه إلى البِدعة؛ فإن نجَا من البِدعة بالاعتِصام بالسُّنَّة، والمُتابَعَةِ للكتابِ والسُّنَّة، دعاه إلى الكبائِر وزيَّنَها له، وسوَّفَ له التوبةَ، فتَمَادَى في الكبائِر حتى تغلِبَ عليه فيهلِك.
فإن لم يستجِب له في الكبائِر، دعاه إلى صغائِرِ الذنوبِ ويُهوِّنُها عليه؛ حتى يُصِرَّ عليها، ويُكثِرَ منها، فتكون بالإصرار كبائِر، فيهلِكُ لمُجانَبَة التوبة.
فإن لم يستجِب له في الصغائِر، دعاه إلى الاشتِغالِ بالمُباحَات عن الاستِكثارِ من الطاعاتِ، وشغَلَه بها عن التزوُّدِ والاجتِهادِ لآخِرَتِه، فإن نَجَا من هذه دَعَاه إلى الاشتِغالِ بالأعمال المفضُولَةِ عن الأعمالِ الفاضِلَة؛ لينقُصَ ثوابُه؛ فإنَّ الأعمالَ الصالحةَ تتفاضَلُ في ثوابِها، فإن لم يقدِر الشيطانُ على هذا كلِّه، سلَّطَ جُندَه وأتباعَه على المُؤمن بأنواع الأذَى والشرِّ، ولا نجاةَ من شرِّ الشيطانِ إلا بمُداومَةِ الاستِعاذةِ بالله منه، ومُداومَةِ ذكرِ الله عزَّ وجل، والمُحافظَةِ على الصلواتِ جماعةً؛ فهي حِصنٌ وملاذٌ ونجاةٌ، وبالتوكُّلِ على الله، ومُداوَمَةِ جِهادِ هذا الشيطان، والتحرُّزِ من ظُلمِ العباد.
قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: 36].
ومما يصُدُّ عن الحقِّ والاستِقامةِ والخيرِ: حُبُّ الدنيا والرِّضا بها من الآخرة، وجَمعُها من حلالٍ وحرامٍ، والرُّكونُ إليها، ونِسيانُ الآخرة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يونس: 7، 8]، وقال تعالى: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: 38].
والدُّنيا عدوَّةُ الإنسان إذا استَولَت على قَلبِه فاشتَغَلَ بها، وأعرَضَ عن عمل الآخرة، فأكثرُ أهل الأرض آثَرُوا الدنيا، قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: 16، 17]، وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [إبراهيم: 2، 3].
ولا نجاةَ مِن شرِّها وضرَرها، ولا وِقايةَ من سُوء أحوالِها إلا باكتِساب مالِها بالطُّرق المُباحَةِ المشرُوعةِ، وبالتمتُّع فيها بما أحلَّه الله مِن غير إسرافٍ وبذَخٍ وتبذيرٍ، ومِن غير استِعلاءٍ وتكبُّرٍ على الخلقِ، ومِن غير فرَحٍ وبطَرٍ بها.
ولا يستَطيلُ بقوَّته على حقوقِ العباد، ولا بُدَّ أن يعلَمَ حقيقتَها، وأنها متاعُ الغُرور، سريعةُ الزوال، مُتقلِّبةُ الأحوال، وأن يتذكَّر هذه الحقيقةَ دائِمًا، فذلك صلاحُ قلبِه.
عن المُستورِد الفِهريِّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما الدُّنيا في الآخِرةِ إلا كما يجعَلُ أحدُكم أصبعَه في اليَمِّ، فلينظُر بِمَاذا يرجِعُ؟!»؛ رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان.
وأن يكون على وَجَلٍ من شرِّها وعاقِبَتها، وأن يحذَرَ مِن أن يقول له الشيطانُ: إنما أعطاكَ ربُّك هذه الدنيا لفضلِك، ولعلمِك بوُجوهِ المكاسِبِ، كما غرَّ قارُونَ بهذا، فكانت عاقِبَتُه ما قد علِمتُم.
وأمرٌ مُهمٌّ يجبُ عليه فيها: وهو أن يُؤدِّيَ حقَّ الله فيها، ويُؤدِّيَ فيها حُقوقَ الخلقِ الواجِبَةَ، وهي: أداءُ الزكاة، والنَّفقةُ على الأهلِ والأولادِ والضَّيفِ، ومُساعَدةُ المُحتاجين، والنَّفقةُ في أبوابِ الخَيرِ بإخلاصٍ مِن دون رِياءٍ ولا سُمعةٍ، ولا طلَبِ مَحمَدَة؛ فالرِّياءُ يُفسِدُ العملَ.
وكان الصحابةُ الكبارُ لهم أموالٌ، وهم أزهَدُ الناسِ في الدُّنيا.
قال أبو سُليمان: "كان عُثمانُ وعبدُ الرحمن بن عَوف رضي الله عنهما خازِنَين من خُزَّان الله في أرضِه، يُنفِقَان في طاعتِه، وكانت مُعاملتُهما لله بقلوبِهما".
وفي الحديثِ: «ازهَد في الدنيا يُحبَّك الله، وازهَد فيما عند الناس يُحبَّك الناسُ»؛ رواه ابن ماجه من حديثِ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه.
والزُّهدُ فيما عند الناس: ألا يتعدَّى عليهم، ولا يظلِمَهم في حقوقِهم، ولا يتمَنَّى زوالَ النِّعَم عنهم، وأن ييأَسَ مما في أيدِيهم.
ومن أعظم الزُّهد الممدُوح: ألا يُحبَّ الترفُّع في الدنيا، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83].
باركَ الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفَعَنا وإياكم بما فيه مِن الآياتِ والذكرِ الحكيم، ونفَعَنا بهَديِ سيِّد المُرسَلين وقولِه القَويم، أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ الله العظيمَ لي ولكم وللمُسلمين، فاستغفِروه إنَّه هو الغورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله، الحمدُ لله لربِّيَ الحمدُ في الأُولى والأُخرَى، له الأسماءُ الحُسنَى، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له نَصِفُه ونُثنِي عليه بصِفاتِه العُلى، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا وسيِّدَنا مُحمدًا عبدُه ورسولُه المُصطَفَى، اللهم صَلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك مُحمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه الأتقِياء.
أما بعد:
فاتَّقُوا الله حقَّ التقوى، وتمسَّكُوا بدينِه الأقوَى.
عباد الله:
إن ربَّنا قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [فاطر: 5].
وفي الحديثِ: «الكيِّسُ من دانَ نفسَه وعمِلَ لما بعد الموت - أي: حاسَبَها -، والعاجِزُ من أتبَعَ نفسَه هواها وتمنَّى على الله الأمانِي»؛ حديثٌ حسنٌ عن شدَّادٍ رضي الله عنه.
وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: «إن للمَلَك لَمَّةً بالقلبِ؛ فلَمَّةُ الملَك تصدِيقٌ بالوَعدِ، وتصدِيقٌ بالحقِّ، وإن للشيطانِ لَمَّةً بالقلبِ؛ فلَمَّةُ الشيطان تكذِيبٌ بالوَعدِ، وتكذِيبٌ بالحقِّ».
والمُسلمُ عليه أن يُحاسِبَ نفسَه، ويُقيمَها على الصراطِ المُستقيم، ويحذَرَ مِن كيدِ الشيطان، ومِن هوَى نفسِه، ومِن الاغتِرار بالدنيا؛ فإنَّ متاعَها قليلٌ.
عباد الله:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا».
فصلُّوا وسلِّموا على سيِّد الأولين والآخرين، وإمام المُرسَلين.
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
اللهم وارضَ عن الصحابةِ أجمعين، وعن التابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم أعزَّ الإسلام والمُسلمين، اللهم دمِّر أعداءَك أعداءَ الدين إنَّك على كل شيءٍ قدير، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألُك مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علِمنا مِنه وما لم نعلَم، ونعوذُ بك مِن الشرِّ كلِّه، عاجلِه وآجلِه، وما علِمنا مِنه وما لم نعلَم.
اللهم إنَّا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك مِن النار وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختِم بالصالِحات أعمالَنا يا ذا الجلال والإكرام، برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم آتِ نفوسَنا تقوَاها، زكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها.
اللهم إنا نسألُك العلمَ النافعَ، والعملَ الصالِحَ.
اللهم اغفِر لموتانا وموتَى المُسلمين، اللهم اغفِر للمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمنات، الأحياء مِنهم والأموات برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدينِ، اللهم فقِّهنا والمُسلمين في الدينِ.
اللهم اكشِف كُرُبات المُسلمين، اللهم اكشِف كُرُبات المُسلمين، واكشِف الشَّدائِدَ يا رب العالمين التي نزلَت بالمُسلمين، اللهم ألِّف بين قُلوبِهم، وأصلِح ذاتَ بينهم، واجمَعهم على الحقِّ برحمتِك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألُك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام ألا تكِلَنا إلى أنفُسِنا طرفةَ عينٍ.
اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباعَه، وأرِنا الباطلَ باطلًا وارزُقنا اجتِنابَه، ولا تجعله مُلتبِسًا علينا فنَضِلُّ يا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام.
اللهم فرِّج همَّ المهمُومين مِن المُسلمين، اللهم نفِّس كَربَ المكرُوبين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين، اللهم واشفِ مرضانا ومرضَى المُسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا مِن إبليس وجنودِه وذريَّته وأوليائِهِ إنَّك على كل شيءٍ قدير.
اللهم إنا نسألُك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفَظ بلادَنا مِن كلِّ شرٍّ ومكرُوهٍ، واحفَظ جُنودَنا إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير، اللهم اكفِ بلادَنا شرَّ الأشرار، وكَيدَ الفُجَّار يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفِّق خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، وأعِنه على كلِّ خيرٍ يا رب العالمين، اللهم وفِّقه للرأي السديد، والعمل الرشيد، وأعِنه على ذلك إنَّك على كل شيء قدير، اللهم وفِّق وليَّ عهده لِما تُحبُّ وترضَى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعَل عملَه في رِضاك، اللهم وفِّقه للرأي السديد، والعمل الرشيد إنَّك على كل شيء قدير، اللهم وانفَع بهما الإسلامَ والمُسلمين يا أرحم الراحمين.
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201].
عباد الله:
﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
فاذكُرُوا اللهَ العظيمَ الجليلَ، واشكُرُوه على نِعَمِه يزِدكُم، ولذِكرُ الله أكبرُ، والله يعلَمُ ما تصنَعُون.
